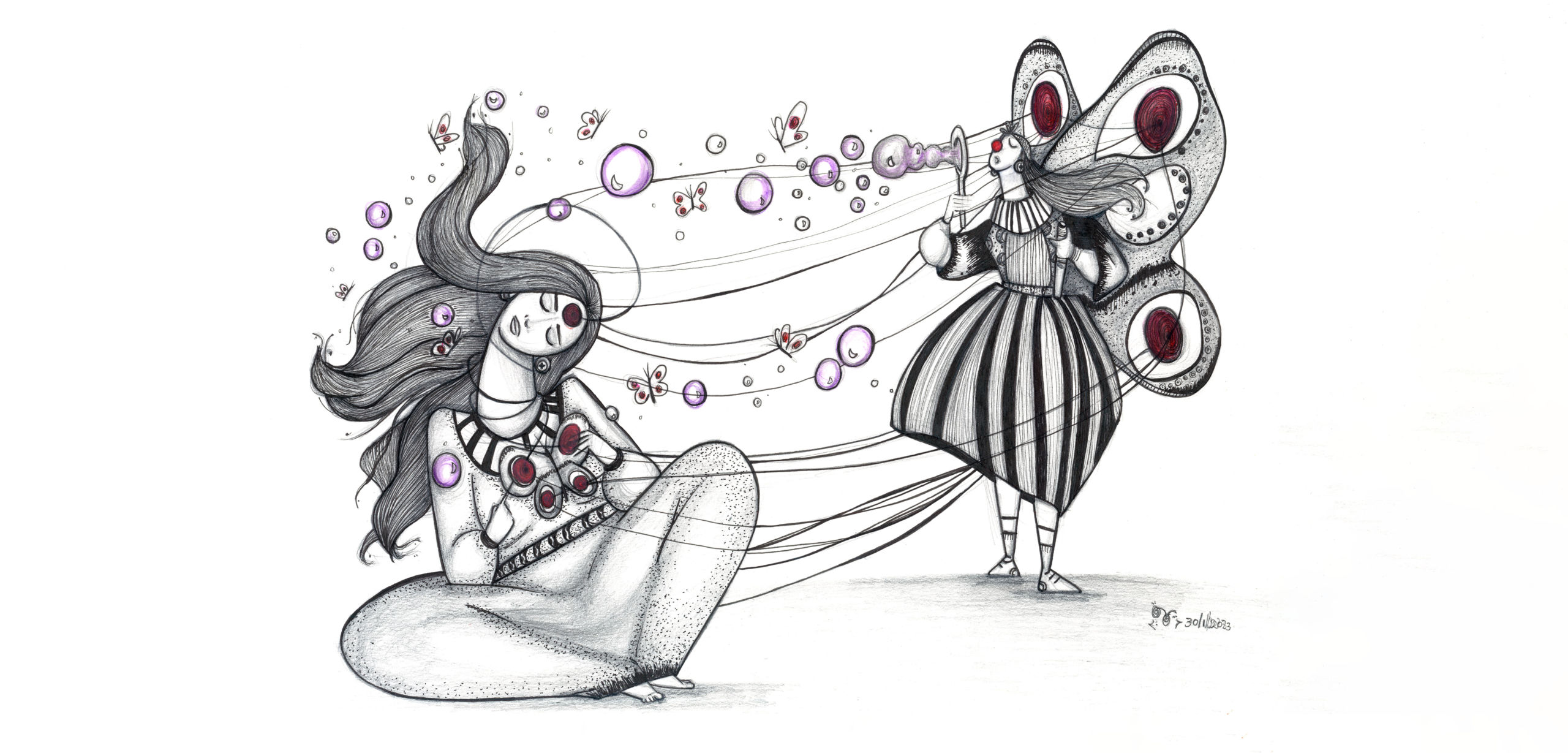قابلت أحد أقاربي عقب خروجه من السجن. عامان ونصف من الحبس الاحتياطي. ورغم كل المرارة والصعاب التي لازمته في محبسه، فإن أشد ما آلمه كان توقيت الاعتقال نفسه، عام 2019. يخبرني بأنها كانت لحظات هزيمة نهائية ومستمرة، ولم يكن هناك داعٍ للتنكيل. وضرب مثلًا بجنود مهزومين وجثثهم ملقاة في الصحراء، ثم جاءت الدبابات فمرت فوق الجثث والأشلاء. والسجن، بالنسبة له لم يكن الموت بل سحق الدبابات للأجساد.
كنت أعلم أنها سنوات مهدورة، وأن كل التجارب التي حكاها معتقلون، من مثقفين وكتاب وفنانين وقادة سياسيين، في أزمنة سابقة، لا تنطبق على السجون في لحظتنا الراهنة. لكن قريبي لخص الفارق قائلا: “حكايات وحواديت الشيخ إمام ولطفي بوشناق كلها (فشنك)”. ولا أعلم هل اعتقل الملحن التونسي لطفي بوشناق من قبل أو قضى سنوات في الحبس، أم أن قريبي يتحدث ساخرًا ويذكره كأي شخص يحمل العود والسلام. (أعرف الآن أن بوشناق كان على علاقة جيدة مع نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي).
ومن نتائج الدخول إلى السجن مهزومين، إن كان سجناء “الرأي” في حالة من التناحر والعدوانية مع بعضهم البعض، كما أخبرني. ورغم كلماته المريرة، وجدته محتفظًا بنقاء روحه وتوقد ذهنه الذين طالما عرفتهما فيه قبل السجن.
أتابع أخبار المعتقلين، لذلك تبددت منذ فترة التصورات الحالمة عن السجن بوصفه فسحة للتأمل أو تجربة مغايرة للعيش. لكن الكلام السابق يؤكد أن غاية المراقبة تكمن في جعل الحياة داخل السجن منزوعة التجربة، وخالية من أي معنى.
المزحة القديمة عن أن السجن هو فرصة لقراءة هيجل وفهم كتابه “فينومينولوجيا الروح” لم تعد صالحة. ورغم كونها مجرد مزحة، فإنها مع ذلك كانت مصدرًا خفيًا للعزاء- على الأقل بالنسبة لي: أن هناك نشاطًا للروح والعقل لا يمكن أن تحده الأسوار، وأنه يمكن للإرادة والخيال مقاومة سجن الجسد.
في كل يوم من حياتنا العادية، ينطفيء حلم. وربما لأسباب أقل قسوة من السجن بكثير. تتسرب الحرية، رويدًا رويدًا، من بين أيدينا. نظن أن الحرية الخارجية، الظاهرية، الممنوحة لنا، هي الشكل الأهم من الحرية. لذلك نساوِم، ونساوَم، عليها بما عداها
لذلك كانت مطالبة المبرمج والكاتب والناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح بحقه في القراءة داخل محبسه، واستمراره لأكثر من خمسين يومًا في الإضراب عن الطعام -لم ينهي علاء إضرابه حتى كتابة هذه السطور- حتى يحصل على حقوقه الأساسية التي حُرم منها، مثيرة للتأمل وباعثة للأمل. إذ إنها تُعيد إضفاء المعنى على الصراع كله. والأهم أنها لا تلجأ إلى فعل “طبيعي” كنوع من “المقاومة”، بل إنها تدفع الجسد إلى ما فوق الحدود الطبيعية من أجل الحصول على الحقوق الأساسية، الطبيعية.
وهنا تصير القراءة فعلا تضامنيًا. ينتقي من هم خارج السجن كتبًا يهدونها إليه في حملة إلكترونية تحت الوسم “نقرأ مع علاء“. وخلف “رمزية” التضامن والمشاركة، تمكث حقيقة “مادية” ثقيلة عن جسد في مقاربة مع الفناء. وربما يكتسب “الرمزي” زخمه من هذه الحقيقة دون سواها، كما يكتسب السجن من الجسد موضوعه ومادته.
أنظر إلى الكتب المتناثرة حولي. أفكر في أوقات فتوري عن القراءة وانشغالي عنها بتوافه لا معنى لها، ثم أدرك مسئولية أن تكون حرًا في قراءة ما تختاره، وحدود هذه الحرية، قيمتها ومعناها.
في كل يوم من حياتنا العادية، ينطفيء حلم. وربما لأسباب أقل قسوة من السجن بكثير. تتسرب الحرية، رويدًا رويدًا، من بين أيدينا. نظن أن الحرية الخارجية، الظاهرية، الممنوحة لنا، هي الشكل الأهم من الحرية. لذلك نساوِم، ونساوَم، عليها بما عداها. نزهد في حريتنا الداخلية، وهي في الأصل، النوع الوحيد من الحرية التي يراد أن تُسلب منا.
مساحة الفعل
الملهم في إضراب علاء عبد الفتاح أنه من أجل حقوقه كـ”سجين”، أي من أجل تحسين ظروف السجن، واحتجاجًا على سوء معاملته وحبسه انفراديًا وحرمانه من التريض والقراءة. توصف المطالب من كثيرين بأنها “إنسانية” و”بسيطة”. بالطبع هي جزء من صراع أكبر لكنها تلخص أيضًا جوهر المقاومة الحقيقية التي يقدمها علاء.
في حواره الأخير مع موقع مدى مصر، يتحدث عبد الفتاح عن ضرورة إيجاد “مساحة للفعل”. والإضراب عن الطعام هو المساحة التي خلقها من أجل “الفعل”. بالنسبة لعلاء، أن “تفعل” الآن أهم من أن تنتظر خروجك من السجن حتى “تقاوم” من جديد. لأنك ربما تقضي أيامك وسنواتك في انتظار تلك اللحظة البعيدة، مسايرًا ومتجنبًا للصراع ولو كُتب عليك كرهًا. لكنك فور خروجك لن تصير أنت الذي كنته قبل الدخول. ربما تخرج محطمًا ومكسورًا، “مسحوبًا من رصيدك الإنساني” بتعبير الكاتب المصري علاء خالد.
تصف منى سيف أخاها بأنه “واحد من أهم سجناء الرأي في مصر”. وما يبدو للبعض مبالغة محمودة – أو مذمومة- هو عين الحقيقة. علاء عبد الفتاح ليس سجينًا سياسيًا ذا بُعد واحد، فهو قادر على تعميق أفكاره السياسية بروافدها الإيديولوجية لتتحول إلى “أفكار إنسانية أكثر شمولًا”. نلحظ في مقابلته مع “مدى” رغبة في مساءلة الوعي السابق وتحريره، ومقاومة الجمود والأفكار السائدة.
أشعر أن جرامشي ربما كان أوفر حظًا من علاء. فرغم أنه دفع حياته ضريبة لنضاله ضد فاشية نظام موسوليني، ورغم مرضه واعتلاله الدائم، فقد تمكن من كتابة اثنين وثلاثين دفترًا، أي ثلاثة آلاف صفحة مكتوبة بخط اليد
هكذا تصبح المطالب “الإنسانية” أو “الآدمية” التي يُنادي علاء بها، من داخل محبسه، خطوة إلى الأمام في سبيل الحرية لا مجرد رغبة واقعية في تحسين شروط القمع من أجل البقاء والاستمرار. ودلالة فعل علاء غاية في الجلاء: إنه يعلن عن عزمه ملامسة خطر الفناء إن تطلب الأمر. وربما يبتسم الآن الفناء داخله لأننا رفعنا رأسنا. قد يكون هاشتاج “نقرأ مع علاء” مجرد تريند لا يلبث أن يزول، لكني أراه الآن دليلًا على أنه لا ينبغي لحياتنا الإنسانية أن تكون خاضعة للقيم التي يفرضها أي نظام السياسي، وأننا لسنا أفرادًا منعزلين، أو مجرد ذوات فردية منكفئة على كتبها.
وأدرك الآن أن جوف علاء خاوٍ من الطعام، لكنه يمتليء بالخلود.
من “ميكي” إلى “جرامشي”
كانت المرة الأولى التي سمعت بها مقولة المفكر والمناضل الماركسي أنطونيو جرامشي عن “تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة” خلال لقاء تلفزيوني لعلاء عبد الفتاح، ومعه مجموعة من شباب الثورة، على قناة On TV يناير 2013. كانت أفكار جرامشي المألوفة لي وقتها هي تلك المتعلقة بـ “المثقف العضوي” ودوره في تغيير ونقد ثقافة محيطه. اختتم علاء حديثه بأنه ينبغي التمسك بـ “تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة”. والفكرة كما أفهمها الآن تعني الرؤية النقدية للواقع بما فيه من قضايا جدلية ومثبطات كبرى مع السعي من أجل تغييره. ربما لأننا محكومون بالأمل، كما يقول سعد الله ونوس.
يقول الصديق الروائي المصري نائل الطوخي، على حسابه بفيسبوك، إن سلسلة من ثلاث مقالات، كتبها علاء عبد الفتاح داخل السجن، قد وصلت إليه أثناء عمله محررًا لصفحة الرأي في موقع مدى مصر. تناول فيها علاء فكرة اقتصاد التشارك وجماعة اللوديين المعادية للتكنولوجيا. واندهش نائل من أهمية المقال وتماسكه رغم كتابته في ظروف غير طبيعية داخل السجن. بعدها، وصل إليه مقال علاء “صورة للناشط خارج محبسه“. وبعد القراءة قال لمدير التحرير “مش لاقي غلطة في المقال”. لم يكن المقال “صحيحًا” فقط وإنما مبهرًا أيضًا.
لا أعرف علاء بشكل شخصي لكني أخمن أنه يحب جرامشي. “علاء بيقرا كل حاجة من ميكي لجرامشي”، كما تقول أخته. ومن كان جرامشي ملهمه فلا غرابة في أن تكون كتابته على هذه الدرجة من الدقة والإبهار رغم محبسه.
لقد اعتاد الناس على هذا الشيء الغريب.. وبما أنهم اعتادوا عليه، فقد تم إصدار حكم عليه. ليجوع كما يشاء، وهو ما يفعله في الواقع، لكن لن يستطيع أي شيء إنقاذه. لم يلتفت إليه أحد
قضى الفيلسوف والمناضل الإيطالي أحد عشر عامًا داخل السجن. قبل اعتقاله عام 1926، كان جرامشي من قادة انتفاضة العمال في “تورينو”، أسس الحزب الشيوعي الإيطالي وترأس اللجنة التنفيذية، كما ساهم في تحرير عدة صحف ومجلات اشتراكية. إضافة إلى اهتماماته البحثية في مجالات الفكرية والثقافية والأدبية.
أشعر أن جرامشي ربما كان أوفر حظًا من علاء. فرغم أنه دفع حياته ضريبة لنضاله ضد فاشية نظام موسوليني، ورغم مرضه واعتلاله الدائم، فقد تمكن من كتابة اثنين وثلاثين دفترًا، أي ثلاثة آلاف صفحة مكتوبة بخط اليد، قدم من خلالها إسهامات نظرية متعددة، وتناول فيها مراحل مختلفة من التاريخ الإيطالي وشتى الموضوعات السياسية والفلسفية والأدبية، فيما عرف بعد ذلك بـ ” كراسات السجن“.
ربما لو توفر لعلاء الحد الأدنى من الظروف الطبيعية و الوثائق والمواد الببليوغرافية داخل محبسه لاستطاع إنجاز مقالات وموضوعات أكثر. إلا أن جرامشي كان أكثر حظًا كذلك حين مُنح فرصة كتابة الرسائل وإرسالها إلى أمه وزوجته وأبناءه وبعض أقاربه، مخلفًا بذلك إرثًا إنسانيًا عظيمًا، “رسائل السجن“.
دعونا نلقي نظرة على رسائل جرامشي إلى أمه “جيوسبينا مارسياش” ومحاولاته المستمرة لطمأنتها على صحته، ونقارن بينها وبين محاولات السيدة الدكتورة ليلى سويف والدة علاء المضنية، نومها على الرصيف أمام سجن طرة، حتى تسمح الداخلية باستلامها خطابًا من ابنها. كل هذا في ظل وباء عالمي، والسجن بمثابة بؤرة له. كانت ترفع ورقة بيضاء كتبت عليها: “عايزة جواب من ابني”. باتت الأم ليالٍ على الرصيف، في أجواء وباء مرعب، من أجل “جواب” تطمئن منه على ابنها بعد منع الزيارات، حتى تسلمته في النهاية.
خط ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft
قبل أن يأتي يوم لا عد فيه ولا إحصاء
بينما يختار البعض روايات وأعمال طويلة ليقرأها علاء حتى يقتل الوقت، أجدني أفكر في نص قصير لا تستغرق قراءته سوى دقائق. هل قرأت يا علاء”فنان الجوع“؟ آخر قصة كتبها كافكا قبل وفاته.
تدور القصة حول رجل يعمل كـ “فنان جوع”، كان يصوم من أجل العيش. يرتحل من مدينة إلى أخرى مُقدما عروضه في مكان عام داخل قفص مبطن بالقش. لم يكن مروج/مدير عروضه يسمح بأن تزيد مدة صيامه عن أربعين يومًا، لا خوفًا عليه وإنما لأنه وجد أن اهتمام الجماهير يفتر بعد أربعين يومًا.
يحتشد الناس حول القفص ليشاهدوا الفنان وهو في قمة هزاله، وحين تنتهي مدة الأربعين يومًا، يقطع المدير صيام الفنان عنوة، ويطعمه بالقوة، ثم يتفرق الحشد. في الحقيقة أكثر ما يجعل فنان الجوع بائسًا هو أنه قادر على الصيام لفترة أطول، وأنه يعتقد أن المشاهدين يكرهونه.
أرجو ألا تتعجل وتعتبر الترشيح إحالة ساخرة إلى تماثل وضعك داخل السجن مع حالة فنان الجوع داخل قفصه. أنت لا تشبه فنان الجوع في شيء، لكننا، نحن المتابعين لأخبارك، نشبه جمهوره في نقاط كثيرة.
إنها قصة عن سوء فهم أبدي. كان الجمهور يشكك دائما في تفاني الفنان وتضحياته من أجل فنه.
بدأ وضع فنان الجوع في التدهور، و”تطلع الجمهور لأشكال جديدة وأكثر إثارة من الترفيه”. وانضم الفنان مضطرًا إلى السيرك وأصبح عرضًا جانبيًا. كانت عروض السيرك الأخرى تجذب الحشود، خاصة عروض الحيوانات، وتُصرف انتباهها عن الفنان البائس. وكانت النتيجة أن استمر الفنان في الصيام إلى أطول مدة ممكنة، ولم يوجد من يهتم بإحصاء عدد أيام الصيام.
في النهاية ظن مشرف السيرك أن القفص فارغًا، لكن بإمعان النظر وجدوا الفنان مدفونًا في القش.
كانت كلمات الفنان الأخيرة للمشرف أنه مجبر على الجوع لأنه لم يجد طعامًا يرضيه.. “لو كنت عثرت على الطعام الذي أشتهيه، صدقني، لما أحدثت ضجة، ولأكلت منه حتى أشبع مثلك ومثل الباقين”.
لا أسعى إلى إسقاط رمزية القصة عنوة على حالة علاء. فلا السجن قفص اختياري ولا الإضراب عن الطعام فن زائل. لكن جمهور المشاهدين واحد في الحالتين، في القصة والواقع.
نتابع أخبار علاء ثم يلهينا السيرك المنصوب حولنا في الواقع الفعلي والافتراضي. ونحن مثل جمهور الفنان في إصداره الأحكام والتفتيش في النوايا. والأهم نشبههم في اعتياد القسوة.
وكما كتب كافكا:
” لقد اعتاد الناس على هذا الشيء الغريب.. وبما أنهم اعتادوا عليه، فقد تم إصدار حكم عليه. ليجوع كما يشاء، وهو ما يفعله في الواقع، لكن لن يستطيع أي شيء إنقاذه. لم يلتفت إليه أحد”.
لكننا نختلف كذلك عن ذلك الجمهور، إذ أن منا الجوعى دومًا، كفنان كافكا، ولكن بلا أقفاص. وحده علاء يستطيع أن يجعل من جوعه شيئًا نبيلًا، أن يخلق المعنى من قلب البؤس.
بين الرمز والجسد
نلحظ في كتابات علاء وحواراته مكانة محورية لفكرة “الجسد”. فمثلا، يُلخص ما أرادته ثورة يناير، كحدٍ أدنى، في شقين: 1- الديموقراطية في شكلها الليبرالي التقليدي من تداول السلطة، 2- ما أسماه بـ “وقف امتهان الجسد”.
في مقاله “مدخل شخصي للفجر في الخصومة”، يقدم علاء ما يعتبره “قصة أجساد المساجين”، وهي قصة من الأهمية بحيث تتعدى كونها تخص صحة المساجين فقط، وإنما القصة “تخص الوطن نفسه”. فأجساد المساجين بعد خروجهم، فاقدين “جانبًا لا يعوض من أرواحهم وصحتهم”، “ستتفاعل مع أجساد ذويهم وأحبابهم، وآثار تلك الجراح لن تُحتوى داخل أسوار السجن”.
والسجن، كما يرى علاء، هو النفي التام للجسد حيث “الاستباحة الكاملة لأجساد المساجين”، وإخضاع الجسد من خلال الأدوات القمعية. لذلك يطرح علاء سؤالا مع نهاية المقال:
” كيف نحمي أجساد أبنائنا من ميراث السجون هذا ؟”.
هذا الميراث يتمثل في “فُجر الخصومة” حيث أن ” قمة الخصومة هي ألا تراني ولا تحاول أن تفهمني؛ أن أتحول إلى مادة فقط للإزاحة أو اﻹبادة أو الحجب أو النفي أو اﻹقصاء، أن أتحول إلى رمز أو فزاعة بلا وجود جسدي مادي”.
يعارض مفهوم “الخصومة” فكرة “الرزانة العقابية” التي يرصد فوكو التحول التاريخي إليها مع مطلع القرن التاسع عشر. أي سياق استباحة الجسد مقابل سياقات ضبطه الغربية. صار الجسد بموجب ذلك النوع الحديث من العقاب، كما يحلله فوكو، خاضعا لنوع من الانضباط والمراقبة التقنية من قبل الأطباء والعلماء النفسيون من أجل ضمانة تحقيق “العدالة”. انمحى المشهد الكبير للعقاب الجسدي، والتعذيب كتقنية للألم. فالجسد والألم لن يكونا الغرض النهائي لعمل مؤسسة العقاب التأديبية الأوروبية.
لا يكتسب الجسد بذلك وجوده المادي فقط، وإنما قدرة راديكالية أيضا. عصيان وتمرد ضد كل بؤس جسدي، ضد إرث كامل يمتد منذ عقود. عصيان ضد البرد، ضد الاختناق والتكديس، ضد الضرب
ورغم مركزية الجسد في كلا الرؤيتين، فإن علاء لا يتخذ علاقة الجسد بالمؤسسة العقابية الغربية كحالة معيارية ويقيس عليها الأوضاع في السجون المصرية، بقدر ما يضعها- دون أن يشير إليها- كمسلّمة أمام من “لديهم تصور مسبق أن الغرض من السجون هو تدمير الصحة”، كما يصفهم في مقاله. هو لا يبحث عن “منطق” السجن، وإنما يقدمه فهمه لحقيقته. لذلك يقول إن “أول درس تتعلمه في السجون، لا تمرض.”
إذن، لماذا ينقض علاء، بإضرابه عن الطعام، درسه الأول والأساسي؟
لأن هذا الإضراب هو صوت السجين، الذي كما يقول “ينتفي تأثيره تمامًا ما أن يُحجب المرء خلف أسوار السجن”. هذا الإضراب هو “ما يحكيه الصوت عن الجسد”. وكلما ازداد الجسد وهنًا، علا صوت الحكاية.
لا يكتسب الجسد بذلك وجوده المادي فقط، وإنما قدرة راديكالية أيضا. عصيان وتمرد ضد كل بؤس جسدي، ضد إرث كامل يمتد منذ عقود. عصيان ضد البرد، ضد الاختناق والتكديس، ضد الضرب.
ومن خلال مراكمة الضعف والهشاشة لن يتحول إلى رمز، بل إلى وسيلة للتغيير.