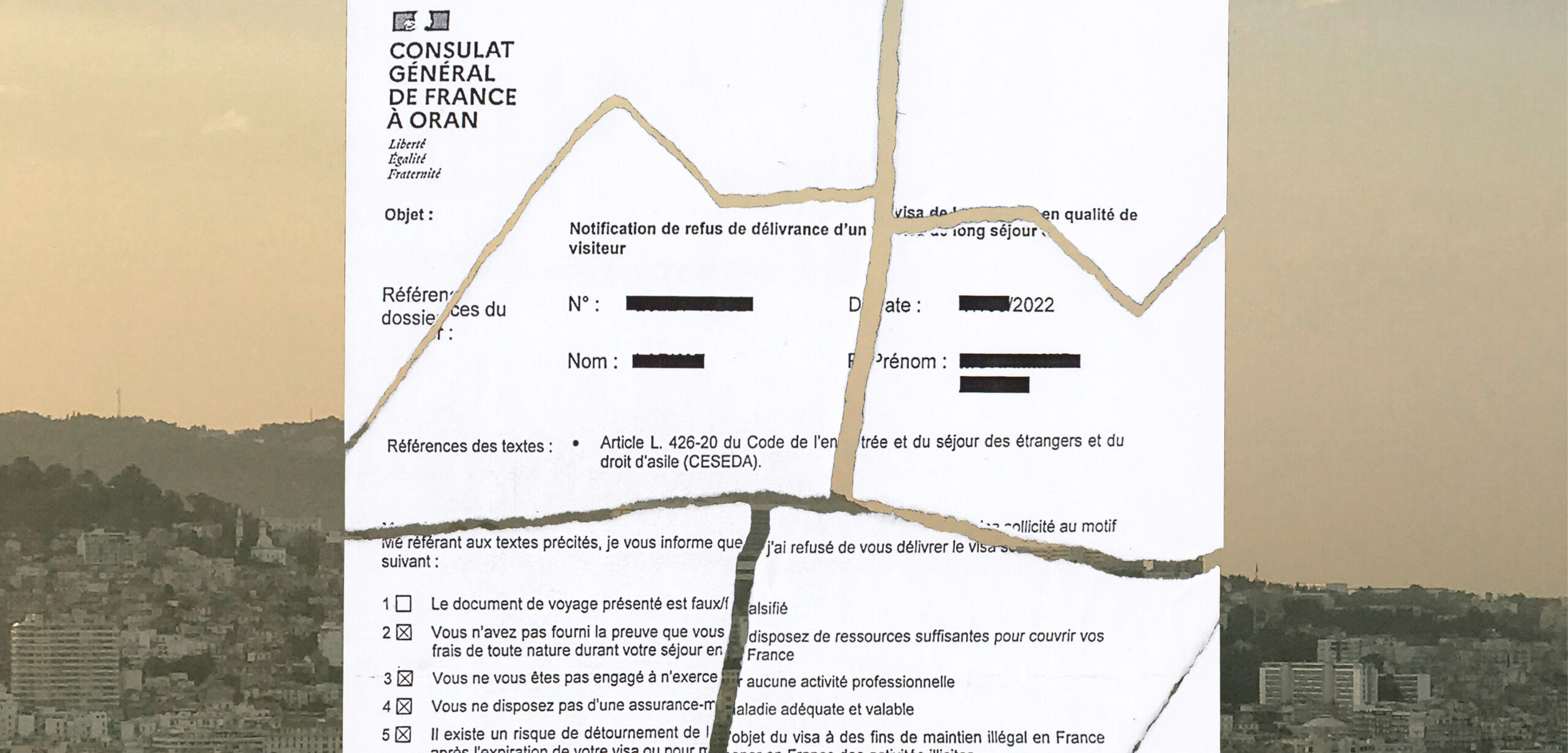في الأيام الأولى لاندلاع الحرب في السودان، منتصف أبريل من السنة الجارية، كنا نتناقش أنا وإحدى أخواتي عن المستندات التي يجب حفظها وتحضيرها قريبًا تحسبًا لأي طارئ، لم يكن لإحدانا الجرأة للتحدث بإسهاب عن ماهية هذا الطارئ لأن مجرد الفكرة كانت مرعبةً بصورة كافية. اليوم، أكتب هذه السطور، سبعة شهورٍ تحوّلت فيها حياتنا إلى طارئ-مستقر، وقد نزحنا بعيدًا عن بيتنا.
جهزت حقيبة ظهرٍ صغيرة وضعت فيها بعض المقتنيات المهمة، وجواز السفر الموشك على الانتهاء، وقضيت بقية الليل محاولةً تجاوز أصوات الرصاص ومفكرةً في نفس الوقت كيف أقنع والدي بأنه في وقتٍ ما يجب علينا الخروج، خصوصًا وقد خلا حي المجاهدين، الذي نقطنه في جنوب الخرطوم، من الجيران وتجاوز انقطاع الكهرباء للأسبوع. وبدأت تصل الأخبار لبدء اقتحام المنازل في أحياء معينة مثل حي المدينة الرياضية، ذات المكان الذي شهد ساعة الصفر حسب عدة أقوال. وبحكم وقوع منزلنا جوار إحدى تلك المناطق فقد كان الدور قادمًا علينا بالضرورة.
عملية الخروج بعينها من مكانٍ لآخر في ذلك الوقت -وإلى الآن- تظل خطرة وتخضع لعددٍ كبير من المتغيرات والأسئلة: هل نأخذ كل المقتنيات الثمينة؟ هل نخرج متفرقين أو جماعة؟ ماذا لو تم نهبنا في الطريق أو إطلاق الرصاص علينا؟ ماذا لو تمت مداهمتنا في المنزل؟ هل يجب عليّ أخذُ غرفتي كلها؟ هل أترك الأشياء بترتيبها؟ عصفت بي عشرات الأسئلة في زمنٍ ضيق جدًا لاستيعابها، كانت أطرافي باردةً جدًا وأنا أحاول جمع حياتي في حقيبةٍ صغيرة.
عكف والداي على بناء منزلنا هذا، بجنوب الخرطوم، طوال العقدين الماضيين، وكنت شاهدةً على جميع المراحل وهذا حال كثير من الأسر حيث تمثل هذه المنازل مدخرات سنينٍ من التعب والعمل المتواصل. أتفهم الآن لماذا لم يقدرا على أخذ أي شيءٍ سوى بعض الملابس.
قررنا الخروج والذهاب لمنزل الأسرة الكبير بأم درمان. صار الطريق –وعلى غير العادة- طويلًا، بين الخرطوم ومنزل جدي بحي العرضة بأمدرمان. نفس هذه المسافة قطعناها في الليلة السابقة للحرب في 30 دقيقة وكنا نقطعها كل أسبوعٍ في نفس الزمن، كيف نأخذ أكثر من ساعتين حتى نصل بيت جدي؟ هذا كان كل ما يجول بخاطري خلال الطريق. طيلة الطريق لم أستوعب كيف لهذه المدينة التي لا تهدأ عادةً، أن تصير مدينة أشباح، لا يُسمعُ فيها سوى صوت الرصاص والعربات القليلة التي خاطرت بالتحرّك.
وصلنا المنزل الكبير لجدي بأم درمان. في ذلك الوقت لم تكن الحرب والاقتحامات الممنهجة لميليشيات الدعم السريع لمنازل المواطنين قد وصلت المدينة. ارتباطي بمنزل جدي وثيق، وأكاد أجزم بانتمائي إليه أكثر من الأماكن التي عشت فيها في الخرطوم مجتمعة.
مضى أسبوعان وبضعة أيام حتى أصبحت الاقتحامات قريبةً كفاية لتبقينا يقظين ليلًا، ثم تتولّى أصوات الاشتباكات مهمة إبقائنا بلا نوم نهارًا. ليلةٌ طويلة من الخوف كانت كفيلةً بإقناعنا جماعةً بضرورة إخلاءنا لمنزل جدي ما أن طلع الصباح، تأكدت ضرورة هذا القرار بتصاعد الأحداث من حولنا، خاصةً بعد أن سمعنا عن اقتحام منزلنا من طرف ميليشيات الدعم السريع.
غادرنا صباحًا للمرة الثانية إلى خارج ولاية الخرطوم، إلى الولاية الشمالية بالتحديد. كانت المغادرة هذه المرة أصعب وأثقل علينا جميعًا. نفس العوامل الكثيرة والاحتمالات اللانهائية ماذا نترك وماذا نأخذ وأي طريق نسلك وأي زمنٍ هو المناسب، لا إجابة صحيحة قاطعة. مرةً أخرى كانت الإجابة: طالما نحن معًا لا يهم وطالما سنكون في مكانٍ آمنٍ نسبيًا.
وصلنا بعد رحلةٍ أخرى استغرقت اليوم كله لولاية الشمالية، قطعنا فيها أزيد من 425 كلم. قضينا أسبوعًا كاملًا في ضيافة أقاربنا. كلما أفكر في وقعِ الذي حدث أتنبه إلى شكل النسيج الاجتماعي الفريد في السودان، فلولا شكل هذا الترابط الأسري الممتد لما استطعنا مجابهة المصائب المتتالية التي تحل بالبلاد على مدى عقود. خير البيوت السودانية لا يشمل قاطنيها فقط، بل يعم الأسر بأجيالها المتتابعة وبامتدادها.
انقطعتُ أسبوعًا عن شبكات الاتصال، فلم أتابع ماذا يحصل في الخرطوم، وكان هذا كافيًا لاسترداد شكل الحياة بلا صوت الرصاص. لكن النوم الهادئ كان غريبًا في أولى الليالي، كذلك تجولّنا بحرية بين جنائن النخيل الواسعة. شعرتُ بالغرابة عندما حصلت وفاةٌ في الحي، واستطاع الناس تأدية واجب العزاء والوقوف مع أهل المتوفى. تذكرتُ كل معارفي الذين فقدوا أناسًا على مدى الاسابيع الماضية ولم أستطع رؤيتهم ولا تعزيتهم.
انتقلنا مرةً رابعة. نحو المنزل الذي استأجرناه بمدينة كريمة، بنفس الولاية. الرحلة كانت أقصر والمكان كان مألوفًا لوالدي الذي قضى فيه بضع سنين خلال مرحلة الثانوية. ونحن نحاول ترتيب المنزل وابتكار نظام حياة جديد مختلف عن كل ما اعتدناه، لاحظت نبتة البامبو الصغيرة التي يحملها خالي. وضعها بالقرب من الباب ومنظرها كان ظلّ يذكرني بأشجار ونبتات جدي المتنوعة وحديقتنا الصغيرة بمنزلنا بالخرطوم. أتساءل في كل مرة أرى فيها البامبو: لماذا هي من دون النبتات وكيف تذكر أخذها؟ أعود لليوم الذي كنت أحاول وضع غرفتي بأكملها في الحقيبة وانتهى بي الأمر لترك معظم الأشياء وإرجاعها أملًا في إنها مسألة بضعة أيام وسنعود.
اليوم، كل هذه الأغراض الناجية من النزوح والنهب صارت هي أساس كل مكانٍ نسكنه. إعادة ترتيبها جعلني أفكر في الأسباب التي جعلتني أخذ أشياء بعينها دون الأخرى، وبدأت أركز أيضًا في الأشياء التي أخذها كل أفراد أسرتي معهم. تذكرت بوضوح يوم غادرنا منزل الخرطوم ورجوعي مسرعةً لأخذ ألبومات الصور القديمة قبل مغادرتنا بدقائق.
لم تستطع أختي، طالبة الطب، ترك سماعتها وميزان الضغط الذين اشترتهما بنفسها، لم تستطع ترك ما يربطها بمستقبلها كطبيبة في بلدٍ توقف فيه التعليم بكل مراحله في كافة عموم البلاد. لم تستطع أختي الأخرى ترك مجموعتها من طلاء الأظافر والمكياج، الأشياء التي تعكس هوايتها وحبها للألوان.
لا يشرب جدي الماء إلا من “القلة” الخاصة به ومن مجموعة الأزيار العديدة بمنزلنا العريق بأم درمان، وأيضا لم ننس أخذ ساعته المفضلة. كل مرة أشم فيها رائحة البخور تأخذني الرائحة مباشرة لكلا المنزلين في الخرطوم وأمدرمان وكل تفاصيلهما. نُهِب البيتان ، أكثر من مرة، كما وصلتنا الأخبار. حيث عاثت فيهما المليشيات خرابا ودمارا كمعظم منازل ولاية المدينة وتضاعفت قيمة كل غرضٍ في حوزتنا.
فقدتْ الأغراض التي حملناها معنا، ومع مرور الوقت، عشوائية اختيارها. لماذا هذا الغرض وليس ذاك؟ وماذا حلّ بالغرض الذي بقي.. صارت أغراضنا رابطنا بما مضى. تُخفِّفُ عنّا وطأةَ وثِقل ما نجهله مستقبلًا، الذي نُحاول أن نواجهه مُحتَفِظين بالأهم: أن ننجو معًا.. مهما حدث.