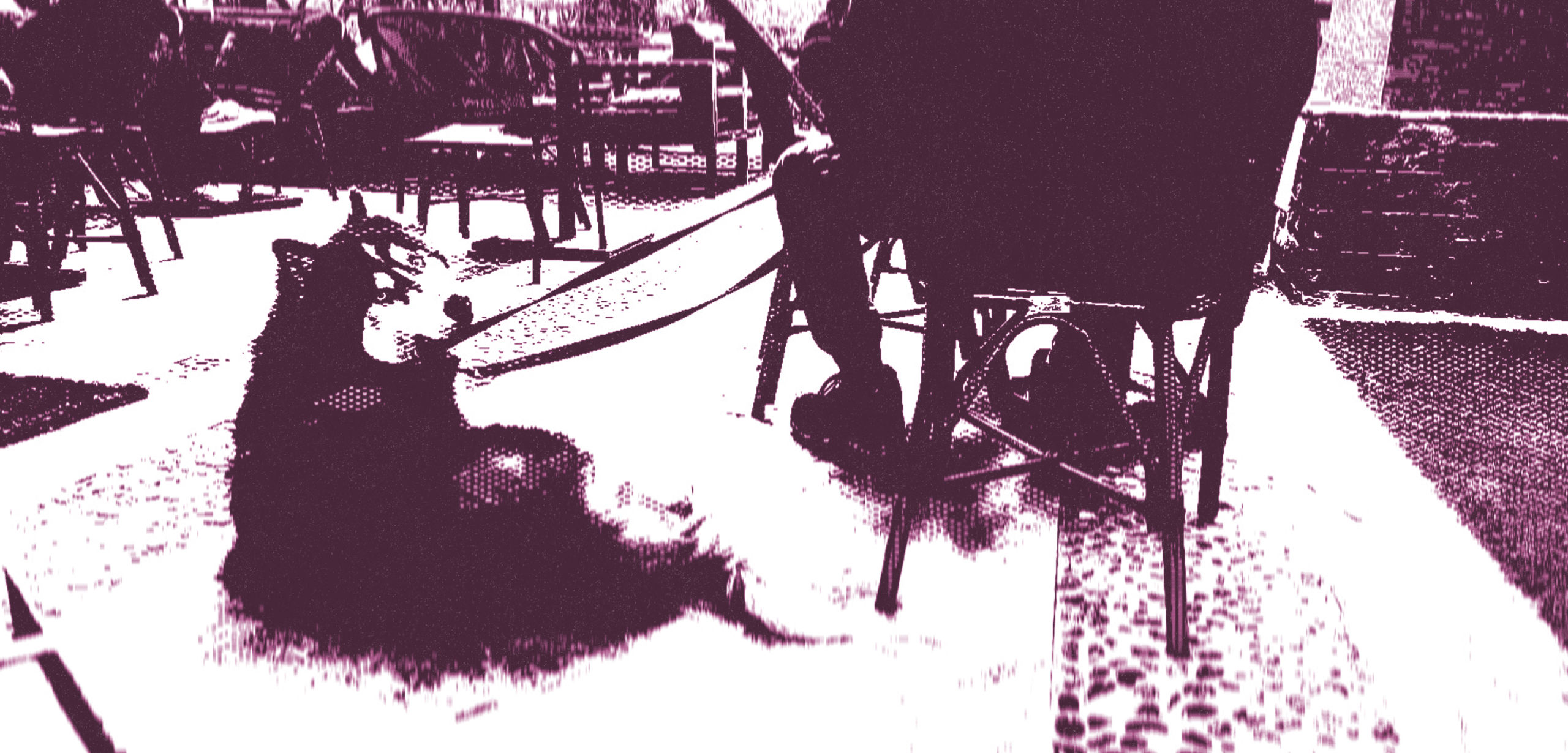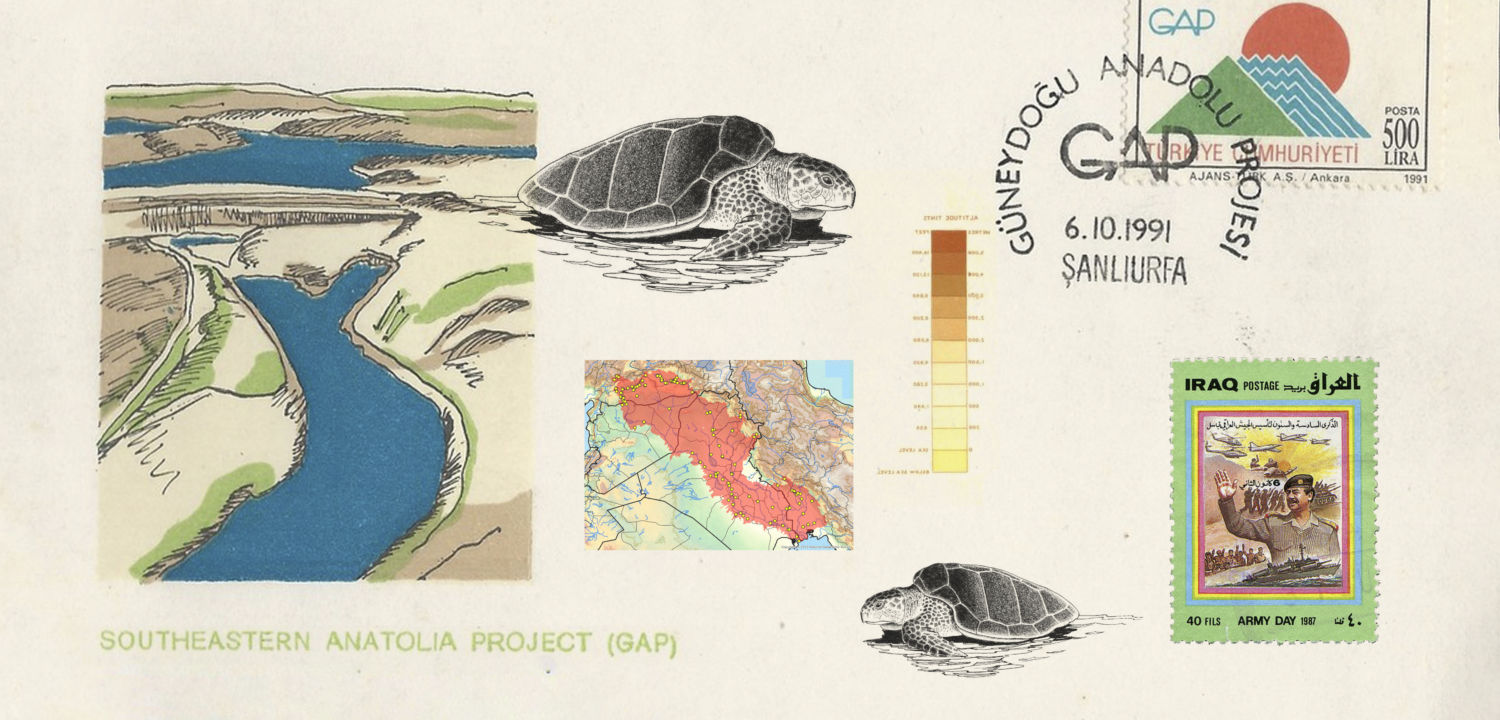في الحي الذي أقطنه، بمنطقة الدويرة غربي الجزائر العاصمة، تعوّدتُ على أن أكون المصوّر المُعتمد للمناسبات الكبرى، واعتاد الجميع على وجودي وكاميرتي وكلّما تأخرتُ في الوصول كلما تعالت الصيحات نحو دارنا والمطالبات بحضوري حتى أوثّق الأوقات الخاصة والمهمة في حياة أهل الحي.
أكثر هذه المناسبات أهميةً، هما عيد الفطر –أو العيد الصغير- وعيد الأضحى –العيد الكبير، وبالنسبة لمن يقف خلف الكاميرا، هنالك فرقٌ بين العيدين طبعًا. في العيد الصغير، هنالك جوٌ احتفالي بنهاية رمضان ووصول العيد، فيتجمّع الرجال والأطفال بعد الخروج من المسجد وهم يرتدون أجمل ملابسهم، حيث تكون الأناقة والنظافة عنوانًا للمشهد الذي أراه. أما بالنسبة للعيد الكبير، فهو تقريبًا على النقيض من هذا، إذ يكون للناس انشغالاتٌ أخرى، أكثر عُضويةً. فما أن تنتهي الصلاة، وأدعى للتصوير طبعًا، حتى يتوجّه الجميع نحو ساحة الحي وهو يلبس ثيابًا بالية أو قديمة ويجرّ أضحيته ويحمل سكاكينه ويتحضّر للذبح.
أوثّق حياة أهل الحي، الذي تتكون غالبيته من مختلف شرائح الطبقة الوسطى، منذ سنوات. وعلى مدار هذه المدّة شاهدتُ المتغيّرات التي مسّت هذه الطبقة في مناسبةٍ مهمّة –دينيًا واجتماعيًا واقتصاديًا- كالعيد الكبير. خاصةً في السنوات الأخيرة، التي تلت الحراك وجائحة كورونا، وزادت فيها الأسعار لتتضرّر القدرة الشرائية للناس.
فمثلًا، انضمّ الكثير من الأعضاء الجُدد لما يُمكن تسميته بنادي “ليلة شك شراء الأضحية”. ففي حين تُفضّل العائلات التي تُضحّي، في أغلب الأوقات، أن تشتري كبشًا أيامًا قبل العيد وتجلبه إلى الحي كي يلعب معه الأطفال ويُشاركوا في الأجواء التي تسود المكان، إلّا أن كثيرين ينتظرون ليلة العيد كي يجرّبوا حظهم مرّةً أخيرة، وبعد أيامٍ من زيارة الأسواق والحظائر والسؤال عن الأسعار، لعلّهم يظفرون بصفقةٍ مناسبة لجيوبهم. هذا كان موجودًا دائمًا، يبقون في الشك حتى آخر لحظة، إلاّ أن المستجّد هو انضمام الكثيرين لهذا “النادي” بسبب الغلاء الفاحش لأسعار الأضاحي هذه السنة.
الوضع الاقتصادي وتدهور القدر الشرائية للنّاس، يجعلك تشعر أن هناك أطوارًا إقصائية تمرّ بها شرائح الطبقة الوسطى كل سنة. فالعائلةُ التي كانت معروفةً بشرائها لكبشٍ سمين ذي قُرون كبيرة، صارت تكتفي بخروفٍ “محترم” دون إضافاتٍ تجعل الأطفال يتفاخرون بأضحيتهم التي تُشبه كباش المصارعة. آخرون تخلّوا حتى عن الخروف “المحترم” واكتفوا بـ “كبيّش” أو جدي في بعض الحالات، المهم أنها شاةٌ سليمة تصلح كأضحية وتسمح لهم بتطبيق السُنّة.
الكباش “المحترمة”، والتي كان متوسط أسعارها في أسواق العاصمة، هذه السنة، بين 60 و 80 ألف دينار (ما يُقارب 300 إلى 400 دولار، بسعر السوق السوداء) حرمت الكثيرين من التضحية وترك هذه السُنّة/العادة، في حين منعت آخرين من عادتهم السنوية وهي الزهو بشراء كبشٍ ضخم “يعمّر العين”.
يُمكن القول أن التغييرات طالت المرحلة الأولى من هذه المناسبة، مرحلة التحضير للعيد الكبير، حيت تختلف الأحجام والقُدرات الشرائية، ولكن المرحلة الثانية التي تبدأ مع صباح العيد ظلّت على حالها، تقريبًا. فلمّا تحين ساعة الذبح والسلخ ندخل في موضوعٍ آخر ويصير الحديث عن قُدراتٍ ومهارات أخرى. وكمصور، أجد أني أحب التقاط الصور للأشخاص الذين لا يبدون اهتمامًا بحضوري أو غيابي. هذا يعطي الصورة طابعًا أكثر عفوية، وهذا ما أفضله بشكل خاص في العيد الكبير، فأجد نفسي أكثر نشاطًا وحركة، حيث أنتقل بين أرجاء الحي لالتقاط أكبر قدر ممكن من الصور وأحاول ان أوثق أكبر عدد ممكن من اللحظات الحميمة والمميزة.
تدور هذه المحادثات والتعليقات حول تفاصيل الذبح والسلخ، مثل التقنيات والوسائل المُستخدمة. تكثرُ التعليقات والنهرُ والجزر للمبتدئين، وتختلط العادة بالسُنّة المُحبّبة بتقنية الجزّار. يصير الطلبُ كبيرًا على ابن الحي الذي يُكمل مهمته في فترة قصيرة، ويقفُ كبار السّن أرباب العائلات –الذين يُترك لهم الذبح غالبًا- على رؤوس الشباب المُنهمكين في السلخ وتبادل الخبرات والأساليب التي تضمن جودة عملية السلخ وعدم تشويه الأضحية.
بينما أقوم بتوثيق تلك اللحظات المهمة، أجد نفسي أحيانًا مستمعًا إلى كلماتٍ وتعليقاتٍ ساخرة تتردد هنا وهناك. يقول البعض: “أنت لا تعرف سوى التصوير، عندما تتزوج، نادي علينا لنساعدك في ذبح وسلخ أضحيتك.” كأنّ الرجل الذي لا يُتقنُ الذبح والسلخ –ومن جهةٍ أخرى المرأة التي لا تعرف تنظيف أمعاء ودوّارة الأضحية- ليسا جديران برباطٍ مُقدّسٍ كالزواج.
وفي نفس السياق، يتوجّه الجميع نحو الرجال المتزوجين حديثًا بجملة “عس دوزانك”، التي تنتشر بشكلٍ ساخر ومرح. يستخدمون هذه العبارة لتنبيههم بضرورة أخذ الحيطة والحذر من تُسرق خصيتي أضحيتهم.
تذكّرني هذه المقولة بحادثةٍ وقعت فعلًا لأحد أبناء الحي، حيث تمت سرقة إحدى خصيتي أضحيته. وبدأ هو في إطلاق عبارات الوعيد والتهديد بحق من قام بسرقته، لكنّه لم يتوصّل إلى معرفة الفاعل. بدا الأمر كأنّما سُرِقت خصيته هو. كان غاضبًا ومُحبطًا. لم يتحمّل فكرة تعرضه للسرقة في هذه المناسبة الخاصة.
شيءٌ آخر بقي على حاله وإن كان يُنبِئُنا ليس فقط بحال القدرة الشرائية لدى الجزائريين بل أيضًا بعلاقتهم بالأكل واللحوم، ألا وهو الكْبدة. دائمًا ما كان الحديث، مع قُرب نهاية السلخ، حول ضرورة الإسراع في العملية لأكل الكبدة. فأغلب الرجال يصومون صباح العيد ولا يُفطرون إلاّ على كبِد الأضحية. وحتى من لا يُطبّق هذه العادة، يسعى لأكل الكبدة، هذا لأن أغلب الجزائريين قد لا يأكلونها سوى في الأعياد.. أو خلال المرض.
تنتهي عمليات الذبح قبل منتصف النهار غالبًا، بعد أن تحوّل الحي إلى مذبحٍ في الهواء الطلق، ينهمك الرجال في حمل أعضاء الأضاحي إلى بيوتهم ورمي الجلود –التي ما عاد النّاس في حاجتها وتحاول الحكومة تنظيم طريقة جمعها– في حين ينهمك آخرون في “تشويط” رأس الخروف وقوائمه.. ثم ينسحبُ الجميع إلى منازلهم للاغتسال والجلوس إلى وجبة الغداء.