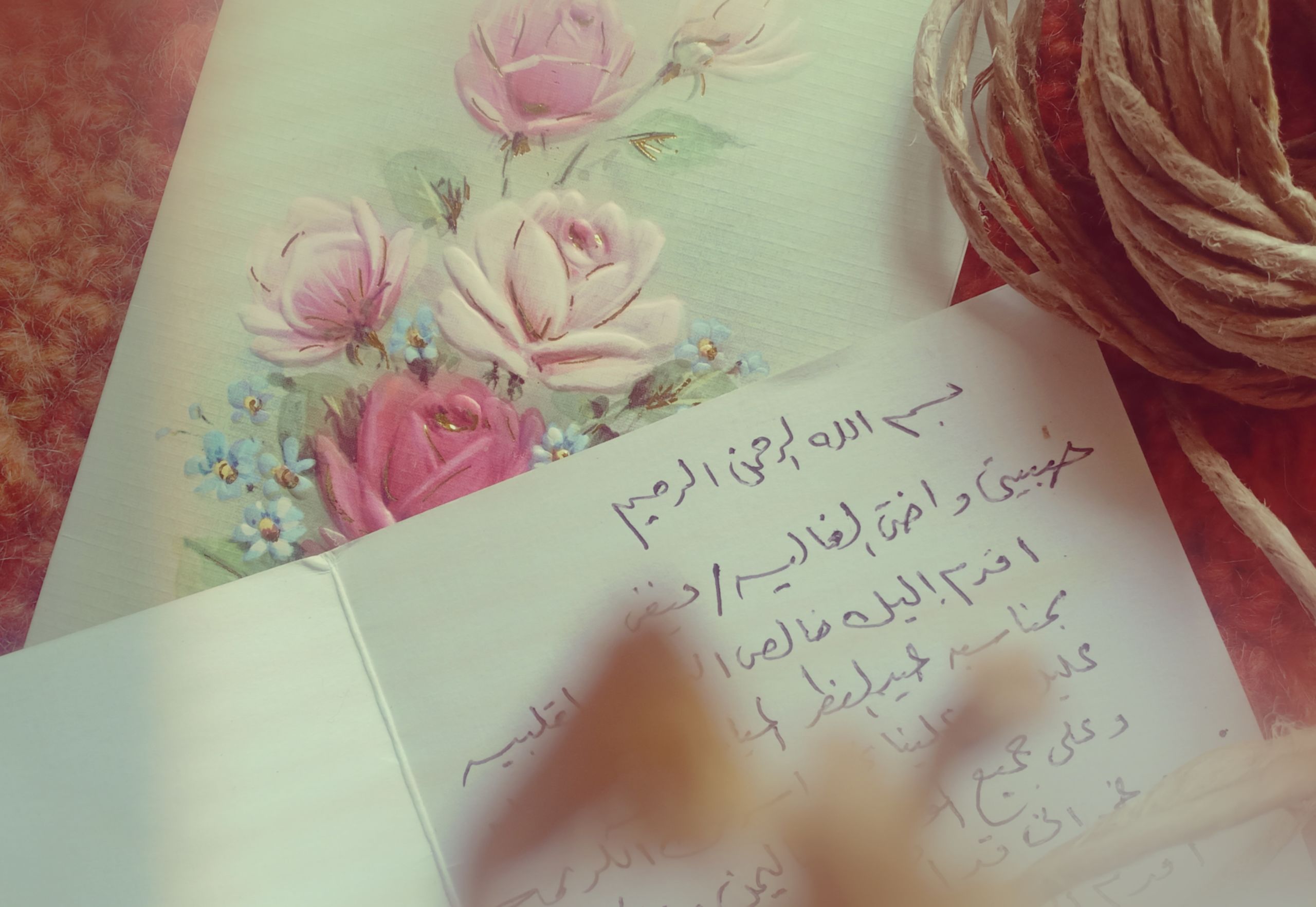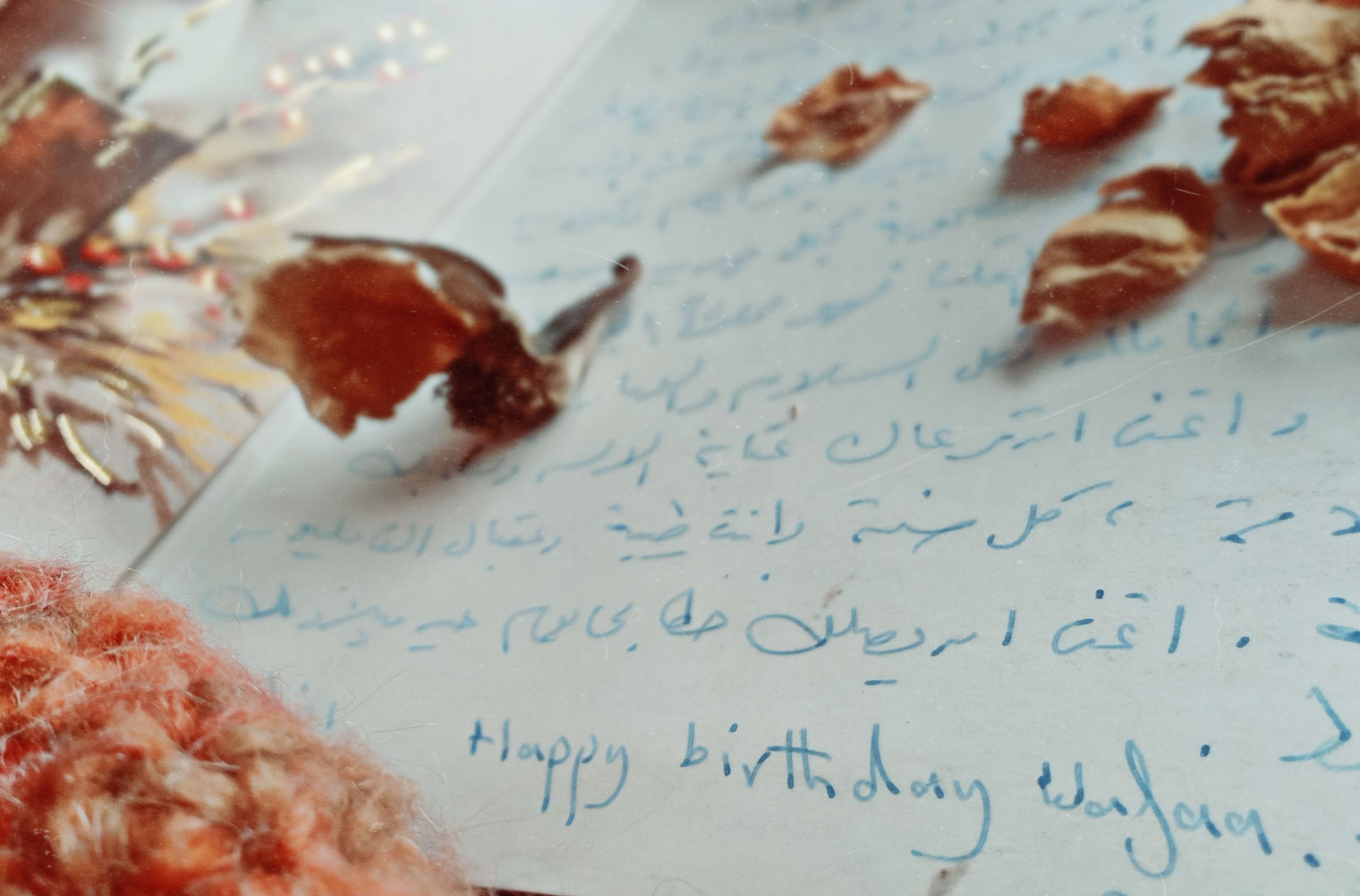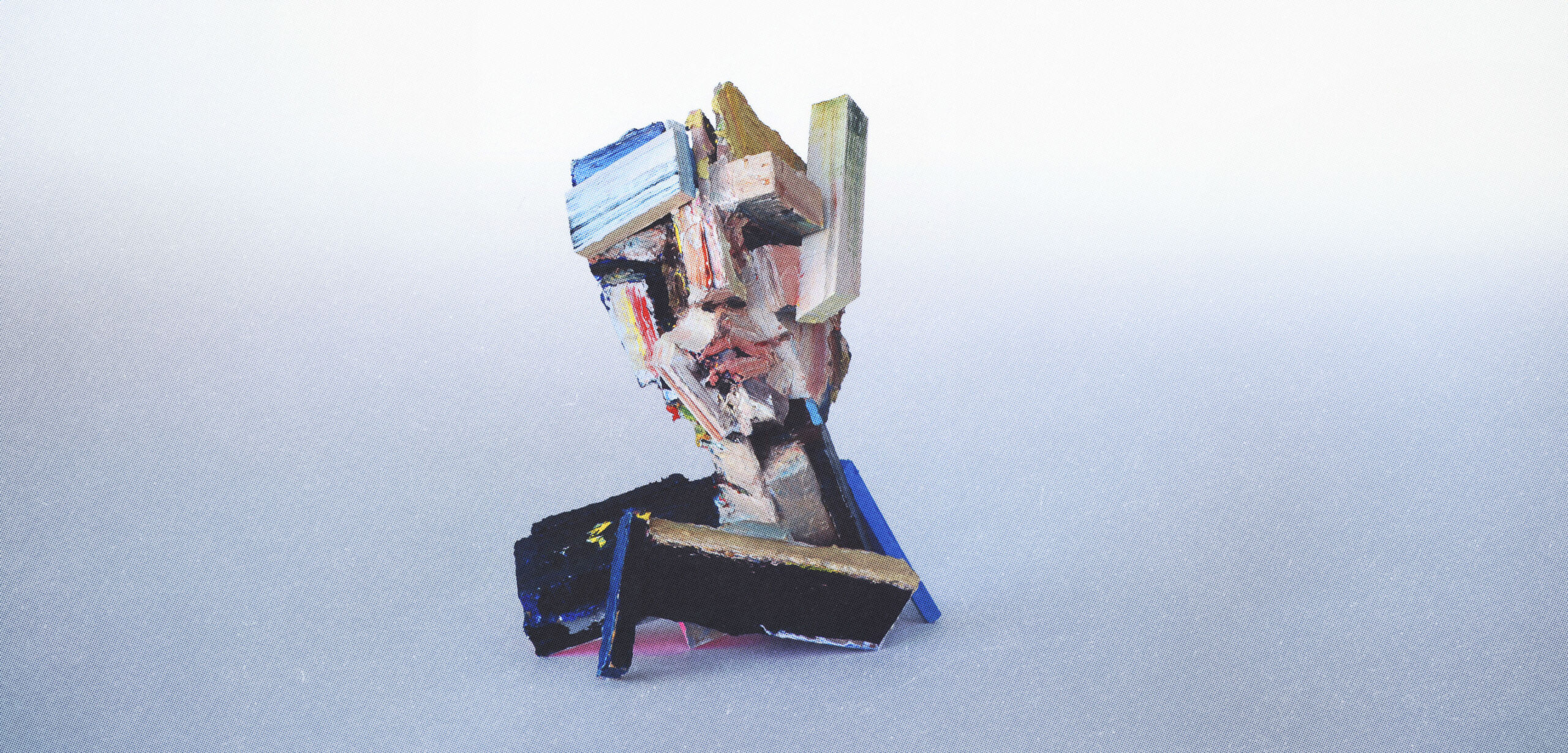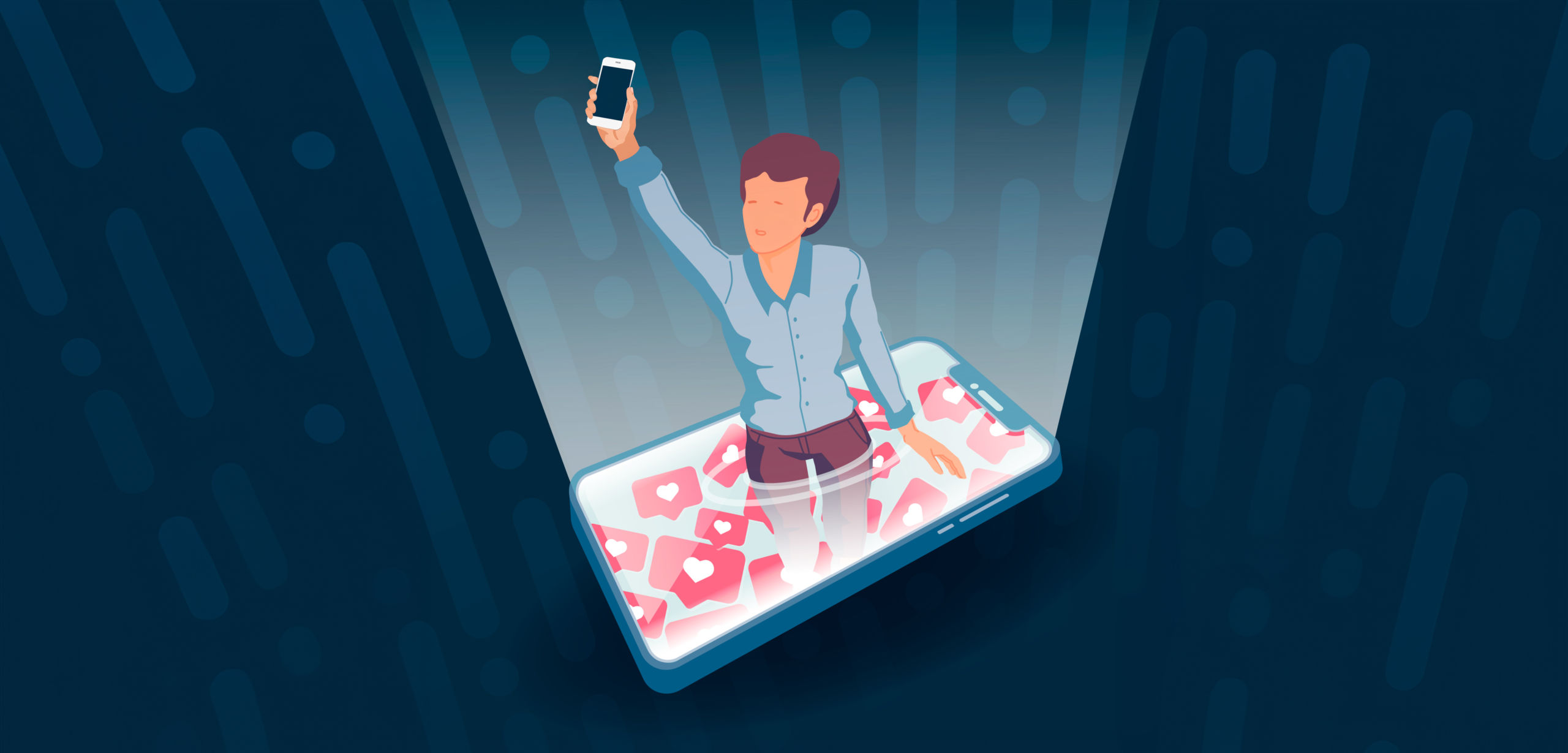هل تأسرك رائحة الخطابات القديمة؟ هل حصلتَ يومًا على وردة جفَّفْتها في كتاب لتزورها يومًا في مذكراتك؟ هل لديك دفتر مذكرات أصلًا أم تجرفك سرعة التكنولوجيا ولا وقت لديك لتأمل هذا الجمال الذي ربما يصمد في أشياء ملموسة، مثلما شعرت أنا أمام صندوق أمي؟
اسمح لي أن أفتح معك علبة ذكريات المرحومة وفاء.. “ريحة من ريحتها على الأرض”.
في حياتها لم يكن الصندوق مغلقًا ولم تكتب عليه أمي “ممنوع الاقتراب”، لكنني كنتُ وما زلت جزءا من تروس ماكينة تجري أسرع مما أدرك، أو ما يسمح لي برؤية التفاصيل.. لم أفتح الصندوق إلا بعد رحيلها حين اكتملت مرحلة الفقد، وهنا بالضبط تنمو بذرة الذكرى..
كانت صاحبة الصندوق موجودة وتملأ الحياة قبل قليل، وهذا ما كان يُغنيني عن محاولة الفرجة على ماضيها.
كان اقتراب يدي من أسطح هذه الكتلة المغلقة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على وفاتها يقلقني.. ماذا سأجد به؟ ماذا ستقول لي أمي من خلاله بعد رحيلها؟.. أفكر أن موتانا يقولون أشياء كثيرة بعد رحيلهم لو أجدنا قراءتها، اكتشفتُ هناك ما يربطني بها أكثر أو يشرح رأيًا لها كنتُ أعارضه يومًا ما..
عاشت ماما عالمًا أغنى –حسبما أتخيل- من ما نعيشه، ذكرياتنا إلكترونية ننساها أول بأول.. “الهارد ديسك” محكوم بمساحات تخزين محدودة، ويجبرنا على مسح القديم إن أردنا إضافة جديد..
لا أميز رائحة خاصة للتكنولوجيا، لذا تحيا الجوابات والصور المطبوعة، ويبدو حين نلمسها كأننا ندوس على زر الماضي فتنفتح شاشة تُخرج لنا لسانها.. “اتضحك عليكم!”
عاشت ماما فترة دراسة/عمل بمجال الطب أوائل ثمانينيات القرن العشرين في ليون بفرنسا.. كان زمنًا بلا هاتف محمول ولا إنترنت، الوسيلة شبه الوحيدة للتواصل بين الأهل والأصدقاء كانت الرسائل.
كثيرا ما حدثت نفسي أن أمي قدّمت تضحية ضخمة بترك عملها عام 1993 بعد أن صارت مشرفة على عمليات المخ والأعصاب بمستشفى القصر العيني، لتتفرغ لي ولأختيَّ.
عندما مددت يدي في الصندوق وجدت دليلًا على هواجسي.. خطاب ظلّ في الصندوق من الفترة الفرنسية، يحمل نبأ انضمام طبيبة جديدة تُحضّر رسالة دكتوراه مع مشرف فرنسي.
كانت نفس الطبيبة في ذات سكن/مستشفى أمي، بالغرفة المجاورة تمامًا، بحثت عن اسم زميلة أمي تلك في جوجل فوجدتُها قد صارت طبيبة شهيرة، تظهر كثيرًا في البرامج التلفزيونية، وتملك سلسلة معامل طبية باسم عائلتها.
لستُ أُمًّا إلى الآن لأدرك ذلك التفاني، الذي تغرزه الأمومة وتجبرنا لنتحرك على أساسه بلا منطق سوى ما تراه الأم فضل لمصلحة ابنائها، أما منطقي أنا فربما هو ما تشعرني بخسارة عملية كبيرة قبلتها وفاء بحب لتضمن لنا أفضل رعاية ممكنة.
من المحتمل أن وجودي ذاته كان جزءًا من حرمانها مجدًا مهنيًا وتخليدًا لاسمها على مستشفى خاص مثلًا، أو ثروة توفر لها حياة أكثر ترَفًا.. لكني أتذكر جملة لها كانت اندهش لها أحيانا.. “انتو كل ثروتي”.
مجموعة خطابات أخرى بتوقيع شخصية من العائلة، سمعتُ من أمّي أنها لم تكمل تعليمها الجامعي، كُتبت الرسائل بخط جميل، رسم أنيق للحروف، لغة عربية سليمة بمفردات وصياغات جمالية معتنى بالتفكير فيها.
تستطيع بوضوح أن تتخيل حال المدارس ونظام التعليم منذ 50 سنة إذا أمسكت بتلك الرسائل.
الأصدقاء العرب لأمي في فرنسا كانوا حريصين على استخدام العربية في مراسلاتهم، ربما كانت الهوية واللغة رقمًا في المعادلة رغم أنهم يعيشون بالفرنسية حياتهم اليومية.
انعكس هذا الحرص فيما بعد، أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، عليّ وأختيَّ.. “اتركنت” اللكنة الفرنسية على جنب، ودعّمت وفاء الفصحى ونطقها في كلامنا العادي بدلا من استسهال لغة الخواجات -الطازجة حينها- لا أنسى تنمّر زملائي بالمدرسة لأنني أنطق القاف حين أقول “برتقالة” أو لقب عائلتي “ثاقب”، بدلا من نطقهم القاف همزة.
لا ينفي هذا التمسك بالهوية حرص ماما على تعلمنا اللغات، لكن بطريقة “لكل مقام مقال” ودون تعدّي لكنة وافدة على هوية صاحبة بيت، لئلا تخلق فينا “لسان معوج” يدعو للتباهي.
كانت ألفاظ ماما مستغربة لدى جيراننا، تنطق.. “التنسيق”، “البارود المشتعل”.. وهكذا
ظنّت إحدى جاراتنا أن أمّي تسخر منها عندما سألتها بكل طيبة.. “كيف حال زوجك؟” عندما كان مريضًا.. وفي الوقت نفسه، ظلت لديها كلمات فرنسية ثابتة على لسانها، فتسمع منها بوضوح “فورميدابل” تخرج بعفوية إذا بهرتها تصرفاتك.
بتاريخ 12 سبتمبر 1981 -عيد ميلاد وفاء السادس والعشرين- وجدتُ برقيات تهنئة قصيرة وطويلة مرسلة من أصدقاء وأهل في مصر إلى عنوانها في “ليون” لا أعرف غالبيتهم، ربما أخذتهم مشاغل الحياة، وربما ماتوا، لكنهم سكنوا الخلود هنا في هذا الصندوق، أما مُعايدات زمننا فلا تعيش أكثر من 24 ساعة كـ”ستوري” على أحد مواقع التواصل.. تعزياتنا وتهانينا بـ”لايك” فقير لا نعرف أين سيكون مصيره في الفضاء الأزرق بعد 40 سنة أخرى.
هل يمكننا الهروب من التكنولوجيا، ولو دقائق قليلة، نعود فيها لذكرياتنا الورقية.. لا أعرف.
احترم شبكة الإنترنت، تلك القدرة التي تربط أطراف هذا العالم ببعضها، أفكر في إمكانات التواصل التي منحها للمغتربين في عالم اليوم. وأفكر أيضًا في أمي وعلاقتها بالشبكة العنكوبتية، صارت ماما مستعملة جيدة للإنترنت، خاصة أنه سهّل لها التواصل مع ابنتها/ أختي الكبرى، التي سافرت بعثة دراسية إلى ألمانيا بعد 25 سنة من ترك أمها أوروبا.
أيضًا لم تنجرف لإدمان تكنولوجي، ظلت تطور نفسها، مستخدمة تابلت ونظارات طبية، وقدر كبير من المعافرة الطفولية الملهمة.
دارت بيننا مناقشات كثيرة، كانت تناقشني في الكتب التي تقرؤها على “الكيندل” تخيل معي امرأة ستينية على سرير بمستشفى في آخر أيام تربطها بالدنيا تقرأ كتبا في “كيندل” وتختلف مع ابنتها الشابة المتطورة/ أنا، وترفض تنزيل الكتب مجانًا احتراما لحقوق الملكية.
وعيت حجم خسارتي بعد وفاة أمي بسنة كاملة عندما غيّرت هاتفي المحمول، إذ فقدتُ بذلك غالبية محادثاتنا اليومية.
واليوم وأنا أعمل على هذه الصور، أفكر أني سأطبعها وأحفظها في صندوق ربما يشبه صندوقها القديم ذاك، “وفاءً” لذكراها الطيبة.