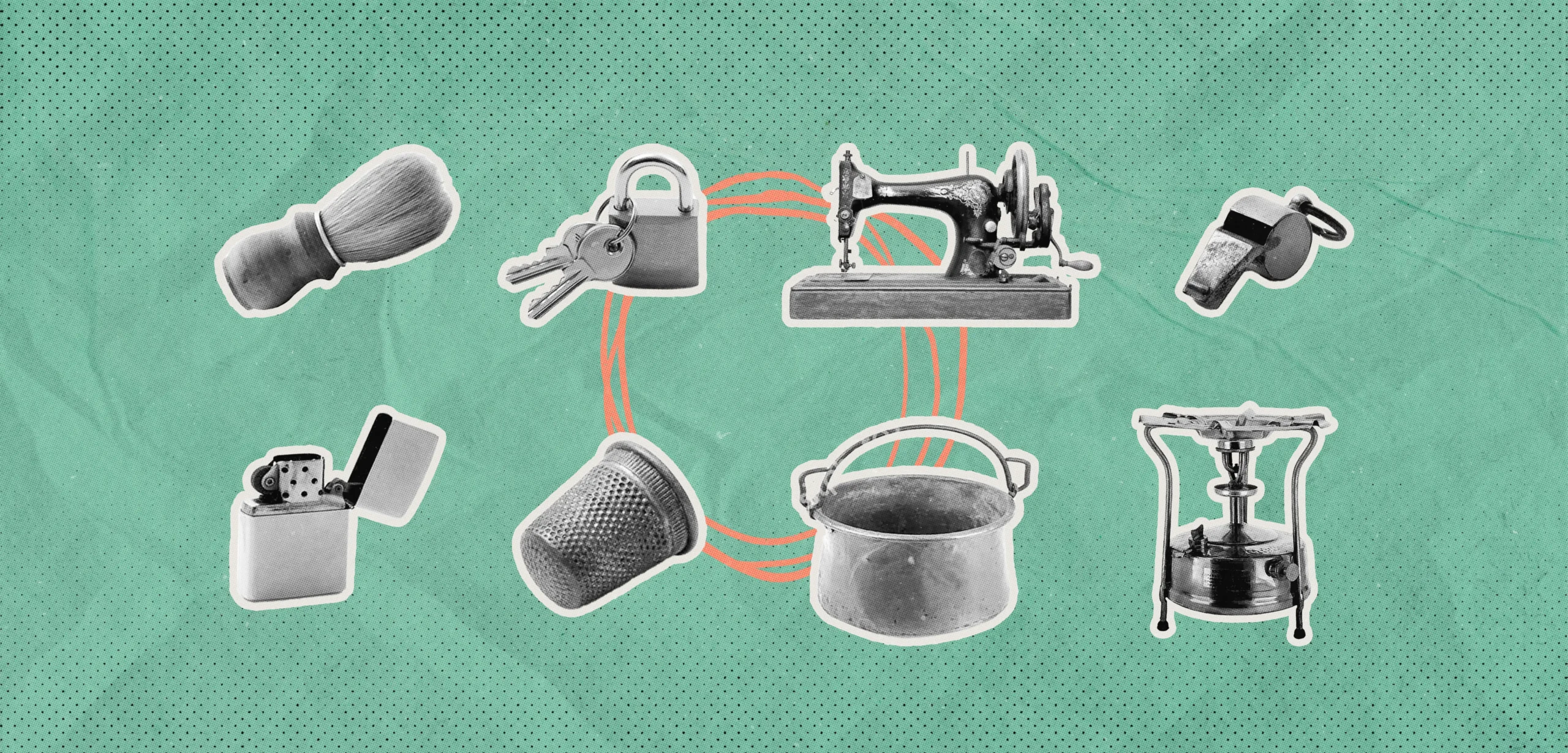هل ترى ذلك الشارع الواسع المظلم؟ أظن أن هناك رجلاً كان يقف في منتصف الأوتوستراد ويسند الشمس بيده اليمنى كي لا تشرق.
هل ترى ذاك النفق؟ كان عليّ أن أمضي سريعاً إليه كي ألتقط صورة، ولكن في اللحظة التي كان يجدر بي التقاطها لم أفعل.. بل ذهبت بعيداً.
ذات يوم قررت صاحبة المنزل الذي نسكنه في حي باب توما بدمشق أن تقوم ببعض التغييرات على نحو مفاجئ، أغلقت إحدى النوافذ في غرفتي وأبواباً كانت تصل المطبخ ببقية الغرف، دهنت المنزل وأسقطت عليه كل مفاهيم الحداثة الخاصة بها.
كان كلّ ما أملكه يقبع خارج غرفتي وهذا ما كان يحدث لسنوات، كلّ ما يخصّنا أصبح خارجنا ويتجه لأماكن لا تنتمي إلينا. وأنا كنت أعرف أنّ أمامي مدة محدودة من الزمن قبل أن أوجد كجميع قطع الأثاث تلك، في مكان لا أنتمي إليه.
هناك نوع من المقاومة يولد بشكل أوتوماتيكي عندما تخطو آخر خطوة خارج حدودك، فكانت تلك اللحظة الأولى التي أفهم فيها ما هو الفراغ.
في ذلك اليوم قررت أن أبحث، وأرى ما أريد أن أراه فقط، وكان ذلك هو اليوم الذي فقدت فيه القدرة على رؤية ما لا أرغب برؤيته، على نحو مفاجئ أيضاً!
هناك حمامة بدأت منذ أشهر مضت ببناء منزلها داخل حقيبة سفر وضعتها فوق براد لا يعمل على شرفة منزلي في الطابق الخامس. ظّلت تجلس هناك أكثر من شهر، أخبرني أحد الأصدقاء يوماً ما أنّه عليّ رميها بعيداً وأنها ليست بفكرة جيدة أن تكون موجودة مع قطة في نفس المنزل، ولكنني لم أفعل بل أطلقت عليها إسماً في ذلك اليوم، وفي كل صباح كنت أقلق من فكرة أن تنجب صغارها في هذا المكان الملاصق لنافذة غرفة النوم، ولكنني لم أبعدها.
كنت أتعامل مع الظرف عندما يحدث كما أفعل دائماُ، لا ينفع أن تستبق الأشياء هنا لأنك حتى لو حاولت لن تستطيع.
مضت عدة أسابيع على وجودها، وذات يوم استيقظت وتذكرت أنّه في مدينة ما، ركضت أم بابنتها في شارع واسع، كان تمسك بيد الطفلة التي تقاوم هذا المشوار مجهول الوجهة. ينتهي الشارع وتدخل الأم مع ابنتها في زقاق ضيق يبدأ بدرج طويل، تنزلان الدرج، أصوات إيقاعية ترتفع ثم تصبح منتظمة، تدخلان من الباب، تلقي الأم تحية سريعة على أحدهم، تترك الطفلة وتغادر. كانت تلك المرة الوحيدة التي تقودها فيها إلى مكان وتتركها فيه، في معهد للموسيقى.
نهضت من سريري إلى الشرفة مباشرة، لم أجد الحمامة، كان بيتها فارغاً، وهي لم تعد حتى الآن!
منذ فترة ليست بقصيرة أوقفتني إحدى الجارات في الطابق الثاني من المبنى الذي أسكن به وأخبرتني أن أتجنب الإمساك بحافة الدرج. كانت خائفة ويظهر على وجهها مزيج من الحزن والإحساس بالذنب، قالت إن جارتنا اللطيفة وزوجها في المنزل المقابل توفيا يوم أمس “كان معهن كورونا“.
كل ما فكرت به في تلك اللحظة هو كيف لم أسمع بذلك! طبعاً لن أسمع بذلك، فأنا أبذل جهداً مضاعفاً خلال فترة تواجدي في منزلي كي لا أسمع، وخلال السنتين الماضيتين أظن أنني كنت أبذل هذا الجهد حتى خارج منزلي، كانت تخبرني أنّها تشعر بالذنب لأنها لم تقم بواجب العزاء وأنا كنت أفعل ما أفعله خلال هاتين السنتين، لا أسمع!
أمشي دائماً مع السماعات في أذني، وأرفع صوت الموسيقى منذ وصولي إلى المنزل.
أصرّت على أن أخبر الحادثة لجميع أصدقائي وأحذرهم من الإمساك بحافة الدرج، أخبرتني أنها تعقمه كل يوم ولكن مع ذلك “بدنا ندير بالنا”.
لا أعلم لما قالت كلّ ذلك، ولكن منذ تلك اللحظة وأنا أمتلك رغبة ملحة بالإمساك بحافة الدرج!
لقد جعلت كل شيء أصعب، حتى التوازن على درج المبنى الطويل أصبح صعباً من دون الإمساك بالحافّة.
بالحديث عن الصعوبات، إحدى الصديقات التي طلبت مني تحذيرها من الإمساك بالحافّة عملت معي في إثنين من أفلامي خلال السنوات الماضية مرّة عام 2018، ومرّة أخرى هذا العام، وفي كلتا المرتين كان ضعف الإنتاج وانهيار العملة يضعانا أمام مواقف فوضوية، فكانت تجمع ما ينقصها من أدوات من أماكن مختلفة، أحدها كان منزلاً في إحدى الحارات الشعبية بمنطقة باب توما نفسها، سكنّاه قبل سنتين.
لم أخبر جارتي بذلك ولكنني تذكرت اللحظة التي قررت بها التوقف عن سماع كل شيء، بداية الحجر الصحّي، المنزل نفسه، كنت أرى كل شيء من نافذة المطبخ.
اسمه غيث، ولا أظن أنّه قد فعل شيئاً خاطئاً!
في ساحة باب توما وقفت فتاتان وثلاثة شباب، في موقف ولد أمامنا مباشرة، لربما كان قد تكرر لمليون مرة عبر السنوات الماضية ولا زال يتكرر خارج مجال رؤيتنا، ومن الممكن أن هذه الحادثة تأخرت لسنوات عن أن تحدث.
لم يكن غيث مطمئنّاً وكأن المكان بأكمله يلاحقه. لا أظن أنّ أحداً كان يعرف ما حدث، ولكنّ المؤكد أيضاً أن أحداً لن يعرف أبداً ما الذي سوف يحدث لاحقاً.. كان ملاحقاً حتّى من المدينة بأكملها، من أعيننا وآذاننا أيضاً!
إحدى الفتيات كانت تصرخ بشكل هستيري وهي تعده بالعديد من الطرق للنجاة، رفضت أن ترحل وتتركه خلفها، ولكنّه كان يدفعها بقوة إلى السيارة مع صديقتها، كل ما أراده هو أن تغادر فقط وأن يرحل بعيداً عنهم، أن تمتلك هي الحق في إنكار معرفة كل ما حدث معه، أن تهرب، أو أن تنجو؟ لقد أراد منها أن تنجو بنفسها من دونه.
كان خائفاً، نظره باتجاه وسمعه باتجاه آخر!
كان صوتها مسموعاً عندما أخبرته أنها لن تغادر من دونه، وهي لم تغادر من دونه.. لم يكن خيار الهروب مطروحاً حتى، وهنا تأكدت أن هذا الموقف لم يتأخر، لقد كان مختلفاً فقط. تبقّى سعال المارّة في تلك الساحة!
أنا لا شيء، لم أكن مشاهدة حتى، كنت مستمعةً فقط!
مستمعة بإيقاع مشوش ولكن على الأقل يبدو أنني أسمع مرة أخرى!
إن علاقة المصوّر بمحيطه صعبة بما فيه الكفاية، وممتعة أيضاً، ولكن الأمر مختلف هنا.. إن كنت تريد أن تعمل فعليك أن تنظم إيقاعك وفقاً لساعات الكهرباء والشمس، ساعات الازدحام والشمس، تواريخ الموافقات والشمس مرّة ثالثة. لذلك، كان التخلي عن الأشياء التي أسعى إليها في لحظة اقترابي منها هو تيمة رافقت عملي في السنوات الأخيرة.
دمشق-شارع الثورة، كان الشارع واسعاً ومقسوماً إلى قسمين: جسر، ونفق تحت الأرض يدعى بنفق الحياة.
وقف رجلٌ في منتصف الأوتوستراد، كان يسند الشمس بيده اليمنى كي لا تشرق، وأنا كان عليّ أن أمضي سريعاً إلى ذلك النفق كي ألتقط صورة ثم أعود قبل أن تشرق الشمس.
في الساعات الأخيرة للظلام، مضت خمس محاولات على ذلك الأوتوستراد المظلم.
أخبرني خمسة من الأشخاص معي في ذلك اليوم عن خمس قصص مختلفة وتتصف بالذاتية، المرّة الأولى عن أننا حققنا ما كنا نحلم به على الرغم من أن الوضع كان مضحكاً، والثانية كانت أنّه لا يوجد مصدر إضاءة واحد في هذه المدينة -أنت تتكئ دائماً على الظلام-، الثالثة كانت عن معنى السعادة بأبسط أشكالها، الرابعة كانت عن عواقب نسيان ما ننتمي إليه، والخامسة كانت كل ما حدث على امتداد السنوات الماضية، عن كل ما أنكرناه وتحوّل إلى حقيقة، عن أهميّة أن نرى، وإن لم نستطع ذلك فلا عذر أمامنا، يجب أن نرى!
على الأقل أنا أرى من جديد، في ذلك اليوم قررت أن أغيّر ما استمر لسنوات وأن أرى غير ما أريده!
تماماً، لعنة التخلّي عن الأشياء عند الاقتراب منها تعود من جديد، لم التقط تلك الصورة.. في اللحظة التي كان يجدر بي التقاطها لم أفعل.