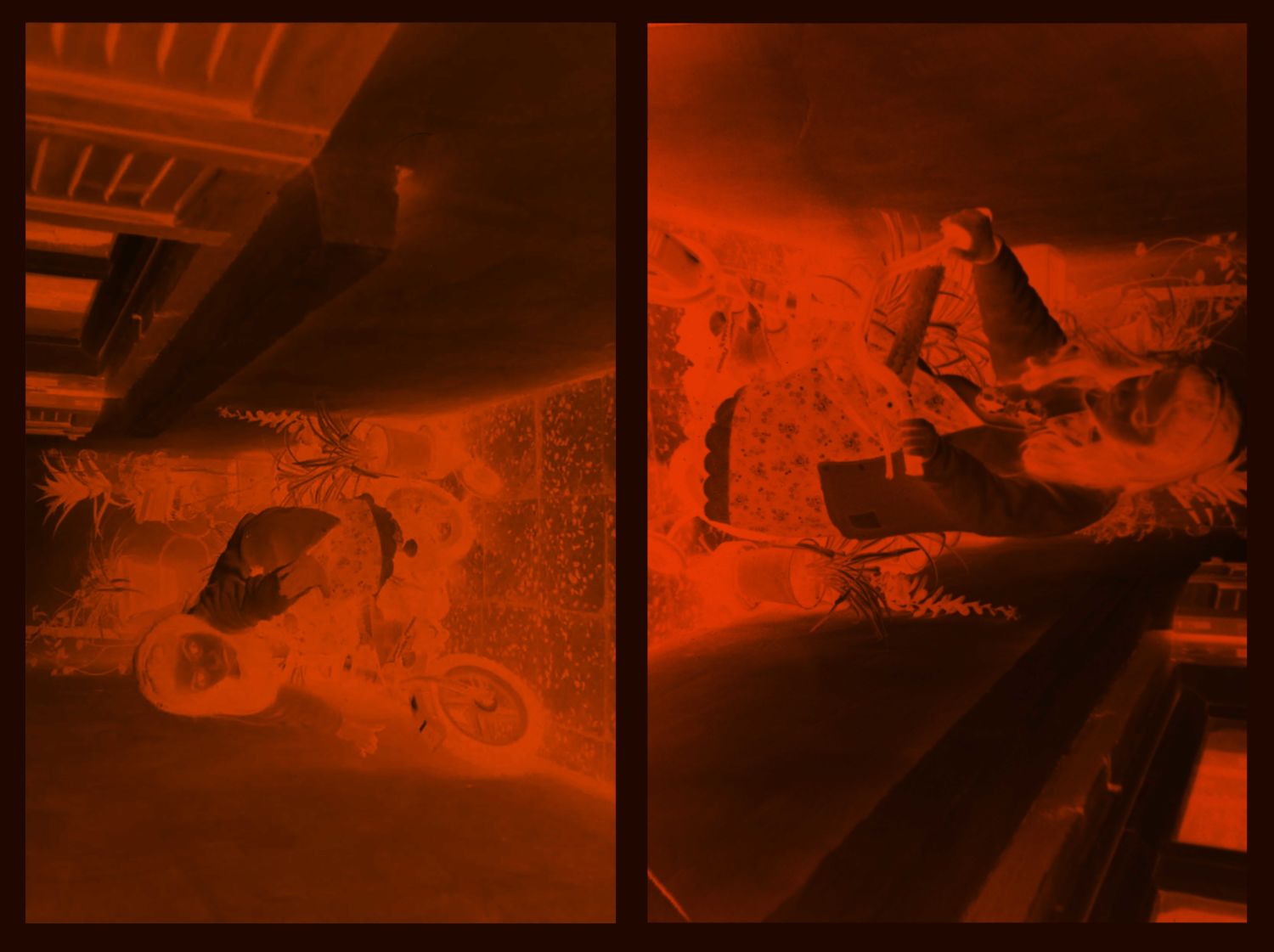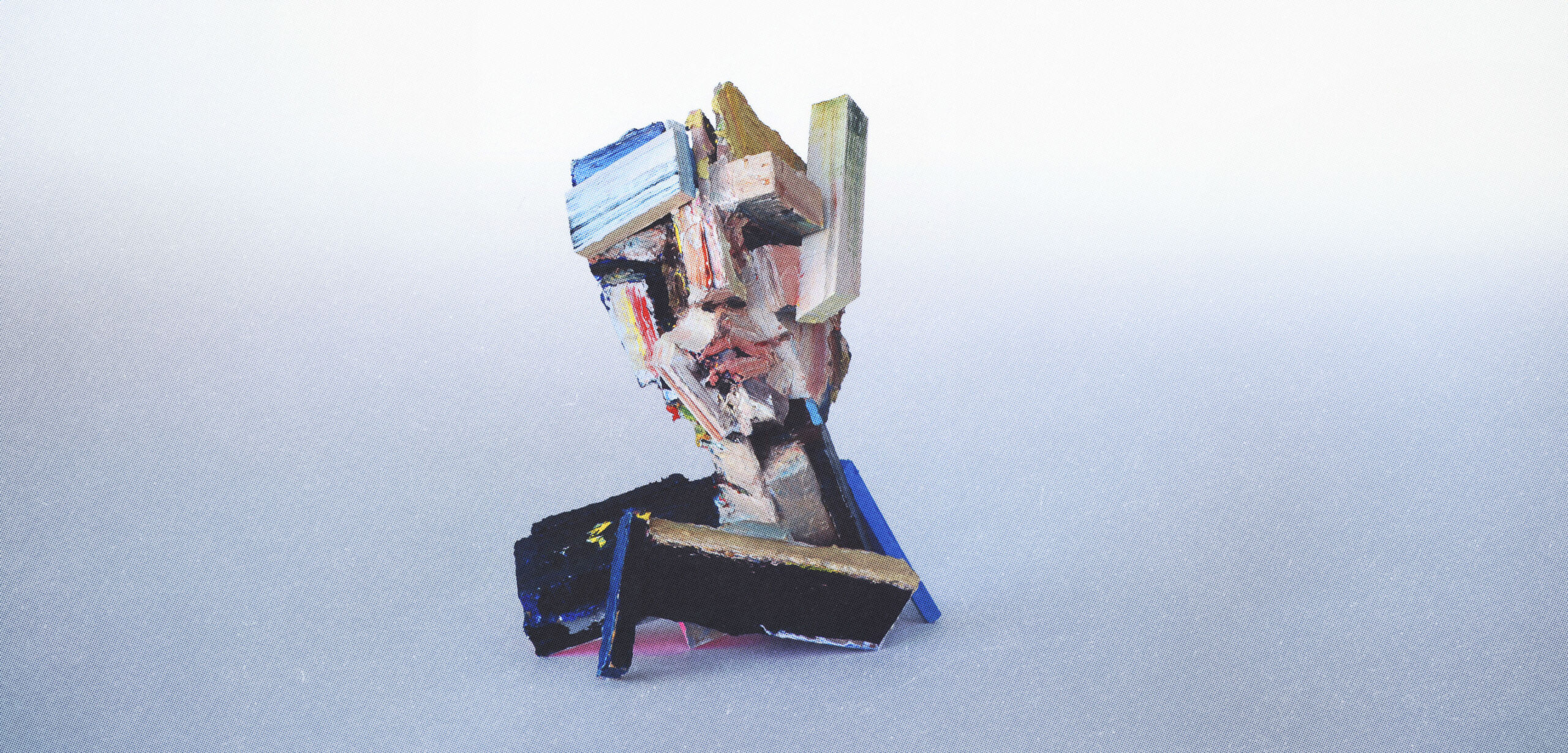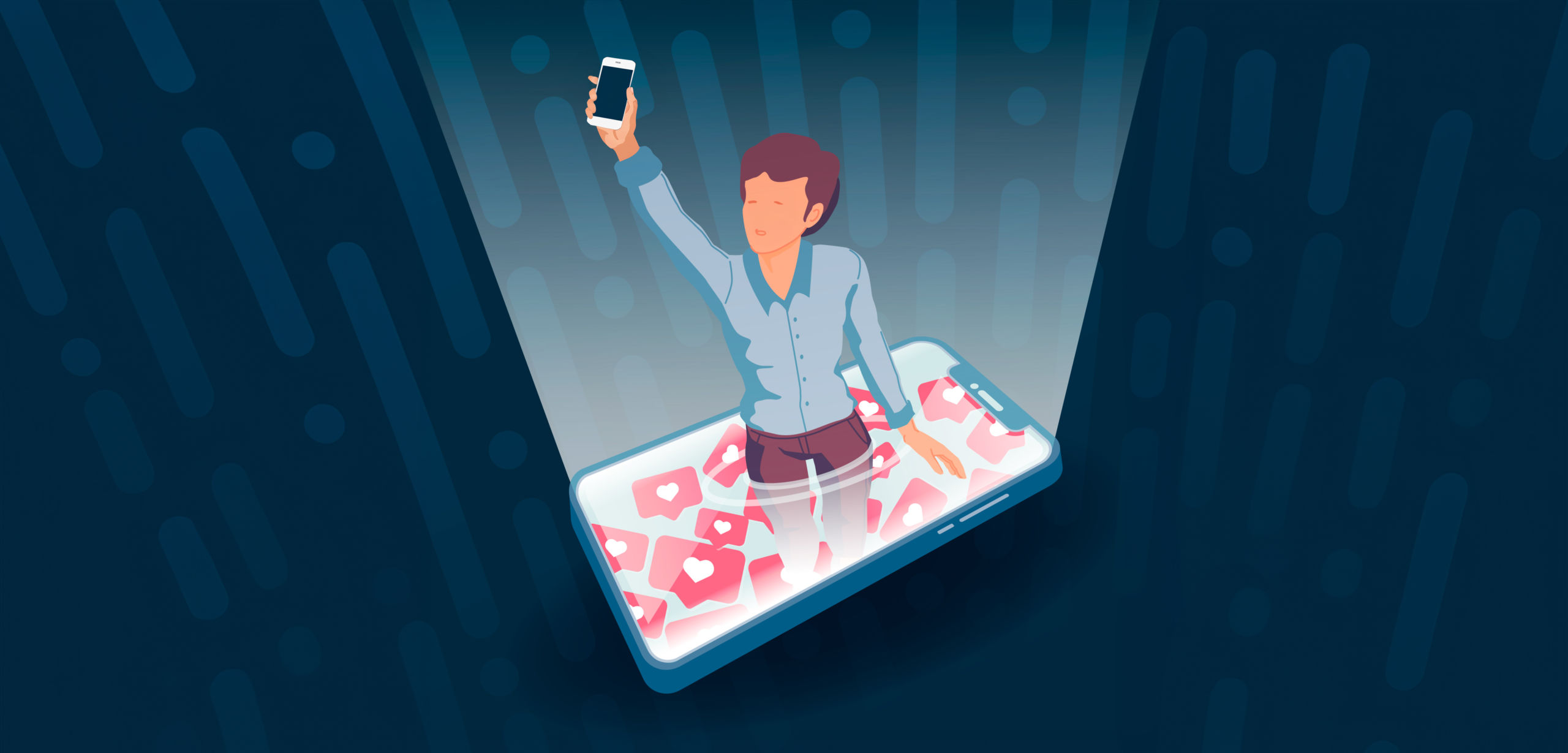قضيت طفولتي في منزل جدّاي بمدينة وهران، غرب الجزائر، أكثر الذكريات وضوحًا بدأت مع سن السابعة، أذكر تلك السنة.. 2003، كانت أمي ستسمح لي باختيار ملابس العيد، ورأيتُ لأول مرّة موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان جدّاي يحبّانه.. يصوّتان له ويقولان أنه جاء ليُنهي الحرب التي دامت أكثر من عشر سنوات.
كانت حياة عائلتي رتيبةً، ولكنها رتابةٌ سعيدة وآمنة. هكذا أتذكرها. نجتمع في عطلة الأسبوع في بيت العائلة. تصنع جدّتي الخبز في سطح بيتنا المطل على البحر، وأجلس أنا أمامها أسمع حكاياتها وأضحك فيظهر مكان سنّي العلوي المفقود.
كان عمري 7 سنوات.. كان بوتفليقة يتحضّر للترشّح لعهدة رئاسية ثانية، ومن سطح بيتنا رأيتُ موكبه يمرّ. حتى ذلك اليوم لم تتحدث عائلتي بالسوء عن الرئيس، ومن دون كللٍ كانت تصوّت له ولجزب جبهة التحرير الوطني، كنا –كالعادة- نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.
حتى اليوم لا تهمني نزاهة بوتفليقة من عدمها.. ما بقي معي اليوم هو الفرصة التي حظيت بها الطفلة التي كنتها في قضاء أولى سنواتها وهي تشعر بالأمان.
بعد أزيد من عِقد، كان بوتفليقة لا يزال رئيسًا للبلاد رغم كونه مريضًا ومُقعدًا.. وكان البحر الأبيض شامخًا ما يزال وكانت أعذرانا على حالها أيضًا. لكن شيئًا ما كان عاجزًا أمام الوقت. كان وقتًا مختلفا، رغم أن العالم كان ما يزال لطيفًا معي ومع عائلتي.
ظل جدّاي يكرران أنهما لم يستفيدا في زمن بوتفليقة من أية امتيازات ولكنهما يأسفان لحاله. كثيرون كانوا يقولون أن “العيب ليس فيه.. بل فيمن حوله”.
أرى سنين الطفولة تلك، وعلى بُعد كل هذه المسافة الزمنية، حمراء-برتقالية اللون. كلما فتحت الألبوم العائلي أجد اللون البرتقالي طاغٍ في الملابس والديكور وفي الحنّة التي على أيدي النساء والأطفال. وعندما اقترحت المُصوّرة حورية مصباح أن أدرِج الصور مع النّص، وجدنا أن أفضل حل للحفاظ على خصوصية العائلة هو التحويل نحو ألوان نيغاتيف برتقالي-أسود.
فبراير 2019.. حدث الأمر ما بين ظهر الجمعة وعصرها. أصوات الهيلكوبتر أزعجت جدّاي، كانا يخشيان الاضطرار للتعامل مرّة أخرى مع الحرب. لم أنتبه من قبل أن ما جرى لم يحدث دفعةً واحدة. في بيتنا وفي البلد، تغيّرت أمورٌ كثيرة.
نزل أفرادٌ من عائلتي للمشاركة في مسيرات الحراك الرافضة لعهدة رئاسية جديدة لبوتفليقة، والبعض الآخر كان يريد تغييرًا لكنه لم يكن متفّقًا مع الشعارات التي تُعاير الرجل بمرضه وإعاقته.
أردتُ المشاركة في المسيرات، ونزلت مع بنات خالتي. لم أطِل المكوث، انسحبتُ لاحقًا. لم أتقبل أن يتآخى المواطنون خلال زمن المسيرة ثم يتحرشون بي لاحقًا، كلما مشيت في الشارع. شعرت وقتها أن مسألة التغيير أكبر من مجرّد المشاركة في المسيرات.
كان الأمر مُركبًا ومُربِكًا، أما بالنسبة لبوتفليقة الذي ظلّ رئيسًا للجزائر مدّة 20 سنة، فقد ظلّ جدّاي يتعاطفان معه لأنه بالنسبة لهما كان يوجد احتمال صغير بأنه يكون قد أنهى الحرب ذات يوم.. أما أنا فلا زلتُ أتساءل حول هذه الإمكانية، مُتذكرةً تلك السنة.. وسعادة الطفلة التي كُنتها.
سبع سنوات.. ربما يكون هذا كله بفعل الحنين، إلا أني أتذكر بوضوح كيف كان هذا الوقت واعدًا وسخيًا. كنت أدعو هذه الرفاهية براحة البال وكان سبيلي الوحيد إليها هو عائلتي..
أذكر أنها كانت ظهيرة يوم ثلاثاء، وأكاد أقسم أن اليوم في ذلك الزمن كان أطول من أربعٍ وعشرين ساعة، كانت الصحون قد غُسلت والشمس –رغمًا عن الشتاء- تُشرق بابتهاج على سطح بيتنا.
كان أفراد عائلتي يكدحون طيلة أيام الأسبوع، وكنا جميعنا، وأنا معهم، جزءًا من اللاوعي الجماعي الذي يُغرق نفسه في مسلسل “شفيقة بعد اللقاء” ويشارك في إدخال المشاهد “الجريئة” إلى غرفة معيشته “المحافظة”.
كان السطح في بيتنا قديما ومتعبا وشاهدًا على البحر الأبيض وهو يختفي شامخًا إلى الجانب الآخر.. نحو العذر الذي نبرّر به الركود الذي نعاني منه.. “أوروبا”، وكان جدي وقتها يحاول إصلاح كل ما يمكن إصلاحه..
أفكر بجدتي عندما تفوح من شيء رائحة الفحم أو الخميرة.. أفكر بها كلما شعرت بالألفة.. مع مرور الوقت، تبيّنتُ لهجتها ومعجمها، ثم مع السنوات اضطررت للتخلّي عن هذين الأمرين حتى لا يسخر مني أقراني.
بعد كل هذه السنوات، أبحث عن معلومات تخص زيارة بوتفليقة لوهران فأجد أنه جاء مع الرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك، وكان جدّاي حريصين على متابعة الموكب من السطح.
لم أستثمر أي جهد في السياسة وفهمها آنذاك أكثر مما أستثمره الآن، كان تصوري عن بوتفليقة نفس تصور جداي عنه، رئيس الجزائر منذ 1999 أمضى سنواته الأولى محاولًا إعادة السلام، هكذا قيلَ لي.
عندما انطلق الحراك.. أزعجت أصوات الهيلكوبتر جدّاي، كانا يخشيان الاضطرار للتعامل مرّة أخرى مع الحرب. لم أنتبه من قبل أن ما جرى لم يحدث دفعةً واحدة. في بيتنا وفي البلد، تغيّرت أمورٌ كثيرة. ظل جدّاي يكرران أنهما لم يستفيدا في زمن بوتفليقة من أية امتيازات ولكنهما يأسفان لحاله.