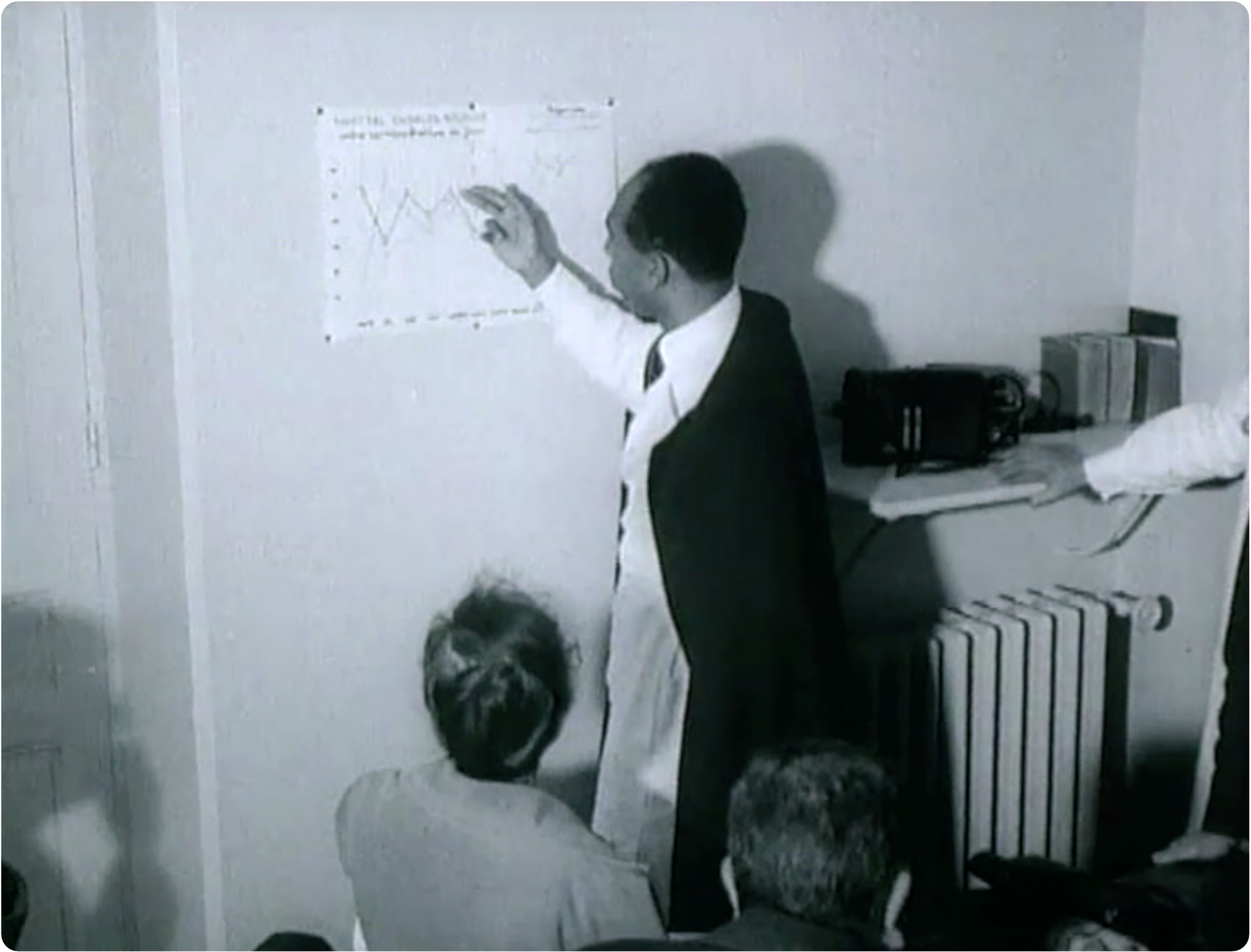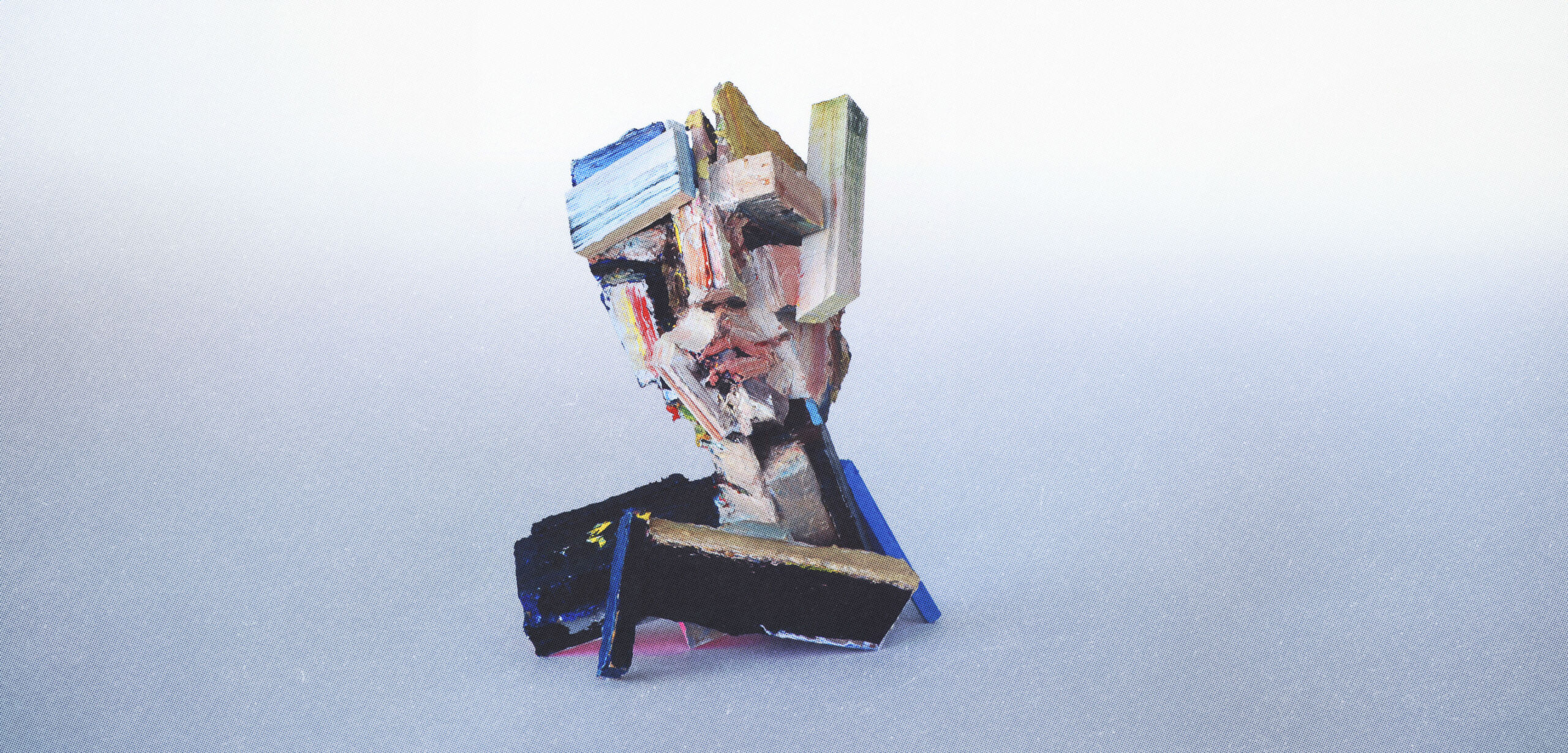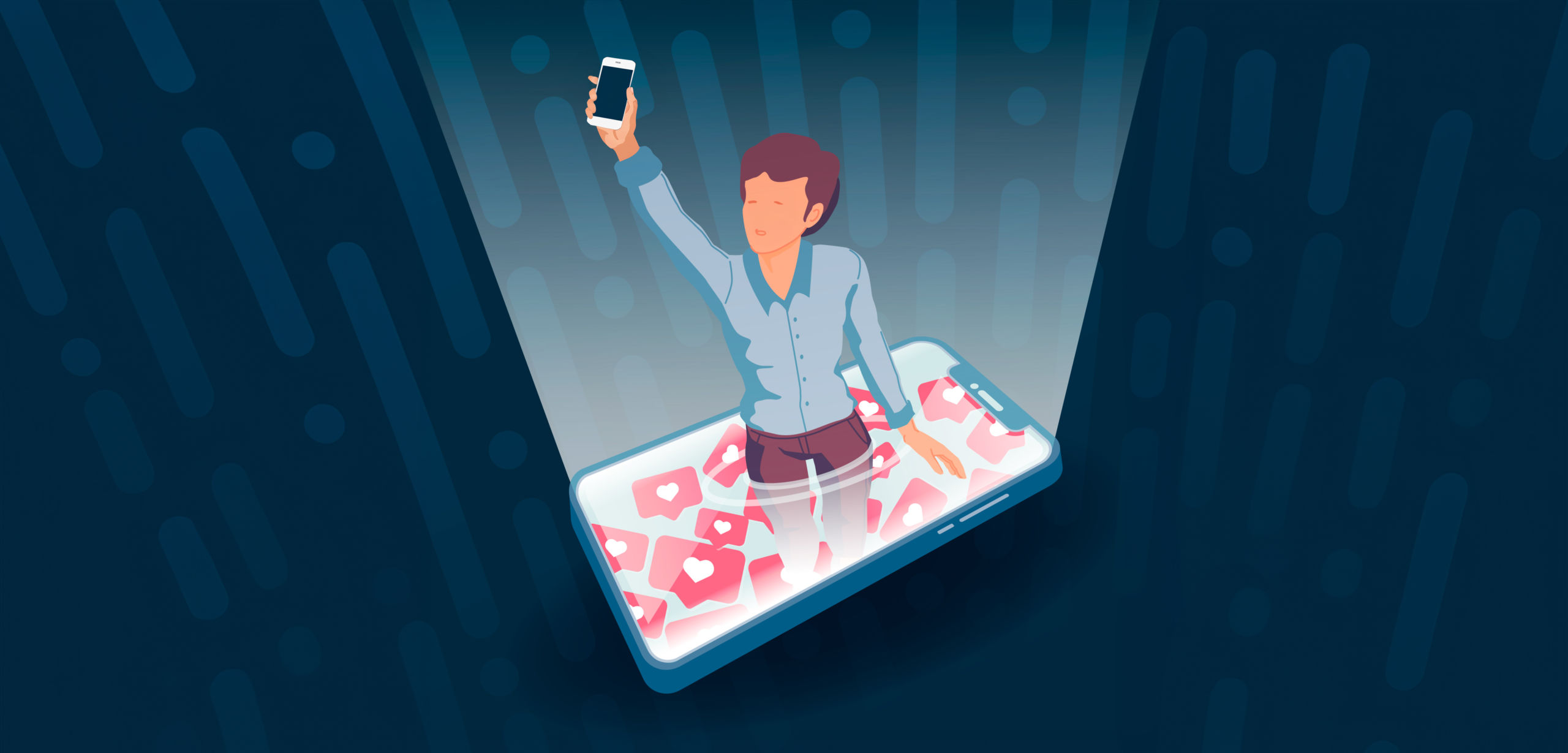نظرت إلى هاتفي متحققاً من الساعة ثم داخل حقيبة ظهري متأكداً من وجود السترة القطنية، الجو متغيّر هذه الأيام، وعلي أن أكون مستعداً لتقلبات السياسة والسماء. مضت نصف ساعة على وقوفي بجانب الطريق، وكل الحافلات التي تمر ممتلئة عن آخرها. توزيع آلاف السكنات من دون دراسة خطوط النقل من العبقريات منقطعة النظير.
تحريرٌ ثان
وصلت أبكر مما توقعت. جلست منتظراً قرب السكنات المجاورة للمستشفى أمام جدارية لمحتها لنادي إتحاد مدينة البليدة (39 كلم جنوب العاصمة الجزائر)، رغم اتساخها بدت لي حديثة. يعيش الفريق نكبته الثانية منذ بضعة سنوات ويصارع من أجل البقاء في القسم الثالث، ومع ذلك كُتب: “البارحة، اليوم وغداً“.
لـ”الجمعية” كما يحب الأنصار تسميتها تاريخ عريق في كرة القدم الجزائرية، وكذلك في النضال. قدّم النادي أكثر من 30 شهيدا لثورة التحرير، وكانت جماهيره تصنع أجواء جمعات حراك 2019.
قبل سنوات كنت أذهب لمشاهدة بعض المباريات، اعتبرت الملعب متنفساً للشارع الخانق، و”بارومتر للمورال”. حالات الهزيمة كانت تنعكس بالصمت القاتل للمئات الخارجين من المدرجات، حينها كان يقول لنا كبار السن الذين نمرّ بهم: “الجمعية خلاص، راحت، ماتحوسوش عليها وماتقلقوش روحكم”، لكن عند الفوز كانوا يكتفون بابتسامات الفخر.
أظن أن ردّ فعلهم هذا يلخص رؤية مواليد جيل الاستقلال تُجاه نكسات ووثبات البلاد: يأس، وفخر عندما يتوفر شبه سبب له. لكنه في الحالتين.. مجرّد ردّ فعل.
قطع الشاب الذي اتكأ على الحائط مُكلِّماً صديقته على الهاتف حبل أفكاري. كان يخبرها أنه لم يذهب إلى العمل اليوم، لأن سعر الحبوب أصبح أغلى من أن يشتريها ويعيد بيعها لكسب رزقه وهو يفكر في البديل. فكرت أنا أنه عليّ الاتصال بصديقي صلاح لأعلمه بوصولي.
أخبرني أنه على بُعد دقائق من المستشفى. وقفت على رصيف الطريق أنتظره، عينٌ على السيارات المارة وعين على شاشة الهاتف وأنا أمرر صفحة الفيسبوك للأسفل، شدني عنوان مقال على موقع الفورين بوليسي: الجزائر تحتاج إلى تحريرٍ ثان. هذه المرة من حكامها المسنين.”
استفزّني العنوان لكنّي لم أفتح المقال، رغم كل شي نحن هنا من أجل هذا السؤال: الاستقلال.
متحف الجنون
بعفوية بادية على ملامح وجهه، ونبرته ولباسه وطريقة تحيّته، خرج عبد النور زحزاح (1973) لاستقبالنا مُعتذراً منا لاتساخ يديه فقد كان يقوم ببعض الأشغال اليدوية. وُلد زحزاح في البليدة، أنهى تعليمه العالي في الدراسات السمعية البصرية، أسّس نادي سينما في المدينة ثم اشتغل في سينماتيك (متحف السينما) البليدة، ولعب والده في “الجمعية”.
يستعدّ عبد النور لتصوير فيلمه الروائي الطويل الأول.. “السينما فيها كثير من التبذير” يقول ضاحكاً وهو يدعونا لجولة داخل المنزل الذي يعمل على تهيئته. ربما قوله هذا يشرح لماذا لم يرد أن يكون المنزل مكان تصويرٍ عابر فقط، ولماذا يسرف -عكس ما نُصِح به- في الإنفاق على تجهيزه بشكل لائق.
سيحكي الفيلم السنوات التي عاشها الطبيب والمناضل فرانز فانون في الجزائر، حيث عُيّن ليكون رئيس قسم الطب النفسي في المستشفى الذي يحمل اسمه اليوم. مجيء فانون إلى الجزائر لم يكن مخطّطاً له، إذ كانت الفكرة الرئيسية هي العودة إلى موطنه مارتينيك (مستعمرة فرنسية في الكاريبي) بعد إكمال دراسة الطب في ليون (فرنسا).
“اجتاز امتحاناً احتل فيه المرتبة الثالثة عشر، وأرسله حظه إلى الجزائر”، يقول عبد النور، ويضيف “وجدنا رسائل لفانون تظهر تردّده بخصوص المكان الذي عُيِّن فيه.. هل هناك سكن؟ هل يحتوي المسكن أثاثاً؟” وغيرها من الأسئلة التي تُظهر فانون في ثوبه البشري.
جاء فانون إلى الجزائر، ولم يغادرها اسمه أبداً. نقترب في الزمان اليوم من ذكرى وفاته الستين، وفي المكان، نقف وسط المنزل نفسه الذي سكنه، والذي يتبع مع ثلاثة منازل أخرى لإدارة المستشفى. يقوم عبد النور بتهيئته من أجل تصوير الفيلم، وليصبح متحفاً يحفظ تراثه ويصون ذكرى عمّال المستشفى الذين سقطوا شهداء في ثورة التحرير. يأمل المخرج أن يكون “متحف الجنون” بحمولته التاريخية والثقافية إضافة لمدينة لم تعد تعرف نشاطاً ثقافياً وفكرياً كبيراً بعد سنين التطرف، خلال العشرية السوداء.
رحبة الاستيطان
نظرةٌ واحدة على المنزل تشي بكل مواصفات العمارة الاستعمارية الفرنسية.. هيكلٌ متناظر ومتناسق، شرفة وإطارات خشبية، نوافذ طويلة، سقف قرميدي عالي شديد الانحدار تبرز منه مِدخنتان، أبوابٌ فرنسية مزدوجة، غرفٌ فسيحة وحماماتٌ عديدة، وحَوشٌ مسرف الاتساع.
لم تقلق السلطات الفرنسية كثيراً بشأن المساحة في مخططات البناء على ما يبدو، فالأرض المنهوبة واسعة.
يفتح لنا عبد النور النوافذ والأبواب ويرينا الصيانات التي قاموا بها، ويوضّح: “قمنا بأمور متعبة ومستنزفة، لكنها لا تظهر كثيراً للعيان، مثل هذه.” جعلني هذا الكلام أفكر في كل الأمور التي نفعلها (وأعني هنا أغلبنا) ولكن لا تظهر، التفاصيل التي نعيشها ونقوم بها، ولكنها لا تظهر، فتُنسى.
الأحياء السكنية تحيط بالمكان اليوم كما لم تكن من قبل، فعند تأسيسه كان المستشفى يقع في منطقة ريفية بعيدة عن المدينة حتى لا يصل صوت المرضى إلى سكانها، قرية على أطراف البليدة تسمى “جوانفيل”. يُرجع عبد النور الفضل في اِسترجاع المنزل إلى جمعية “أحباب فانون” التي ينشط فيها أطباء وعمال من المستشفى.
زاوية تصوير القصة
يقول عبد النور أن هناك مشروعين لتصوير فيلم عن فانون يتم التحضير لهما خارج الجزائر، لكنه يعتقد أنه يمتلك الزاوية المناسبة لنسج قصة المارتينيكيّ أمام الكاميرا. هذه الزاوية هي تصوير فصل واحد من فصول حياة فانون القصيرة والغنية.. مروره بمستشفى البليدة من 1953 إلى 1956.
ولد فانون سنة 1925 لعائلة أفروكاريبية من الطبقة العاملة في بورت دو فرونس، هو ثالث الذكور في أسرة ذات ثمانية أطفال. عمل والده “فيليكس” -الذي ينحدر من سلالة عبيد أفارقة- وكيلاً جمركياً، واشتغلت أمه في متجر بقالة. استطاعا أن يوفرا له تعليماً ثانوياً في مدرسة “فيكتور شولشر” التي كان يُدرِّس فيها الشاعر والمفكر إيمي سيزير (1913-2008).
كان شولشر سياسياً فرنسياً اشتهر بدعوته لإلغاء الرق في المستعمرات الفرنسية. خضعت الجمهورية الثانية للمطلب بعد سنوات من تمردات العبيد السود ونشاط أمثال شولشر. بالكاد تحسّنت حياة المارتينيكيين التي بقيت تحت رحمة الميليشيات الفرنسية، ثم حكومة فيشي -حليفة ألمانيا- التي أسّست نظاماً قمعياً، جعل فانون يصفهم بأنهم خلعوا الأقنعة وتصرفوا مثل “عنصريين حقيقيين”، وجعله أكثر اشمئزازاً من العنصرية الاستعمارية.
قبل إنهاء دراسته الثانوية، في سن السابعة عشر، قرر المشاركة في الحرب ضد النازية ودول المحور، فهرب مع صديقه مارسيل مونفيل -الذي سيصبح محامٍ لجبهة التحرير الوطني الجزائرية لاحقاً- من أجل الانضمام إلى القوات الفرنسية الحرّة.. “هرب ليلة عرس أخيه، العرس في دارهم وهو هارب” أخبرنا عبد النور ضاحكاً.
يواصل المخرج سرد قصّة فانون: “أصيب في الحرب وأرسل إلى الجزائر، عولج في مستشفى في بجاية (شرق العاصمة)، يحمل اليوم اسمه هو الآخر”.
بعد صدمة الممارسات العنصرية خلال الحرب وهي تجربة أتاحت له مراقبة بنية المجتمع الاستعماري، عاد فانون لمارتينيك لفترة وجيزة، أكمل فيها شهادة البكالوريا وعمل في الحملة البرلمانية لصديقه ومعلمه إيمي سيزير، قبل أن يذهب لفرنسا مرة أخرى. “حصل على منحة من روبير لاكوست (سياسي فرنسي وحاكم الجزائر بين 1956-1958) لدراسة الطب في مدينة ليون، لاكوست نفسه الذي أرسل له فانون لاحقاً استقالته الشهيرة من مستشفى البليدة”. درس الفلسفة أيضاً، ثم أجرى تربصاً تحت إشراف الطبيب الراديكالي الكاتالوني فرونسوا توسكيياس، “وجدنا رسائل يطلب فيها فانون آراء وتوجيهات من أستاذه”، يقول عبد النور.
بدأ فانون بملاحظة آثار العنف الاستعماري على النفس البشرية، وكتب حينها تحليلاً لأثر القمع الاستعماري على الوعي العرقي. قرأ مسودته فرونسيس جونسون (شيوعي فرنسي من مساندي جبهة التحرير الوطني) ودعا فانون للقائه، كان جونسون وقتها محرراً بمنشورات “لو سوي”. “كان لفانون شخصيةٌ عصبية، لما سأل جونسون عن رأيه في الكتاب وأجاب بـ”ليس سيئاً”، ردّ قائلا “ليس سيئاً بالنسبة لزنجي أليس كذلك؟” وخرج من مكتبه، “فانون كان عصبياً” يكررها عبد النور.
رأى فانون أن العنف هو السمة المميّزة للاستعمار، لهذا قد يكون أيضاً ردًا عن قمع الاستعمار وأداةً ضرورية للمشاركة السياسية. وهو ما وجده عندما قدم إلى الجزائر.. حركة ثورية مسلحة بواجهة سياسية، انضمّ إليها وأصبح لاحقًا رئيس تحرير جريدة المجاهد -الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني.
يرى عبد النور زحزاح أن فانون هو طبيب نفسيّ في المقام الأول قبل أن يكون سياسياً ومفكراً وكاتباً، وبالرغم من أنّ صورته كطبيب مارس أفكاراً ثورية في مهنته لا تغلب على صورته الثورية، إلّا أن فهم أفكاره ومسارة النضالي لن يكون سوى بالعودة أولاً وآخراً إلى “فانون الطبيب النفسي”، وهو الذي تواجد لسنوات ثلاث في البليدة، أطول من أي مكان آخر مارس فيه المهنة.
فانون.. منذ البداية
كَوْن عبد النور من البليدة صدفة مميزة.. “حتى لو لم أكن من البليدة لاخترت أن أركز على سنوات حياته هنا” يقول شارحاً.
هذه ليست أول مرة يعمل فيها المخرج على فانون، فقد قام بإخراج فيلم وثائقي عنه بالشراكة مع المختص في الطب النفسي البروفيسور الراحل بشير ريدوح قبل قرابة عقدين من الزمن، وكان عنوانه فرانز فانون، ذاكرة الملجأ. “استغرقني الفيلم 3 سنوات. كان فيلمي الأول وكنت لا زلت أتعلم.. كانت تجربة أولى بمعنى الكلمة”، ثم يواصل.. “دوماً ما يأخذ فانون كثيراً من الوقت، هذه المرة لما ظننت أن الأمور أسهل، جاء فيروس كورونا وتأجّل كل شيء”، فانون على حد تعبيره “صعب”، لأنه مشهور ومحبوب، لذا الخطأ غير مغفور.
انكبّ عبد النور الشاب على جمع شهادات من ممرضين محليين اشتغلوا مع فانون أو تدربوا تحت إشرافه.. “كان المستشفى مركز توظيف كبير، حوالي 2000 عامل، منهم كثير من البليديين.. ولأن أبي بليدي فقد وجّهني نحو أسماء اشتغلت فيه، بالإضافة إلى تلك التي عرفتها خلال عملي مع البروفيسور ريدوح.” يسرد لنا عبد النور مغامراته السينمائية الأولى.
“دحمان مختار، كان مساعداً لفانون، جميلة حسني، محمد بلغراد الذي كان لا يتحدث إلا الفرنسية أو العربية الفصحى، وغيرهم قمت بتصويرهم في منازلهم.. كما قمت بتصوير المستشفى والندوات/الجلسات التي كان يقيمها بشير ريدوح.”
كان هذا هو الفيلم الجزائري الأول عن فانون بعد فيلم أنتجه التلفزيون الوطني (إخراج حورية سايحي) أواخر الثمانينات. على قدر ما اشتهر فانون، أبعده ذلك عن حقيقته كما يرى عبد النور، وأصبح في بعض الانتاجات الأجنبية كذبة، نُسبت إليه أمور لم يقم بها ولم يتحدث عنها مطلقاً.
الاستماع للشهادات وتصويرها جعله يصنع صورة ذهنية أكثر قرباً من فانون الطبيب و”الإنسان”، يسرد لنا ضاحكاً: “أخبرني عمي أن آخر مرة رأى فيها فانون كانت عند الجزار.. وقلت لنفسي: كان يذهب للتسوق إذن”.
لم يكتف عبد النور بالشهادات المحلية، فمع بدايات دخول الأنترنت، وجد مصادراً دلّته على عناوين عدة شخصيات فرنسية لها ارتباطاتها الظرفية بفانون، على غرار ناشره فرونسوا ماسبيرو (1932-2015) وصاحب أول فيلم جزائري بعد الاستقلال جاك شاربي (1929-2006). قام بمراسلة الجميع كتابياً وتلقى رداً من أغلبهم. “رُفِض وقتها طلب حصولي على الفيزا، لذا راسلتهم مرة أخرى للاعتذار، لكن ماسبيرو قال أنه سيأتي للجزائر، واتصل بي من أجل التصوير.. كوّنت معهم علاقات صداقة، وزرت ماسبيرو عدة مرات لاحقاً في فرنسا”.
أربع ساعات ناقص الصوت
كان محمد يزيد (1923-2003) من بين الشخصيات الوطنية التي قابلها عبد النور من أجل الوثائقي. أحد الثوريين والسياسيين الجزائريين الذين احتكّ بهم فانون. وُلد يزيد ودرس في البليدة ثم أتمّ دراساته العليا في فرنسا، كان أحد أعضاء الحكومة المؤقتة وممثلها في الأمم المتحدة وضمن الفريق الدبلوماسي في باندونغ ثم الولايات المتحدة. يقول عبد النور: “محمد يزيد ورفاقه في الأمم المتحدة هم من مهّدوا الطريق للاستقلال، ثورتنا كانت في المقام الأول ثورة دبلوماسية.. وما هو الاستقلال غير أوراق مُعتَمدة من الأمم المتحدة؟ اتفقنا؟ محمد يزيد هو من جاء بهذه الأوراق”.
“كان محمد يزيد لا يزال على قيد الحياة حينها، صوّرته في منزله وراء الرئاسة في العاصمة.. بالمناسبة هل تعرف كيف توفي؟ ليلة أول نوفمبر (تاريخ انطلاق الثورة التحريرية)، أقام بوتفليقة عشاءً في الرئاسة لقدامى جبهة التحرير والشخصيات الثورية ولم يقم بدعوته، هو لم يكن يأبه للمناصب التي اعتزلها منذ الاستقلال ولكنه كان مريضا ويبدو أن الأمر أثر فيه، ومات ليلتها.”
يضيف “خاطبني: تعال لأريك ما الذي صنعه من أجلكم عمكم يزيد. حوّل ركنًا كاملًا من منزله إلى دار صحافة، مذهل جداً ! لم يثق في الرئيس الجديد (أي بوتفليقة) وفكّر أنها قد تفيد الصحفيين لكتابة ما يجري في الجزائر للعالم الخارجي، لو فكّروا يوماً في منعهم من دخول مكاتبهم”.
أجرى عبد النور معه حوارًا امتد لأربع ساعات.. “اغتنمت الفرصة للحديث عن عدة مواضيع.. لكن الكاميرا لم تعمل بشكل صحيح، وتعطّل الصوت”، يشرح عبد النور الذي واجه في نهاية التسعينات مشكلة في الحصول على عتاد التصوير النادر والغالي.. “أملك وجه اليزيد فقط.. استطعت استرجاع خمس دقائق فقط، كانت كافية من أجل الفيلم، لأن كل كلامه ذو جودة” يقول عبد النور.
وأنا أستمع لعبد النور يقصّ حادثة يزيد، فكرت أنه لا يختلف كثيرًا عما نملكه عن كثير الشخصيات التي صنعت أمسنا القريب، أوجهٌ فقط، مقولة هنا، وأخرى هناك.
يحكي محمد يزيد في فيلم عبد النور كيف لعب فرانز فانون دوراً هاماً في حصول جمهورية الكونغو على استقلالها -بعدما أعاد كتابة البرنامج الانتخابي لصديقه باتريس لومومبا، عندما زاره عشية الاستفتاء سنة 1960، وحرّضه على طلب طرح مشروع “الاستقلال التّام“.
“لماذا؟” يسأل عبد النور، قبل أن يُجيب: “لأن الزمن والهوى السياسي كان يريد ذلك.. لأن الأمر كان مُمكنناً.. لأنهم كانوا يعيشون ويصنعون زمن الاستقلالات”.
كان فانون حينها سفيراً للحكومة المؤقتة في غانا، شارك في عدة ملتقيات إفريقية دولية، وجُمِعَتْ كتاباته لهذه الفترة في كتاب “لأجل الثورة الأفريقية” عن منشورات ماسبيرو، وترجمه لاحقًا محمد الميلي إلى العربية بعنوان “من أجل إفريقيا“.
نعرف من شهادة محمد يزيد اليوم، أن تأثير فانون تجاوز كتاباته عن ضرورة التحرّر في شكل وحدة أفريقية، وتعزيزها من أجل مواجهة شرور الإمبريالية، وتعدّاه إلى التأثير المباشر بالحضور الجسدي.
“لم يكن ديبلوماسياً ممتازاً كما يقال، تجده بجانب اليزيد دوماً، كان أستاذه، لكنه على الأقل حقّق الاستقلال للكونغو”.. يخبرنا زحزاح ضاحكاً.

فانون ومحمد يزيد في مؤتمر الشعوب الأفريقية في ليوبولدفيل (1960). المصدر: صفحة فرانز فانون الرسمية (فيسبوك)
المعلمة الفلسطينية
صدر فيلم زحزاح “فرانز فانون، ذاكرة الملجأ” سنة 2002، وعرض في عدة مهرجانات فرنسية جعلت عبد النور يخوض تجربة سفر طويلة إلى هذا البلد دامت لثلاث سنوات، أصدر فيها فيلمين، الأول عن الفن الهامشي في الضواحي الباريسية بعنوان (اللافعل – Le Non-Faire) والآخر عن الكاتب الفرنسي “موريس بون”، أحد موقعي بيان الـ 121 (والذي دعا إلى الاعتراف بالثورة الجزائرية كنضال شرعي من أجل الاستقلال) الذي نشره جان بول سارتر.
فضّل زحزاح حمل الكاميرا والعودة إلى الوطن عام 2006، مصممًا على التصوير في الجزائر فقط وعلى العمل بشكل مستقل.. “في السينما يلزم تخدم وحدك”، يقول بنبرة فيها الكثير من الجدية.
مع استضافة الجزائر لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية سنة 2007، أودع عبد النور سيناريو فيلم وثائقي عن رحلة للبحث عن معلمته الفلسطينية.. “كان فيلماً عن العلاقات الإنسانية بين الجزائريين والفلسطينيين، علاقات الدم الناتجة عن التهجير والترحال في الجهتين.. كان ليكون رحلة بحث تصل حتى لبنان وتعرض قصصاً عن تداخل الشعبين.. لا أدري لماذا رُفِضَ في تظاهرة للثقافة العربية، ما الذي يجمع العرب غير فلسطين؟” يضيف: “لكنني تأكدت لاحقاً أنهم لم يقرأوا السيناريوهات”.
قصة العلاقات الإنسانية بين الجزائريين والفلسطينيين تعيد فكرة فانون عن شرط نجاح الفعل الاستعماري.. إعادة تنظيم حياة أهالي المستعمرات. الممارسات الفرنسية شملت سياسات التهجير القسري والنفي في حق مئات العائلات إبّانَ الثورات الشعبية الجزائرية (خلال القرن 19) إلى خارج البلاد، فمثلاً هناك جزائريون هربوا من فرنسا إلى القدس في القرن 19، ثم هُجِّر أحفادهم خلال النكسة 1967، ورجعوا الجزائر التي ما عادت أرض الأجداد ولكنها “دولة شقيقة”. “بين الجزائر وفلسطين قصة كبيرة” يقول عبد النور.
“المسيرة الطويلة نحو النيباد” (2009) كان أول فيلم يقوم به عبد النور بعد عودته إلى الجزائر، وكان بطلب من وزارة الثقافة. تستضيف تلمسان بعد سنتين تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وتتم دعوته من قبل الوزارة لصناعة فيلم تحت الطلب أيضًا، كان عن الميراث الموسيقي الأندلسي في الجزائر “قم نغتنم ساعة هنية” (2011). لكن ما الذي تغيّر بين عاصمة الثقافة العربية والإسلامية؟
الذي حصل، كان قراقوز (2010) أول فيلم روائي متوسط الطول يكتبه ويخرجه عبد النور، وقد لاقى نجاحاً نقدياً مُعتَبَراً بحصوله على عدة جوائز ومشاركات في مهرجانات سينمائية دولية. الفيلم يحكي قصة محرِّك دمى (قراقوز) ورحلته في طرق جبلية في جزائر ما بعد الحرب الأهلية، كتب عبد النور القصة وكافح حتى أنتج الفيلم وأخرجه. “قمت بإرساله للمهرجانات بنفسي، أحضّر الأقراص المضغوطة بنسخ مترجمة وملفات حاضرة وأرسله من البريد المركزي في كل مرة، فال الخير.. كما أخبرتكم، يجب أن تقوم بكل شيء وحدك” يقول عبد النور.
الواد، الواد
أخبرنا عبد النور أنه يفضل دوماً التصوير في مكان قريب منه إذا كان العمل وثائقياً، ولا يوجد أكثر قرباً لساكني متيجة من الوادي.
تخيّلت في أن المساحة الممتدة بين الأطلس البليدي جنوباً والبحر شمالاً هي الجزائر، كل الجزائر. وهي المساحة التي يخترقها وادي سيدي الكبير من منبعه بأعالي الجبال (حوالي 1525 م) وحتى مصبه غرب مدينة الجزائر.
تعتبر جبال الأطلس البليدي أغنى جبال الجزائر من ناحية الثروة المائية، مئات الينابيع والجداول والشلالات. بينما لا تزود عائلات مدينة البليدة بالمياه إلا ساعات قليلة كل أربعة أيام، وكل هذا بسبب شركة “نستله” التي أمّمت منبع سيدي الكبير وملأت مياهه في عبوات.
يتبع عبد النور مسار الوادي جغرافياً وإنسانياً من خلال قصص مختلفة للسكان وتأثر حياتهم به. صوّر لوحات طبيعية لجمال مرور المياه، ولتلويثها أيضا، أسمعنا خرير الوادي، مصحوبا بأصوات حزينة تشكي ظروف المعيشة خمسة عقود بعد الاستقلال.
منذ آخر أفلامه الواد الواد (2013) يستعدُّ عبد النور -بعد مسار عشرين سنة وعدة أفلام- لتصوير فيلمه الروائي الطويل الأول أخيراً. بكلمات يشوبها بعض الأسف أخبرنا: “أقترب من سن الخمسين لأصور فلمي الطويل الأول..لكن هذه هي الجزائر ربما، عليك أن تقضي وقتك في القيام بألف مهمة ومهمة بدل الكتابة والإخراج”.
ولكنّ عبد النور يعتبر تأجل مشروع التصوير (لبداية 2022 حسب ما أخبرنا) بسبب الكورونا جاء بفائدة نوعاً ما، حيث أنه راجع السيناريو ونقّحه وجدّد بيت فرانز فانون بالكامل وهو يهيّئه ليصير متحفاً بعد تصوير الفيلم.
فكّرت ونحن نودّع الرجل المُخلص في عمله، أن ثمار الاستقلال تتعطّل في بعض الأحيان، وقد يطول الأمر.. والأكيد أنه يبقى ناقصاً دائماً في حاجة للمزيد من العمل.