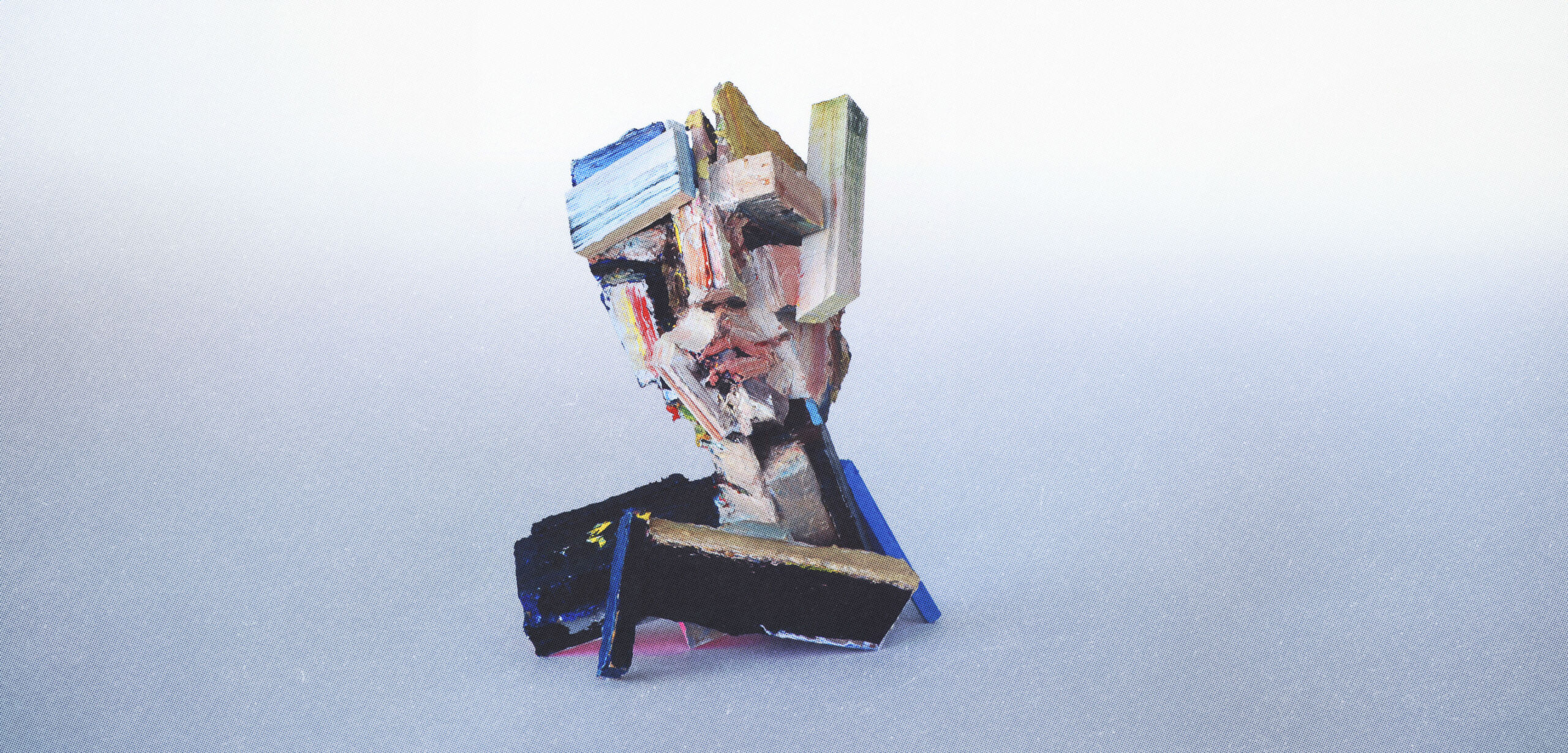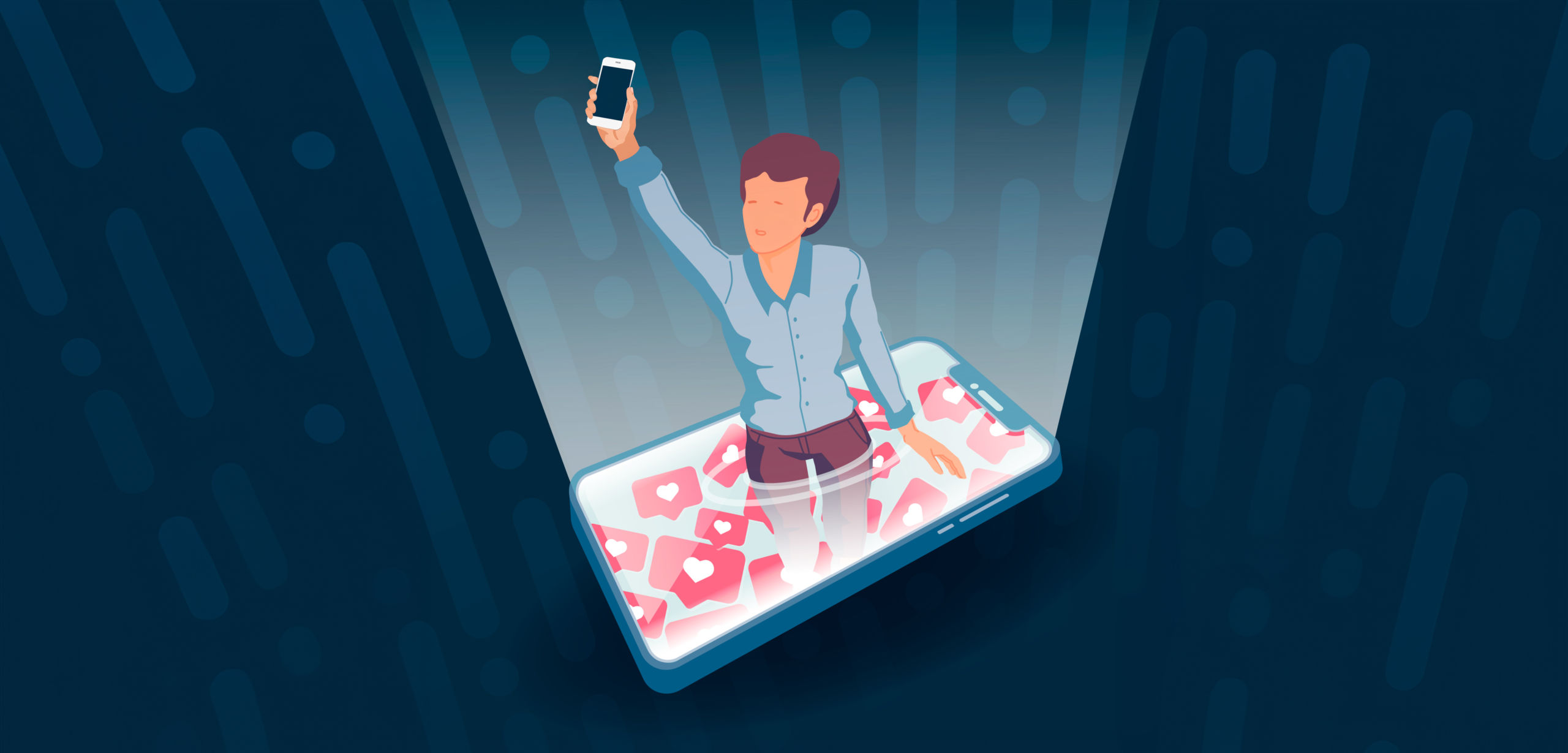نعرف القليل عن آبائنا. تتطلب الكتابة عن الأسرة نبشًا في الماضي. والماضي نوعان: نوع عشته بنفسك مع أسرتك، والآخر ذلك الذي حدث قبل أن توجد في هذا العالم. إننا لا نكتب الماضي وإنما، على الأرجح، نواجه ذاكرته. نسآءل ذاكرتنا، نقلّبها، بما يعتمل فيها من صور وأحلام واحباطات وآلام.
يكون والدينا في منتصف العمر حين نبدأ تعرفنا الحقيقي عليهما. وتلك المعرفة يختلط فيها التواصل مع إصدار الأحكام. ما كان بالأمس حبًا غير مشروط، يصير مع بداية مراهقة الأبناء صراعًا مستمرًا وسلسلة من سوء الفهم وتصادم الرغبات. يتوارى الحب تحت هذا الركام.
لكي يعرف الفرد تاريخ أسرته عليه أن يسأل. أو يمنحه الله حكاءً ضمن الأهل والأقارب.
ربما المشكلة لا تكمن في توفر المعرفة من عدمها، وإنما في الرغبة فيها بالأساس. أن ترغب في معرفة والديك قبل أن يكونا كذلك، ومعرفة وجودهما الذي يتخطى دورهما كمجرد أب وأم داخل الأسرة، جوانبهما الذاتية الأخرى التي نتغافل عنها، بعيدًا عن لائحة الأوامر والنواهي والإرشادات. أعرف القليل “عن” والديّ، لكني أعرف والدي نفسهما. ربما لهذا لا اسأل كثيرًا عما أجهله. لا أعرف مثلًا كيف التقى أبي وأمي، أين ومتى، إلا أني أعلم أنهما يحبان بعضهما حبًا راسخًا. وهذا يكفيني.
أفكر في ما هو أهم من التاريخ كوقائع، التاريخ كسردية؛ يقدم أرباب كل أسرة سرديتهم الخاصة، سردية غير معلنة، تستخلصها الأجيال التالية، الأبناء من الأبناء، أو الأحفاد من الأجداد وهكذا. هناك سرديات كبرى وأخرى صغرى. الصغرى، تلك المرتبطة حصرًا بالأب والأم أو بالتفاصيل اليومية، تبدو أكثر صدقًا وحميمية.
كما قلت، تتخلق تلك السردية بأثر رجعي. تتجمع من شتات الحكايات والمواقف. الآن، أحاول استنتاج السردية الخاصة من حياتي مع أسرتي.
سردية صغيرة
تزوج أبي وأمي رغم الفوارق المادية والاجتماعية. عائلة أمي نموذج للطبقة الوسطى في تركيزها على المكانة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والترقي الوظيفي، مع انتماء الأجيال الأكبر إلى مُلاك الأراضي.
ولد جدي لأمي عام 1901؛ كان أزهريًا ومعلمًا للغة العربية في المدرسة الفاروقية البحرية. أمي الأصغر بين ثمانية أخوة. كان الأخ الأكبر لواء جيش، أما الثاني فهو محامٍ؛ عمل في السعودية لسنوات، وانتمى للإخوان في فترة مبكرة من حياته. بقية الأخوة منهم الطبيبة والمدرسة والصيدلي. أما والدتي فهي مهندسة مدنية، وإلى الآن لا أعلم هل عملت فترة من حياتها في ذلك المجال أم لا.
لا يحمل أبي مؤهلًا جامعيًا، وينتمي لأسرة ريفية بسيطة، ربما لا تتعدى حيازتها للأراضي بضعة قراريط. نزح أبي وأخوته إلى المدينة عدا عمتي، التي ما زالت تعيش في القرية. جُند أبي في الجيش من عام 1968 إلى عام 1975، واستقر بعدها في الإسكندرية.
عندما تقدم أبي لخطبة أمي كان أبواها قد توفيا. لم يوافق الأخوة على أبي، لكن المعارضة الأشد كانت من أزواج الأخوات. “العدايل” بالعامية المصرية. كان منهم المستشار والطبيب، ولم يجدا في أبي النسب الملائم لهما. تمسكت أمي بقرارها، وتزوجا وقاوما الظروف الصعبة، وما زالا يقاومان حتى الآن.
لذلك يُعتبر الحب أساس تلك السردية. وإليها أعزو ضعف اهتمامي بالأمور المادية، وتراجعها من حيث الأولوية.
لكن القصة لا تنتهي هنا، أي لا تنتهي بزواج أبي وأمي، بل كانت هذه فقط البداية.
لا أشعر بالمرارة التي تنتاب أولئك الذين ظلموا من آبائهم، أو لاقوا عسفًا وقهرًا في تربيتهم، وإنما ما أشعر به هو الندم. ويمكنني صياغة هذا الندم في جمل بسيطة. لم أكن الابن الذي تمناه أبي وأمي، لقد خذلتهما. هذه عقدة ذنب داخلية، لا أبوح بها إلى أحد
يمكنني صياغة البقية في جمل بسيطة. ناضل أبي وأمي من أجل أن أكون، أنا وأخوتي، أفضل ما يمكن؛ لقد تحملا وثابرا، قدمت أمي التضحية تلو الأخرى، وكدح أبي في الحياة بيديه، يوميًا من الصبح حتى ساعات متأخرة من المساء. ولذلك يجب أن نكون أفضل من البقية، من الأقارب والأغراب. وحده التفوق يمكنه أن يعوضهما عن عناء السنين. أن يسعد أمي، أن يجعل أبي فخورًا ويحقق له مكانة مفقودة، وذلك بأن يصير أبناؤه أفضل من أبناء الذين رفضوه من قبل.
أنظر الآن إلى المطلب “البشري” البسيط الذي طالب به أبي وأمي. لم يعلنا صراحة: نريدك أن تكون أفضل من فلان أو ابن فلان، لم تكن ثمة حاجة إلى ذلك. وكنت متفوقًا طوال سنوات الدراسة، لكني أخفقت في الثانوية العامة. تمثل الإخفاق في عدم دخولي واحدة من كليات القمة.
أحببت القراءة منذ الصغر، لكني اكتشفت عالم الأدب مع نهاية المرحلة الإعدادية وبداية الثانوية. قرأت أغلب أعمال يوسف إدريس ونجيب محفوظ في الصف الثالث الثانوي. خذلت أبي وأمي لكني عرفت طريقي. أريد أن أكتب. وتحت وطأة الخذلان، تناسيت تلك الرغبة في السنوات الأولى من الجامعة، ثم اجتاحتني مرة أخرى قبل التخرج، وبقيت داخلي حتى الآن، وربما للأبد.
حين أنظر إلى سنوات طفولتي ومراهقتي وشبابي حتى تزوجت وأصبحت أبا وصارت لدي أسرة، لا أشعر بالمرارة التي تنتاب أولئك الذين ظلموا من آبائهم، أو لاقوا عسفًا وقهرًا في تربيتهم، وإنما ما أشعر به هو الندم. ويمكنني صياغة هذا الندم في جمل بسيطة. لم أكن الابن الذي تمناه أبي وأمي، لقد خذلتهما. هذه عقدة ذنب داخلية، لا أبوح بها إلى أحد، وجدتني أكتبها الآن، تجاوز أبي وأمي إخفاقي منذ زمن بعيد؛ فرحا بنجاحاتي التالية، وبحفيدتيهما. لم ينبشا في لحظة ماضية لا معنى لها، وبالنسبة لي لا فارق عندي بين الكليات والوظائف والمناصب.
لكن بقي داخلي هاجس أصيل: أنا لم أحقق ما كان متوقعًا مني، وحتى في علاقتي مع الكتابة، تلك الحياة التي اخترتها، لم أحقق الحد الأقصى الذي تشي به إمكانياتي، لا استغل قدراتي كما ينبغي، أو أدفع بنفسي إلى الحد الأقصى. مجرد هواجس، ربما.. لكن كما تعرفون: لا دواء للندم.
الصورة: محمد عمر جنادي، من أرشيف العائلة
ذاكرة الأسى
طرح أحد الأصدقاء سؤالًا على حسابه بالفيسبوك. كان يتساءل هل من المفترض أن نسامح أهلنا/ والدينا على ما فعلوه بنا وما سببوه لنا من أذى لمجرد أنهما صارا أضعف الآن. يضيف الصديق مستنكرًا: ألم نكن ضعافًا ولا حول لنا أثناء طفولتنا؟ كيف يكون في الغفران أي نوع من العدالة، ونحن ما زلنا نعاني من الآثار النفسية والجسدية المدمرة، البصمات الآثمة التي لن تُمحى أبدا من داخلنا؟
تراوحت التعليقات بين التأكيد على عدم الغفران وضرورته؛ الغفران ضروري كي نستطيع أن نكمل حياتنا ونصير أسوياء، والغفران ظلم أيضا لأنه يحملنا ما لا طاقة لنا به، ويطالبنا بالتسامي على مشاعر طبيعية، حتى لو كانت سلبية.
أعرف الصديق من حياتنا “الحقيقية” منذ عشر سنوات، قبل أن يصير لديه أكثر من أربعين ألف متابع لحسابه الشخصي. وأظن أن السوشيال ميديا تشجع البعض على البوح بطريقة قد لا يوفرها الواقع الفعلي. في رده على التعليقات، قال الصديق إن الكوابيس ما زالت تزوره في نومه، يصحو مفزوعًا متخيلًا أن أباه سرق مدخراته أو طرده من البيت.
“إننا لا نذيع دائمًا بصوت عال أهم ما نود قوله. كذلك لا نتقاسمه دائمًا في خصوصية مع أقرب الناس إلينا، مع أصدقائنا الحميمين، أكثر من هم مستعدين بإخلاص لتلقي اعترافنا”. هكذا كتب فالتر بنيامين في مقاله ذائع الصيت “صورة بروست“. يصف بنيامين عمل الذاكرة في سرد الروائي الفرنسي العظيم مارسيل بروست بـ “الذاكرة اللاإرادية”. يقول بنيامين مستلهمًا قوانين التذكر ضمن عمل بروست إن “أي حدث خبره المرء هو حدث متناه، بينما أي حدث يتذكره المرء هو حدث لا متناه، لأنه لا يعدو أن يكون مفتاحًا لكل شيء جرى قبله وبعده”.
لا أريد أن يفهم من كلامي أني أب مثالي لا سمح الله. لم أكن ابنًا مثاليًا ولن أصبح أبًا مثاليًا كذلك. لا وجود لأساطير الكمال والمثالية في عالم الأسرة. لا وجود لآباء أو أبناء مثاليين. وربما لو اعترفت كل أسرة بتلك الحقيقة لصارت الحياة جنة ونعيمًا
بإخلاص، أتذكر الآن اعتراف الصديق، وأفكر: حين يستيقظ كل صباح، فإنه لا يمسك في يديه إلا النزر اليسير من نسيج الحياة المعاشة، بينما في الليل كانت ذاكرته تنسج أحلامًا من “نول النسيان”، وخلال اليوم، ينخرط مثلنا بقصدية في محاولة تخليص ما يود تذكره من غلالات النسيان، ودفع كل ما استرجعه بشكل لا إرادي إلى مناطقه المعتمة.
لو فكرنا فيما يمكن أن يتذكره أطفالنا من حياتهم معنا، في الاحتمالات الغامضة التي ستقدمها الذاكرة، فإن اليأس هو أقل ما يمكن أن نصاب به. لأن أقل فعل، أقل لفتة، أقل إيماءة غضب، أو أبسط زفرة ضيق نطلقها في وجه أطفالنا ونحن مشغولون عنهم بهم، بنضالنا في الحياة اليومية من أجلهم، يمكن للذاكرة أن تضخمها وتكسبها ظلالًا من التعاسة. هكذا يحمل أي فعل نُقدم عليه إمكانية الأذى. ولا أستطيع أن أتخيل وسط كل هذا ما تحدثه أفعال الأذى المتعمد في نفس من أوذيّ. أذى لا متناه، سبق أن خبره الصديق، والآن يتذكره.
أتذكر بروست على الدوام. تحديدا الصفحات التي قرأتها بالمجلد الأول من رائعته “البحث عن الزمن المفقود”. يحكي فيها عن انتظاره وهو الطفل اللحظة التي تصعد فيها أمه إلى غرفته لتتأكد من نومه، أن تحبُك الغطاء من حوله، وربما تقول له “تصبح على خير” مرة أخرى. تكتسب تلك الكلمات سحرًا خاصًا بها. تتجاوز كونها مجرد تحية أو أمنية أو لازمة تقال لزوم النوم. تصير وعدًا من الكبار إلى أطفالهم بأن القادم جميل، أن اليوم الجديد يحمل الخير بين جنباته. لا مجهول في العالم، نؤكد لكم ذلك أيها الصغار.
يحكي بروست عن لحظات الانتظار خلال صمت الليل وظلمته، وتناهي حديث الأسرة في الأسفل مع الأقارب أو الضيوف. وأتذكره دومًا خلال تحايل إحدى ابنتيّ على النوم، والتحجج بشرب المياه أو دخول الحمام، أو أيٍ من توافه الأمور. لحظتها، يصبح صبري بلا حدود، أبدي، أتفهم كل الحجج وطرق التملص وإرجاء النوم بحكمة كاهن من التبت. ولولا بروست لتخللت الحدة كلماتي معهما، أو اكتسبت صيغة آمرة، صيغة لا تتفهم وطأة ما قبل النوم على خيال الطفل.
شكرًا مارسيل بروست.
لا أريد أن يفهم من كلامي أني أب مثالي لا سمح الله. لم أكن ابنًا مثاليًا ولن أصبح أبًا مثاليًا كذلك. لا وجود لأساطير الكمال والمثالية في عالم الأسرة. لا وجود لآباء أو أبناء مثاليين. وربما لو اعترفت كل أسرة بتلك الحقيقة لصارت الحياة جنة ونعيمًا. لكن لا وجود للجنة على الأرض، وتلك حقيقة أخرى. هكذا لم يكن عيشي مع الأسرة مثاليًا، لكنه كان خاليًا من مثل ذلك الأذى الذي اختبره الصديق.
في حالتي، كانت المعاناة غير مرتبطة حصرًا بأسرتي. ذلك لأن الأسرة لا توجد في الفراغ. لو أردت النظر إلى الوراء في غضب، فإني سأتأمل تقاطع أسرتي مع ما هو أكبر منها؛ وأقصد: الزمن والطبقة والمجتمع.
تحولات أسرية في ظل الصحوة الإسلامية
تزامنت طفولة مواليد الثمانينيات، بنصفيها الأول والثاني، مع أوج “الصحوة الإسلامية”. هذا الاسم هو الذي أطلقته التيارات الإسلامية المختلفة على حركة الأسلمة الواسعة الممتدة من بداية السبعينيات حتى ثورة يناير. ومع المراهقة ثم سنوات الشباب الأولى كانت الصحوة قد حققت سيادتها على المجال العام.
يوضح المؤرخ المصري شريف يونس في كتابه ” البحث عن خلاص” أن الصحوة “تجسدت في خطب منبرية، وشرائط تسجيل دعوية أو تحريضية، وطباعة كثيفة بتمويل خليجي للتراث الإسلامي الفقهي الأكثر تشددًا، ودور نشر وتوزيع”. وكانت القنوات الفضائية مع منتصف العقد الأول من الألفية خاتمة تلك الممارسات. ويُبين يونس أن الصحوة شملت أيضًا تنظيمات دعوية ومسلحة وسياسية، كما شملت أيضًا مجمل شرائح الطبقة الوسطى وضمت أجيالا مختلفة. و”استمر مد الصحوة في الارتفاع لحوالي أربعة عقود.. استطاعت خلالها أن تعيد تشكيل حياة ومنظورات قطاعات واسعة في المجتمع بمنظور سلطوي إسلامي شامل”.
خلعت خالتي النقاب بعد أن ساءت حالة القلب والتنفس، وكانت تقترب من الخامسة والسبعين. تجمعني بها صورة في واحد من ألبومات صورنا العائلية. كانت تحملني مبتهجةً وأنا طفل دون الثانية من العمر. كنا على أحد شواطيء جمصة، ومن ورائنا البحر يصطخب بحركة الناس والأمواج
ويؤكد صاحب “الزحف المقدس” و”نداء الشعب” أن هدف الصحوة الرئيسي كان محاولة إخضاع الدولة الحديثة لتصور ديني ما، أي أسلمة الدولة الحديثة نفسها. وأن فكرتها العامة كانت هدم فكرة المواطنة من جذورها. اكتسبت طابعًا شعبويًا عدوانيًا، محوره هو امتلاك أو اغتصاب المجال العام. ونضح خطابها بالكراهية للفكر والفن والحرية، والتحريض ضد الأقباط والمرأة والمثقفين. وبانتشارها شعبيًا، تحول الفرد إلى “تجسيد حي” لها، لكي يصبح “صالحًا لضبط البشرية” وفقًا لنفس مواصفات الصحوة. وتحول الفرد المتأثر بها إلى “نقمة مصبوبة على أية حياة اجتماعية، بل على أية أعراف أو عبارات متداولة تخالف النموذج”.
عززت الصحوة من تقسيم المجتمع طائفيًا إلى مسلمين ومسيحيين، واتسعت الوصاية على الناس من ضبط مصادر الفكر والمعرفة لتشمل المواطن في حركته اليومية، كما يوضح يونس. لكن لا يمكن لأي نقد تاريخي أن يتخيل كمية التفاصيل الحياتية واليومية التي عايشها جيلي نتيجة محاولات الصحوة الجبارة فرض تنميطاتها وأفكارها، في البيوت والمدارس والشوارع.
شهوة عنيفة اجتاحت البعض ليصيروا رقباء على غيرهم في محاولة لإعادة تشكيل مفردات الحياة اليومية وفق العقيدة الصحيحة، كما كان يُروَج لها.
حكايات من زمن فات
واظبت أمي مع أم أحد أصدقائي المقربين على دروس حفظ القرآن. كنت وقتها في الصف الأول الثانوي، وفي يوم من الأيام، قامت أمي بنزع بوستر بروس ويلز من على حائط غرفتي، وإزالة التماثيل الصغيرة من صالون البيت. وذلك من أجل دخول الملائكة بالطبع. (مؤخرًا، كان خبر اعتزال بروس ويليز مؤلمًا بعد تأكيد إصابته بحبسة كلامية. ومع نهاية مسيرته نودع قسطا كبيرا من ذاكرة طفولتنا). لحسن الحظ، لم تتسع قائمة المحظورات، ولم يكن من طباع أمي الإذعان المباشر سواء لإملاءات الصحوة أو غيرها.
لكننا شهدنا مع غيرنا من الأسر المصرية أخبارًا عن تحول فتاة شابة إلى كائن يشبه السلعوة، وانتبهنا إلى المؤامرات على زجاجات المياه الغازية. توّجنا بن لادن بطلًا للأمة، وصدقنا حكايات زغلول النجار عن الإعجاز العلمي. وقبل أن نأتي إلى العالم بسنوات، صدق أهلنا سحر البركة في معاملات شركات توظيف الأموال. وربما ما زال البعض يصدقونها حتى الآن. رأيت التدين في وجهه العُصابي، وآمنا بإلهٍ غاضب، يمسخ البشر بدوامٍ كامل.
للأمانة، كانت علاقة الأُسر بالصحوة “حبة فوق وحبة تحت”. أي أنها لم تكن إملاءً فوقيًا من الآباء أو الأمهات فقط، وإنما تشارك الأبناء كذلك في تكدير الحياة الاجتماعية من حولهم. عرفت أكثر من أسرة كان الشباب هم من احتجوا على مفردات الحياة اليومية، مُساقين بشهوة إثبات خطأ وجاهلية الحياة برمتها، بينما يستميت الأب والأم في الدفاع عن نموذجهما من الحياة، أو في الجدال معهم وثنيهم عن عزمهم نقض كافة التفاصيل اليومية.
انتابت أخي حالة عجيبة قبيل دخوله الجامعة. بدأت بمقاطعة التليفزيون والتجمعات والمناسبات العائلية والمصايف، وتطورت من “غض البصر” إلى السير مغمض العينين في الشارع. كان يجلس منزويًا في غرفته عدة أيام. ولا ينزل الشارع إلا قليلًا، إما للصلاة أو لحضور بعض الدروس الدينية. وازدادت لهجته حدةً وعنفًا، وتفاقمت داخله الكراهية لكل ما هو أنثوي. ثم أخذت حدته تخفت رويدًا رويدًا، بعدما خيمت على البيت حالة مستمرة من القلق والتوتر.
ربما يُفهم من كلامي أن الصحوة كانت سببًا مباشرًا لرفض أخي الحياة من حوله. قد لا تكون العلاقة مباشرة إلى هذا الحد؛ كان أخي حالة خاصة في انسحابه وسلوكه الشخصي، لكن معظم من حولنا من الأصدقاء كانوا يمارسون التدين في نسخته المُعرقلة للحياة. كان وسيلة للتمايز أو تجاوز الإخفاقات أو التمرد والتعبير عن الذات. ردة فعل طبيعية نتيجة إحساس مقيم بالذنب. وكان الخطاب السلفي المهيمن وقتها، منتصف العقد الأول من الألفية، يعزز من رفض الحياة الاجتماعية، ويخلق حالة من عدم تصالح الذات مع الآخر، ومع نفسها في النهاية. وتستمر الحالة حتى يكتشف الفرد منا أن كل ما فعله قد فشل في محاربة الخواء والتعاسة.
هكذا أفقنا من الصحوة واحدًا تلو الآخر، بعد أن أهدر بعضنا فرص عمل متميزة لأنها حرام، وخسر آخرون علاقات إنسانية حقيقية، وفي أفضل الأحوال، تمثلت الخسارة في فقدان سنوات من الشباب المبكر.
لا أعرف سر عداء الأسرة المصرية لكاتب مثل نجيب محفوظ. كنت في الصف الثالث الابتدائي، وكان ضمن دروس القراءة في اللغة العربية موضوع عن محفوظ. عاد أبي من العمل ووجد صورة محفوظ تتوسط صفحة كتاب القراءة، فما لبث أن قال مستنكرًا: “ما تشوف يا ابني حد تاني غير الراجل ده”. لكن أمي ردت: “ده درس عليه هو ماله”..
داومت خالتي رحمها الله على حضور دروس دينية في مسجد مجاور لها بعد عدة سنوات من رحيل زوجها. كانت أرملة وحيدة بلا أبناء. لذلك اعتبرتنا، نحن أولاد وبنات أخواتها، أبناءً لها. كانت تملك قدرة فريدة على العطاء والتعاطف مع من حولها. كنت أراها في صور زفافها تشبه شادية. اختارت خالتي ارتداء النقاب وهي في سن كبيرة تتجاوز الستين. يصيبني الغم كلما رأيتها تجاهد لأخذ أنفاسها من تحته. كانت تعاني من مشاكل جمة في القلب والتنفس. لكن “الأخوات” في المسجد كن يُشجعنها ويُباركن “اختيارها”.
كانت تسارع إلى تغطية وجهها فور ظهور أبي. ولا أعلم ما فائدة تغطية الوجه أمام إنسان جمعتها به عشرة العمر. في السبعين من عمرها، تسير متسربلة في السواد، لاهثة. وأي إنسان قرأ حرفًا في الفقه كان ليعلم أن من في مثل عمرها هن القواعد من النساء. لم تسلب “الأخوات” إرادتها، إلا أن “الزن على الودان أمر من السحر” كما يقول المثل الشعبي. وكان النقاب هو كود الأخوات في الملبس، ولن تستقيم الأخوية إلا في لباس موحد بالطبع.
خلعت خالتي النقاب بعد أن ساءت حالة القلب والتنفس، وكانت تقترب من الخامسة والسبعين. تجمعني بها صورة في واحد من ألبومات صورنا العائلية. كانت تحملني مبتهجةً وأنا طفل دون الثانية من العمر. كنا على أحد شواطيء جمصة، ومن ورائنا البحر يصطخب بحركة الناس والأمواج. وهكذا أحب أن أتذكرها: سعيدة وفي صحة جيدة ومقبلة على الحياة، على رأسها إيشارب صغير. تحملني في سعادة حقيقية، كأنني ابنها.
وعلى ذكر ألبومات الصور، لا يمكنني أن أنسى حكاية الصديق الذي عاش فترة كبيرة من حياته في السعودية. قام الصديق في فورة حماس الشباب بتمزيق كل الصور العائلية، الموجودة في الألبومات وحتى تلك المحفوظة في الأظرف، وذلك بعد سماعه خطبة من شيخ سعودي عن “حرمانية” التصوير الفوتوغرافي. وكان التوقيت الذي أخبرني الصديق فيه عن فعلته مثاليًا. حكى نادمًا بعدما شاهد مؤخرًا فيديو الشيخ والداعية السعودي عائض القرني وهو يعتذر للشعب السعودي “باسم الصحوة” عن “التشدد والأخطاء ومخالفة سماحة الإسلام”. ورأى الصديق أن ذلك الاعتذار جاء “بعد خراب مالطة”. وإذا كان ألبوم الصور العائلية هو غالبًا “كل ما يتبقى من العائلة الواسعة”، كما تقول سوزان سونتاج، فإن هذا الصديق لن يشهد أي إحياء للذكريات، أو يرى أي شواهد على حيوات مضت.
الصورة: محمد عمر جنادي، من أرشيف العائلة
وما دُمنا نصفي حسابتنا مع الصحوة ومقولاتها التي تحكمت بنا – أو تركناها تتحكم في حياتنا، ووسيلتنا في هذا الحساب هي الذاكرة، فإني أرغب في تذكر شخصية كانت الهدف الأثير الذي تصوب إليه الصحوة سهامها، وتَبتِعها في ذلك الجماهير الغفيرة، في المدارس والبيوت والجامعات. والشخصية المقصودة -بالطبع – هي: نجيب محفوظ.
لا أعرف سر عداء الأسرة المصرية لكاتب مثل نجيب محفوظ. كنت في الصف الثالث الابتدائي، وكان ضمن دروس القراءة في اللغة العربية موضوع عن محفوظ. عاد أبي من العمل ووجد صورة محفوظ تتوسط صفحة كتاب القراءة، فما لبث أن قال مستنكرًا: “ما تشوف يا ابني حد تاني غير الراجل ده”. لكن أمي ردت: “ده درس عليه هو ماله”.
لا يعني ذلك أن تصور أمي تجاه أديب نوبل كان أكثر تصالحًا. قالت لي بعدها بعامين أو ثلاثة إن أعمال نجيب محفوظ “لا تمت للواقع بصلة”، وهل كل الآباء مثل سي السيد؟ وهل يُعقل وجود شخصية مثل سي السيد في المجتمع؟!
حاملًا ذلك اليقين، صرت أردد هذه التساؤلات المستنكرة كلما جاءت سيرة الرجل. إلى درجة أن مدرس الإنجليزية تحداني قائلا: “هجيبلك كفاح طيبة -وكانت مقررة على دفعات دراسية قبلنا- ولو عرفت تسيبها وتقوم للغداء أو العشاء لك عندي خمسين جنيه”. طبعا قبلت التحدي بصلافة، إلا أن المدرس لم يأتني بالرواية، وأنا لم أسأله. كانت مزايدة حميدة منه أثناء الجدال. وربما كان هذا المدرس سببًا في حبي للأدب، من خلال الطريقة التي درس بها أعمال شكسبير المبسطة المقررة وقتها.
يمكن استخدام محفوظ كذلك مقياسًا لانحصار الصحوة. بدأت أمي مؤخرًا في طلب ترشيح روايات من أجل القراءة. أعطيها الرواية مع زيارتي الأسبوعية لها، وغالبا تنتهي من قرائتها خلال أسبوع أو أكثر بقليل. هكذا طلبت قراءة “الجريمة والعقاب” التي لطالما سمعت عنها. ولما أنهتها طلبت مني “أولاد حارتنا”. سألتني بعد القراءة عن سبب تكفير محفوظ والهجوم عليه. لم ترَ في الرواية داعيًا إلى ذلك. وتعاملت مع رمزيات الرواية من منطلق كونها إعادة “حكي لتاريخ الإنسانية”، والصراع من “أجل الخير والحق”. ولما سألتها عن رأيها إن كانت الرواية جيدة أم لا، قالت: “هو أنا اللي هأحكم على نجيب محفوظ”.
التقاطع مع المجتمع: في رثاء الطبقة الوسطى
لا توجد الأسرة في الفراغ. تحتل الأسرة مكانة “محورية” بين الفرد والمجتمع. يبين الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني ماكس هوركهايمر أن نوع الأفراد الذين تخرجهم العائلة “يعبر عما يحتاجه المجتمع في مرحلة معينة من تطوره”. فالعائلة عند هوركهايمر تعبر عن توترات المجتمع الواسع المتناقضة.
وفق مفهوم هوركهايمر عن “الفاعلية التكوينية” للأسرة، فإنها “تتولى أمر نوع الشخصية الإنسانية التي يحتاجها المجتمع”، ويوضح في مقالته الأساسية “السلطة والعائلة” بكلمات دالة: “توفر العائلة للكائن البشري قدرًا كبيرًا من التكيف الذي لابد منه مع سلوك سلطوي التوجه يعتمد على وجود النظام البورجوازي ذلك الاعتماد الشديد”. تبدو كلمة “التكيف” وكأنها كلمة السر في ربطها بين الفرد/المجتمع، والسلطة/العائلة. لكن من أجل معرفة طبيعة هذا “التكيف” في حالة الطبقى الوسطى المصرية، التي أنتمي إليها، فمن الضروري معرفة الشروط المجتمعية للطبقة الوسطى، وأوجه الاختلاف والتفاعل بين “عالمية” تلك الشروط والمتغيرات المصرية المتعددة.
لعل الوصف الأكثر سلبية للطبقة الوسطى هو الذي نطالعه في الأدبيات الماركسية. بدايةً من البيان الشيوعي، يرى ماركس وإنجلز أن الطبقة الوسطى ليست حتى محافظة بل” رجعية”. إنها “لا تسعى إلا إلى إنقاذ وجودها من الزوال. إنها فقط تحافظ على طريقتها في العيش، بأن تُترك لتعمل وتحيا في سلام”. لا أرى ما يشين في المطلب الأزلي للطبقة الوسطى. فهو مطلب تحركه النوازع الأشد بشرية، البقاء، الخوف الوجودي، ومقاومة “التسييس”.
تسعد الأسرة المصرية بتدين أحد أفرادها طالما كان تدينًا فرديًا لا يشتمل على أنشطة أو فاعليات جماعية تعطل الدراسة أو تُعرضه للملاحقة الأمنية. وتحلم الأسرة بالنبوغ العلمي لأبنائها، لكنها تتمنى لو امتزج باللباقة الدبلوماسية والقدرات الفائقة في التواصل الاجتماعي، أو بمهارات السوق والتجارة وذكاء الشارع
إلا أن التناقض المأساوي يتحقق عند الترجمة السياسية الاجتماعية لهذه المخاوف والمطالب. يرى الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك في طرائق تفكير الطبقة الوسطى السبب وراء ميلها لـ “مساندة الانقلابات الشمولية التي تعد بوضع نهاية للحراك السياسي المجنون بالمجتمع، فيستطيع كل شخص العودة إلى مكانه الطبيعي”. إضافة إلى تنكر أعضاء الطبقى الوسطى في “الغالبية الأخلاقية الوطنية”، وفي الحالة الأوروبية هي المُحرِضة الرئيسية على” الحركات اليمينية الشعبوية”، حد تعبير جيجيك.
على المستوى الفردي، تطلب الأسرة المتوسطة من أفرادها تكيفًا قائمًا على وأد التورط، أو مقاومة الارتباط والتعلق بالأنشطة والأفكار الإنسانية. خذ فقط من أي نشاط أو قيمة ما ينفعك في حياتك، والحياة المقصودة هى الحياة “العملية”، المُسالمة، السائرة دومًا بجوار الحائط. فمن الجميل أن تقرأ، لكن القراءة المحمودة تقتصر على أوقات الفراغ بديلا عن الأنشطة الضارة ومرافقة أصدقاء السوء. أما الأفكار النقدية التي قد تتكون عبر فعل القراءة، والتي تُسائل القيم أو المقولات الراسخة فمرفوضة تمامًا لأنها تعتبر مروقًا وخروجًا على الأعراف. مجرد شطح ذهني مريض في عرف الأسرة.
وقد تُربي أسرة بداخل طفلها نوازع الشجاعة والكرامة، وتحضه على أخذ حقه من زملائه وأقرانه. لكن ما إن يصير فردًا بالغًا في المجتمع الأكبر، فعليه أن يغض الطرف عن الإهانات أو التجاوزات المحتملة في حقه سواء كانت من متسولين أو بلطجية أو أمناء شرطة أو أي صاحب نفوذ.
تسعد الأسرة المصرية بتدين أحد أفرادها طالما كان تدينًا فرديًا لا يشتمل على أنشطة أو فاعليات جماعية تعطل الدراسة أو تُعرضه للملاحقة الأمنية. وتحلم الأسرة بالنبوغ العلمي لأبنائها، لكنها تتمنى لو امتزج باللباقة الدبلوماسية والقدرات الفائقة في التواصل الاجتماعي، أو بمهارات السوق والتجارة وذكاء الشارع. كما تُشجع على ممارسة الرياضة والفنون في الصغر، إلا أنها قد تُعارض احترافها أو استمرارية التعلق بها مع التقدم في سنوات الدراسة.. هكذا ترى الأسرة المصرية، عبر هذه التناقضات، أنها تتبع المبدأ الأثير: خير الأمور الوسط.
الصورة: محمد عمر جنادي، من أرشيف العائلة
يتناول هوركهايمر “الفاعلية التكوينية” للأسرة في ارتباطها بمرحلة معينة من تطور المجتمع. لكن إذا كان المجتمع في مرحلة غير مسبوقة من جموده وتخلفه، كما في الفترة التاريخية المصاحبة للصحوة، فما نوع الفرد الذي كان يحتاجه المجتمع في تلك المرحلة؟ ما سمات الشخصية الإنسانية التي كوّنتها الأسرة المتوسطة المصرية من أجل مجتمع الصحوة ؟
تزامنًا مع مد الصحوة، وتحديدًا مع منتصف الثمانينيات -تاريخ مولدي للأسف- تضاعفت العقبات أمام النمو الاقتصادي للطبقة الوسطى. تمثلت الأعباء الجديدة، والمستمرة إلى أكثر من ثلاثة عقود، في ضعف تيار الهجرة إلى دول الخليج مقارنة بالسبعينيات وما تلاها، ارتفاع مستوى البطالة، مع تخفيض الإنفاق الحكومي والدعم.
صارت الوظائف الحكومية أو في القطاع العام أشباحًا من الماضي، وتراجعت فرص الهجرة إلى الخليج نتيجة الانخفاض الشديد في سعر النفط عام 1986، وهجوم صدام حسين على الكويت مع بداية التسعينيات، مما دفع أعداد كبيرة من المهاجرين المصريين بالعودة إلى مصر، كما يوضح المفكر الاقتصادي جلال أمين. يذكر أمين أنه في عام 1991 قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي “أدى إلى تخفيضات جديدة في الإنفاق العام”.
في السعي إلى تمييز نفسها عن الطبقات الدنيا، لم تجد الأسرة المصرية المتوسطة سبيلا سوى التعليم. المؤهل العالي، الشهادة الجامعية، صك الغفران الوهمي. مع تدهور منظومة التعليم وارتفاع مستوى البطالة، أصبحت فرص العمل المتميزة، بما يصاحبها من وعود بالترقي الاجتماعي، مقتصرة على تخصصات أو مجالات بعينها، أو منوطة بالعلاقات الاجتماعية ومدى فاعلية “الواسطة” التي في جُعبتك.
كان الشعور بالإحباط مُخيمًا على جيلي. أتحدث عن العقد الأول من الألفية. شعور بالفشل لا يرتبط بإجهاض أحلام ثورية أو قومية، كما كانت الحال مع الأجيال السابقة. كانت المعادلة التي رأيتها أنا وزملائي وأصدقائي هي إما أن تكون متفوقًا أو فاشلًا، أعلى الهرم أو تحت التراب، شاهدت تهافت الأسر المقدس على التقديم إلى الكليات العسكرية، وكان القبول بإحدى تلك الكليات بمثابة جواز المرور إلى عالم آخر، نعيم أبدي.
رأيت مجتمعًا ذا خيارات محدودة، لا يرى أفراده إلا نمطًا محددا للحياة. ولمن لا يملك حيثية اجتماعية أو علاقات بشخصيات “مهمة” فإنه لا سبيل إلى النجاة إلا بالتعليم دون التورط بأي مشتتات أو مسارات جانبية. هكذا تجتمع السمات الشخصية المطلوبة للتكيف مع المجتمع المصري في مرحلة ما قبل ثورة 2011. الإيمان بضرورة الشهادة الجامعية، وليس التعلُم نفسه أو الرغبة في المعرفة. حلم الترقي الاجتماعي المستحيل، تجاوره تأثيرات خطاب ديني سلفي يُحقِر من الحياة بأحلامها ومصاعبها، ويعزز من السلبية والنكوص. يديم الخطاب الديني الشعور بالذنب، ولا يسمح لأفراد المجتمع بمغادرة الطفولة، خالقًا طفولة عقلية مستمرة ومطلوبة، خوف من السلطة مع سلوك يستبطنها بشكلٍ قهري.
ربما بدت تلك المرحلة، بتوتراتها المجتمعية المتناقضة، أبدية. لكن فجأة جدّت أحداث خارقة اهتزت لها حياتنا.
صراع أجيال.. عن معنى الصراع وحقيقته بعد الثورة
من السخف اعتبار أن ثورة يناير هي التي بلورت مفهوم “صراع الأجيال” أو حولته موضوعًا للنقاش العام. إلا أنها ربما خلقت بُعدًا آخر لمعنى الصراع؛ إذ طُرح بوصفه مفهومًا سياسيًا، أو مفتاحًا للتأويل السياسي. اكتسب صراع الأجيال صبغة سياسية اجتماعية، لا مجرد “سُنة الحياة، صراع دائم بين القديم والحديث” كما يكرر الفنان محمد رضا في نهاية فيلم “الزواج على الطريقة الحديثة” (1968).
ولا يجب أن يُفهم من الفقرات السابقة أن الثورة حدثت خلافًا للمزاج العام. بالتأكيد كانت الأغلبية غير منخرطة في الثورة، ولا يُفترض في أي ثورة انخراط غالبية المجتمع فيها. يكفيها فقط طلائع أو شرائح تُشكل نواة الأحداث والمطالبة بالتغيير. مع بداية الثورة، انقطعت الشعرة الفاصلة بين النقد الغاضب للنظام والتورط في عمل سياسي مباشر، الشعرة التي ظلت مشدودة سنوات عديدة، وكان قطعها حتميًا. إلا أن الوجه الحقيقي للصراع يتجلى من خلال الرغبة في “المعرفة”؛ إعادة النظر في التصورات المستقرة عن ذواتنا، والعالم. المعرفة من خلال نقد الوعي ومحاولة خلق مسارات جديدة في الحياة. وفي ذلك أثر الثورة الخالد، أثر الفراشة الذي لن يزول.
يركز المحلل النفسي جان-بيير وينتر على ما يسميه “لغز تداول المعرفة” بين الأجيال. فلا يرى إمكانية اكتساب الطلبة المعرفة من خلال “التلقين التربوي وحده”. وبالنسبة له، فإن “مهنة التدريس تنتمي إلى مجال التحرر/ الانعتاق. إنها تتكون من كشف المعرفة وعرضها على عقول شابة، ثم دعوتها إلى تفسيرها”.
يؤمن وينتر أن “التعليم السلطوي إلى درجة مفرطة يصبح عائقًا”، عندما يحيل افتراضات الدرس إلى معرفة ينبغي إعادة إنتاجها دونما اهتمام بالعملية نفسها. وعندما يكون هولاء المدرسون السلطويون أفرادًا من العائلة، يشير وينتر إليهم بتسمية “الإخصائيون التربويون” Educastrators بدلا من Educators، في تلاعب ذكي بالألفاظ، حيث يمزج بين كلمتي “تعليم education ” و “إخصاء castration”، إشارةً إلى قيام التعليم السلطوي بتجريد الطلبة من الخيال. لأن الفهم يتعين بإزالة العوائق أمام التفكير، والمعرفة تتعلق بالسؤال الدائم دون إجابة قاطعة. بكلمات أخرى، فإن كل ما نعرفه، في سعينا نحو حقيقةٍ ما، نعرفه ضد معرفة سابقة، و”بالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير”، كما يقول الفيلسوف الفرنسي جاستون باشلار.
“معارف سيئة البناء”.. وهل هناك أسوأ من المعارف التي شُيدت في العقود الماضية داخل البيوت والمدراس وفوق المنابر؟!
لنتخيل أن أبناء عبد الغفور البرعي، أو أحفاده، أرادوا النزول إلى الميدان والمشاركة في المظاهرات، أو أن العمال في مصانعه قاموا بالإضراب مطالبين بزيادة أجورهم. ماذا سيكون رد فعله؟ فكرت في المقولات التي تُشبّه مبارك بالأب، أو تطلب منا اعتباره كذلك وإنزاله تلك المنزلة. ألم تفكر غالبيتنا، ممن شاركوا في الثورة، أن فكرة السلطة الأبوية هي أصل كل الشرور؟
مثل معظم جيلي، أحب مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” (1996)؛ أدمنت مشاهدته، معاودًا مشاهدة الحلقة الأولى فور نهاية حلقته الأخيرة، كمُدخن شَرِه يشعل سيجارته القادمة من سابقتها. وجدتني في الشهور التالية لثورة يناير أسيرًا لنوع من القراءة السياسية لهذا العمل الجماهيري، الذي يوحي عنوانه بأنه صيحة رفض، إعلان تمرد ضد السلطة الأبوية. لكننا نعلم حقيقة هذا التمرد ونهايته. الابن، عبد الوهاب، يعمل في النهاية مع الأب ويتزوج ابنة خاله. ثم أدركت أن أسوأ قراءة ممكنة لمسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” هي القراءة السياسية المباشرة.
لنتخيل أن أبناء عبد الغفور البرعي، أو أحفاده، أرادوا النزول إلى الميدان والمشاركة في المظاهرات، أو أن العمال في مصانعه قاموا بالإضراب مطالبين بزيادة أجورهم. ماذا سيكون رد فعله؟ فكرت في المقولات التي تُشبّه مبارك بالأب، أو تطلب منا اعتباره كذلك وإنزاله تلك المنزلة. ألم تفكر غالبيتنا، ممن شاركوا في الثورة، أن فكرة السلطة الأبوية هي أصل كل الشرور؟ الرئيس، الأب، الذي يعلم ما لا يعلمه الشعب، الأبناء. ولا خير في الشعب الذي يبدي عقوقا للأب الذي دأب على “تربيته” لثلاثين عامًا.
هكذا وجدتني أشاهد المسلسل في “جو من الندم الفكري”، بتعبير باشلار.
أقول إن إحلال مجاز الرئيس/النظام محل الأب/الأسرة في المسلسل ينطوي على قدر من المغالطة. لأسباب ذكرتها في مقال طويل كتبته عن المسلسل، تتعلق بحالة الأب الفريدة وطبيعة المجتمع الذي لم يتطور إلى نمط متأخر من الرأسمالية الكونية.
لذلك ينبغي أن نسأل: هل المسلسل عمل في مديح البطريركية، أم في إيضاح شروط التمرد والمقاومة؟ ثم أدركت ما هو أهم، أن الثورة تتجاوز مجرد كونها مقاومة لسلطة الأب. لكن في البداية، ولكي تكون المقاومة ممكنة ينبغي استبطان سلطة الأب نفسها والتمرد عليها.
لن أعيش في جلباب أبي. المصدر: يوتيوب
في البطريركية / السلطة الأبوية
فشلت ثورة يناير من حيث القدرة على تغيير النظام السياسي، وأيضًا في مواجهة نظام عالمي يفرض رؤاه وإملاءاته. ربما لا جدال في ذلك، إلا أننا يمكن أن نجادل بشأن الأثر الذي خلقته في المجتمع.
يشرف الشاعر والروائي علاء خالد على إصدار مجلة “أمكنة” المعنية بثقافة المكان وتاريخه. وفي عددها الأخير “حيوات بديلة”، يرصد خالد تجارب حياتية مختلفة تنم عن “وعي جديد ينمو في مصر”. في حواري معه، يقول خالد إن الثورة قامت بنقد المتخيل الجمعي. أي نقد الوعي والتصورات السابقة عن الذات والوجود. ويؤكد أن أحد أشكال تجلي حلم الثورة يكون من خلال “تجديد الوعي الجمعي” و”إعادة ترتيب المخيلة”.
حين سألته عن الإتاحة التي خلقتها الثورة، من أجل اكتشاف الذات وخلق “ذاكرة جديدة”، وصدامها مع رغبة في التنظيم وفق مفاهيم ومحددات لفعل أي شيء، سواء قيم الأسرة أو الدين أو غيرها؛ أجابني: “بس ده اتكسر. الفكرة الأبوية ممكن تكون دلوقتي في أضعف حالاتها، بكل أشكالها من أول الأسرة لحد الحاكم. مش معني وجود “السلطة” إن في فكرة أبوية. دي سلطة، حاجة أكبر من الفكرة الأبوية. مفيش نموذج معين فارض أداته. كسر النموذج – المهيمن – عمل نوع من الإتاحة لفكرة السعي الشخصي، مع وجود الميديا والحداثة، وإن الناس مش بس تخترع أشكالها للحياة، الأشكال موجودة ويعاد العمل داخلها..
يتحدث علاء خالد من خلال تجربة العمل في عدد “حيوات بديلة” عن النماذج التي تفكر في حياة مستقلة، نوع من “الولادة الجديدة”، أي تغيير مسارات وظيفية وتعليمية وحياتية، والرغبة في البدء من جديد: ” نماذج لناس بتسافر، تطلع جبال، حد يرجع يذاكر عشان عايز يعرف أكتر عن تاريخ مصر، بنت تروح تعمل مشروع في الصحراء..”.
ورغم تأكيد خالد أن “إتاحة” الثورة ليست لحظة “لا نهائية” لأن هناك أنظمة مستقرة، أنظمة للسوق والمؤسسات، فإنه يركز على وجود فراغات داخل تلك الأنظمة، يستطيع الفرد من خلالها عمل نقلات في حياته أو تغييرها مستخدما فكره وروحه : “في “حيوات بديلة” كان التركيز على ده. دي أخلاق جديدة الثورة أتاحتها. وخلقت الإقبال على برامج وورش المؤسسات الثقافية. خلقت الرغبة في إن الفرد يغير مساره وينمي نفسه وإنه يخرج من القوقعة اللي قاعد فيها”.
كان عبد الوهاب عبد الغفور البرعي يبحث عن مسار مختلف لكنه لا يعلم ماهو. وما أوجدته الثورة- ولم يكن موجودًا أثناء تخبط عبد الوهاب- هو المكان الذي يتطلع إليه الوجود الفردي، “جغرافيا جديدة بين الذات الفردية والجماعة”، بتعبير علاء خالد. إعادة قراءة تكشف المناطق المحجوبة بداخلنا.
ثمة تمايز بين سقوط السلطة الأبوية/ البطريركية في الحالة المصرية الراهنة وتآكل سلطة العائلة في مجتمع الفرجة، الجماهيري، بشكل عام؛ الجميع يتوقون اليوم للنصيحة بشأن حياتهم الداخلية تقدمها سلطة من “خارج” العائلة. برامج وأنصاف خبراء وأدبيات نفسية رائجة مبسطة. ويبين آلن هاو أنه رغم التحرر من التراتبيات الأسرية الصارمة نتيجة شروط المجتمع الحديثة، فإن لذلك التحرر جوانب أخرى، تتعلق بصعود الشخصية النرجسية، وارتباط ملامح الحياة بالسوق والاستهلاك.
فمثلا، يعتقد كريستوفر لاش أن: “تدهور العائلة البطريركية قد ترك وراءه توترات غير محلولة مستمدة من مرحلة النمو الأوديبية”. فعدم التماهي مع أب قوي ترك الأفراد يظهرون صراعاتهم بدلا من تصعيدها أو كبتها. يوضح لاش أنه تم إسقاط شعور القلق، المستمد من مرحلة الطفولة تجاه الوالدين، على العالم الخارجي.
ربما حين أعادت ثورة يناير خلق الوعي وترتيب مخيلة البعض، فإنها واجهت القلق الطفولي الكامن فينا ونحن نواجه العالم. لعل السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن: كيف سقطت البطريركية ونحن محاصرون، على الدوام، باتهامات الخروج على “قيم الأسرة”، ومطالبون بوجوب المحافظة عليها؟
نقد “قيم الأسرة”
يجب أن نفكر في السياق الذي يظهر من خلاله مفهوم “قيم الأسرة”. يُتداول المفهوم بوصفه أداة رقابة مجتمعية وذريعة للمنع والمصادرة، وهذا ما يجعلنا لا نتأمل طبيعة الأنساق القيمية المقصودة. تذكرنا تهم انتهاك/تهديد مباديء وقيم الأسرة المصرية بتهمة التشويه والإساءة إلى “سمعة مصر”.
تتجلى الأسرة ومصر كشخصية معنوية عامة، لكنه من الممكن ألا ترتبط بتحقيق أغراض أو التزامات اجتماعية واقتصادية، خلافا للتعريف القانوني للشخصية المعنوية (الاعتبارية). أي أنها ليست مثل الشركة أو الجمعية الأهلية التي ترتبط بعقد معين لتأسيسها. كأننا لا نرى فاعلية الأسرة/ الدولة إلا في التهم والمصائب. لكن مفهوم “قيم الأسرة” ليس خاويًا إلى ذلك الحد.
يحاول الباحث السوري محمد سامي الكيال النظر في حجج أنصار “قيم الأسرة”. ويتساءل: ما الذي يدافع عنه بالضبط هؤلاء أنصار؟
يقول الكيال إن” قيم الأسرة” صارت في الآونة الأخيرة “تكثيفاً لمعظم السلطات الرقابية في العالم العربي، ففيها على ما يبدو تتقاطع كل المحظورات الدينية والأخلاقية والسياسية”؛ ويوضح أنها بناء سياسي إيديولوجي وليست مجرد “ثقافة موروثة” أو تعبيرًا عن مجتمع “محافظ” أو “شعب متدين بطبعه”، وإنما يكمن هذا البناء فيما يسمى “مجتمع الأغلبية” الذي يقوم على “سلسلة متشابكة ومعقدة من الإقصاءات: كي تنشأ أغلبية ما، لا بد من تهميش فئات عديدة، وتحويلها إلى أقليات، غالباً ما يكون أسلوب حياتها مداناً، وكذلك طرق تعبيرها وخياراتها”.
يسخر نقاد “قيم الأسرة” من تلك المنظومة المفروضة، ويعتبرون تلك القيم نوعا من “النفاق والتدليس”؛ “فالمجتمعات العربية، رغم كل ادعاءاتها عن الفضيلة، مليئة بكل أشكال الانحرافات عما تعتبره صواباً، حتى داخل الأسر الأكثر استقراراً، وبالتالي فلا معنى لفرض الرقابة على التعبير، وعلى تصوير الحالات والميول الإنسانية المختلفة في الأعمال الفنية، بحجة أخلاق وقيم ليست موجودة”، كما يقول الكيال.
يبين الكيال أن المدافعين عن قيم الأسرة ليسوا مجرد منافقين.. “بل أشخاصاً حريصين على ضمان الحد الأدنى من الأمان المجتمعي، رغم كل الهرمية والأبوية التي يفترضها ذلك الأمان”، إنهم يرون في السلوكيات والميول المناقضة لثقافة الأغلبية (وفي الترويج لها) ضياعًا للمشترك المجتمعي، للمرجعية أو الإطار الأخلاقي الذي يعمل على ضمان تماسكهم الاجتماعي، خوفا من ضغط المسؤولية الفردية، ورفضًا للتهديد الوجودي المرتبط بـ “الفردانية”.
تزوجت بعد قصة حب. لكني أعتقد أنني لم أعرف هول الحب إلا بعد ولادة ابنتي آسيا. حب خارق، يُنبت الخوف بداخلك كما يُدخل عليك الفرح. خرجت كلمات الحب وتعبيرات مثل “فلذات كبدي” من المجاز إلى حيز الواقع. وأرى ضرورة أن نتذكر دائما الحب الذي نشعر به تجاه الأبناء، والسعادة التي يمنحها لنا وجودهم، خلال عملية التربية المضنية. لقد منحونا امتياز رؤيتهم يكبرون
حاولت أن أكون أكثر فهمًا للرؤية الحريصة على الأمان والمشترك الإنساني عبر “قيم الأسرة”. وجدت قدرا كبيرا من ضالتي في كتاب اسمه “فلسفة الأسرة” للكاتب والداعية علاء عبد الحميد. وعبد الحميد له عدة كتب من الأكثر رواجًا. ويقدم في كتاباته رؤية أصولية محافظة بأسلوب سجالي مبسط. أقرب إلى كتابات مصطفى محمود في مرحلته الدعوية.
يوضح عبد الحميد أنه يتناول قضية الأسرة من منظور “فلسفي”، أي تقديم “فلسفة كلية” وفق فهمه للإسلام دون تشريعات جزئية أو أحكام شرعية تفصيلية. وبالطبع يريد من الكتاب أن يتصدى للمفاهيم الغربية الواردة والرؤى الحقوقية السائدة. يقول الكاتب إن “الإنسان ليس مصدر التشريعات والقيم”، وليس ما يحقق أغراضه المنشودة هو الصواب فمعيار الصواب “هو معيار التشريع” لا موافقة مراد أو مصلحة الإنسان، ووظيفة الدين “تقرير معايير ثابتة للحق والباطل وعدم التماهي مع الإنسان النسبي في أفكاره، السيّال في فلسفته اليومية المتأثرة بتجاربه وانفعالاته”.
ولذلك يؤكد على أهمية المبدأ الكلي أو المفاهيم الحاكمة دون القوانين والتشريعات التي تتناول مشكلات جزئية. فكل دعوات المساواة وحركات الحقوق والتحرر لا تؤدي، في نظره، إلا إلى تفاقم المشكلات أو خلق مشكلات جديدة. وذلك نظرا للمُنطلق الإنساني في معالجة تلك المشكلات، ومعالجتها بمعزل عن “الصورة الكلية”.
وفي فصل “الأسرة والعائلة والفرد”، يتحدث عن “سلطة الأسرة الحديثة التي لا تؤمن سوى بالروتين والأنماط المعدة سلفا للإنسان من دراسة ووظيفة”، و”فلسفات الحقوق الفردية” التي تأتي” كتجلٍ طبيعي ” للأسرة الحديثة في صورتها الروتينية النظامية اللاغية لتفرد الإنسان. يرى الكاتب خطأ الدعوات الحقوقية في أنها تنظر لحقوق الإنسان كفرد مثل حقوق الطفل وحقوق الزوجة.. يقول: “فمن الخطأ معالجة قضايا الإنسان كفرد دوما، فعندما ننظر للمرأة كمرأة فقط باعتبار جنسها ونهمل انتماءها لدائرة الأسرة الصغيرة التي دخلتها بعلاقة تعاقدية ودائرة العائلة الكبيرة التي هي علاقة نسبية تراحمية، ونبحث عن حقوقها دوما بمعزل عن ملاحظة هذه الدوائر، فإننا نرسخ عقيدة الفردانية التي لا تنظر للإنسان إلا كوحدة مستقلة متضخمة.. ثم معالجة هذا الفرد بتكريس الحقوق والواجبات في جانبه، وهذه المعالجة مؤذنة بانهيار المجتمع بالكلية”.
هذا هو الخوف من الفردانية الذي ذكره سامي الكيال. يكرر عبد الحميد أكثر من مرة أن رؤية الكتاب تبدو “مثالية”. والمثالية التي يقصدها تعني الرؤية الحالمة أو ربما النقية. لكنها في الحقيقة رؤية “مثالية” في توسلها الفلسفي، ترد كل مظاهر الوجود إلى الفكر (أو الشرع في هذه الحالة)، وتؤكد على أسبقيّة الشرع بكل معانيه على الواقع، فهو يقع خارج حدود الفكر البشري والمادة. وبذلك نحن أمام يوتوبيا أسرية مأمولة. فردوس متخيل، من أجل تحقيقه يجب أن يتوقف البشر عن الزواج والارتباط والإنجاب حتى نبدأ من جديد بوعي جديد. نحتاج إلى عمل Restart للمنظومة برمتها.
ومع تأكيد الشيخ علاء عبد الحميد أن الشرع يضمن المساحة الفردية للإنسان، وتوضيح الكيال أن ما يسميها “الفردانية الحساسة” يمكنها ألا تقدم سوى “أفراد يخافون من الآخر، يعانون من التهديد الوجودي لحياة الأقليات، ترهقهم المسؤولية الفردية في عالم لا أسس صلبة له”، فإن كلا منهما يأمل في نوع من التقاطعية أو تأسيس مشتركات فعلية.
ومثل هذا الأمل لن يتحقق إلا بالحوار، على المستويين الخاص والعام. وربما تأمل السطور السابقة، بتجميعها مقولات مختلفة لكتاب وباحثين، أن تخلق حالة تحاورية، ولو بالنزر اليسير.
التربية الحديثة أم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون؟
بعد أن صرت أبًا فهمت الجملة الخالدة التي يرددها الآباء والأمهات: “مش هتحس غير لما تخلف”.
تزوجت بعد قصة حب. لكني أعتقد أنني لم أعرف هول الحب إلا بعد ولادة ابنتي آسيا. حب خارق، يُنبت الخوف بداخلك كما يُدخل عليك الفرح. خرجت كلمات الحب وتعبيرات مثل “فلذات كبدي” من المجاز إلى حيز الواقع. وأرى ضرورة أن نتذكر دائما الحب الذي نشعر به تجاه الأبناء، والسعادة التي يمنحها لنا وجودهم، خلال عملية التربية المضنية. لقد منحونا امتياز رؤيتهم يكبرون.
كانت والدة أحد أصدقائي في مرحلة متأخرة من السرطان. كان صديقي يجلس بجوارها بعد أن فقدت قدرتها على الحركة. ربما رؤيتها للأسى العميق على ملامحه دفعها أن تقول: أنا مش زعلانة، عشت أيام جميلة، كفاية إني استمتعت بيك وبأختك وأنتم صغيرين لحد ما كبرتوا”.. “استمتعت بك”.. ننسى متعة وجود أطفالنا معنا لأن المتطلبات كثيرة والحياة صعبة وظالمة.
وما غير المتعة التي عرفناها تكون عزاءً لنا في لحظات الألم والشقاء. هناك أشياء تربيت عليها وأحب أن أتبعها خلال تربية ابنتيّ. وهناك أيضًا ما أريد ألا أكرره، وأن أسلك طرقًا مغايرة.
يثير مصطلح “التربية الحديثة” السخرية لدى البعض، وربما يراه آخرون مقتصرًا على اللانش بوكس والتابلت وبعض الأنشطة المستحدثة. لا شك أن الطرق التربوية الحديثة منحت الأسر الكثير من الأساليب الصحية، وسمحت للأطفال بنمو نفسي وذهني أكثر طبيعية. صار ضرب الأطفال من الوسائل المستبعدة في العقاب، وأصبح لدى الطفل مساحة أكبر للحديث بعد ارتكاب الأخطاء وأيضا من أجل إعلان ما يحبون وما يكرهون.
والمشكلة، إن وجدت، لا تكمن في الطرق والأساليب ذاتها وإنما في التطبيق الآلي لها، كأنها روشتة، أو كتالوج تسري إرشاداته على جميع الأطفال دون تمييز أو مراعاة للفروق والخصال.
تماما كما يتعامل البعض مع نصائح التنمية البشرية: إيجابية مفرطة، ورؤية أحادية البعد للعالم والأشياء، يصبح إتمام النشاط أداتيًا، بمعنى أن الآباء يمكنهم أن يصطحبوا أبناءهم للتمرين أو تعلم الرسم أو الموسيقى مثلا، دون العناية بعملية الفعل نفسه، مراحله، أهدافه ومعناه. مجرد نشاط، ضمن قائمة من المهام، يجب أن نقوم به حتى نضع بجوار علامة صح.
الصورة: محمد عمر جنادي، من أرشيف العائلة
تمارس آسيا رياضة الجمباز. وهناك بطولتان خلال كل موسم رياضي. تقام البطولة إما في استاد القاهرة أو نادي المقاولين حسب اختيار الاتحاد المصري في كل مرة. رافقت آسيا في كل بطولات الجمهورية السابقة. أجلس في المدرجات وأشاهدها. بجواري آباء وأمهات زميلات آسيا في الفريق.
هناك من يقاوم توتره بقراءة القرآن، ومن يخفيه بالمزاح، ويجلس البعض كأن على رؤوسهم الطير. أخفي توتري بتشجيع كل البنات، حتى يأتي دور آسيا. أراقبها في أمل وقلق. أؤمن أن الغاية من كل ذلك ليست الميدالية التي ستحصل عليها نهاية اليوم، وإنما تتمثل الغاية في اكتساب الطفل ثقة في النفس، ومعرفة الكيفية التي يواجه بها المواقف الصعبة بعيدا عن التوتر الزائد.
الحرص على الرياضة من المظاهر الجديدة في تربية أبناء الأسر المتوسطة. في طفولتي، كانت ممارسة الرياضة طوال السنة شيئا نادرًا. لم أعرف في محيطنا الاجتماعي من يذهب إلى التمرين بانتظام. الآن، صارت الرياضة ركنًا أساسيًا في حياة الكثير من الأسر.
لحظة تسليم الميداليات درامية للغاية. أن ترى أمامك بنتًا عمرها أقل من تسع سنوات تبكي لأنها حصلت على ميدالية فضية، وأمها جالسة تبكي، والأب يتملكه الوجوم. أود أن أقول “كبرتوا الموضوع يا جماعة”، لكني أتفهم رغبة كل أسرة في أن يصير أبناؤها الأفضل. رغبة بشرية طبيعية إلا أن الخلل ينشأ من محاولات تحقيق أحلامنا الفائتة من خلال أولادنا، أن نستغل الأبناء في التغلب على إحباطاتنا، وأن نثبت ذواتنا من خلالهم بدلا من أن نعوضهم عما حرمنا منه وأن نجنبهم الأخطاء التي حدثت لنا.
في الغالب، يعيد الأبناء وصل ما انقطع مع الأبوين. يرمم وجودهم الصدوع ويُضفي الحياة على البيت القديم. ربما تُشفي براءة الأبناء الندوب القديمة، وتُذهب المرارة.
عن قلق العيش في انتظار الفجيعة
أستعين بتلك البراءة على قلق العيش. وتخفف عني حالة الخوف من الفقد. تلك الحالة المستمرة معي منذ سنوات. مع بداية عام 2016 تم تشخيص أبي بسرطان المثانة، وهو يقاوم بصلابة وإيمان منذ حينها. لم أكن بحاجة إلى وباء عالمي كي أدرك أن الحياة امتياز في ذاتها. كنت أعلم هذه الحقيقة عندما رأيت الألم. رأيت كيف خطف الموت أناسًا وكيف غيّب السجن آخرين. لم أكن بحاجة إلى الحروب والأوبئة لأعلم ما هو الخوف، أو كي أحب ابنتيّ وزوجتي ووالديّ أكثر.
التفكير فيما يحدث حولنا من العالم يبعث في نفسي الرعب. رعب يزكيه قلقنا على من نحب، على صغارنا. نتأمل أطفالنا في خوف لا سعادة. ننظر إليهم، ونتسائل عن الموعد الذي ستتداعى فيه قلاع نرجسية الطفولة، هذا التوهم بأنهم مركز العالم. تلك اللحظة الفارقة التي نعي فيها بأن العالم لا يأبه لنا، لا أحد يسمعنا، بأن الحياة غير عادلة، وأن الطمأنينة لم تكن يومًا أبدية.
حسنًا، لن أفكر في الأبدية بل في اليوم الجديد الذي سأعيشه مع من أحب، وستصبح أسرتي هي العالم، كل العالم.