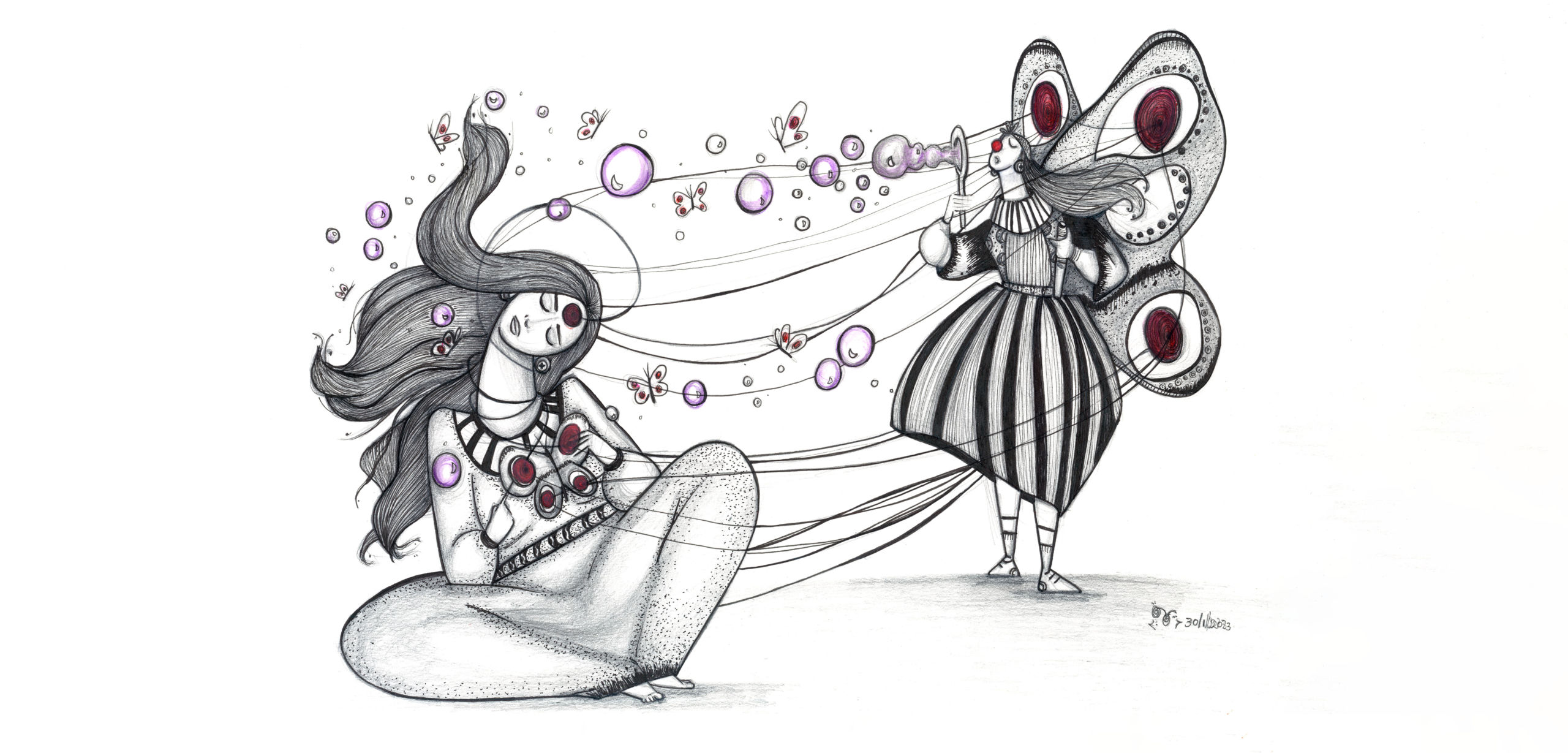“إننا لا نحيا لنكون سعداء”
هذا ما قاله طه حسين لزوجته سوزان في الصفحة الأولى من مذكراتها “معك“؛ تتذكر سوزان كلمات زوجها الخالدة عن السعادة:
“عندما قلتَ لي هذه الكلمات في عام 1934 أصابني الذهول، لكنني أدرك الآن ماذا كنت تعني، وأعرف أنَّه عندما يكون شأنُ المرء شأنَ طه، فإنَّه لا يعيش ليكون سعيدًا وإنما لأداءِ ما طِلب منه. لقد كنا على حافة اليأس، ورحت أفكر: لا، إننا لا نحيا لنكون سعداء، ولا حتى لنجعل الآخرين سعداء. لكني كنت على خطأ؛ فلقد منحت الفرح، وبذلت ما في نفسك من الشجاعة والإيمان والأمل. كنت تعرف تمامًا أنَّه لا وجود لهذه السعادة على الأرض، وأنَّك أساسًا، بما تمتاز به من زهد النفوس العظيمة، لم تكن تبحث عنها، فهل يُحظر عليَّ الأمل بأن تكون هذه السعادة قد مُنحت لك الآن؟”
وفي كتابه عن شاعره الأثير “أبي العلاء المعري” يقول طه حسين:
“وما ذنب أبي العلاء إذا كان لم يُخلق للسهولة ولا للين، وإنما خُلق للمشقة والجهد! وصدقني إن الحياة لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها البهجة والرضا، كما أنها لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها إلا الحزن والسخط”.
كأني وجدت كلمة السر عندما قرأت ما سبق. إذا كانت تلك هي كلمات أحد أعظم الشخصيات المصرية في تاريخ الفكر والثقافة، فما حاجتي للتساؤل إن كنت سعيدًا أم لا؟
وحّد فقد البصر بين طه حسين والمعري. إلا أن الأخير لم يكتف بـ “سجن العاهة” وإنما فرض على نفسه الإقامة في بيته لا يغادره، عزلة طويلة دامت أكثر من نصف قرن. كنت أقرأ عن سجن المعري لنفسه طواعية داخل بيته، وفي نفس الوقت تؤرقني متابعتي للمقاطع والفيديوهات على فيسبوك وتيك توك التي تصور مختلف المدن والمعالم والأماكن في شتى بقاع الأرض. مدن أوروبية على الأغلب، جميلة، جبال وخضرة، غابات وحياة برية، إمكانيات هائلة، ومسارات حياتية بلا حصر، تضعها شاشة الموبايل أمامك. حياة أخرى يقدمها لك الواقع الافتراضي كوعدٍ بالفردوس.
كلما شعرت أنني ربما لن أزور يومًا تلك الأماكن التي فُتنت بها تذكرت المعري وعزلته. فأقول: إننا لا نحيا لنرى العالم أو نجوبه.
ساحة نزاع متعددة الأطراف
كيف يمكن أن تكتب عن شيء لا تؤمن بوجوده؟ أو بالأدق، فقدت إيمانك بوجوده، واعتبرت هذا الفقد من علامات النضج. ثم أخذت تبحث بين صفحات الكتب عن ما يعززه. رحلت فكرة “السعادة” مع غيرها من موجودات الطفولة. صارت من الخرافات. على الأقل، صار الإيمان بإمكانية وجود “سعادة خالصة” كالإيمان بالخرافات والأساطير.
ولكن، أما يزال أغلبنا مؤمنًا بالخرافات والأساطير؟
يمكن أن نعتبر السعادة مجرد محصلة عمليات كيميائية في دماغ الإنسان. لكن الجملة السابقة، ورغم ما تظهره من علمية، تخفق في الإحاطة بالسعادة كمفهوم تاريخي وفلسفي وسياسي كذلك.
“السعادة” ساحة نزاع متعددة الأطراف. من الفلاسفة الرواقيين والمعاصرين إلى صانعي إعلانات المياه الغازية ودعايا الكومباوندات وشركات الموبايل، مرورًا بالمعالجين النفسانيين و”خبراء” التنمية الذاتية ورجال الدين. نزاع حول حقيقتها وكيفية تحقيقها.
يؤكد أرسطو أن السعادة هدف الإنسان، وهي غاية في ذاتها. ويُعرف الفيلسوف أبيقور السعادة بأنها “نشاط يضمن لنا الحياة السعيدة عبر الجدل والمحاكمات العقلية”. والبحث عن الحياة “الطيبة” أو “السعيدة” هو ما يُسمى الحكمة. وكما يعلم أغلبنا أن كلمة “فلسفة” تعني اشتقاقيًا “محبة الحكمة”. “السعادة”، “الحكمة”.. ربما لا توجد كلمات في الفكر المعاصر سيئة السمعة أكثر من هاتين الكلمتين؟
لكن ثمة سؤال مهم ينبغي أن نطرحه في البداية..
هل التفكير في السعادة يساعدنا على أن نكون أكثر سعادة؟
يؤكد الكاتب والفيلسوف الفرنسي فردريك لونوار في كتابه “في السعادة: رحلة فلسفية” أن التفكير في هذا السؤال من شأنه أن يجعلنا سعداء، وأننا نتحمل قدرًا من المسؤولية في أن نكون سعداء أو لا نكون. هناك شروط طبيعية وقدرية ترتبط بها السعادة لكننا في الوقت نفسه لسنا محكومين بها.
يتساءل لونوار: أليست السعادة هي السبب الأساسي لوجود الفلسفة. ويشير إلى الاحتقار الذي يبديه قطاع كبير من المثقفين والأكاديميين المعاصرين تجاه مسألة “السعادة”.
في القرن الثامن عشر، جاء “عصر التنوير” مُحملًا بالمعالجات الفلسفية لموضوع “السعادة”. وقُدمت كفكرة جديدة في أوروبا. وفي أمريكا، تم إقرار “السعي نحو السعادة” في إعلان الاستقلال الأمريكي (1776) بوصفه “حقًا من حقوق الكائن البشري لا يجوز المساس به”.
يوضح لونوار أن السعي نحو السعادة صار “فعلا ديمقراطيًا” يتضافر مع “التعطش الجماعي لتقدم المجتمعات”. لكن مع تعاظم الأمل بالتقدم الاجتماعي بدأ نقد لفكرة البحث عن السعادة “الفردية”.
في الحركة الرومانسية خلال القرن التاسع عشر “تجلت التعاسة بوصفها الأكثر أصالة”، و”الأكثر إنسانية وتأثيرا وإبداعًا”. يقول لونوار إنه قد صار هناك اعتناء بـ “الكآبة” بوصفها “مصدر الإلهام الرئيسي، وبجمالية التراجيديا والمعاناة اللذين يتميزان بالتقدير وبالخلق”. و”صار البحث عن السعادة، بوصفه همًا برجوازيًا لبلوغ الرفاهية والراحة، أمرًا محتقرًا ومرذولًا”.
حين عرفت لحظة التحول التاريخية نحو “التعاسة”، كما يوضحها لونوار في رحلته الفلسفية، شغلتني فكرة أن تقديري الشخصي والجمالي للـ “كآبة” له روافده الرومانسية.
وليس المقصود بالرومانسية هنا المذهب الأدبي المعروف، بل معنى أوسع: “الرومانسية كروح وإيديولوجيا ونظرة للحياة، أو موقف من العالم”. وتدور حول فكرة أساسية، هي فكرة “الذات” باعتبارها “معيار الحقيقة ومصدر المعرفة ومعنى الوجود”، كما يوضح المؤرخ المصري شريف يونس، ومن خصائص الذات الرومانسية رغبتها في إعادة تشكيل العالم على صورتها ومثالها. فالواقع يفتقر إلى “نقائها وتفردها”، لذلك تخلق عالمها الخاص، وتطلق “أحكام القيمة” على الواقع.
في رأيي؛ غالبًا ما ينتمي أعظم الفنانين إلى “الرومانسية”، إذ تدفعهم رغبتهم في الخلق إلى الحدود القصوى لطاقاتهم الإبداعية. لكن الأمر نفسه لا يمكن أن نقوله على السياسي الرومانسي، أو الباحث أو خبير الاقتصاد مثلا.
وربما تتغير الآن رؤيتي للكآبة، فلا أراها في مرتبة أعلى من “السعادة” بشكلٍ مطلق، وإنما فقط في عالم “الفن”. من الممكن أن أرغب في خلق عمل فني بأجواء ميلانكولية، كئيبة، أو استمتع بتلقيه، لكنني بالتأكيد لا أريد الحياة في واقع كئيب. ولا أعتقد أن أحدًا يرغب في ذلك بإرادته الواعية.
ترتبط الحياة السعيدة بـ “حساسية الفرد” بتعبير شوبنهاور، وترتبط أيضا بالشروط الاجتماعية والاقتصادية كما يرى ماركس. إذا، السعادة ليست ذات وجود خاص أو جوهر متعالٍ. لن نحقق الحياة السعيدة بمجرد الإيمان بالسعادة أو البحث عنها. تلك الحقيقة من البديهيات التي يجب التأكيد عليها. ويجب ألا نتناساها حتى لو غرقنا في سيلٍ من الدعايا والوعود المبهرة والترويج للإيجابية.
الثورة واليوتوبيا السعيدة
يقول لونوار إن “مآسي القرن العشرين جعلت المثقفين الأوروبيين أكثر تشاؤمًا من ذي قبل، وصارت مسألة القلق مركزية في أعمالهم، مثل هايدجر وسارتر، في حين تم نفي البحث عن السعادة إلى مرتبة اليوتوبيات البالية”.
كيف إذن استعادت السعادة مركزيتها في الكتابات الفلسفية الأوروبية المعاصرة؟
تحققت تلك العودة مع سقوط الإيمان بـ “التقدم”، الأسطورة المؤسِسة للحداثة. يوضح لونوار أنه بعد ما أظهرت الأيديولوجيات السياسية الكبرى عدم أهليتها لجعل العالم أفضل، سقط بسقوطها الإيمان بالتقدم وطفت السعادة إلى السطح من جديد.
ما لا يقوله لونوار هو أن الإيمان بالتقدم لم يسقط بمفرده، بل اُعتبرت “الحقيقة” و”تحرر الذات” أيضا من السرديات الكبرى التي لم يعد العقل الغربي يصدقها. وهو حين يربط بين سقوط السرديات الكبرى وبزوغ السعادة كمسألة فلسفية، لا يعيد فقط رؤية الفيلسوف الفرنسي جان فرسواز ليوتار ما بعد الحداثية في إنكارها وجود مفاهيم كونية شاملة، وإنما يناقض رؤيته نفسها. إذ يؤرخ لبداية ظهور السعادة مجددا خلال سنوات الستينيات من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية في خضم حركة “الثقافة المضادة”.
بزغت حركة “الثقافة المضادة” (Counterculture) في أمريكا كاحتجاج من الشباب على المجتمع ومؤسساته وأعرافه. وتحققت من خلال الموسيقى الشبابية الصاخبة كما في مهرجان «وودستوك» (1969)، وتجاربهم مع المخدرات والتحرر الجنسي ورفضهم منظومة العمل، ومعارضتهم حرب فيتنام ومقاومة التمييز العنصري ضد ذوي الأصول الأفريقية.
لا يمكن نفي الطبيعة الإيديولوجية للنسخة الأمريكية من حركة التمرد في الستينيات والسبعينيات، أو إغفال أثر مايو 1968 الممتد على كل حركات التمرد في أوروبا وأمريكا. بالطبع، لم ينضوِ كل الشباب المنخرط في الاحتجاجات تحت رايات اليسار الراديكالي وقتها، إلا أن تلك النقطة لا تنفي الروح المناهضة للرأسمالية خلف التمرد. ربما سقطت رؤى التحرر اليسارية في ما بعد، إلا أن السعادة في تلك اللحظات الستينية السبعينية كانت نابعة من قلب الأفكار والمقولات اليسارية على تنوعها.
يدفعنا الاستطراد السابق إلى التفكير في الحالة المصرية بعد ثورة 2011.
يرسم عقد الثورة دورة حياة شعورية كاملة. فبعد الغضب والحماس والإيمان، يأتى أقصى ما في الثورات، بتعبير الكاتب الجنوب إفريقي ج. م. كوتزي، أقصى ما يمكن أن ينتظره المرء منها: أسبوع أو اثنان من الحرية، من البهجة والجمال. ومن بعد البهجة يأتي القلق والخوف، الصدمة، ثم الحزن واليأس. ونصل بعد ذلك إلى سقوط كل دوافع الإيمان السابق. وتأخذ النهاية صيغًا مختلفة من الخواء أو العدمية أو الفرادنية القلقة وفقدان المعنى. ومعها تأخذ السعادة شكلًا من التحقق الشخصي، من الخلاص الفردي عبر “تحقيق الذات”.
وهنا يجب أن نتساءل: هل كان نبذ الإيمان القديم مُعينًا للذات على تجاوز أزمتها؟ أم أن إعادة اكتشاف الذات لا يمكن تحقيقه إلا باستبطان الوعي الجديد الذي خلقته الثورة؟.. أخلاق جديدة أتاحتها الثورة، فراغات، يمكننا استغلالها في خلق حياة مستقلة، في تغيير وجودنا الفردي.
تقاطعات السعادة
بديهيًا، تتقاطع السعادة مع مفاهيم عديدة، مثل الرضا، اللذة والراحة، وأسوة بفردريك لونوار، لنفكر قليلًا في “تقاطعات” السعادة.
يبدو التفكير في السعادة ضروريًا لأن الإحساس بها يرتبط بوعي الذات. حين نعي أننا أمام لحظة سعيدة فإننا نسعي لعيشها بكل جوارحنا. ومن دون الوعي فإننا ربما لن ندرك لحظة السعادة إلا بانقضائها. ربما السعادة في جوهرها هي الوعي بحالة الرضا، والرغبة في إدامة هذا الوعي. هل كان آدم ليأكل من الشجرة لو أدرك ما هو فيه من السعادة قبل السقوط؟
بعد التأمل، وجد فلاسفة الإغريق أن الحياة السعيدة هي الحياة التي تمنح اللذة. واللذة أمر غريزي في الإنسان، رآها فرويد المبدأ الذي “يحدد غائية الحياة”. لكن اللذة لا يمكنها أن تكون دليلنا الوحيد في الحياة. حذرنا شكسبير على لسان شخصية الراهب لورانس في “روميو وجولييت” قائلًا: “تلك الملذات العنيفة، لها نهايات عنيفة”. ويؤكد أرسطو أن هناك الكثير من اللذات الأخرى غير اللذات الحسية التي استأثرت بميراث اللذة ودفعتنا إلى حث الخطى نحوها، مثل الحب والصداقة والمعرفة والتأمل. ويوضح أن لذّات الروح هي أكثر ما يساهم في بعث السعادة، وأن العقل هو من يسمح بتنظيم اللذات في وجود “الفضيلة”. لذلك يؤكد أرسطو أن “السعادة هي نشاط الروح بما يتوافق مع الفضيلة”.
ويميز الفيسلوف أبيقور بين ثلاثة أنواع من الملذات: أولًا الملذات الطبيعية والضرورية (الطعام، الشراب، الملبس، البيت..) وثانيًا الملذات الطبيعية غير الضرورية (الوجبات الفخمة، جمال الملابس وتنوع وسائل الراحة)، وثالثًا الملذات الطبيعية غير الطبيعية وغير الضرورية (كالسلطة والنسب والترف الباذخ). وفي رأيه يكفي الاكتفاء بالفئة الأولى ليكون المرء سعيدًا، ومن الأفضل الاستغناء عن ملذات الفئة الثانية، “أما ملذات الفئة الثالثة فيرى ضرورة تجنبها”.
يُبجل أبيقور “أخلاق الاعتدال” كما يقول لونوار. ويوضح أيضًا أن “لدينا صورة مشوهة عن الحكمة الأبيقورية”. فالحياة عنده ليست قائمة على البحث عن اللذة الحسية بأكبر كثافة ممكنة. وتتجلى السعادة الأبيقورية بما يدعوه “الراحة المطلقة للروح”. ولا تتحقق هذه الحالة إلا بإقصاء الخوف، وتحديدًا الخوف من الآلهة والموت.
يصوغ لونوار تعريفًا “توليفيًا” من أفكار أرسطو وأبيقور وشوبنهاور وغيرهم، ليقول إن “السعادة هي الوعي بحالة رضا عامة ومستدامة في وجودٍ ذي معنى مؤسَس على الحقيقة”. ويكون “هدف الحكمة” هو “محاولة جعل السعادة أعمق وأكثر تجاوزًا لمصادفات الحياة والأحداث الخارجية والعواطف المحببة أو المنفرة للوقائع اليومية”.
تبدو “الحكمة” قرينة “السعادة” خلال رحلة البحث، هي أعلى مراتب السعادة كما يقول الرواقيون. وإن كانت الحكمة ضالة المؤمن، فهي سمة أو غاية غير مرغوبة في العمل الفني أو الفكري. للفيلسوف سلافوي جيجيك تصريح طريف في أحد حواراته: “أعارض الحكمة”. وسبب رفض جيجيك لها هو أنها “امتثالية”. ليست ذات بُعد نقدي، وكأن مهمتها التعمية على الحقيقة عبر الامتثال للوضع القائم.
لكن “السعادة” ليست كذلك. دعونا نفكر فيها؛ السعادة تُعرف غالبا بالنفي، حضورها يتحقق بالغياب. غياب الألم أو القلق يحقق السعادة. نفي الحزن يحقق السعادة. نفي الخوف يخلق السعادة. هي، كما أراها، فكرة نقدية، قوة سالبة، تتحرك دومًا باتجاه ما يجب أن يكون لا باتجاه ما هو كائن.
ولنتحدث الآن عن السعادة بوصفها قوة إيديولوجية، كمفهوم نقدي يكشف عن بعد آخر للواقع الذي نعيشه.
جريمة الحديث عن السعادة
هناك قصة من التراث الصوفي يذكرها لونوار في كتاب آخر “قوة الفرح“، وتجسد في رأيه كيف يعلم الحكيم أن المصدر الحقيقي للسعادة موجود في داخله:
كان ثمة رجل عجوز يجلس عند مدخل مدينة، واقترب منه رجل غريب يسأله: كيف حال أهل هذه المدينة فأنا لا أعرفهم؟ ويجيبه العجوز بسؤال: “وكيف حال أهل المدينة التي قدمت منها؟” فيقول الغريب: “أنانيون وأشرار ولهذا رحلت”. وهنا يرد العجوز: “إذا، مثل هؤلاء ستجد هنا”. وحين يقترب من العجوز غريب آخر ويسأله نفس السؤال، يجيبه العجوز: “كيف حال الناس في المدينة التي جئت منها ؟” فيرد الغريب: “صالحون وودودون، وعندي كثير من الأصحاب في مدينتي، وإني لأجد صعوبة في مفارقتهم”. فيبتسم العجوز قائلًا: “إذا، مثل هؤلاء ستجد هنا”.
وكان بائع جِمال – لا شيء آخر أقل من الجِمال- يتابع المشهدين من بعيد، فيقترب من العجوز ويسأله لماذا قلت لهذين الغريبين أمرين متناقضين؟ ويجيبه العجوز:
” لأن كلًا منهما يحمل عالمه في قلبه”.
يعقب لونوار على تلك القصة قائلًا: “إن نظرتنا عن العالم ليست هي العالم، إنما في تصورنا الذي كوّناه في أنفسنا عن العالم. حين يسعد رجل في ما في مكان ما، فسيكون سعيدًا أينما حل. ورجل ما تعيس في مكان ما سيصير تعيسًا أينما حل”.
يمكننا أن نلحظ انصياع لونوار إلى الطبيعة “الامتثالية” للحكمة. إلا أنه يناقض نفسه كذلك حين يقول إن السعادة التي يتحدث عنها الفلاسفة ليست عابرة وإنما حالة مستمرة، “غاية تتحقق عبر العمل والإرادة والكفاح”.
هل حقًا سنحمل تعاستنا معنا من بلادنا المنكوبة، أو المحاصرة أو الفقيرة، ونرتحل بها إلى بلاد الشمال مثلًا؟ إن التعاسة وفق هذا المعنى ليست إلا جرثومة خبيثة، مرض مزمن لا دواء له. لا مسببات تاريخية أو اقتصادية أو سياسية لها.
يؤكد لونوار على السعادة الناجمة عن تجربة التواصل مع الطبيعة. ويقول إنه بوسعنا أن نشعر بالفرح لأن جمال الطبيعة يؤثر فينا بقوة.. “ولدت أكبر الأفراح التي شعرت بها في حياتي على هذا النحو. تتيقظ حواسي حين أتنزه، أتابع شعاع نور بين الأشجار المتشابكة، حركة موجة على المحيط..”.
ويضيف: “لقد أدركت إلى أي درجة يُشكل الاحتكاك مع الطبيعة تجربة حسية متجددة. عندما نتمكن من القيام بنزهة في الغابة أو نغوص في البحر أو في النهر، أو نتجول في الجبل ونحن متيقظين تمامًا لأحاسيسنا وللذة التي يمنحنا إياها هذا النوع من التجارب”.
حديث لونوار عن أثر التجربة الحسية للتواصل مع الطبيعة ينفي، إلى حد ما، فكرة أننا نحمل عالمنا في قلبنا، وأن السعادة أو التعاسة لا ترتبطان بتغير مكاننا من العالم.
لو عاش لونوار في مصر، هل سيتمكن من التواصل مع الطبيعة بأشجارها وبحرها، والتنزه في الحدائق العامة؟ والإجابة هي قطعًا لا. إلا لو أقام في كومباوند بالطبع؛ حيث المساحات الخضراء محسوبة النسب، ومُقننة، خلف أسوار، ومن حولها الصحراء.
تشهد المدن المصرية عدوانًا ممنهجًا على الأشجار والمساحات الخضراء. انتشرت عمليات قطع وإزالة الأشجار في عدة مناطق بالقاهرة، لعل أبرزها ما حدث في حي مصر الجديدة، بدعوى المصلحة العامة من تطوير طرق وإقامة كباري. واستمرت مذابح الحدائق العامة في مصر. حديقة المريلاند بمصر الجديدة، حديقة الطفل في مدينة المنصورة، وحديقة الأسماك في حي الزمالك وغيرها. في كل مرة تعلن الجهات الحكومية عن عمليات تطوير في واحدة من الحدائق العامة، تصيبني الكآبة رغم التعهدات برفع كفاءة الخدمات مع المحافظة على النباتات والأشجار النادرة الموجودة بها.
نالت الإسكندرية نصيبها من تطوير الحدائق وإزالة الأشجار. وكغيري ممن قضوا طفولتهم في الإسكندرية، تربطني بحدائقها علاقة وطيدة، أو كانت كذلك. أسكن بالقرب من حدائق المنتزه. وصار المرور بجانبها ذهابًا وعودة باعثًا على الأسى.. يمكنك دخول المنتزه الآن، وهناك من أبدوا سعادتهم بالتجديدات التي حلت بها. استحدث القائمون على التطوير بحيرة جديدة داخلها على حساب الأشجار بالطبع.
مؤخرًا، أراد أبي وأمي التنزه بعد الانتهاء من الزيارة الدورية للطبيب. فذهبا إلى حديقة أنطونيادس. الحديقة العريقة مهملة منذ سنوات. وتجري بها الآن أعمال الإنشاءات والتطوير. تعذر على والديّ المشي بسبب الحفر والهدم وحركة الأوناش والبلدوزرات. نأمل أن لا تتقلص المساحات الخضراء بها. أتذكر فسحة أنطونيادس؛ كانت من اللحظات السعيدة في طفولتي. أتمنى أن يعيش أطفالي مثلها.
●●●
أي زمن هذا ؟
إن الحديث فيه عن الأشجار يوشك أن يكون جريمة؛
لأنه يعني الصمت على جرائم أشد هولًا!
برتولد بريخت
●●●
حين أقرأ جملة لونوار الآتية: “لقد اختبرنا كلنا تقريبًا تجربة التمدد على عشب الحديقة أو في حديقة عامة بعد نهارٍ كثيف أو بعد أسبوع من العمل”، أجد نفسي لا أستطيع إلا أن أرد قائلًا:
“نعم (اختبرنا)، ولكن، في الماضي. الآن نختبر تجربة مغايرة. أن تكون مثلا بجوار حديقة المسلة بالزمالك، وتشهد إقامة جراج أمامها على النيل. أو تتمشي على كورنيش البحر في الإسكندرية لكنك لن ترى البحر بل الجراجات ومن حولها الكافيهات. أعلم أنه ليس ذنبك يا لونوار. أنا فقط أحاول أن أفكر معك في السعادة”.
هل السعادة ممكنة في هذا الخط من العالم؟
ذهبت إلى مدينة الغردقة (حوالي 400 كم جنوب شرق القاهرة) مع زوجتي وابنتيّ نهاية الصيف الماضي احتفالًا بذكرى زواجنا. ولأن الفندق الذي أقمنا فيه يقع وسط المدينة، شاهدنا التباين الصارخ بين المنتجعات والقرى السياحية والمدينة المتهالكة.
عند العودة، ومع دخول الأوتوبيس القاهرة، يمكنك أن تشاهد أعمال الإزالة للبيوت المتاخمة للطريق الدائري. البيوت الباقية يحوطها الركام. بنايات نصف مهدمة. نظرت ابنتي الصغرى من خلف الزجاج وقالت: “إزاي في ناس عايشة في البيوت المطبقة دي؟”. سبق رؤيتنا للطريق الدائري والبيوت المجاورة له، مرورنا على مجموعة من الكومباوندات وعدد من التجمعات العقارية “الراقية” قيد الإنشاء. ربما التباين الشديد بين براح الكومباوندات باذخة التصميم وركام بيوت الدائري هو ما دفع ابنتي ذات الأربع سنوات إلى سؤالها المستنكر. أفكر في من يتفتح وعيه داخل مدينة مثل القاهرة، ويشاهد يوميًا أمثلة حية على تحيز العمران وظلمه. كيف ستنبع السعادة من داخله؟!
ليست السعادة اختراعًا أوروبيًا بالتأكيد. لفلسفات الشرق تاريخ طويل وإسهام إنساني في رحلة البحث عن الراحة والسكينة والسلام. تعبر مرحلة النيرفانا في المفاهيم البوذية عن الوعي الحقيقي الذي يؤدي إلى تحرير الإنسان من المعاناة، ويجب أن يتضمن إدراكًا نقديًا للمشاعر حتى يصل الفرد إلى مشارف التنوير الروحي ويحقق السعادة والسلام الداخلي. كما انتشرت فلسفة الزن في الغرب، وتعاليم الطاوية، وصارت تمارين اليوجا -هندوسية الأصل- وجلسات التأمل روتينًا يوميًا غربًا وشرقًا.
تثير الروحانيات الآسيوية والحِكم الشرقية فضول الغربيين، خاصة البوذية التي تحتل فيها مسألة السعادة موقع الصدارة. إلا أن هناك تباينًا جوهريًا بين الشرق والغرب (أوروبا وأمريكا) في مسألة السعادة. لا أقصد الاختلاف بين روحانية شرقية ومادية غربية، بل شيئًا أهم من ذلك. تتمثل دول آسيا السعادة بوصفها ديانة، أو كنوع من التدين الشخصي والكهانة، أعراف وتقاليد أو معتقدات قديمة للأهالي. أما أوروبا فتتخذ من السعادة برنامجًا للعمل السياسي، مع اختلافات في توظيف المفهوم نفسه. وتُقر الولايات المتحدة “السعي نحو السعادة” في إعلان استقلالها.
في كتابه “مفارقات السعادة: سبع طرائق تجعلك سعيدًا“، يوضح الفيلسوف لوك فيري تناقض مفهوم السعادة نفسه، فرغباتنا نفسها متناقضة ومتغيرة أيضًا. ويعارض فكرة أن السعادة لا تتوقف إلا علينا، أي وهم السعادة الفردية، قائلًا:
“الوعد بتحقيق سعادة دائمة من خلال مجهود يبذله الإنسان وحده بفضل تمارين روحية تتمركز حول ذاته، يكاد يكون نوعًا من الضلال الفكري”.
يتناول فيري تطور مفهوم السعادة داخل الفكر الفلسفي والسياسي الأوروبي. من لاهوت المعاناة المسيحي حيث البؤس تذكرة دخول إلى الخلاص، حتى ظهور الأخلاق العلمانية، ومفاهيم الجمهورية والتراث الأنجلوساكسوني والنفعية. وكانت مايو 68 إيذانًا بتقديم نموذج أخلاقي جديد، صارت السعادة فيه واجبًا. لذلك “لم تكن مصادفة أن يصير الانشغال بحياة الرفاهية والسعادة أمرا أساسيا منذ عقود”، كما يوضح فيري.
اعتمد الاتحاد الأوروبي موسيقي بيتهوفن “أنشودة الفرح ode to joy”، من السيمفونية التاسعة، نشيدًا رسميًا منذ الثمانينيات. كلمات القصيدة الأصلية للشاعر الألماني شيللر تعبر عن الأخوة الإنسانية. ويصرح الاتحاد الأوروبي بأن موسيقى “أنشودة الفرح” تعبر عن المُثل الأوروبية.. الحرية والسلام والتضامن.
شاهدت مؤخرًا فيديو للسيمفونية التاسعة من أداء أوركسترا شباب الاتحاد الأوروبي بقيادة المايسترو فاسيلي بيترينكو في برلين. الجديد في هذا الفيديو أننا لا نشاهد فقط العازفين أو الحضور داخل قاعة الحفلات، وإنما تنتقل الكاميرا خارج مبني الكونسرتهاوز، إلى الجماهير في ساحة جندارمينماركت، ساحة السوق التاريخية في برلين. جمهور متنوع من رجال ونساء وأطفال، شباب وكهول، وأمامهم شاشة عرض تنقل لهم أداء الأوركسترا في الداخل. تجمع للمئات، تداعبهم نسمات الهواء، يجلسون أو يقفون في تآلف وتلقائية. ومن الناس من يغني كلمات شيللر حين نصل إلى الحركة الختامية من السيمفونية. في النهاية يدعو المايسترو الحضور داخل القاعة للوقوف، لتشارك الفرقة في الغناء، وتصدح الحناجر داخل القاعة وخارجها بغناء نشيد أوروبا، نشيد الفرح.
من مميزات الفرح أنه “تشاركي”، كما يوضح لونوار. إنه حالة من السعادة نريد أن نتقاسمها وننقلها إلى الآخرين. الفرح “يحمل قوة تزيد من إحساسنا بوجودنا” وتجعلنا “نفيض بالحياة”.
هذا الفرح التشاركي في ساحة جندارمينماركت التاريخية غير وارد حدوث مثيله في مصر الآن. لا لأننا نعاني من نقص الميادين أو الساحات التاريخية، ولا لأننا لا نجيد الألمانية، ولكن لأسباب سياسية وأمنية في المقام الأول.
يقيد القانون المصري الحق في التجمع السلمي، يشترط قانون التظاهر على منظمي المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة لأكثر من 10 أشخاص، والتي تتم في مكان عام بدون دعوة شخصية مسبقة، أن يخطروا وزارة الداخلية قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل. وتمنح إحدى مواد القانون لمسؤولي وزارة الداخلية حقاً مطلقاً لحظر أي مظاهرة أو اجتماع عام على أساس مبهم يتمثل في “معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم”، دون اشتراط تقديم مبررات محددة.
ربما لهذا كان مشهد الإفطار الجماعي في حي المطرية بالقاهرة مبهجًا للبعض، رغم كونه أمرًا طبيعيًا بالنسبة لأي اجتماع إنساني. أن يتشارك الناس في تجربة جماعية، خاصة وإن كانت من الطقوس المألوفة قديمًا.
تختلف نظرتنا إلى الأمكنة باختلاف ذاكرتنا وانطباعاتنا عنها. ربما تصير “المطرية” علامة على السعادة، كلمة تخلق دلالة سارة في ذهن من يسمعها أو يقرأ حروفها. بالنسبة لي، تحمل “المطرية” ذكرى مختلفة؛ كنت أجلس مع أحد الأصدقاء، وانضم إلينا صديق مشترك يعمل في إعداد ورش المسرح والحكي. وأثناء الحديث عن آخر تجاربه، وصلتنا أخبار عن اشتباكات مع قوات الجيش والداخلية وأعمال عنف في “المطرية”. كنا في عام 2014. انتابت صديقنا المسرحي الذي نشأ في المطرية وله أقارب ومعارف هناك، حالة قلق شديدة. وتحدث عن تخوفه من أن يزيد الردع الأمني الغاشم الوضع كارثية نظرًا لطبيعة المجتمع هناك، وتركيبته السكانية التي يعرفها جيدًا. تجددت الاشتباكات في يناير من العام التالي.
وبعيدًا عن حقيقة انتماء المتظاهرين أو مثيري الشغب إلى جماعة بعينها أو فصيل ما، كانت الصورة النهائية الباقية في ذاكرتي، حتى الآن، هي تكدس مدرعات الجيش في ميدان المطرية. احتلت الدبابات الميدان، وأغلقت مدرعات الأمن المركزي شارع الحرية المتفرع منه. ربما لا تعبر تلك الأحداث عن أهالي “المطرية”. ربما انقضت تلك السنوات المحتقنة بما حملته من تناحر واستقطاب. لكن فكرة أن يتحول ميدان منطقة شعبية كثيفة السكان إلى ثكنة عسكرية، إلى ساحة حرب، من شأنها أن تشوش بكآبتها على الإفطار الرمضاني السعيد.
إضافة لابد منها: كان من المُفترض إقامة إفطار المطرية مرة أخرى بعدها أسبوع لكنه أُلغي؛ لعدم الحصول على “الموافقات الأمنية”.
كنت أشاهد مع أخي إحدى نهائيات بطولة رولان جاروس للتنس. الأجواء جميلة، الناس خارج الملعب مستمتعة بنسمات الهواء وبالشمس التي تأبى الغروب رغم اقتراب الساعة من التاسعة مساءً. والشاشات خارج الملعب تنقل أحداث المباراة. كرنفال مبهج. كانت وقتها الانتفاضة اليمنية في أوجها. وكان علي عبد الله صالح يطل علينا، بكثافة، في نشرات الأخبار بوجهه الكئيب. علق أخي بعد أن رأي مجموعات الناس المتناثرة في باريس: “شوف الناس عايشة إزاي ومستمتعة.. وناس تانية بيحكمها تاجر فحم من خمسة وتلاتين سنة ومش عايز يمشي”.
هل يمكن أن تكون سعيدًا والعالم تعيس من حولك؟
تفترض بعض الحجج الرواقية، التي تجد صدى كبيرًا الآن، أن السعادة لا تتوقف إلا علينا نحن وليس على العالم الخارجي أو على الآخرين. ولأنه من الصعب تغيير الواقع والسياسة السائدة، فإن الكثير من الكتابات المعاصرة تعمل على إغواء القاريء بإمكانية تغيير نفسه، تغيير نظرته إلى العالم، أن “يحب الحياة”، و”يعيش كل لحظة إلى آخرها”.
لهذا يطرح لوك فيري تساؤلات في غاية الأهمية: “هل يمكن أن نصبح سعداء فعلًا ونحن في أوشفيتز أو جوما (مدينة شهدت جرائم حرب في الكونغو)، وسط مذبحة تقع في وسط أفريقيا أو في غرفة تعذيب بسوريا؟”.
تعيش معظم بلادنا العربية “حالة الاستثناء“، بتعبير المفكر الإيطالي جورجيو أجامبين. العيش تحت حالة طوارئ دائمة لا نهاية لها. تحولت حالة الاستثناء إلى “الوضع الطبيعي”، وتعمل السلطة على تعميمه وإدامته.
اعتياد الناس العيش تحت حالة الطوارئ الدائمة “يختزل حياتهم إلى وظيفتها البيولوجية فقط، ويفقدها بذلك ليس بُعدها الاجتماعي والسياسي فحسب، وإنما الإنساني والعاطفي أيضًا”، كما يوضح أجامبين.
هكذا يصبح صراع الفرد منا داخليًا أيضًا. النضال من أجل استعادة البُعد الإنساني والعاطفي المهدد بالضياع. وهنا تكمن المفارقة، لأن العيش تحت هذه الظروف يجعل أبسط المكتسبات واللفتات والمبادرات باعثة على السعادة. أن نمارس حقًا من حقوقنا المدنية أو الإنسانية هو إنجاز سعيد.
يعيد فيري طرح سؤال قديم:
هل من أفضل أن تحيا في سعادة لكن في ظل العبودية والوهم، أم أن تعيش بقدر أقل من السعادة لكن في كنف الحرية والحقيقة ؟
مع انتشار أفكار “توماس هوبز” السياسية عن سيادة الدولة المطلقة على الأفراد، تحقق عقد اجتماعي قائم على تفويض من المواطنين للسلطة كي يخرجوا من حالة الخوف والصراع فيما بينهم وأن تكفل السلطة الحماية لهم. ويُعبر عنها بكلمة تلك السلطة بكلمة “لوياثان”، وهو كائن بحري خرافي يشبه التنين. و”الدولة التنين” كما يصفها هوبز هي “الدولة ذات الطبيعة التدخلية والمحورية في مختلف الأنشطة الاجتماعية بالتنظيم التشريعي والإداري”.
وفق هذا التصور، نضحي بالحرية على مذبح السعادة، ونتخلى عن نصيبنا من السيادة كي نكسب قدرًا من الرفاهية والطمأنينة. ويوضح فيري أن هناك تراثًا فلسفيًا في الفكر السياسي يرى أنه في حال الصراع بين الحرية والسعادة، فإن الحرية تأتي أولًا. لأنها صفة متأصلة في الإنسان.
والحرية هي “أقصى درجات التراجيديا”، لأنها تعني مسؤولية الفرد أمام مصيره وقرارته، وتحمله تبعات إرادته الحرة. يتحرك فيري بين قوسين، أحدهما الديموقراطيات الغربية ووعودها للجماهير بالسعادة، والآخر الأنظمة الشمولية الإيديولوجية مثل الصين الماوية والاتحاد السوفيتي وغايتها “تحرير” الجماهير.
من هنا نفهم أنه لو كان الحرمان من الحرية شرًا فتطبيقها لا يضمن تحقيق السعادة، وهي الفكرة التي يقترحها فيري، ويدلل عليها عبر تناول أفكار نيتشه وسبينوزا، ومفهوم ماكس فيبر عن تراجيديا التاريخ أو “تناقضات الفعل التاريخي”.
فأن تكون حرًا يعني أنك مسؤول أكثر من كونك بريئًا. ويقودنا ذلك إلى ماتتطلبه التراجيديا “التضحية براحتنا باسم القيم التي تفوق السعادة: الكرامة الإنسانية، ومقاومة القمع، ومقاومة الشمولية والبربرية أو حتى وببساطة الالتزام بالدفاع عمن نحب”.
في مدننا العربية، يقترب الحزن من المعنى الذي يستخدمه عالم الأنثروبولوجيا ورائد البنيوية، كلود ليفي شتراوس في “مداريات حزينة” عن المدن المدارية والمجتمعات البدائية في أمريكا الجنوبية وغيرها. الحزن الناتج من البؤس والمعاناة. يبتعد الحزن عن كونه مُعبرًا فقط عن حالة نفسية ويقترب من خبرة شعورية جماعية. الحزن “الغير نابع من مرض و ألم شخص واحد، بل من “ثقافة ومحيط يعيشهما الملايين”.
تسويق السعادة: بين النزعة الاستهلاكية والتنمية الذاتية
منذ عامين أو ثلاثة تقريبًا، انتشرت في مصر موضة المحلات التي تحمل عناوين مثل “دكان السعادة”، “محل السعادة”، تاجر السعادة”. تبيع تلك المحلات الحلويات المستوردة، من المارشيميللو والجيلي والشوكولاتة والسناكس، وغيرها. أحبت أمي زيارة محل “دكان السعادة” المجاور للبيت وشراء الحلويات استعدادًا لزيارة الأحفاد. دولاب الجدة، في حالة أمي، أسطورة تتحقق في الواقع. الدولاب الذي لا تنتهي فيه الحلويات، معين لا ينضب. إذا فتحته وأردت البحث عن حلوى لتأكلها فلن تجدها، حتى تأتي الجدة وتمد يدها في نفس الأماكن التي بحثت فيها من قبل، لكن يد أمي/الجدة تخرج قابضة على الحلوى. من يقول أن السحر انتهى من العالم ؟
كانت هذه النوعية من المحلات أبرز ضحايا التضخم الاقتصادي في مصر خلال الشهور الأخيرة، ارتفعت أسعار الحلويات بها لأن غالبية بضاعتها مستوردة. كانت التضحية بها سهلة، ويمثل العزوف عنها أولوية في أي قائمة تقشف أو خطة لتقليل النفقات. بدأت غالبية المحلات في الإغلاق.
حافظت أمي على سحر دولابها، وجدت بدائل محلية وتنويعًا بين الأصناف المختلفة. لكن لهذا السحر ثمنًا بالطبع. لكي نأتي في العطلة الأسبوعية ونجد صنوفًا متنوعة من الطعام والشراب، تشهد أمي مع أبي نوعًا من التقشف بقية أيام الأسبوع. يُمارس مثل هذا التقشف في سعادة وإخلاص ودون رغبة في تعويض مقابل. شراء السلع ليس هدفًا في ذاته، وإنما الغاية إسعاد من نحب.
أكتب هذه السطور في شهر رمضان، وصخب المواد الإعلانية يتزايد طول الشهر. إعلانات شركات المحمول، والكومبوندات العملاقة، المياه الغازية والملابس الداخلية القطنية، ومؤخرًا البنوك الحكومية. الإعلانات يصاحبها الغناء كأداء ملازم لجنة الاستهلاك.
تعاني الحياة بشكل عام من “التشيؤ”، إلا أن “إسباغ الشيئية” يتضاعف في رمضان. تنتحل السلع مجموعة من القيم الوهمية. يتضافر مع هذا التشيؤ ما تسميه الأدبيات الماركسية ﺑ “الفيتشية السلعية”. إذ تُضفي الإعلانات على السلع إما خصائص “صوفية”، أي تُكسب السلعة/المنتج قيمة أرفع وأسمى من قيمتها الاستعمالية (كما في إعلان مدينتي) أو تتوسل بالسخرية والمفارقات الكوميدية كأدوات فنية كي تنال حظوة الجمهور واستحسانه. الأغنية هي أداة الإعلان للمبالغة في قيمة شيء هو من اختراع قوى السوق.
تظهر السلعة في الإعلانات بوصفها “قوة تحتل الحياة الاجتماعية” كما يعبر المفكر الفرنسي جي ديبور. ويقول موضحًا في كلمات دالة : “تقاتل كل سلعة محددة من أجل ذاتها، وتحاول أن تفرض نفسها في كل مكان وكأنها هي الوحيدة”.
كل سلعة تدعي أن السعادة لن تتحقق إلا عبر حيازتها. تصير السعادة نفسها سلعة. و في كل مرة تسبغ السلعة فيها على نفسها من السمات المتعالية للسعادة، فإنها تمعن في تسليعها أكثر، كأنها تقتات عليها تاركة إياه مجرد فخ لاستهلاكها.
في “دليل المنحرف إلى الإيديولوجيا” يكشف سلافوي جيجيك عن الكيفية التي تعمل بها الإيديولوجيا، وكيف توظف عناصر ما قبل إيديولوجية في خطابها. يتحدث جيجيك عن الإيديولوجيا الكامنة في قهوة ستاربكس، إحدى قمم نزعتنا الاستهلاكية. ويقول إن الإعلانات والبوسترات داخل مقاهي ستاربكس توجه رسائل مُفادها: إن قهوتنا ربما تكون أغلى لكننا نخصص نسبة من العائدات لصحة الأطفال في جواتيمالا أو إنقاذ الغابات أو مد شبكات المياه إلى مناطق فقيرة..إلخ. يوضح جيجيك أنه قديمًا في أزمنة الاستهلاك الخالص كنا نشتري السلعة ونشعر بالسوء أو الذنب لأننا مجرد مستهلكين أو مسرفين بينما الناس في أفريقيا تموت من المجاعات. فنلجأ إلى رد فعل مضاد يتمثل في أعمال الإحسان أو التبرعات.
ما فعلته ستاربكس أنها جعلت سلعتها تتضمن الفعل الاستهلاكي والفعل المضاد له، بل أدرجت كلفة الفعل الضد داخل سعر السلعة نفسها. كأنها تقول لك إنك لم تعد مجرد مستهلك، بل صرت تؤدي دورًا لمساعد المجتمع والإنسانية.
إنه نموذج مغاير من النزعة الاستهلاكية، تلاعب إيديولوجي، لا يعدك برشوى لبيدية قائمة على اللذة فقط، وإنما يتضمن وعدًا أسمى بتحقيقك لمعاني التضامن والأخوة. في الوقت نفسه، هو إقرار نيوليبرالي غير مباشر بأن الاستهلاك وحده لا يمكن أن يحدد سعادة الفرد.
يمثل فيلم “السعي نحو السعادة” جوهر الخطاب الأيديولوجي للنيوليبرالية. رحلة معاناة الأب (ويل سميث) مع ابنه بعدما ضاقت الحياة وحاصرهما الفقر. لكن ذكاء الأب وإصراره يأخذان بيده إلى بر النجاة، إلى السعادة. وتتلخص السعادة في أن يصبح الأب “سمسار بورصة”. يحاول الفيلم إقناعنا بأن النجاح أو الفشل هما مسؤوليتنا المطلقة وحدنا. إذا كنت لا تزال فقيرًا فإن ذلك يعني أنك لم تستطع قنص الفرصة المناسبة.
يقول المنّظر الانجليزي مارك فيشر (1968- 2017) إن أحد “أنجح التكتيكات التي استخدمتها الطبقة الحاكمة لفترة من زمن هي تحميلنا بالمسؤولية بحيث يصبح كل فرد من الطبقات الخاضعة لديه شعور داخلي بأن الفقر وقلة الفرص والبطالة أخطاؤهم الفردية وهم وحدهم المسؤولون عنها”. نلوم أنفسنا بدلا من توجيه النقد إلى البنى الاجتماعية الحاكمة.
ويتحدث فيشر عن مفهوم “الإرادية السحرية” الذي ينقده الطبيب النفسي ديفيد سمايل في كتابه “جذور التعاسة“. والإرادية السحرية هي “الإيمان بأن كل الأفراد لديهم القدرة على جعل أنفسهم ما يريدون”. وتلك الفكرة هي “الأيديولوجيا المسيطرة والديانة غير الرسمية للمجتمع الرأسمالي المعاصر”. ديانة يروج لها خبراء التنمية الذاتية ورجال الأعمال، والسياسيون من قبلهم. وهي “الجانب الآخر من الاكتئاب الذي باطنه أننا جميعا مسؤولون وحدنا عن تعاستنا”.
السعادة والبحث عن المعنى
يُصاغ أي تصور أو مفهوم عن “السعادة” بناءً على ما نعتقده عنصرًا أساسيًا في “الطبيعة الإنسانية”. وأرى أن سؤال السعادة يشتبك مع سؤال آخر: هل هناك شيء يدعى الطبيعة الإنسانية المتأصلة أو الموروثة المستقلة عن خبرتنا والشروط المادية والتأثيرات الخارجية؟
فما نعتبره جوهريًا في طبيعتنا الإنسانية يحدد طرائق سعينا نحو “السعادة”، ومدى إيماننا بها من عدمه.
يُعتبر فيلم “سعادة Happiness” 1998 للمخرج الأمريكي تود سولوندز من أكثر الأفلام إثارة للجدل. بداية من عنوانه الذي يناقض حبكته وأفعال شخصياته. يقدم الفيلم حياة عدة أفراد تتقاطع وتتداخل فيما بينها، بينما يمضي كل منهم في مساره الخاص، الغريب. شخصيات الفيلم كلها محكومة بسعيها اليائس نحو التواصل الإنساني، ويجمع بينها الانحراف والغرابة. البيدوفيليا والقتل يقدمان داخل الفيلم في بساطة وعادية. ويكشف سولوندز عن الجانب التعيس واليائس في الجنسانية أو السعي وراء اللذة عمومًا. يبحث سولوندز عبر شخصياته المنبوذة الغير سعيدة عن مصادر التعاسة من حولنا. وربما يؤكد على أن ما يُسعدنا يجعلنا تعساء كذلك. والسعادة، وفق هذا المعنى، مستحيلة، أو غير ممكنة إلا بوأد نوازع الأذى داخلنا، وإقامة تواصل حقيقي مع غيرنا من البشر.
أعتقد أن معظم قراراتي في الحياة كانت بدافع البحث عن “المعنى”. لكنني أعتقد أيضًا أن تجنب التعاسة يُمثل دائمًا دافعًا طبيعيًا ربما لا أفطن إليه في حينها.
حين تركتُ الوظيفة وقررت أن أكون كاتبًا لم أعلم ما ستقدمه لي الأيام القادمة، وما زلت. شعرت بالسعادة التي تقدمها الحرية، لكنها سعادة مقرونة بالمسؤولية والخوف الدائم من المجهول، خوفي من الجانب التراجيدي لتلك الحرية. فالحاجة إلى العمل المبدع وإلى الإبداع الحر دون تأثير متعسف من قبل المؤسسات المتسلطة لهو عنصر أساسي للطبيعة الإنسانية، كما يقول نعوم تشومسكي. يمكنني أن أقول الآن: أنا سعيد في حياتي. لكنني لست سعيدًا فقط، أنا سعيد وغاضب وخائف ولدي من الأمل قدر ما بي من اليأس. المهم أني أعرف ما أريده وما أود فعله. وهذا يكفيني.
بحثت عن الحب فترة من حياتي حتى وجدته وتزوجت. وعرفت حبًا أكبر حين صرت أبًا. أفكر أحيانًا في حياة أخرى تحمل إمكانيات أخرى لكنني لست بحاجة للفلسفة كي أعلم أن مثل تلك الحياة الأخرى سأتوق فيها إلى أخرى غيرها، وهكذا.
لو استطعت أن أحيا حياة عاشها غيري من الأفراد الذين مروا على تاريخ الإنسانية، سأختار أن أحيا مثل فرانز فانون مثلا أو أنطونيو جرامشي أو روزا لوكسمبورج. حياة قوامها النضال من أجل العدالة والبحث عن المعنى. حياة بأكملها قُدمت في سبيل المعنى. لكنني ارتعد حين أفكر في الثمن الذي قدمه هؤلاء المناضلون.
أو ربما حياة مثل “سيدني فاربر”، الطبيب المختص بباثولوجيا الأطفال المولود في نيويورك عام 1903. قدم فاربر إلى العالم الأمل في الشفاء من السرطان حيث حققت تجاربه الكيماوية نسب شفاء عالية من اللوكيميا عند الأطفال. اكتشف فاربر مادة كيماوية فعالة ضد السرطان في أحد نظائر الفيتامينات. فاربر هو “أبو المعالجة الكيماوية الحديثة “، وكان يحلم بتحقيق شفاء عالمي من السرطان.
المعنى لا يجب أن يكون نهائيًا أو متعاليًا، أو من أجل غايات كبرى ومستحيلة. يمكن لمضمون المعنى أن يختلف من شخص لآخر. نجد المعنى في بناء مسار مهني يمكننا من الإبداع واستغلال طاقتنا، ونجده حين نقرر بناء عائلة وتربية أبناء وتنظيم حياتنا وفقًا لذلك القرار، وهكذا.
نهاية سعيدة
توصف النهايات السعيدة غالبًا بأنها ساذجة أو متفائلة أو توفيقية. اعتقدت لسنوات أنه لا يمكنني أن أرى فيلمًا عظيمًا وتكون نهايته سعيدة. فنهاية مثل هذه ستحمل حلا تلفيقيا أو غير واقعي بالتأكيد. آمنت بذلك حتى رأيت أفلام المخرج فرانك كابرا.
تحض سينما كابرا على الأمل والتضامن في مواجهة سوداوية زمن كارثة الكساد الكبير والأزمة الاقتصادية مع بداية ثلاثينيات القرن العشرين. يصف الناقد و المؤرخ الثقافي إبراهيم العريس أفلام كابرا “السيد ديدز يتوجه إلى المدينة” 1936، “السيد سميث يذهب إلى واشنطن” (1939) و”رجل الشارع” (1941)، في فترة حكم الرئيس الأمريكي روزفلت بـ “ثلاثية الأمل”. الأمل في الخروج من الكارثة المدوية بالإيمان في التضامن الإنساني بين الأفراد، ودور المواطن العادي، المتوسط، في مجتمع ما بعد الكارثة. وتروج الأفلام للديموقراطية الشعبية الحقيقية ودور الشعب في صياغة حلم أمريكي جديد، بمفاهيم جديدة عن الحياة والثروة.
قدم كابرا أيضا في “لن تأخذها معك” خطابًا إيديولوجيًا يتماهي مع سياسات روزفلت الطامحة إلى نهضة اجتماعية. ويعبر كابرا سينمائيًا عن أخلاق جديدة تتخلق من رحم الكارثة الاقتصادية، فأمريكا لن يعاد بناؤها إلا عبر الناس البسطاء، لأنها بلادهم هم في المقام الأول.
أما في عمله الكلاسيكي الجميل “It’s a wonderful life” 1946، نشاهد حياة جورج بايلي، المواطن الصالح الذي ظل طوال حياته يخدم مجتمعه الصغير من خلال مؤسسته الصغيرة الموروثة عن أبيه. تقدم شركته القروض وتساعد أهل المدينة على بناء منازلهم الخاصة.
في المقابل هناك السيد بوتر، رجل الأعمال الجشع الراغب في السيطرة على المدينة. لكن “بايلي” يستمر في عمله ويناضل من أجل بقائه. يتزوج ويكوّن أسرة جميلة، يتخلى عن حلم السفر ويبقى في “بيدفورد فالز”، مدينته الصغيرة، حتى لا تقع وأهلها تحت رحمة بوتر ونهمه إلى الربح ولا شيء غيره. تتأزم أموره المالية مع الوقت، ويفقد المبلغ المفترض إيداعه في البنك كي لا يُعلن إفلاسه. يُقدم بايلي على الانتحار لكن يظهر له ملاك حارس، مرسلا من السماء كي يثنيه عن نيته في إنهاء حياته.
لا يأتي الملاك بشيء خارق، لكنه يعرض لـ “بايلي” كيف كانت الحياة في “بيدفورد فالز” لتصبح من دونه. كأن الملاك يريه إمكانية عدمه مقابل وجوده. لحظتها، يدرك بايلي مدى تأثيره الطيب على الناس من حوله. كل أفعاله الخيرة لم تكن لتوجد، ويترتب على ذلك الكثير من الأسى والفقد. يعود إلى بيته راضيًا، ليجد في النهاية أن أهالي “بيدفورد فالز” يتشاركون في تجميع المبلغ المطلوب، عشية الكريسماس، في محاولة لرد صنيع بايلي طوال سنوات. فيلم جميل عن إرادة الخير.
لكن ثمة سؤال يؤرقني: لماذا أرسلت السماء ملاكًا من الدرجة الثانية لإنقاذ “جورج بايلي” ؟ ألا يستحق هذا الإنسان الطيب ملاكًا بجناحين وقدرات أكبر ومنزلة أعلى ؟ لماذا ترسل السماء ملاكًا مثل ذلك مع وعد بإعطائه جناحين إن نجح في مهمته؟
ربما تريد تلك التحفة الكلاسيكية أن تقول إن الحل دائمًا يأتي من الأرض لا السماء. لن تقدم السماء حلا سوى إعادة إيمانك بوجودك. فإن كنت قد أقمت حياتك على أساس من الحب والخير، فلا تيأس مهما اشتدت الظروف من حولك.
يشيد فيلم “حياة أو موت” رائعة المخرج المصري كمال الشيخ (1954)، حبكته من تفصيلة صغيرة قدمها كابرا في فيلمه عن بايلي ومدينته وملاكه الحارس. يخطيء الصيدلي في تركيب الدواء فيتحول إلى سم زعاف. في فيلم كابرا، يعمل “بايلي” طفلا لدى صيدلي حزين على فقد ابنه في الحرب، ويستطيع بايلي أن ينبه الصيدلي إلى الخطأ القاتل قبل فوات الأوان.
أما في فيلم كمال الشيخ، فتذهب الابنة بالدواء القاتل إلى أبيها البائس، الذي تركته زوجته. ولا يعلم الصيدلي اسمًا لها أو عنوانًا كي يتدارك خطأه. وتدور الأحداث في وقفة العيد أيضًا. يلجأ الصيدلي إلى حكمدار العاصمة، في البداية يظن الحكمدار أن الصيدلي لديه معلومات عن مجرم هارب، ولكن بعد أن تتضح له الصورة ورغم انخراط البوليس في البحث عن المجرم الخطير، فإن الحكمدار يحاول أن يفعل ما بوسعه ليعرف موقع بيت الأب المسكين داخل العاصمة. ويصير البحث عن الفتاة وإنقاذ الأب عملا جماعيًا، مسألة حياة أو موت.
يقدم الشيخ رؤية إنسانية تُعلي من شأن الفرد، وصورة مثالية للتكافل الاجتماعي والتآزر، و”نموذجًا للكيفية التي يجب أن تنظر بها الدولة إلى مواطنيها”، كما يقول الناقد السينمائي المصري علي أبو شادي.
ورغم أن الفيلم قد صنع في السنوات الأولى من ثورة يوليو 1952، فإن خطابه الإنساني النبيل ليس دعائيا في رأيي. إن النهاية السعيدة في “حياة أو موت” تُعد مثالا للكيفية التي تصبح فيها السعادة رؤية لما يجب أن يكون عليه الوضع القائم. أي أن المخرج العظيم كمال الشيخ “نزع عامدًا إلى تقديم الصورة التي يجب أن يكون عليها المستقبل”.
إيديولوجيا شخصية للسعادة
يقول الكاتب البريطاني بول بولز في روايته “السماء الواقية“:
“لأننا لا نعلم متى سنموت، فإننا نجنح إلى رؤية الحياة كأنها بئر لا ينضب. رغم أن كل شيء يحدث لعدد محدود من المرات، وما هو إلا عدد ضئيل في الواقع. كم عدد المرات التي تستعيد فيها فترة ظهيرة معينة من طفولتك، ظهيرة ما تستحوذ على جزء كبير من كيانك حد أنك غير قادر على تصور حياتك بدونها؟ ربما خمس مرات أو أكثر، ربما أقل من ذلك. كم مرة سترى فيها القمر مكتملًا ؟ ربما عشرون مرة. ورغم ذلك يبدو وكأن الأمر يفوق الحصر”.
أفكر في يوم معين من طفولتي، يوم سعيد لا أتصور حياتي بدونه. كنت في الصف الثاني الابتدائي. وعدتني أمي بالذهاب إلى السينما ومشاهدة فيلم “حديقة الديناصورات” إن صرت الأول على الفصل في امتحانات الشهر. وبالفعل كنت الأول في ذلك الشهر، وجاء وقت المكافأة والوفاء بالوعد. ذهبنا ظهيرة يوم سبت إلى حديقة الشلالات في الشاطبي. وبعدها جاء أبي، في غير موعد إجازته المعتادة، ليصحبنا إلى السينما، وشاهدت فيلم سبيلبيرج الجميل. كنت سعيدًا رغم الرعب الذي خلقه تحرر الديناصورات وهجومها على البشر. فسحتان في يوم واحد.
كم تحتاج الآن أسرة مصرية متوسطة من أربعة أفراد للذهاب إلى السينما وقضاء اليوم في الخارج؟
كل لحظة سعادة مسكونة بزوالها. لو أدركت أنني أمام لحظة سعادة خالصة، فردوسية، هل سأحلم بتكرارها إلى ما نهاية حتى وإن أصبحت سجينًا بها؟ ربما الوعد بالفردوس يشبه ذلك الحلم. لحظة سعادة ممتدة، هناء شخصي أبدي قوامه لذة لا تزول.
في ثاني ألبومات فرقة البوست روك الاسكتنلندية “موجواي”، يضعنا العنوان، Come on Die Young هيا مُت شابًا، في حيرة. هل نحن إزاء عدمية نهاية القرن العشرين، حيث اللامبالاة والاكتئاب الدائم؟ أم أن العنوان مجرد مفارقة ساخرة؟
يتبدى من أول تراكات الألبوم الحس الساخر لموجواي، أو تعمد الخفة، وهي سمة ما بعد حداثية في الفن. تميز التراك الأول بعنوان پانك روك، في إشارة إلى النوع المشتق من الروك آند رول منتصف السبعينات، بعدوانيته وثوريته ورفضه لتيارات الروك السائدة، والذي شهدت بريطانيا أعنف موجاته وأشدها راديكالية.
لا تتوقف المفارقة عند هذه النقطة، عند استدعاء الأيديولوجيا المعادية للسلطوية (السمة الرئيسية للبانك) في زمن إعلان موت الايديولوجيا، نهاية القرن العشرين؛ بل نتبين مستوى أعمق من الباروديا، أو المحاكاة الساخرة التهكمية، في كون موسيقى موجواي أساسًا على النقيض من موسيقى الپانك روك. تستلهم موجواي الطبيعة المقاومة في موسيقى البانك روك، والروح الاستقلالية المناوئة للسائد، وتطرح جانبًا التعبير السياسي/الأيديولوجي المباشر من أجل الوصول إلى جماليات خاصة تميزهم.
نلحظ في المقطوعة الجميلة “قد لا يأتي من بابك شيء غير السعادة”، أن ثمة تكرارًا للجملة اللحنية للجيتارات والدرامز، لكن مع تحريف بسيط في كل مرة. وفي منتصف المقطوعة يتميز التكرار بالتصاعد ثم يبدأ بالخفوت. توحي المقطوعة بثيمة الانتظار والترقب، وتتعدد أطيافها الشعورية بين القلق والأمل والتوتر والراحة.
ربما إن فتحنا بابًا داخلنا للاستقلالية والتمرد، فستأتي منه رياح تهدد أماننا وحريتنا، أو ربما لا شيء سيعبر من خلاله في النهاية -ورغم كل ما قد يحدث- إلا السعادة.