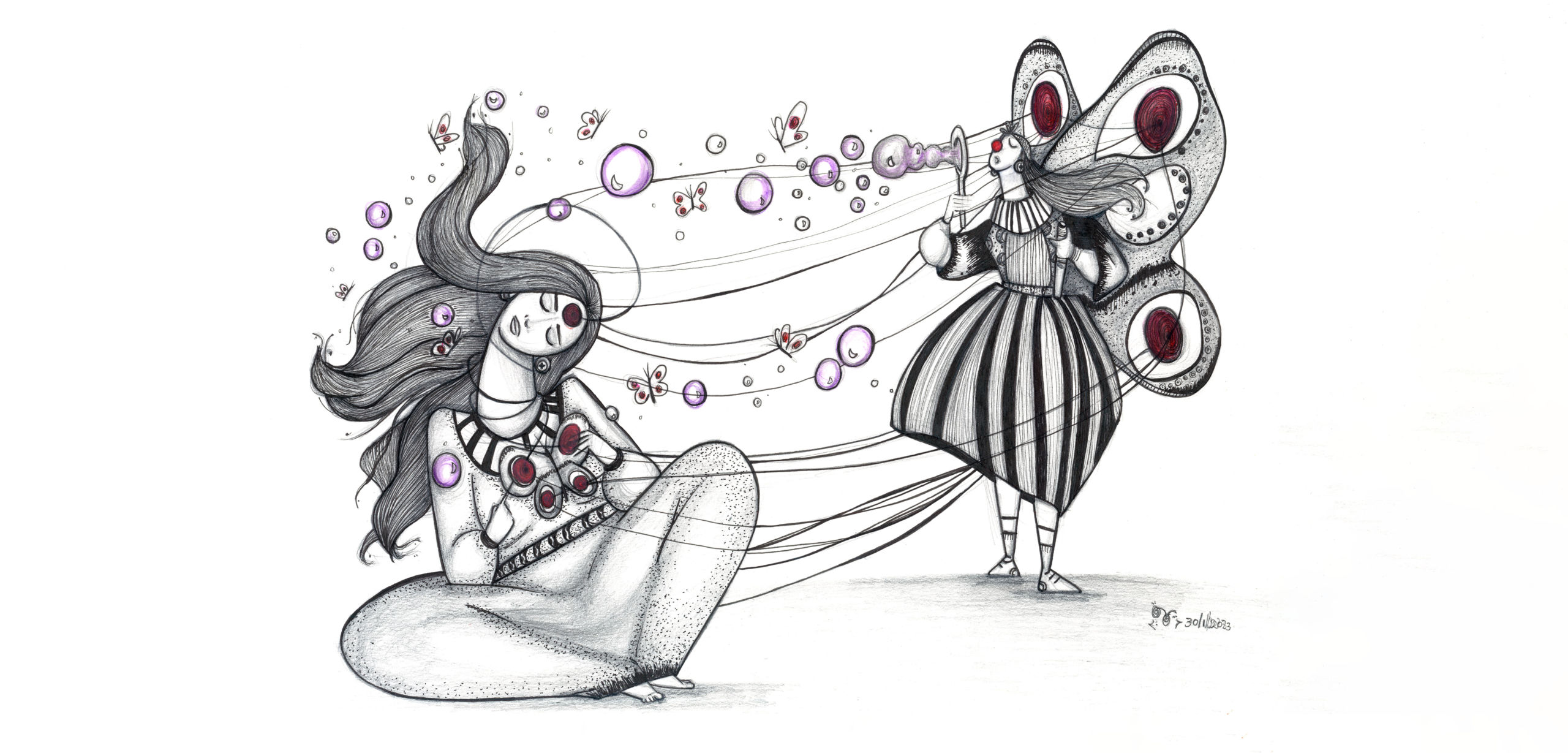سأل ابن أخي والديه عن مهنتي، فأجاباه: طبيب نفسي، وعندما عاد فسأل، كما هو متوقع منه آنذاك كطفل في الخامسة، عمّا يفعله الطبيب النفسي، أجاباه: هو الطبيب الذي يذهب الواحد إليه إن كان حزيناً جداً، أو سعيداً جداً! فهل نحن كذلك، الأطباء النفسيين، قوم لا يهنأ لهم عيش إن اختبر الآخرون تخوم الألم أو البهجة؟ عسس ساهر على إبقاء أمزجة الناس غير بعيدة عن المتوسط الحسابي؟
لم أجد حتى الآن شرحاً مبسطاً لمهنة الطبيب النفسي يكون في متناول طفل في الخامسة أفضل مما قدمه أخي وزوجته. فأحوال المزاج أقرب لفهم الأطفال من الخبرات النفسية الأخرى التي يدخل علاج ما قد يصيبها من اضطرابات في دائرة اختصاص الطب النفسي. فأن تكون حزيناً جداً لدرجة المرض، أمر يتخيله الطفل، فيمكن له أن يتصور كيف أن الحزن، الخبرة غير السارة التي يعرفها بشكل مخفف على الأقل عندما لا تتحقق أمنياته مثلاً، قد يزداد تفاقماً حتى يبلغ حداً لا يمكن احتماله، فيذهب الشخص إلى الطبيب.
بالمقابل سيصعب عليه، وربما حتى على الكبير، تخيلُ عوالم أمراض واضطرابات أخرى كالفصام أو الوسواس القهري أو اضطرابات الشخصية. فالحزن عاطفة عامة ومرجعية للإنسان، يبدأ عادة باختبارها في المراحل العمرية التي تسبق اكتساب اللغة. ولكن السعادة أيضاً كذلك، فإذا كان من المتيسر تخيل الحزن بوصفه مرضاً، فهل يمكن تخيل السعادة بوصفها كذلك؟ هل يمكن للطفل مثلاً أن يتصور أن فرحه باللعب والمآكل الطيبة إن تزايد قد يبلغ حدود المرض كما عندما تتراكم التعاسة؟
لا أعتقد أن هذه التجربة الذهنية متاحة للأطفال دون تدخل من الأهل والمربين. فدون مفاهيم مزروعة من نوع „كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده„ أو تذكرة بعقابيل قد تترتب على الإفراط في أكل الحلويات أو في اللعب على حساب النوم، يبقى الميل إلى الازدياد أقرب إلى الفطرة. ودون تفكّر بالعواقب ليس متاحاً للصغار ولا الكبار أن يتصوروا ذاتياً كيف يمكن أن تقودنا المتعة إلى الطبيب. فما دامت الخبرة تعاش من الداخل، بنوعيتها المرغوبة الصافية، بلا تفكير بما يمكن أن يطرأ عليها من خارج، لمَ يذهب الإنسان إلى الطبيب ليشكو من فرط سعادته؟
كأنما السعادة شأن أبعد مما يرافقها عادة من نشاط عصبي ـ كيميائي، كأنها في جوهرها الفعلي شعور إنساني نوعي عميق، خبرة بشرية تجاوزية، لا يصحّ اختزالها بمكوناتها المادية. أو أن السعادة لا تحتمل الذرائعية، أنها كغاية لا تبرر الوسيلة، وكأن كلاماً قد يستسهل اللسان الخوض فيه من قبيل: „السعادة شأن نسبي” إن صحّ، فصحّته نسبية!
لا يصح تشخيص اضطراب المزاج ثنائي القطب ما لم تثبت الإصابة بنوبة من الاضطراب الهوسي أو تحت الهوسي في ماضي المريض أو حاضره. وتمتاز هذه النوب بالمزاج العالي (اختار له المعجم الطبي الموحد تسمية الشمق: شمق فلان، حسب المعجم الوسيط، أي مرح مرحاً حدّ الجنون) وبزيادة النشاط، وبأحاسيس بالعافية والكفاءة الجسمية والنفسية، وبالروح الاجتماعية الزائدة، وانخفاض الحاجة للنوم.
وفي الحالات الأشد التي تستوفي تشخيص الهوس (أي ليس „تحت الهوس” فحسب)، قد تصل حالة الجذل والخلو من الهم إلى ثوران وازدياد في الطاقة متجاوز للمألوف، إضافة إلى اختفاء المحاذير الاجتماعية المعتادة، ما قد يؤدي إلى إسراف في العلاقات العاطفية والجنسية بما لا يوافق طباع الشخص نفسه خارج النوبة، وإلى الإقدام على مشاريع قد توصف بالتهور الشديد، وإنفاق المال بغير حساب، والتورط بمشتريات بلا رصيد مصرفي يغطيها. يترافق ذلك عادة مع تقدير متضخم للذات وأفكار عظمة مفرطة في التفاؤل.
فإذا تجاوزنا قليلاً الغربة التي قد يستحضرها استخدام الطب النفسي الدقيق لمصطلح الهوس (المفردة قد تشير إلى معاني أخرى في استخدامها اليومي واللغوي) أو مفردة الشمق (الخارجة من بطون المعاجم)، وحاولنا تقمص عالم نوبة الهوس من داخل المصاب بها: سنجده شخصاً سعيداً جداً، متفجّر الانفعالات، مقبلاً على مباهج الحياة، مجسّداً لبيت الخيام: „فما أطال النوم عمراً ولا قصّر في الأعمار طول السهر”، جذلان، يتحدث ليل نهار متلاعباً بالألفاظ ناثراً النكات والدعابات، شاعراً بالهمة والسعادة وسموّ الشان، متخفّفاً من التقاليد والأعباء الاجتماعية، ثم إنه بحر في عطائه. فكيف لإنسان بهكذا حال أن يراجع الطبيب من تلقاء ذاته؟ وهو في الواقع قلّما يفعل، فيُدفع من قبل محيطه إلى العلاج دفعاً، ربما للامبالاةٍ مفرطة بالأعراف والحدود الاجتماعية، أو لتورطه بشيك بلا رصيد، أو لنوبات غضب انفجاري قد تصيبه بلا سبب واضح، وأحياناً عندما يتشكك أحد بصحة ادعاءاته العُظامية.
والمريض هنا لا يتعمّد أن يزوّر بشأن رصيده المصرفي، ولا يكذب أو يلفّق بشأن ما ينسبه لنفسه من عظمة، بل يشعر بحقيقة داخلية من الرفعة بمكان، تبدو معها الحقائق الخارجية متدنية الأهمية بل بالغة الوضاعة. وليس ذلك هو السبب الوحيد في تردّد المريض في مراجعة الطبيب النفسي.
كثيرٌ من المصابين بنوبة هوس أو تحت هوس خبروا قبلها نوباً اكتئابية طويلة، لتأتي بعدها أعراض الهوس كما لو كانت انفراجاً من آلام الاكتئاب الشديدة. ومع كل ذلك فإن المرضى ذوي الخبرة الذاتية الأكبر بالاضطراب ثنائي القطب، كثيراً ما يسارعون إلى أطبائهم، ما أن يلمحوا الأعراض المبكرة التي تنذر بنوبة هوس وشيكة، خاصة عندما تتأسس بينهم وبين أطبائهم علاقة علاجية ينال فيها الطبيب ثقة المريض بمقابل ما يقدّمه من فهم وجدية واحترام.
يعرف أولئك المرضى وعود المشاعر الإيجابية التي تحملها لهم نوبة هوسية محتملة، ولكنهم يعرفون أيضاً بخبرتهم السابقة مع الاضطراب ذي القطبين، أن الولوج في الخبرة „المرغوبة” قد يترتب عليه الانغماس بمسالك بالغة التطرّف، يمكنها أن تودي إلى عواقب في المحيط الاجتماعي والمهني كان الشخص بغنى عنها، وخاصة إن عانى المريض في طور اكتئابي سابق مشاعر الذنب والعار والميل إلى تضخيم صغائر الأمور (التأرجح بين قطبي المزاج هو مفتاح تسمية الاضطراب بثنائي القطب).
فقد يطلب الإنسان إذاً المساعدة الطبية لتجنب اختبار حالة مرغوبة لما قد يترتب عنها من عواقب غير مرغوبة. فيتجنب الإنسان السعادة المفرطة، لأنها قد تودي للتعاسة…
فما السعادة؟ وهل السعادة شيء آخر غير تواتر وتكرار اختبار الشعور الصافي بها؟ بالسعادة؟
سأنتقل إلى مثال آخر من دوائر الطب النفسي السريري، إلى ما يسمى بسوء استخدام المواد ذات التأثير النفسي (كالكحول والمخدرات) والاعتماد عليها (الاعتماد هو المصطلح المعتمد من المعجم الطبي الموحد لما يُعرف بالإدمان).
إذا وضعنا جانباً ما يكثر الحديث عنه من مساوئ هذا المسلك البشري، لنرصد فضائله التي من المتوقع أن تكون مغرية بشكل كاف لتجميل الانزلاق إلى سوء الاستعمال والاعتماد على الرغم من التحذيرات الطبية والنفسية ـ الاجتماعية، سنجد أن لاستخدام معظم المواد المخدرة بالإضافة إلى الفوائد „السلبية” التي تتجلى بتجنب الألم النفسي والجسدي أحياناً (أصفها بالسلبية لأن تجنب الألم ليس خبرة شعورية مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو تجنب خبرة غير مرغوبة) فوائد إيجابية من اختبار مشاعر ومتع مرغوبة بذاتها: مشاعر الرضا، والسرور، والانبساط، والاكتفاء، والامتلاء، والتمكّن، والقدرة على التواصل، وصولاً إلى النشوة العارمة، والشعور بالتقييم المرتفع للذات، وربما بالعظمة والتمتع بقدرات فائقة.
من غير الممكن دوماً التمييز بين هذه الخواص الإيجابية والسلبية بشكل حاسم ونهائي، فلا يمكن إيجاد الخط الفاصل بين الانبساط وانحسار القلق مثلاً (يزداد الأمر تعقيداً عندما تنشأ متلازمة الاعتماد على المواد، فتختلط الظواهر غير المرغوبة، كالقلق مثلاً، بالأعراض الانسحابية).
طبياً تُستخدم هذه المواد لخواصّها السلبية على الأغلب، بهدف تخليص المريض من علة مشخّصة (كاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو الألم غير المستجيب على مضادات الألم غير المورفينية) أو للتخفيف منها ومن عواقبها. لكننا بدأنا نلمح في الاستخدام الطبي المستجد لمواد مصنفة كمخدرات ومهلسّات في علاج الاكتئاب المعنّد على العلاجات الدوائية الأخرى شبهة استهداف للخاصية الإيجابية لهذه المواد أيضاً، فمع أن الآلية المضادة للإكتئاب التي جرى رصد أثرها عند الاستخدام الطبي المضبوط لعقاقير من مثل الإسكيتامين والـ LSD ما تزال غير معروفة، فليس مستبعداً أن تكون خبرة النشوة أو حتى الخبرة الإهلاسية إحدى مكوّنات هذه الآلية المجهولة. مع ذلك لا بدّ من التشخيص الطبي المتمحّص للاكتئاب غير المستجيب على الأدوية الأخرى كشرط أساسي لاستخدام هذه المواد حتى وإن ثبت أن خواصها الإيجابية مقصودة بذاتها.
هل يمكن لنا أن نقارن سعادة نيلسون مانديلا أو مهاتما غاندي بسعادة ديكتاتور يقصف الأحياء الشعبية بالسلاح الكيميائي؟ هل يمكن مقارنة عاشقين سعيدين بالحب المتبادل بينهما، بسعادة من أرغم امرأة لا تحبه على الزواج منه؟ هل كل ذلك سعادة؟
هنا يطرح السؤال نفسه: إلى أي مدى تجلب هذه المواد السعادة لمن يطلبها في غياب الاكتئاب السريري؟
ما من استخدام طبي „إيجابي” خالص لهذه المواد، فليس من أغراض الطب تقصّد المتعة والسعادة. لكن لا يخفى أن استخدام „المواد ذات التأثير النفسي” من غير وصفة أو استطباب أكثر انتشاراً من العكس. وكثيراً ما يحتك الممارس النفسي بأشخاص معتمدين أو معتادين على هذه المواد، يراجعون أحياناً بغرض التحرر من استخدامها، و إلا فلأسباب أخرى قد تكون بلا علاقة مباشرة به.
لكنني لا أذكر شخصاً واحداً من المعتمدين على „المواد ذات التأثير النفسي„ ممن يقضون معظم أوقاتهم بمشابك عصبية تغمرها مقلّدات أو حاثات النواقل العصبية الطبيعية للسعادة (من مثل السيروتونين، والدوبامين، والأوكسيتوسين، والإندروفين) قد وصف خبرته هذه بالسعيدة! فرغم أن المقياس العصبي ـالكيميائي لديهم راجح كمياً نحو مدد زمنية أطول تغمرها المشاعر الإيجابية، فلا يبدو أن هذا المقياس الحسابي البسيط يشكل مرجعاً لفهم السعادة.
لكأن السعادة مختلفة عن التواتر العالي لاختبار حالة الحبور أو الابتهاج.
كأنما السعادة شأن أبعد مما يرافقها عادة من نشاط عصبي ـ كيميائي، كأنها في جوهرها الفعلي شعور إنساني نوعي عميق، خبرة بشرية تجاوزية، لا يصحّ اختزالها بمكوناتها المادية. أو أن السعادة لا تحتمل الذرائعية، أنها كغاية لا تبرر الوسيلة، وكأن كلاماً قد يستسهل اللسان الخوض فيه من قبيل: „السعادة شأن نسبي” إن صحّ، فصحّته نسبية!
فهل يمكن لنا أن نقارن سعادة نيلسون مانديلا أو مهاتما غاندي بإنجازيهما الإنسانيين، بسعادة ديكتاتور تمكّن من السيطرة على تمرّد شعبه بعد قصفه للأحياء الشعبية بالطائرات وقضائه على من تبقى منهم بالسلاح الكيميائي؟ هل يمكن مقارنة عاشقين سعيدين بالحب المتبادل بينهما، بسعادة من استطاع بسلطته المالية والاجتماعية إرغام امرأة لا تحبه على الزواج منه؟ هل كل ذلك سعادة؟
وماذا بشأن سعادة من حقق بدأب مستمر هدفاً لا يتمناه لنفسه واقع الأمر، إنما ورّط نفسه بالسعي إليه انسجاماً مع المقبول اجتماعياً؟ أخبرني صديق في كلية الطب أنه عندما نجح بتفوّق في الثانوية العامة لم يشعر بأي مقدار من السعادة، كون الخطوة التالية المتوقعة منه في محيطه هي دراسة الطب التي لم يكن يرغب بها.
كأن السعادة تتطلب انسجاماً وتناغماً وتصالحاً تحقّقهم „الأنا” بين الهيئتين النفسيتين الفرويديتين الأخريين „الهو” و”الأنا الأعلى”. فلا تتحقّق السعادة بالإشباع الأعمى لدوافع „الهو” الشهوية كحال من يتزوج امرأة ضد رغبتها وإرادتها، ولا بإطلاق العنان لشهوة الدمار كحال الطاغية المنتصر على شعبه، ولا يكفي تحقيق مُثل „الأنا الأعلى” كحال صاحبي القديم الذي حقّق ما يُتوقع منه على حساب ما يرغب.
وفوق هذا وذاك، لا يبدو أن الاحتيال على دارات السعادة عبر حرف مساراتها بالمواد يعطي مشاعر سعادة يعوّل عليها.
حتى من يعالجون بشكل ناجح بمضادات الاكتئاب الدوائية نادراً ما نسمع أنهم يشعرون بالسعادة، بل الأغلب هو الشعور بالعافية وتراجع مشاعر الاكتئاب. وليس نادراً أن يصرّح مرضى معالجون دوائياً دون علاج نفسي مواز، باستمرار وجود „الاكتئاب” ولكن مضبّباً عليه ومحجوباً عنهم بواسطة حالة سواء مزاجي يحقّقها الدواء.
لكأن الاكتئاب يتجاوز الشعور بالاكتئاب، كأنه أكثر من النشاط العصبي ـ الكيميائي الذي يرافقه عادة، والذي يُنتظر من العلاج الدوائي أن يعدّله. كأنما الاكتئاب كمثل السعادة: شعور إنساني نوعي عميق، وخبرة بشرية تجاوزية، لا يصح اخترالها بمكوناتها المادية.