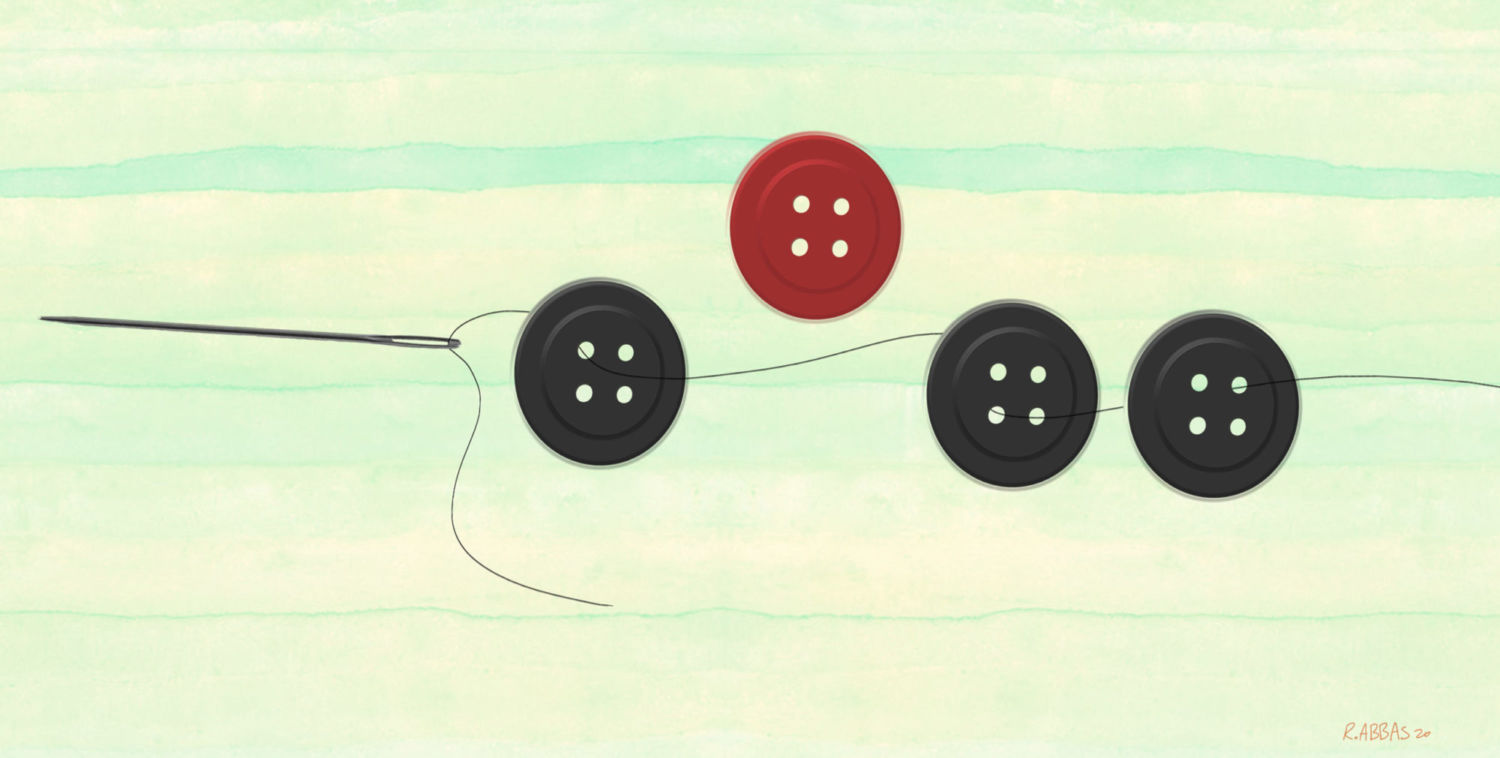عندما كانت عناصر فرقة أمن الدولة تحاصر منزلنا في أطراف الصحراء استعداداً لاعتقالي سنة2007، كانت أمي تعد لي كومة ملابس تحشوها على عجل في جوف حقيبة رياضية سوداء، جواربَ صوفية وسراويل داخلية وبدلة رياضية ودعوات وبكاءً ذا نشيج.
عجّل سقوط آخر فرد في الخلية الطلابية التي زعمت الأجهزة الأمنية أني أنتمي إليها باعتقالي، ولم يعد الهروب يجدي نفعاً، فقد أضحت البلاد خلال الأعوام الأخيرة من حكم زين العابدين بن علي أشبه بالقفص.
اختفت الحقيبة الرياضية ما أن وصلنا مقر وزارة الداخلية، لأمضي ثلاثة أسابيع كاملة، هي كل فترة التحقيق، أكابد برداً مقيتاً، أمني النفس بعودتها، فقد أصبحت أرى فيها وجه أمي. هكذا، ومنذ أول أيام الاعتقال تغيرت علاقتي بالملابس ونظرتي إليها، كما تغيرت نظرتي نحو العالم.
يأتي الصفع من كل الجهات على أبواب مقرّ أمن الدولة. يتداول الضباط المناوبون ليلاً على المعتقل الجديد بالضرب والشتائم، في إستقبال مثير، لا ينتهي إلا أمام شباك مكتب الودائع والأمانات، عندما يسلم السجين ما عنده من أوراق وأموال أو مقتنيات شخصية ثم يوضع في زنزانة لا يعرف إليها الضوء سبيلاً، لا يخرج منها إلا لجلسات التحقيق الأمني.
جنة السجن
الفرق بين فترة التحقيق في مقرات الداخلية أو الفرق الأمنية وفترة التوقيف أو قضاء المحكومية في السجن كالفرق بين الجنة والجحيم. خلال فترة التحقيق يُمنع المعتقل من كل شي تقريباً، بإستثناء بعض الطعام وقضاء الحاجة. وقد رأيت معتقلين يتسلون بعدّ الثقوب الموزعة على ثيابهم البالية. أما في السجن فالقيود مخففة قليلاً، يمارس السجين نوعاً من الحياة اليومية تدور حول فكرة واحدة: كيف يمكن أن يخرج حياً من هذا المكان؟
يأتي السجين من أسابيع التحقيق القاسية وجسمه أقرب إلى كتلة متعفنة منه إلى جسم إنسان، فيستقبل في غرفة التفتيش، ويجبر على التجرد من كافة ملابسه أمام أنظار بقية السجناء، ليبقى عارياً تماماً تعبث به أيادي الحراس المكلفين بالتفتيش الدقيق.
كنت أحاول أن أواري سوأتي بيدي، لم أكن أفكر في الحرية ساعتها. كانت أقصى أماني الشاب العشريني الذي كنته أن يجد سروالاً داخلياً. هنا بدأت فكرة الوعي بقيمة الأشياء، بقيمة السروال الداخلي قبل أي شيء آخر.
لاحقاً يتم توزيع السجناء الجدد على المهاجع حسب السن ونوع القضية، وتبدأ رحلة تدبر ملابس وقتية، حيث لا تمنح إدارة السجن أي نوع من الملابس للسجناء ويضطر الوافدون الجدد لانتظار زيارة العائلة، التي يمكن أن تتأخر بسبب طول الإجراءات الإدارية.
خلال هذه الفترة الإنتقالية ينسج السجين علاقات اجتماعية في سجنه الجديد ويجود السجناء القدامى ببعض ملابسهم. فيما يجد المعتقلون السياسيون ضالتهم في رفاقهم أو إخوانهم، كلً بحسب توجهاته الإيدلوجية، حيث يكون حظهم أفضل بكثير من الحظوظ العاثرة لسجناء الحق العام.
في العام 2008، وبينما كنت أغادر السجن، اندلعت انتفاضة الحوض المنجمي (في مدينة قفصة 364 كلم جنوب غرب البلاد). العمال والفقراء والعاطلون خرجوا جميعاً ضد البطالة والفقر والتلوث والأمراض التي خلفتها مناجم الفوسفات في المنطقة، ووجهوا بالرصاص والاعتقال.
“كانت عبارة عن تيشرت وشورت”، يتذكر عبيد الخليفي، الأستاذ الجامعي، وأحد معتقلي الانتفاضة كيف دخل السجن بملابس الإيقاف والتحقيق مضيفاً:
“ناولني أحد الرفاق زياً رياضياً، كانت بدلة مؤقتة ريثما أغسل ملابسي تلك، وبقيت بلا ملابس داخلية يوم وليلة، وبعد يوم جاءت الزيارة محملة بكميات محترمة من الملابس الداخلية، وبعض من قمصاني وسراويلي.”
حركة الملابس
السجن مكانٌ للجمود، أو هكذا يبدو. لكن ذلك السكون الظاهر يخفي وراءه حركة دؤوبة لا تتوقف، ومنطق مقلوب، يتسع فيه الوقت ويضيق المكان.
يمضي السجن بصاحبه إلى لا نهائية عجيبة، يتحول معها الزمن إلى كتلة غير معروفة الأبعاد، مدورة بشكل محدب، مزعج في تقوسه، إذ يُخيل إليك إنه أقرب إلى حبة الطماطم منه إلى شكل الأرض الكروي، لتتبدل تالياً نظرتنا نحو الأشياء.
لطالما اختبرت ذلك في مختلف المهاجع التي أقمت فيها خلال فترة الاعتقال. ملابسنا التي كنا لا نهتم كثيرا بها كانت في حركة متواصلة، تتأرجح بين السجن والحرية.
كانت الزيارة الأسبوعية تمثل المحور الذي تدور حوله حياة السجين، والمحور الذي تطوف حوله حركة الملابس داخل السجن. يدخل الحارس خطوات قليلة مجتازاً البوابة الحديدية الزرقاء معلناً عن موعد الزيارة فتدب الحركة في المهجع.
يتحول كل ذلك السكون إلى ضجيج. تنقشع سحابة دخان السجائر. يرتدي السجناء أحسن ما عندهم من الثياب لمقابلة العائلة ويحثون الخطى كالأطفال نحو باحة مسقوفة حاملين سلال ملابس متسخة وما إن تنتهي الزيارة حتى تعود السلال مليئة بملابس أخرى نظيفة وطعام طري.
تتكرر الحركة الروتينية أسبوعياً. ملابس تأتي وأخرى تذهب، وربما تعود بعد أسابيع. لا يملك السجين الكثير من الخيارات. يعود طفلاً تشتري له أمه الثياب ويلبسها راضياً.
الزيارة لم تكن فرصة لتبديل الملابس فقط، بل تشكل فرصة لتهريب الرسائل بين ثنايا الثياب، حيث لا يخلو الأمر في بعض الأحيان من بضع دنانير يدسها الزائر في جيب أحد الحراس، حتى يغض الطرف عن ذلك. فنظام المراسلة داخل السجون التونسية يفرض على السجين تقديم رسالته مفتوحة قبل إرسالها كي تخضع للرقابة الإدارية.
تشكل الثياب خيط الوصل المادي الوحيد بين السجين وعائلته في الخارج. فلم يكن ترف مغادرة السجن والعودة إليه ثم مغادرته مرة أخرى متاحاً سوى للملابس، حيث أصبحت تشكل صورة السجين لدى أهله وتعبر عن حاله، بما كانت تحمله من بقاياه.
لا أنسى أبدا كيف اكتشفت أمي العقوبة التي تعرضت لها وتوّجها أحد الحراس بكثير من العنف، من خلال بقع الدماء العالقة بقميصي، وعندما همّت بسؤالي خلال الزيارة نهرها الحارس الواقف غير بعيد.
الملابس تحمل أنفاسنا وعرقنا وروائحنا وتكشف حالنا وتحمل معها كثيراً من القمل والبقّ، كاشفة حال السجون في ذلك الوقت.
رغبة في التعرّي
حركة الملابس في السجن لا تقتصر على حركتها من داخله نحو الخارج أو العكس، بل لها حركة أخرى في الزمن تدور بدوران الفصول والمناخات، في المهاجع المكتظة والرطبة، في جحيم الصيف وزمهرير الشتاء.
في الصيف تختفي تماماً الملابس الرياضية والجوارب ويتخفف السجناء من الثياب، حتى أن كثيراً منهم يطوف في الغرفة بجزء علوي عارٍ. لكن الوضع في الشتاء يكون أكثر قسوةً، خاصة في السجون المنسيّة في أقاصي البلاد.
يرى عبيد الخليفي الذي اعتقل عام 2008 أن “ملابس الحرية” لم تكن تصلح لداخل السجن، فلم يكن في حاجة إلى ملابس شتوية، لأن الغرفة ساخنة جراء الاكتظاظ، فغرفة الثلاثين بها ثمانين مسجوناً، أنفاس المساجين وغبار التبغ الرديء، تجعل هواء غرفة السجن ملوثاً دافئاً يثير الاشمئزاز.
هذا الحال لم يتغير كثيراً حتى بعد رحيل نظام بن علي، إذ يشير تقرير وضعته المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في مارس 2014 إلى أن السجون التونسية أضحت “تُشغل بما يتجاوز 150% من طاقة الإيواء، واضطر المساجين المودعون بها إلى أن يناموا على الأرض وحذو المراحيض وإلى أن يتقاسم كل ثلاثة منهم سريراً واحداً”.
يقول عبيد كاتماً ضحكة بدت على محياه: “لم أعد أطيق ملابسي التي كانت تعلق بها رائحة السجائر والهواء الفاسد وغاز الضراط، فكنت أغيرها بكثرة، وأحياناً لا أكترث لتغييرها مستسلماً للمزبلة التي أعيش فيها… وغالباً ما أشعر بضيق الملابس وتنتابني رغبة مستحيلة… رغبة التعري والتخلص من كل ملابسي”.
كما هو الحال مع صديقي عبيد كان الشتاء داخل السجن يمثل هاجساً مخيفاً بالنسبة إليّ. أرتدي من كل نوع من الملابس زوجين. وآخر وصيتي لأمي خلال الزيارة السراويل القطنية البيضاء، التي كنا نسميها سروال عزت العلايلي، لأن الممثل المصري كان يرتديه تحت الجلابية الواسعة عندما لعب دور سلامة في مسلسل الأرض الطيبة.
فكان يضع طرف جلابيته في فمه راكضاً بين حقول القطن أو على شاطئ الترعة المتخمة بالزبد والوحّل، والجاموسة الضخمة تٌدير بطرف ذيلها في حقل الرؤية، فيظهر سروال أبيض خفيف القماش ملتصق بسيقانه ووركيه.
من سروال إلى شورت
لا يخفي صديقي عبيد الخليفي حنينه الجارف لـ”هركة” (جلابية) السجن الواسعة والممنوعة، فقد كان سجناء التيار السلفي يخفونها لأوقات الصلاة، لكنه اجتهد في الحصول على واحدة من عند صديقه عامر.
”كانت سعادتي بتلك الهركة كبيرة، لأنها خلصتني من أعباء تغيير ملابسي بين الحين والحين للخروج للعدّ اليومي، واجتهد رئيس أعوان السجن في منعي من الخروج بها لكنه تحاشى المشاكل معي وغض الطرف”.
منع ارتداء الجلابية كان واحداً فقط من قائمة ممنوعات طويلة لدى أنظمة السجن الصارمة، فالمرآة والمقصّ وكل مادة صنعت من حديد أو بلور ممنوعة، كما تمنع خيوط الأحذية وأحزمة الجلد خوفاً من استعمالها في محاولات الانتحار العديدة. وهو ما جعل من السجن مكاناً يتعلم السجين داخله تدبير الندرة، فلا يعدم الوسيلة لتجاوز العقبات، من باب أن الحاجة أم الاختراع، وأن عليه التعامل مع الواقع كما هو.
كانت مهاجع سجن المرناقية (غرب العاصمة) تتحول عند الحاجة إلى وِرش، تثمن كل البقايا لتعيد فيها الحياة مرة أخرى في أشكال جديدة يتكئ السجناء خلالها على قوة الخيال. الخيال الذي يجب أن يكون لك منه نصيب وافر كي تستطيع مقاومة فكرة الحبس، والذي سيجعلك طيلة فترة الاعتقال حراً، تجوب الشوارع، وتنام في العراء وتجالس الناس وتمشي في الأسواق.
وبينما تسرح في خيالك، يصنع سجناء من نوى التمر والزيتون السُبح والقلائد، ومن ورق الكرتون لعبة الدومينو تزجيةً للوقت، وكانت السراويل تتحول إلى شورتات. وبغياب المقص، يمزّق بعض السجناء بأيديهم قطعة القماش بحرفية كبيرة، كما لو أنهم مقصّات.
في جناح العزلة
الملابس ذاتها قد تتحول إلى أداة تعذيب جسدي، وحتى إلى وسيلة للقتل داخل السجن.
من بين العقوبات الشائعة داخل السجون التونسية هي الحبس في جناح العزلة، وعادة ما يكون غرفة صغيرة رطبة شديدة القذارة، يُجرد السجين قبل أن يدخلها من جميع ثيابه ثم تقدم له بدلة زرقاء متعفنة كثيرة الثقوب كي يرتديها طيلة فترة عقوبته، توضع في الماء قبل فترة حتى تصبح رائحتها كريهة ومليئة بالحشرات، وخاصة البقّ، العدو التاريخي لكل سجين.
كان في هذا تعارض مع المادة العشرين من نظام السجون في تونس التي تؤكد أن العقوبة تكون “بالإيداع بغرفة انفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام”، فضلا عن تعارضه مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وردت في مخرجات اتفاقات جنيف عام 1955 وصادقت عليها تونس في وقت مبكر، والتي ورد فيها أن “كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطّة بالكرامة”.
“كنا حفاة الأقدام، نرتدي ثيابا رثة، نتسلى بعدّ الثقوب في ملابسنا أو القملات التي نقلتها”. هكذا يصف المعتقل السياسي السابق عبد القادر بن يشرط حال الملابس التي أمضى بها فترة الإعتقال في نفقٍ عمقه 32 درجة تحت الأرض، كان مخصصاً لتهريب السلاح في الحرب العالمية الثانية، وكيف كان ورفاقه يتقاذفون القمل العالق بها، حيث أمضى هؤلاء سنوات دون أن يغيروا ملابسهم.
اعتقل بن يشرط في أعقاب محاولة إنقلابية فاشلة في العام 1962، قامت بها مجموعة من العسكريين والمدنيين ضد الرئيس الحبيب بورقيبة. غير أن شهادته تكشف بوضوح أن لا شيء قد تغير منذ حوالي النصف قرن.
لكن الملابس لا تتوقف عن أن تكون مجرد أداة يستعملها السجان لتعذيب السجين أو لمعاقبته، بل يمكن أن تتحول إلى أداة لتحرر السجين من الحياة، عندما يمضي يائساً في خيار “بيدي لا بيد عمرو” مفضلاً الانتحار. وفي غياب أي أداة يمكن استعمالها كالحبال أو السكاكين أو غيرها داخل السجون، يعمد بعض السجناء للانتحار شنقاً معتمدين على قمصانهم أو سراويلهم.
غير أن الملابس قد تتحول إلى أداة تضليل، أو إيهام بالانتحار، عندما تتكئ عليها السلطة لتبرير مقتل سجين أو موقوف. ففي ديسمبر 2017 وبينما كانت السلطات التونسية تحتفل بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان لطفي العرفاوي يسلم الروح في زنزانة قذرة داخل أحد مراكز الحرس الوطني بولاية سليانة (132 كلم جنوب غرب تونس).
وجهه أزرق وبدنه خارطة من الكدمات والدماء. كان يتوسل لجلاده بأن يتوقف، إلا أن الجلاد كان في عالم آخر، يتلذذ ضاحكاً بركله دون أن يرف له جفن. فيما يقف رئيس المركز غير بعيد يفرك يديه ويشارك من حين إلى آخر في حفلة التعذيب.
فجأة نزلت السكينة على المكان. صعدت روح لطفي نحو المطلق وغرقت إدارة السجن في تدبير حيلة التخلص من وزر الجثة، ليتفتق ذهن أحدهم عن رواية “لا تخر المية”. وما هي إلا ساعات حتى خرجت وزارة الداخلية إلى الرأي العام ببيان مقتضب قالت فيه: “إن الضحية قد أقدم على الانتحار بواسطة خيط معطفه”.
لم يبق لأهل لطفي وأصحابه إلا الخروج إلى الشوارع وإشعال البلدة وقطع الطريق للمطالبة بالحقيقة وإعادة التشريح الطبي. لاحقاً وبعد التحقيق القضائي والشهود الذين قالوا إنهم كانوا يستمعون للضحية يستغيث، قرر القاضي أخيراً إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مركز الحرس وثلاثة أعوان آخرين بتهمة العنف الناجم عنه الموت. وكاد “خيط معطفه” البريء أن يخفي وقائع موته المأساوي.
في المقابل يتمتع المحكومون بالإعدام بنوع من التبجيل بخصوص الملابس. فكل سجين يصدر في حقه حكم بالإعدام يوضع في جناح خاص بشكل منفرد، معزول تماماً عن البقية، ويجرد من ثيابه العادية وتقدم له بدلة زرقاء نظيفة، يمضي فيها ما تبقى من حياته ويعامل معاملة فيها الكثير من التهذيب، تبدو بدافع الشفقة وليس من باب احترام ذوات البشر.
هل كان ضرورياً أن تفقدها؟
كيف لي أن أصف علاقتي بالملابس داخل السجن بعد أن غادرته منذ أكثر من عشر سنوات؟ تبدو لي الصورة مكللة بالضباب والغبش. لكن الصورة لدى عبيد الخليفي مازالت شديدة الوضوح. فقد وجد في معتقل رجيم معتوق (650 كلم جنوب تونس) أن هركته (جلابيته) متناسقة مع الرمال الصحراوية.
فخوراً يصف أيامه الأخيرة في المعتقل: “كنت أخرج بها إلى ساحة التريض كي أغرس ركبتي في الرمل الكثيب.. وأسرح بخيالي بعيداً عن السجن كما لو كنت بدوياً في عمق الصحراء.”
سيارة السجن، أشبه بصندوق حديدي، أقرب لصناديق السيرك التي توضع فيها الحيوانات خلال تنقل السيرك من بلدة إلى أخرى. تأتي باكراً إلى السجن. قبل الشروق في كثير من الأحيان.
أما المساجين فيتجمعون من الخامسة صباحاً في قاعة فسيحة في انتظار نقلهم إلى المحكمة. يلبسون أحسن ما عندهم، حتى أن البعض من نزلاء مهجع رجال الأعمال والشخصيات الرفيعة، يبدو أكثر أناقة من القاضي نفسه.
تذهب جهود الأناقة هدراً بمجرد الصعود إلى ظهر الشاحنة الصغيرة. نساق كالخراف داخلها، إذ تحمل ثلاثة أضعاف طاقتها، حتى إذا تحركت سمعت لها أنيناً وطنيناً يبعث على الخشية من أن كل جزء من أجزائها المتهالكة سيمضي في حال سبيله في جهات الطريق الأربع.
ملابسنا الرثة كانت ملتصقة بأجسادنا النحيلة من أثر العرق، أما الرائحة المنبعثة في المكان فكانت أقل ما يقال فيها أنها قذرة. ومن يريد به الله خيراً يحشره مع المجموعة التي وضعت في مقدمة الشاحنة وحَسنُ أولئك رفيقاً، حيث تكون عينه في مقابلة الفوهة المنسية في بابها الخلفي.
يسترق النظر من خلالها ليشاهد العالم الكبير حيث الناس يُعرفون بأسمائهم وليس بأرقام تضعها إدارة السجن. يرتدون أحذية مُحكمة بالخيوط وأحزمة من جلد وسراويل جينز. عندما تصل الشاحنة وجهتها التي تريد. يجتاحك شعور غامر بالذنب. وتسأل نفسك لماذا لم تكن تدرك قيمة كل هذه الأمور البسيطة؟
خيوط الحذاء، حزام الجلد، سروال الجينز. هل كان ضروريا أن تفقدها كي تشعر بقيمتها؟
بعيداً في مجاهل الصحراء، كان صديقي عبيد قد منع نفسه عن ارتداء بدلته الرياضية التي أحضرتها له أخته في آخر زيارة إلى سجن قبلي، متعلقاً بآمال الخروج فقد قالت له قبل أن تغادر: “لا تلبسها في السجن، فقد رأيت خروجك مناما خلال سبعة أيام”.
عبيد العقلاني الصارم، الذي لا تستهويه الأحلام والرؤى، خان نفسه هذه المرة: “جاريتها في حلمها… فلبستها بعد سبعة أيام، ليلة خروجي من السجن”.