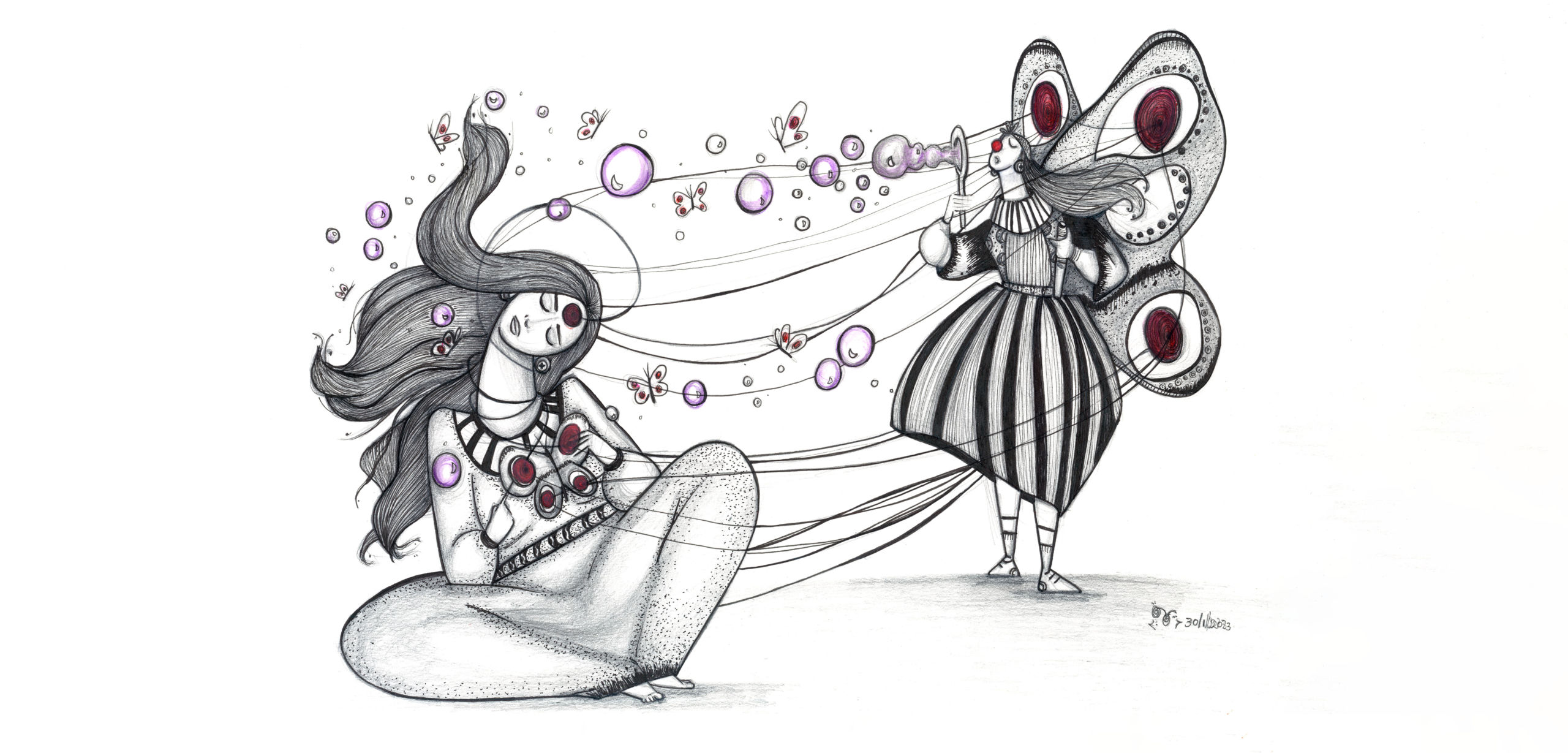أُصبت يوم “جمعة الغضب” بشظية في رأسي، أعلى الجبهة. شعرت بها كمجرد لسعة بسيطة. كانت مجرد طلقة رش. سأسميها اختصارًا “رشاية”. وضعت يدي على رأسي كمن لدغته ناموسة، لكني وجدت خطًا رفيعًا من الدماء ينسل، ثم لم يلبث أن توقف. سارعت الناس من حولي إلى طمأنتي. لم أكن خائفًا ولم أشعر بأي ألم. أتذكر أن رجلًا شطف رأسي بالمياه من زجاجة يحملها معه. لم يعد كل ما سبق يهمني. الأهم هو ما قاله لي مشجعًا: “معلش معلش.. علشان مصر”. أكدت على كلامه مؤمّنًا “طبعًا.. طبعًا”.
أحكي ذلك الموقف كي أقول ما يلي: لو أن أحدهم قال لي نفس الجملة قبل أسبوع من الثامن والعشرين من يناير عام 2011، لكنت سببته أو أهنته ساخرًا، وكذلك شتمت البلد وأهلها.
ما كان شعارًا أجوف أو كليشيه قبل الثورة، صار، في ذلك اليوم الاستثنائي، إيمانًا تامًا لا يشوبه الشك. إيمانًا لا يستكثر الدماء. توقف الدم في ساعتها لأن الجرح كان بسيطا. لكنني تعلمت شيئًا أساسيًا عن الثورة.
الثورة عودة إلى الإيمان، بالوطن وبالشعب، والأهم أنها عودة إلى الإيمان بـ”الذات”، إيمانًا لا يكتمل إلا بالمبالغة والشعارات، وكذلك الكليشيهات.
“الأفورة” ضرورة ثورية. تصدح حناجرنا في المظاهرات والمسيرات بالهتافات، نتوعد الظالمين، نُلخص مشاكلنا في كلمتين مسجوعتين. وبثقة، نأمل في غدٍ أفضل. تلك اللحظة كانت حقيقة. كانت نصرًا حين قبلت، برضا داخلي، كل ما يمكن أن يحدث يومها. وهذا النصر لا تقدر على محوه كل هزائم العالم.
“معلش.. علشان مصر”.. من شأن تلك الكلمات أن تثير الآن موجة عنيفة من السخرية والاستنكار، تماما كما كانت لتفعل في الأيام السابقة على ثورة يناير. كلمة “معلش” نفسها أصبحت موضوعًا للميمز. كلمة لا يمكن صرفها، لا تسمن ولا تُغني. تحولت كلمة “مصر” إلى “ماسر” في عُرف الكثيرين.
فقدت الكلمة دلالتها وأهميتها وزخمها الصوتي، وإيحاء نبرتها. ربما لأنها الكلمة نفسها تحولت إلى سبب ومبرر للقمع والاستبداد. وبذلك فإنها تقهقرت إلى عالم الشعارات الجوفاء. صارت بلا دلالة، أو في أحسن الأحوال، صارت دالة على ادعاء وكذب ناطقها.
هل يعني ذلك أن الإيمان القديم كان باطلًا؟
نلحظ دلائل بطلان فعل الإيمان ذاته في التعالي عليه بالسخرية والسينيكالية. لقد حولنا كل مايحدث حولنا إلى تريند أو إفيه. لكننا، في أغلب الأوقات، لا نوظف السخرية لنقض رصانة السلطة، قدر ما اتخذناها وسيلة مناعية ضد التورط والإيمان.
وبما أننا نتحدث الآن من موقعنا في أرض المجاز والتهويمات، فلا بد لنا من مساءلة “مجاز الإيمان” نفسه في الحديث عن الثورة. لأن “الغواية” يمكنها أيضًا أن تنطبق على فعل الثورة.
تُعرّف الغواية بأنها الضلالة والفساد والخيبة والهلاك. وفي الآية القرآنية، يُحكى عن إبليس قوله “ربي فبما أغويتني..” أي خيبتني وأهلكتني. فالغواية طريق إلى الهلاك. لذلك يفرق أهل التفسير بين “الغواية” و”الفتنة”. فـ”الفتنة” تحمل معنى الابتلاء والاختبار والامتحان. وليس من قبيل المفارقة أنها الكلمة التي يكثُر استخدامها في الخطاب الديني لوصف الانتفاضات والمظاهرات والحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب الناتجة عنها.
الآن، أتذكر كلمات أروى صالح (1951- 1997) الأيقونية عن “تجربة التمرد” وخصوصية المأساة عند جيلها، جيل الحركة الطلابية في السبعينيات. تقول صالح إنه سواء سار الواحد في “سكة السلامة، طريق التوبة والإذعان لقوة الأمر الواقع، وحتى إعلان الكفر بكل قيم التمرد القديم”، أو “طريق الندامة، الانهيار، اعتزال الحياة، المرض النفسي”، أي رغم اختلاف مآلات أبناء الجيل، فإن الفرد لا يعود “نفس الشخص” الذي كانه قبل أن “تبتليه غواية التمرد”، “لقد مسه سحر الحلم مرة وستبقى تلاحقه دومًا ذكرى الخطيئة الجميلة”.
هكذا تكلمت أروى صالح، ولا يطمح هذا النص أن يكون “دفاتر” عن جيل ثورة يناير، ولا أن يكون شهادة لأجل “الأجيال التالية”، بالمعنى الذي قدمته صالح في عملها الفريد “المبتسرون”.
إلا أن تأمل مفردات مثل “الغواية” و”الحلم” و”الخطيئة” يُظهر لنا “الثورة” كخطيئة، لكنها مناقضة لكل الخطايا، إذ يبقى الدافع إليها هو الإيمان لا “الضلال”.
كشفت أروى عن سمات شديدة الأهمية داخل ذوات مثقفي ومناضلي اليسار في زمنها. عن التعالي والتشاؤم والعدمية، عن الكيفية التي أصبح عليها الكلام عن أحلام الوطن مثيرًا للهزء، وعن الحكم على العالم من موقع “البرجوازي الصغير”.
ورغم التباين الشديد بين جيل ثورة ينايرـ جيل الألفية- وجيل السبعينيات، فإن “المبتسرون” يضيء لنا، كجيل تالٍ، الملامح المشتركة لأزمنة “الهزيمة”، تلك النهاية المنطقية لكل أحلام التمرد ومحاولات التغيير.
لكن “ذكرى” الثورة ما عادت تلاحقنا، أو بالأدق، لا تلاحقنا الآن، بعد مرور عشر سنوات، على غير إرادة منا. نبذل الآن جهدًا مضاعفًا من أجل استحضار “صورة” الثورة، حد أن سؤالًا مهمًا ينبغي أن نطرحه في البداية:
ذاكرة الثورة: هل حدثت الثورة بالفعل؟
يتحدث الكاتب وعالم الأعصاب الشهير أوليفر ساكس عن متلازمة “توقف الذاكرة الحاد”، ويعلق على حالة “البحّار جيمي” الذي توقف الزمن عنده مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 رغم مرور أكثر من ربع قرن. كان جيمي يقترب من عامه الخمسين، وهو يظن أنه في التاسعة عشر من عمره.
يتساءل ساكس: “هناك فراغ عظيم.. لا بد لنا من أن نملأ هذه السنوات “المفقودة” بالاستعلام من شقيقه أو البحرية أو المستشفيات التي دخل إليها.. أيكون قد احتمل صدمة هائلة في ذلك الوقت؟ هل كانت الحرب “نقطته العالية”، المرة الأخيرة التي كان حيًا فيها حقًا، واضمحل وجوده بعدها إلى لا شيء؟”.
يشير ساكس إلى كتاب “الحرب الجيدة”، وهو تأريخ شفهي مذهل سجله الكاتب ستادز تيركل، وحصل عنه على جائزة البوليتزر. يسرد تيركل روايات مباشرة من الذين عاشوا أو شاركوا في الحرب العالمية الثانية، بعد مقابلات أجراها معهم. شعر العديد من الرجال المقاتلين بالحرب “كحقيقة واقعة”، وبوصفها “الوقت الأكثر حقيقة وأهمية في حياتهم”. وكل شيء آخر منذ الحرب “ضعيف وتافه” بالمقارنة بها.
من شأن رجال كهؤلاء أن “يتأملوا الحرب” و”رفاق السلاح” وحقائقها الأخلاقية وشدتها. وهذا “التأمل في الماضي” يقابله نوع من “التبلد تجاه الحاضر”، ومن “الفتور العاطفي” للشعور الحالي وتشوش الذاكرة تجاه الحاضر، كما يبين ساكس. ويوضح أن ما سبق لا يشبه بتاتًا “فقد الذاكرة العضوي” لجيمي.
يمكن أن يمتد فقد الذاكرة ليمحو ارتجاعيًا عشر سنوات، كما في بعض الحالات المذكورة في مرجع أ.ر.لوريا “طب النفس العصبي للذاكرة”. السؤال الآن: ما الذي يمكن أن يقوله علم الأعصاب والطب النفسي عن حالة البعض منا، نحن “رفاق يناير”؟
وبالمناسبة، فإن الحرب ليست مثالًا بعيدًا عن الثورة، فبالفعل ترى حنة أرندت أوجه تماثل عديدة في طبيعة وشروط كلٍ منهما. كأن الحرب احتمالية قائمة دومًا داخل أي ثورة.
لا يتأمل “رفاق يناير” الماضي القريب كما يفعل المحاربون القدماء، أو كما يتأمل جيل مايو 68 في أوروبا وقائع ذلك الحدث الثوري. يغمرنا الحاضر حتى النخاع، يدفعنا إلى نسيان الأمس والخوف من الغد. أشعر أننا في حالة من “فقد الذاكرة الانتقائي” إن جاز التعبير.
المحو، في حالتنا، يتخطى الحاضر حتى يصل إلى فترات نشاط الثورة وفاعليتها. مُحيت تلك الذكريات عند أغلبنا بما أوجدته من أمل وثقة. التبلد النسبي عندنا تجاه الحاضر ومعه الماضي كذلك. صار كل شيء، حتى الثورة، ضعيفًا وتافهًا، خلافًا لأبطال قصص ستادز.
ربما لأنه دون هذا التبلد والنسيان المتعمد لن يمكننا الاستمرار في الحاضر أو تحمل وطأته. توجب على معظمنا إخماد جذوة التمرد، الآخذة في الذبول.. نهائيًا.
أتخيل أننا كمن خاض معركة عنيفة في سبيل غاية نبيلة، فقد على إثرها طرفًا من أطرافه أو حاسة من حواسه، لكنه فيما بعد نسي المعركة نفسها. مُحيت وقائعها ودوافعها من ذاكرته. ولم يتبق إلا أثر المعركة المتمثل في طرفه المفقود، أو عجزه المستديم.
هكذا حُرم للأبد من العزاء الناتج عن دافعها النبيل. لن يتمكن من القول: “فقد تلك الذراع أو تلك العين وأنا أدافع عن بيتي أو أرضي” أو “وأنا أحمي أسرتي من سطوٍ مسلح”. في تلك الحالة، لن تلاحقه “ذكرى الخطيئة الجميلة”، بل ما سيبقى يلاحقه دومًا هو ألم العجز، القبيح.
وربما زمن الثورة نفسه قد امتد ليشمل العقد السابق بأكمله. لكن قبل الحديث عن “زمن الثورة“، يجب توضيح المقصود من السؤال الذي طرحناه من قبل: هل حدث الثورة بالفعل؟
***
يُحيل هذا السؤال إلى السؤال الذي عنون به الفيلسوف الفرنسي جان بودريار مقالاته المنشورة في جريدة ليبيراسيون عن حرب الخليج: “هل وقعت حرب الخليج حقًا؟”. نُشرت المقالات في كتاب بعنوان “حرب الخليج لم تقع“.
تتركز فكرة بودريار في أن منفذنا الوحيد إلى حقيقة الحرب هو “الإعلام”، ولذلك “فإنه ليس لمشاعرنا وتأكيداتنا بشأن الحرب أي أساس في الواقع يتعدى الأساس الذي لأي وجه آخر من أوجه الحياة”. فالحرب، كما يرى، مثل كل شيء آخر، “هي قطعة من بلاغة الإعلام تُنقع فيها حياتنا اليومية”.
لا يشير بودريار هنا إلى أن الإعلام يشوه الحقيقة –وهو يشوهها بالفعل في الحالة المصرية- لأنه “ليس ثمة أية حقيقة تقبع وراء مظاهر الصورة” في رأيه، وإنما يعيد الإعلام إنتاج “واقع مفرط”.
يؤكد الفيلسوف الفرنسي أننا غارقون في عالم ما بعد حديث، وأن “النمو المتسارع في الاتصالات الجماهيرية وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وغيرها ولّدت حِملًا زائدًا من المعلومات، وهناك كثير من صور الحقيقة المتاحة، حتى باتت فكرة وجود عالم واقعي يمكننا أن نعلم حقيقته فكرة إشكالية”.
يرى بودريار أننا انتقلنا من عصر “الواقع” إلى عصر موت أو تحلل المبدأ المؤسس للواقع. هكذا يُعلن نهاية فكرة الصراع لأنه لم يعد بمقدور الإنسان التمييز بين الواقعي والمتخيل، الحقيقة والزيف، التقدمي والرجعي.
في مواجهة الإفراط في الصور والإشارت داخل الواقع الفائق/ المصطنع بتعبير بودريار، لم يعد هناك “واقعي” مستقل عما تبنيه وسائل الميديا المتنوعة. فالمشهد أو الصورة لم تعد مقيدة إلى شيء ثابت في العالم الواقعي. يصطدم تمثيل الموضوع بواقعيته، وينزعان استقرار أي تصور ثابت للواقع، حيث “يحل ما حوكي، أي النموذج والتمثيل، محل العنصر الواقعي، ويغدو هو الواقعي بدلًا منه”.
في الدلالة على ذلك، ألم يحاجج خطاب الإخوان في حقيقة مظاهرات 30 يونيو الحاشدة، ووصفها بأنها “صور” مصطنعة أو مفبركة نفذها المخرج خالد يوسف؟ في الوقت نفسه لم تكن الدولة تريد من الجماهير وقتها سوى “صورة” الثورة لا فعل الثورة نفسه وما قد يترتب عليه.
تبدو أفكار بودريار بعيدة تمامًا عن الصواب وقريبة منه رغم كذلك. في الحرب السورية مثلًا، خلق النظام الأسدي وقوات داعش من الحرب واقعًا أبوكاليبتيًا قائمًا بوحشية، لكن إلى الآن هناك من يشكك في استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية أو ثقيلة، ويصف ذلك بأنه صور مُخلقة. وهناك من يصف داعش والنصرة بـالمعارضة أو “الثوار”.
كانت ثورة يناير في أيامها الأولى واقعًا ملموسًا. لم نكن في حاجة إلى “وسيط” ليصورها لنا، أو نراها عبر مجهره. كانت حقيقة يعلمها كل من تواجد مثلا في القاهرة والإسكندرية والسويس حيث كانت المسيرات تجوب شوارع المدن، وكادت ألا تخلو منطقة في البلاد من المصادمات مع قوات الأمن يوم جمعة الغضب.
فشلت في النهاية عمليات التشويه الإعلامية لأن الثورة كانت “حقيقة” راسخة. لذلك لجأت السلطة فيما بعد إلى حصر فاعلية “الحدث” ضمن نطاق بعينه: محمد محمود، مجلس الوزراء، وزارة الدفاع، ماسبيرو.. كي تتمكن من “تصويره” أو تشويهه أو إعادة إنتاج الحدث كما تريد له أن يكون.
لمن لم يعش الثورة، حتى في لحظاتها الأشد زخمًا، إلا عبر صورها ومشاهدها، فإن الوسيط -سواء كان قنوات تليفزيونية أو وسائل تواصل اجتماعي- وحده هو الذي يمكنه أن يصنع الحدث.
أما رسالة الحدث نفسه فليست مهمة سواء كانت امتثالية أم هدامة، كما يوضح بودريار. الثورة حدثت بالفعل. إنها حقيقية كالشمس ودوران الأرض حولها. لكن حتى مثل هذه النواميس والحقائق الكونية تجد من لا يصدقها.
***
تكتسب فرضيات بودريار أهمية بالغة في كشفه عن الطبيعة التقنية للميديا والكيفية التي تشكل بها بنيتنا الإدراكية، وكيف يحدد المشهد أو الصورة بنية المجتمع. إنه العمل لتخريب النظرة السوية إلى الواقع بقوة الميديا. فيكون الواقع في الميديا لا الحدث، كما يعلق الباحث جوزيف عبد الله، مترجم بودريار إلى العربية.
بالطبع يغفل بودريار سؤال الإيديولوجيا. ولا يرى أن الأمور يمكن أن تكون على غير ما عليه، وأن “أي محاولة لاستعادة الواقع مقضي عليها بالفشل”، كما يبين آلن هاو.
في المقابل، تُحارَب الثورة من الإيديولوجيا في تبدياتها المختلفة. من الخطاب الإيديولوجي للدولة إلى الإيديولوجيا التي تتحكم بالميديا والثورة المعلوماتية والرقمية، وتقود الوعي عبر آلياتها.
بات خضوعنا للمراقبة المستمرة من قبل التطبيقات الذكية، حد القراءة المستمرة لأفكارنا، موضوعا للتندر والسخرية. نواجه كل يوم فيضًا من الأخبار والأحداث التي تمتصنا وتستهلكنا تمامًا. واقع مفرط في واقعيته، أو بحسب التعبير العامي الشهير: “الواقع فشخ الخيال”.
هكذا اُستبدلت الثورة بصورتها، كما تغير واقعها. تلك الصورة يمكنها أن تكون براقة في بعض الأحيان، ومشوهة في أحيان أخرى. لحظة نورانية، وكذلك ضلالة مبينة. حركة عفوية ومؤامرة مُدبرة.
***
يكشف لويس ألتوسير عن طبيعة أداء “الجهاز الإيديولوجي للدولة”، إذ تعمل الدولة عن طريق القوة على “التمييز بين الممكن وغير الممكن”. لذلك فإن حدثًا مثل الثورة يُنظر إليه باعتباره “شيء ينفلت من عقال الدولة”.
كل من ستتوق نفسه إلى حقيقة “فعلية” وراء كل هذا فإنه سيُتهم بالوقوع في شراك النوستالجيا. أما “الأجيال التالية”، فإن وعيها هو مجال اهتمام أي إيديولوجيا مناهضة للثورة في سردها لما جرى. والغاية من ذلك إيصال رسالة قصيرة، لا يكتبها الثوار بالطبع، مفادها: ثورة يناير لم تحدث.

رسم: Julia Moreno
زمن الثورة
كانت “الرشاية” لا تزال في رأسي.
أضع أصبعي على موضعها، أشعر بها ثم أتناساها. كنت أشكك في وجودها أسفل الجلد، وأقول ربما ارتدت عن رأسي، كما ارتد غيرها، حيث استقبلت يومها توابع من زخة خرطوش، تولت المسافة البعيدة والملابس الشتوية صدها. نقرت واحدة منها صدغي الأيسر لكنها لم تترك إلا خدشًا سطحيًا.
في يوم من شهر يونيو 2011، ذهبت بدافع من الملل والتهرب من العمل إلى طبيب الشركة التي كنت أعمل بها وقتها. أخبرته عنها، وهل يمكن أن يؤدي بقاؤها في رأسي إلى مضاعفات مثلًا. اليوم أفكر في تفاهة هواجسي حينها، مقارنة بأناس قتلوا برصاص حي، أو ضربوا بأسلحة كيماوية في بلدان أخرى، أو دهستهم الدبابات فامتزجت أبدانهم بالأسفلت.
حسنًا، ضغط الطبيب بأصبعه عليها وحركها. طلب مني عمل أشعة حتى نعرف إن كانت موجودة حقًا أم أن هذا مجرد تليف من الجرح، حد وصف الطبيب. قال: “لو موجودة هتلاقيها نورت في الأشعة”. وبالفعل كان تقرير الأشعة يقول بوجود جسم معدني غريب في مقدمة الجبهة.
أزالها الطبيب في موعد متفق عليه خلال دقيقة. وخيّط الجرح بغرزتين. لماذا بقيت محتفظًا بهذا الجسم المعدني الصغير داخل رأسي قرابة الخمسة شهور؟
كتبت قصة، قبل أن أفكر في إزالتها، عن شاب في رأسه طلقة رش/خرطوش. يتوقف الزمن لديه عن الأيام الأولى للثورة. يتراجع عن قرار إزالتها من رأسه. يسير في الطرقات وعربات المترو حاملًا صورة الأشعة تحت إبطه، ويطلب من المارة أو الركاب أن يتحسسوا موضعها في رأسه. ويظل يحكي عنها ويتمتم: “كانت أيام جميلة”.
***
القرن العشرين، بأكمله، يوصف من قبل فلاسفة مثل حنة أرندت وآلان باديو بـ “قرن الثورات”. ويمكننا كذلك أن نطلق على العشر سنوات السابقة: “عقد الثورة“.
يتأكد حضور الثورة بالغياب، أي أن الخطاب المضاد لها يعيد إبرازها رغمًا عنه. إنها تعود “في أوج النفي”، بتعبير باديو حين يصف الحضور الدائم لأحداث مايو 68.
لماذا إذن تطارد السلطات أطياف شبحية لا وجود لها؟ تُغلق المقاهي في وسط البلد، ويعبث أفراد الأمن في الهواتف المحمولة للمارة باحثين في محتوى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عليها. إجراءات الدولة كرؤيتك حلوى المولد منتشرة عند الباعة. لولا تلك الحلوى ربما نسيت اقتراب المولد النبوي من الأساس. وربما دون تلك الإجراءات القمعية ننسى ما استطعنا تحقيقه من قبل.
إلا أن الثورة هي من تمتلك ما لا تقدر السلطة على الرهان ضده، الزمن. كلما امتد الزمن بالسلطة فقدت شرعيتها، بينما تتعزز شروط حتمية الثورة.
تكسر أي الثورة الإيقاع المعتاد للحياة، هي مفاجأة تتجاوز المألوف. تسارع إيقاع الثورة يخلق زمنًا خاصًا لها، يجعل اللحظة تفلت من بين أيدينا ووعينا.
في ألبوم “استذكار Souvenance“، يقدم الملحن التونسي وعازف العود أنور براهم واحدًا من أهم الأعمال الفنية التي تناولت الربيع العربي. تحاول موسيقى براهم القبض على اللحظة قبل انفلاتها، والتعبير عن سحرها مع الاستجابة العميقة لآثارها وتحولاتها.
لكن، كيف يمكن للإيقاع أن يعبر عن ما لا إيقاع له؟ أو بالأدق، كيف تعبر الموسيقى عن أحداث إيقاعها في تسارع إلى حد التلاشي؟
لا يحتاج براهم إلى ضبط الإيقاع في زمن محدد وثابت لأن الثورة قد فجرت الزمن من حولها بالفعل. يقول أنور براهم عن ألبومه: “فجأة جدّت أحداث خارقة للعادة اهتزت لها حياة الملايين. دُفعنا إلى المجهول واشتدت بنا الهواجس وأحاسيس الفرح والأمل وفاق ما حدث كل تخيلاتنا. لقد مضى وقت طويل قبل أن أتمكن من كتابة هذه الموسيقى”.
“استذكار”، قبل كل شيء، محاولة لفهم وتأمل ما جرى. كأن الموسيقى تقدم خيالًا بديلًا قادرًا على استيعاب الأحداث الخارقة. الألبوم محاولة لاستكناه هذا المجهول، وللتعبير عن هواجس وأحاسيس متنوعة ومتناقضة.
يلتقط براهم الصفة الجوهرية لأي ثورة. إذ أن “أي ثورة هي مفاجأة لا يفيد معها إلا الارتجال” كما يقول الشاعر والكاتب المصري علاء خالد. يقبض براهم على تلك الصفة الارتجالية لكل من الثورة وتأليفه الموسيقي. لكن الارتجال لا يصنع وحده جماليات “استذكار”. أهمية ألبوم براهم تنبع من تضفيره البحث الدؤوب والمتأمل مع الارتجال. بحث عن زمن الربيع العربي المفقود، وتعبير عن التأثر الوجداني العميق بحدث جلل.
أستمع إلى مقطوعات من هذا الألبوم، خاصة مقطوعة يناير، تقريبًا كل يوم، خلال السنوات الماضية.
كنت أمشي والرشاية لا تزال في جيبي. موضوعة في ظرف صغير أو محاطة بالقطن حتى لا تضيع وسط محتويات الجيب. كانت مثيرة للاهتمام والتأمل في نظر زملاء العمل وبعض المعارف وأعضاء “حزب الكنبة”.
تعددت بعد ذلك المعارك والاشتباكات في القاهرة والإسكندرية. صارت الذخائر والغازات المسيلة أشد وأخطر من زمن ما قبل التنحي. باتت طلقة الرش الصغيرة بلا معنى وسط الأهوال التي حدثت بعدها لغيري من المتظاهرين. كانت، في نظري، مُدعاة لتفاخرٍ بائس يثير السخرية والأسى. فقدت اهتمامي بها. قبل نهاية عام 2011، كانت “الرشاية” قد ضاعت، ولم أفكر فيها أو أحاول البحث عنها مطلقًا.
هل فشلت الثورة حقًا ؟
يتحدث الفيلسوف الفرنسي آلان باديو في كتابه “فشل اليسار” عن مفهوم الفشل وأشكاله من خلال استحضاره للعديد من الثورات في القرن العشرين وما قبله، مثل ثورة السبارتاكوسيين في برلين عام 1914 والتي انتهت باغتيال روزا لوكسمبورج وكارل ليبكنيخت، وحركة مايو 68 ، وكميونة باريس عام 1871.
يرى باديو أن المعنى الأعمق للفشل حين نفهم أنه لا جدوى من الانتصار. أن الثورة “ليست سوى فاصل بين مرحلتين في بناء الدولة”. يؤكد باديو أن “العدو الأكثر فزعًا ليس هو القمع الي يمارسه النظام القائم، بل هو السريرة الداخلية للعدمية، والقساوة الضارية التي يمكن أن تصاحب الفراغ”.
في عمله الصادر عام 2009، يحلل باديو نوعا من الفشل يمكنه أن ينطبق على ثورة يناير. ويتعلق بـ”حركة كبيرة تنخرط فيها قوى مختلفة لا تجعل السلطة نصب أعينها رغم أنها تضع بشكل دائم قوى الدولة الرجعية في موقف دفاعي”. مع تراجع الحركة نتيجة النظام القائم، الجديد ربما، تظهر التساؤلات حول جدوى الفعل الثوري، والفكرة التي ترى “أن لا شيء تحقق ولسنا سوى أمام المتخيل”.
كانت نذر الشؤم تحلق فوق رؤوسنا مبكرًا، ربما لم نفطن إليها ولكن غيرنا فعل.
***
في عدد من الرسائل المتبادلة بين الكاتب الجنوب إفريقي جيه. إم. كوتزي الحائز على جائزة نوبل والكاتب الأمريكي بول أوستر، يتحدث أوستر في رسالة بتاريخ الثامن من مارس عام 2011 عن الثورة المصرية. يصفها بأنها “انتفاضة سلمية كانت ذات طبيعة علمانية”، يقودها الشباب من أبناء العشرينيات والثلاثينيات “يعانون من البطالة أو البطالة المقنعة بسبب المجتمع المعطوب الذي تكوّن عبر سنوات من الفساد والديكتاتورية”، مدعومين من نساء وعمال فقراء.
يقول أوستر إنه رغم استثنائية الحماسة والتفاني لدى الثوار فإن الصدوع تتكون من جديد ولم يمض إلا أسابيع. يوضح أوستر أن عشرات السنين بغير حياة سياسية حقيقية أو أحزاب سياسية منظمة أو احتمالية قيام معارضة سياسية متماسكة أدت إلى انعدام وجود أدوات سياسية لتنفيذ الجوع الشعبي إلى التغيير الاجتماعي. “وهو ما ترك الجيش متحكما في البلاد. أعتقد أن هناك فراغًا في السلطة”.
في رسالة بتاريخ الثاني والعشرين من نفس الشهر، يؤكد كوتزي على صحة كلام أوستر. والأهم أنه يقول في كلمات دالة:
“إن المرء يرى أولئك الشباب الأذكياء ذوي الوجوه الطازجة والحماسة المتقدة في شوارع القاهرة يكلمون كاميرات التليفزيون عن مدى إحساس المرء بأنه حر، وعن مدى اشتياقهم إلى مصر جديدة، فيتساءل المرء كيف سيكون كلامهم في غضون عام أو اثنين، حينما تكون نخبة حاكمة جديدة قد استتبت في السلطة”.
***
أما الفيلسوف سلافوي جيجيك فيؤكد على رؤية فالتر بنيامين الثاقبة القديمة: “كل صعود للفاشية يشهد على ثورة فاشلة”.
وبدوره، يُحيل جيجيك إلى ما يسميه الدرس الحقيقي والمشئوم للثورتين التونسية والمصرية:
“إن استمرت القوى الليبرالية المعتدلة في تجاهل اليسار الراديكالي، فسوف تولد مدًا أصوليا لا يقهر”. ألا نعيش الموجات العاتية لذلك المد الآن؟
تتمثل نبوءة جيجيك أيضا في توقعه أن صيف 2011 سيُمثل نهاية الثورة، ويصف الجيش والإسلاميين بأنهم “حفارا قبر الثورة”، وأن الحلف بينهما قائم على “تسامح الإسلاميين مع الامتيازات المادية للجيش، وفي المقابل يتم تأكيد سيطرتهم الأيديولجية”.
نحن نسرد الآن ما هو معلوم من الثورة بالضرورة. لكن لا أظن أن جيجيك كان يتوقع مثل ذلك النقض الدموي للحلف بين الجيش والإخوان. والنتيجة كانت أكثر رعبًا.
تحولت الامتيازات المادية للجيش إلى ممارسة احتكارية متوحشة تلتهم الاقتصاد نفسه. ورغم الهزيمة المدوية للإسلام السياسي، فإن عقود من السيطرة الأيديولوجية لا يمكنها أن تزول بمجرد إقصائهم من الساحة السياسية. تغلغلت الرؤى الأصولية المتطرفة في بنية الوعي المصري لكل من الشعب والسلطة على حد سواء.
***
السؤال الذي يجب أن تطرحه أي حركة ثورية أو انتفاضة هو ذلك المتعلق بكيفية ترجمة “اللحظة التحررية” إلى “نظام اجتماعي جديد”.
هنا نصل إلى الجذر الأعمق الذي يربطنا إلى “الفشل” كما أراه.
يقول باديو إن الشجاعة التي تلزمنا ليست تلك التي نحتاجها أمام قوات الأمن، وإنما شجاعة أن تكون لدينا “فكرة”. إن الاعتقاد بوجوب العيش بفكرة هو ما يسميه باديو “سياسة حقيقية”. فكرة متجاوزة منطق التسليع والمال والرغبة في مجرد البقاء.
ربما حيازة الأطراف الأقوى، الجيش والإخوان في الحالة المصرية، على “فكرة” هو ما يجعلهم كذلك. هكذا تصبح لحظة الهزيمة هي لحظة التخلي عن أي فكرة.
أما “اللحظة التحررية” فإنها تلك التي يعلن فيها الفرد أن بإمكانه “تخطي حدود الأنانية والتنافسية”. لحظة تخطي الفردانية في صيغتها الليبرالية المعاصرة، التي تكرس الوحدة والاكتئاب وتعوق التطور الحر للفرد ضمن روابط جماعية.
ويتمثل الجذر الأعمق الذي يربطنا إلى الثورة بإعادة اكتشاف الذات الفردية. فالثورة “ترسم جغرافية جديدة للمجتمع والذات الفردية، وتعين أيضا مكان الالتقاء بينهما”، كما يقول علاء خالد.
وبذلك تحقق أي ثورة مبدأ التنوير الأساسي حيث “الشجاعة في استخدام العقل”، بتعبير كانط.
هناك جيل جديد في تلك الألفية، شباب في بداية العشرينيات، كانوا أطفالا حين قامت الثورة. بالنسبة لهؤلاء، فإن الدرس الذي دأبت الدولة على تقديمه عبر القمع هو أن الخلاص فردي. لا بمعنى تعزيز الفردانية، وإنما ترسيخ فكرة التماهي مع منظومة العمل والمجتمع، من أجل تحقيق الذات وفق معطيات سوق لا يأبه بالأفراد ولا يشبع احتياجاتهم.
يجعل النظام القائم من أصحاب الأفكار عبرة مخيفة وحزينة، طالما أن فكرتك ليست start up فإن مكانك الطبيعي هو السجن.
انظروا إليهم. انظروا كيف تٌفنى أعمارهم داخل السجون. انظروا جيدًا. وبالطبع، ننظر جميعا ونحن ندرك أن الخطيئة الأصلية لمن هم خلف الأسوار هي الشجاعة. شجاعة الإيمان بفكرة، في عالم بات مقتنعًا أن الفكرة الكبيرة عمل إجرامي، أو أمر يثير السخرية.
مقاومة سياسات الخوف..
في فهم الحالة المصرية الحرجة للدولة والثورة
دفعتني سنوات ما بعد يناير 2011 إلى قراءة ما يمكن تسميته “أدبيات الثورة”، ومحاولة معرفة تصورات مفكري وفلاسفة اليسار الغربي، بتوجهاته المتعددة، حول سؤال الثورة والدولة وسبل التغيير الثوري.
الآن أدرك التباين المهول بين معظم الأفكار والأطروحات الثورية الغربية، منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وبين الحالة المصرية التي تزداد تعقيدًا كل يوم.
خصوصية الحالة المصرية ليست فقط نتيجة ظروف تاريخية متعلقة بالتبعية الخارجية أو موازين قوى دولية. وليست نتيجة التحديات التي يمليها إرهاب الإسلام السياسي في المنطقة. تكمن الخصوصية في منطق الدولة المصرية نفسه وطبيعتها ونمط سياساتها.
تستهدف التصورات المعاصرة للمفكرين الثوريين في أمريكا وأوروبا نموذجًا للدولة الرأسمالية في صيغتها المتأخرة.
نتج عن تطور الرأسمالية انتقال الدولة نفسها من “منطق الانضباط “discipline السائد في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين إلى منطق التحكم control. أي أن عملية الإخضاع تحولت من هيمنة المؤسسات وفكرة المعاقبة إلى شكل جديد من الإخضاع يمثل السوق أداته في التحكم الاجتماعي. هكذا يرصد جيل دولوز التحولات الناجمة عن الرأسمالية المتأخرة.
أما الدولة المصرية فإنها تجمع بين المنطقين. بل إن منطق الانضباط كشكل “لإخضاع النظام الاجتماعي للأفراد” بتعبير أنور مغيث، يكاد ينتمي إلى نموذج يصعب تعيينه تاريخيًا.
يقول جيل دولوز إن “الدولة لم تعد تستحوذ على وسائل سياسية أو مؤسسية أو حتى مالية تتيح لها كبح التداعيات الاجتماعية”. ويشكك في إمكانية قدرتها على الارتكاز على “الأشكال العتيقة” مثل الشرطة، الجيش، والبيروقراطيات ومؤسسات مثل الأسرة والمدرسة.
الدولة المصرية هي النقيض لكل التصورات الدولوزية عن الدولة.
الخيوط التي يلاحظ دولوز انفلاتها من قبضة الدولة، تقبض عليها الدولة المصرية بقبضة فولاذية. ومنها: تحديد الأراضي، قدرة المؤسسات على الإخضاع، وسائل السيطرة على النساء، وغيرها.
ولأن الدولة لم تعد دولة انضباط بل دولة تحكم، فإن الإنسان لم يعد هو الإنسان “المحبوس” ولكن الإنسان “المديون”. ونعلم كلنا، علم اليقين، أن الإنسان “المصري” محبوس ومديون.
وكذلك فإن هامش الحريات الشخصية قد تلاشى تقريبًا. تارة باسم قيم الأسرة وتارة تحت ذريعة ازدراء الأديان، وأشكال لا نهائية تهدف إلى صياغة شمولية للمجال الاجتماعي.
يفكر دولوز في أن نمطًا جديدًا من الثورة في طريقه لأن يصبح ممكنًا عبر ما يسميه “السياسات الصغرى”. لا تستهدف تلك السياسات الوصول إلى سلطة الدولة. إنها تدفق للرغبة، خطوط إفلات تعمل على خلخلة الإطار التقعيدي للرأسمالية حيث توطين الأفراد وفقا لترتيبات السلطة. نضالات يومية ومستمرة للأفراد والأقليات، والمجموعات الصغيرة من شباب ونساء ومثليين.
أي أن الثورة الحقيقية لا تحدث على مستوى النظام الاجتماعي لكنها تحدث داخل الأفراد.
في رأيي، لا يمكن لمثل هذه السياسات الصغرى أن تزدهر أوتتحقق إلا في ظل “انحسار قدرة الدولة”، والذي رصده دولوز كنتيجة “لتراجع دور الجيش والمدرسة والأسرة على إدماج أفراد المجتمع في النظام الاجتماعي المهيمن”، كما يشرح أنور مغيث.
ومثلما تجاهل بودريار سؤال الإيديولوجيا، قام دولوز باستبعاد قضايا أساسية من مفهوم التغيير الثوري. قضايا يحددها مغيث في دراسته عن فلسفة دولوز السياسية مثل قضية “نمط الإنتاج البديل لاقتصاد السوق”، و”قضية شكل الممارسة السياسية” الذي سيعقب انحسار الديموقراطية التمثيلية. فـ”نزع دولوز بذلك عن فكرة الثورة بعدها السياسي”.
إذن، كيف يمكن الاستفادة من كيمياء التغيير الثوري بالمعني الدولوزي ؟
***
في محاوراته، يشير دولوز إلى مفهوم رفيقه فيلكس جواتاري عن “الفاشيات متناهية الصغر”. وهي التي توجد في مجال اجتماعي دون أن تكون “متمركزة بالضرورة داخل جهاز دولة بعينه”. والحقيقة، والأمر ليس مجرد رغبة في التلاعب اللفظي، فإن مثل تلك الفاشيات نراها كمصريين متمركزة بشكل يومي في وسائل التواصل الاجتماعي. يتحدث دولوز في كلمات متبصرة عن نظام “ينغرس فيه كل واحد داخل ثقبه الأسود، ويصبح خطرا داخل هذا الثقب متمتعا بثقة في حالته ودوره ومهمته”.
خطورة تلك الثقوب السوداء المنتشرة في مجتمعنا، على المستوى الفعلي والافتراضي، أنها تبتلع أي محاولة للممارسة المستقلة عن قواعد النظام العام. وبذلك، تصير أي محاولة للتحرر مهما كانت صغيرة، مجرد الكلام بشكل حر مثلا، ممارسة ثورية لأنها تواجه تمركزات فاشية في المجال العام، تنوب عن سلطة الدولة.
هكذا، فإن ثورة يناير، ويا للمفارقة، لا زالت مستمرة.
***
مع دخول الرأسمالية إلى طورها الأكثر وحشية مقارنة بالخمسينات والستينات، برزت حركات جديدة تحاول ردم الفجوة القائمة بين المثقفين والنشطاء، أي بين مُنظري الثورة وممارسيها. من أبرزها “حركة مناهضة العولمة”، أو بالأدق، “حركة مناهضة النيوليبرالية”، كما يحب عالم الانثروبولوجيا والمُنظر الأناركي ديفيد جريبر أن يُطلق عليها. النيوليبرالية حسب تعريف جريبر هي “نوع من أصولية السوق”، طغيانه، وتأكيده أن” ثمة اتجاهًا ممكنا واحدا فحسب للتطور التاريخي”. و “الخريطة في قبضة نخبة من الاقتصاديين والمروجين للشركات الكبرى”.
تتعدد فصائل ومجموعات الحركة “الأناركية الجديدة” مثل “شبكة العمل المباشر”، “استردوا الشوارع”، “توتي بيانكي”. يوضح جريبر في مقاله “الأناركيون الجدد” أن هذه المجموعات تحاول ابتكار “لغة جديدة” للعصيان المدني “تجمع بين عناصر من مسرح الشارع والمهرجان وتكتيكات الحرب غير العنيفة”، حيث جيوش هزلية من شخوص قريبة من رسوم الكرتون في بذلات “، غريبة وتهاجم قوات الشرطة بالبالونات ومسدسات المياه وغيرها.
لا يمكن لمثل تلك التكتيكات في مواجهة السلطة عندنا إلا أن تكون انتحارًا مبينًا. الغاية، كما يصورها جريبر، لا تتعلق بالاستيلاء على السلطة بقدر “فضح ونزع مشروعية آليات الحكم” واكتساب “الاستقلال الذاتي”.
آليات الحكم في الحالة المصرية قوامها الخوف، ولا شيء غيره. الخوف الخام، العاري، الذي لا تجهد الدولة نفسها في إضافة أي مكونات إليه، أو جعله يتقنع خلف ادعاءات أو مقولات بعينها. قُتلت شيماء الصباغ في ذكرى الثورة (2015) وكانت تحمل إكليلا من الورود لإحياء ذكرى الشهداء بميدان التحرير. أطلق ضابط بالأمن المركزي طلقة خرطوش في وجهها. لماذا شكّل الورد تهديدًا للضابط والسلطة من ورائه؟
إن الموت المأساوي لشاعرة وناشطة سياسية مثل شيماء الصباغ ينزع، مفردًا، مشروعية كل سلطات العالم. وتلك الخسارة، وغيرها من الخسائر المفجعة كمًا وكيفًا، قلما يتكبدها المتظاهرون في دولة جريبر أو دولوز.
***
لكن جريبر يوضح لنا نقطة شديدة الأهمية بعيدا عن مسدسات المياه. في مقاله “ الثورة بالمعكوس” يقول إن مفهومنا الانتفاضي عن الثورة لم يعد يبدو قابلًا تمامًا للتطبيق. ويجب علينا أن نبدأ بالتفكير مجددًا في نوعية هذه اللحظات الانتفاضية.
أن نراها كلحظات إبداعية، تعيد خلق الخيال الإنساني المتحرر من أدوات الاستلاب كصناديق الاقتراع وشاشات التليفزيون ومكاتب البيروقراطية وغيرها. وبناء عليه، ينطلق مع “مجموعة العمل المباشر” في الاتجاه المعاكس للثورة بمعناها الراسخ. أن يبدأ من الأشكال الكرنفالية للحشد بحيث لا تندرج ضمن البيروقراطية التي تتطور دائمًا كي تقدر على احتواء اللحظات الثورية. ومن شأن إعادة اختراع الحياة اليومية أن يفيد في خلق مؤسسات بديلة.
ربما يفسر ذلك لماذا تتعامل الدولة بعنف مع فتيات التيك توك مثلا أو مع كوميديان هزلي. لماذا تصر على المعاقبة بالحبس لأي محاولة خيال أو مواقف ارتجالية لا تتماهى مع خطوط الانضباط.

رسم: Julia Moreno
أقصى ما في الثورات
يخاطب الشاعر الألماني برتولد بريشت من سيأتي بعده قائلًا..
“وبينما أدركنا أن بُغضَ القهرِ/ يشوّه ملامحَنا، كان الغضبُ/ من الظلمِ يجعلُ أصواتنا/ عاليةً شنيعة. آهٍ، نحنُ، مَن/ تمنّينا الرُقادَ جنبَ الينابيعِ/ طلباً للسكينةِ والودّ، لم/ نهتدِ إلى مسالكِ الودّ/ أما في الغدِ، حين لا يُعامل/ البشرُ غيرَهم كالحيواناتِ/ فانظر خلفكَ غافراً”
***
نطلب الغفران من الأجيال القادمة، عن خطيئة التمرد الجميلة. وندعوهم إليها. لكن قبل ذلك علينا أن نغفر لأنفسنا. عقد الثورة ليس سنوات ضائعة في الفراغ. لقد عشنا ما يمكن أن نتذكره لبقية حياتنا. وربما ذلك كما يقول كوتزي هو “أقصى ما في الثورات”، أقصى ما يمكن أن ينتظره المرء منها: “أسبوع أو اثنان من الحرية”، من البهجة والجمال.
أحيانًا تدفعنا الظروف الحالكة إلى محاولات دؤوبة في نسيان الثورة. نرغب في أن ننسى ما قمنا بفعله وما حلمنا به، كأننا بذلك سنقدر على استعادة/استرجاع ما فقدناه.. السنوات التي أنفقناها من عمرنا على الثورة وأحلامها. لكن، لا أحد يمكنه استعادة الزمن المفقود.
أنظر الآن إلى أسابيع الحرية الجميلة، وأضعها في ميزان مع مجمل العشر سنوات السابقة، لأراها كريشة الإلهة ماعت، رمز الحق والعدالة. الريشة التي سترجح دوما كفة الميزان في صالحها، مهما وضع في الكفة الأخرى من سنوات أو عقود.