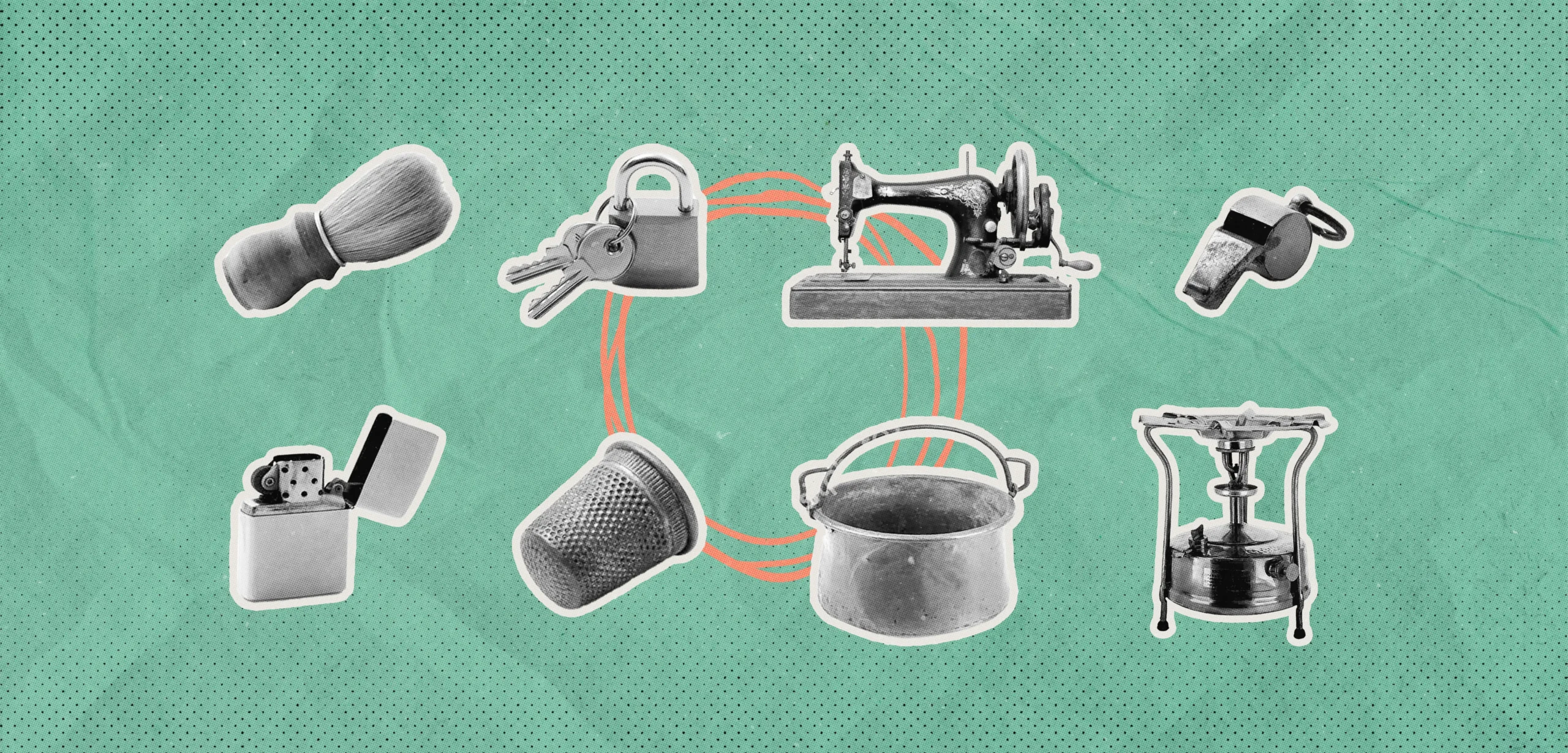أفتح بريدي الإلكتروني صباحًا، من بين رسائل الإعلانات والأخبار التافهة، أجد رسالة بعنوان “دعوة للمشاركة”، ليست دعوة للمشاركة في حملة توقيعات جديدة من أجل قضية ما، ولكن دعوة للكتابة في موقع جديد يحمل اسم “خطـ٣٠”.
الرسالة قادمة من اسم سمعته ذات مرة من أحد الأصدقاء البعيدين، شيء لطيف أن يتذكرك أحدهم بدون مناسبة معينة، وأيضاً يطلب منك المشاركة في كيان مازال تحت الإنشاء.
ما زالت هناك مواقع جديدة تنطلق إذن، أمر جيد.. ربما، وربما لا، دعنا نتعرف بداية على ما سينشره الموقع الذي مازال تحت التأسيس لنعرف إن كان الأمر جيدًا أم لا.. حيث إن “مركب الخرا مش ناقصة طرطرة”..
*
أفكر في مسألة الخط، أكثر من الرقم، لماذا اختيار الكلمة، ألا يبدو الخط وحيدًا؟ ألا يحمل الخط التزامًا ما ربما يعيق عن رؤية ما يقع خارج هذا الالتزام. ألا يعطي الخط توهمًا بالحركة؟ من نقطة إلى نقطة؟ وماذا عن باقي النقاط..؟
أغمض عيني لأرى صفحة بيضاء يخترقها خط أسود، لكن لا يبقى الخط وحيدًا، ينقسم إلى خطين، ثم أكثر ولا تمضي الخطوط بشكل مستقيم، تتعرج، تلتف، تلتقي فتشكل نقاطًا، تنكسر وتحاول العودة إلى نقطة البداية لكن لا سبيل لذلك “فالإنسان لا ينزل لنفس النهر مرتين” لذا تعود لنقطة جديدة.
راح بياض الصفحة أمام عيني، صار خلفية، وصار الخط شبكة معقدة من الخطوط المتداخلة، ونقاط تلاقي غير منتهية.
هل هكذا فكّر من اختار الاسم؟ هل هكذا ستسير الأمور.. لا أعرف، ولا أظن أن من أرسل الرسالة يعرف هو الآخر.. أواصل القراءة.. “آلية العمل في “خطـ٣٠” تعتمد على فتح خطوط/ ملفات انطلاقاً من عناوين/ تيمات تأتي من حياتنا اليومية، لكن لا يقتصر الأمر على إنتاج عدة مواد ثم إغلاق الخط/ الملف.. سيبقى الخط مفتوحاً للإضافة على الدوام كلما استجدت الحاجة لذلك.. بالإضافة للعمل على فتح خطوط جديدة طوال الوقت..”
أشعر أن ما أقرؤه ليس بعيدًا عن تلك الشبكة التي أخفت بياض الصفحة، هل يمكن أن تنطلق عدة خطوط من أماكن ربما لا يجمعها رابط للوهلة الأولى، ومع الاندفاع تتخلق الروابط والصلات.. أرجو ذلك.
*
أذكر حكاية عن أحد الصحفيين المصريين في فترة السبعينات، عمل في تجربة صحفية معارضة، وعند عرضه العمل على أحد الصحفيين الشباب، سأله الشاب إن كان يرى أن هذه التجربة يمكنها الاستمرار.. رد عليه الأول.. “إننا أشبه بمن قاموا بخطف طائرة، وعليهم أن يحافظوا عليها أطول وقت ممكن.. لا توجد طائرة تُخطف حتى النهاية، ولكن هناك فترات خطف أطول من غيرها”.
لا أعرف مدى دقة الحكاية، ولا أذكر من أبطالها، لكن بقى المثال راقداً في خلفية رأسي، استدعيه مع كل التجارب الجديدة التي يراها الواحد، أو التي شارك فيها، أحببت في الحكاية تواضعها، وحساسيتها للواقع الذي نعيش فيه والذي تزداد ظروفه وطأة كل يوم، وخاصة على أصحاب المبادرات الجديدة.
كقارئ أرى كل المحاولات الجادة والتجريبية كمحاولات اختطاف، اختطاف جمهور أسير، اختطاف أفكار يتم محوها أو تشويهها، اختطافها بعيدًا عن من يقومون بخطفنا شخصيًا كل يوم.
إلى أي مدى يمكن أن تستمر المسألة؟ هل تهم الإجابة؟ أسأل نفسي. قديما كنت أفكر في الفارق بين “التجربة” و”المؤسسة” كنت أرى أن التجربة إن لم تتحول لمؤسسة.. ستنتهي، فلا يوجد تجربة تستمر إلى الأبد في حال التجريب.
لكن الآن لا يهم.. المهم أن تبدأ التجربة، أن يتم إلقاء حجر ما في البركة المتجمدة، أن نتعلم إلقاء الحجارة، أليس ذلك أفضل من لا شيء.. ألا يصنع التراكم الكمي ذات يوم تغيرًا كيفيًا كما أخبرنا الألماني العجوز كثيف اللحية؟
*
تطرح الرسالة عدداً من الخطوط التي يتم العمل عليها حاليًا.. عن الطعام، والبيت، والحركة في المدينة، والمكان، وعدة عناوين أخرى.. وتترك الرسالة للمرسل إليه حرية اختيار “الخط” الذي قد يكون مناسباً له أو يشعر بالقرب منه أكثر..
تبدو الخطوط مثيرة للتفكير، وأيضا للتساؤل.. هل هذا يهم؟ هل هذه الخطوط هي ما يهم “من يعيش في تلك الجغرافيات المتباينة” كما تقول إحدى الجمل التعريفية بالموقع الذي لم ير النور بعد، هل يمكن أن تخترق تلك الخطوط بالفعل “تفاصيل الحياة اليومية للفرد على امتداد بلاد خط العرض 30“ أم أنه اختيار للعبور من بعيد دون الاقتراب من الأشواك التي تخترق تلك الحياة اليومية.
لماذا أفكر في هذا كله؟ هذا ليس دوري، فليفكر أصحاب الأمر.. أنا فقط مدعو للكتابة، وليس لإعادة هندسة العالم.
وهل لدي ما يمكن الكتابة عنه لهذه الخطوط.. لا أعرف.
*
زارتنا صديقة إيطالية، لتناول الغداء معنا، نبهت علي زوجتي أكثر من مرة، بأن الصديقة لا يمكن أن تأكل الخبز أو أي طعام يدخل فيه القمح، أسخر منها ومن الصديقة بأنها واحدة جديدة من متتبعي صرعة “الحساسية” التي تجتاح العالم، وتملأ أرفف محلات السوبر ماركت بمنتجات غالية الثمن لخلوها من الجلوتين، أو اللاكتوز.
تحكي الصديقة أن الأمر ليس مجرد موضة جديدة، فجسدها وجسد أمها لا يمكنه التعامل مع الجلوتين -مركب البروتين الأساسي في القمح- وهي ليست وحيدة في ذلك مع أمها، ولكن ثمة الكثير من الإيطاليين الذين يعانون من هذه المشكلة.
يعود الأمر إلى سنين موسوليني الفاشي، إذ قرر موسوليني في مستهل حكمه، ولمواجهة الأزمة الغذائية، وأيضاً لوقف استيراد القمح من الخارج، أن يتم تعميم عدة أنواع مصنعة من القمح ترتفع فيها نسبة الجلوتين، وتم إجبار الفلاحين على زراعة هذه الأنواع فقط، الأمر الذي أدى إلى أجيال من الإيطاليين والإيطاليات المصابين بعدم القدرة على التعاطي مع القمح ومنتجاته، ومن ناحية أخرى إلى انقراض أنواع من القمح المحلي بعد تعميم “قمح الدولة”. لكن تقوم الدولة هناك منذ وقت بصرف معونات مادية ومعنوية للمصابين بهذه المشكلة.
أفكر في يوسف والي (1930- 2020) وزير الزراعة المصري الأطول بقاءً في النصف الثاني من القرن العشرين، بقى في منصبه من 1982 حتى 2004 ورحل عن هذا العالم منذ أسابيع، قيل أن سبب خروجه من منصبه كان تفجر بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دولياً وتؤدي للإصابة بمرض السرطان، والفشل الكلوي.
خرج يوسف والي من كل محاولات إخضاعه للقضاء سالمًا، وعاش كل عمره المديد دون أن يصاب لا بالسرطان ولا بالفشل الكلوي ولا بالتهاب الكبد الوبائي.
أبي مات من الفشل الكلوي، كان صحيح البدن، له life style يمكن أن يحسده عليه الكثيرون ممن يستعملون الكلمة الآن، يأكل الكثير من الخضروات والفواكه، يشرب الكثير من الماء، توقف عن التدخين مبكراً، وبالتأكيد لم يشرب الكحول، ومشى كثيراً في حياته، وأنجب أصغر بناته وهو في الثالثة والخمسين، وغالباً قتلته المحاصيل التي استزرعها والي، ورشها والي، وسقاها والي بمياه الصرف الصحي.
لكن لا.. لا يبدو الموضوع جيداً، ما الذي يربط موت أبي بالحياة اليومية للأفراد على امتداد بلاد خط العرض 30.
*
وماذا عن الحركة في المدينة؟ ولكن هل أتحرك أنا في المدينة؟ أتحرك قليلًا وفي الفترة الأخيرة أدمنت ركوب الدراجة، أركبها حيث أعيش، في ضاحية المعادي الهادئة، جنوب شرق القاهرة، ركوب الدراجة يجعل الإنسان أكثر إحساساً بالأرض.. بالطريق، والحركة في شوارع المعادي تجعل الواحد أكثر ميلًا للعن من ترك تلك الطرقات على هذه الحالة المتدهورة.
الحي الذي خطط له الكسندر أدامز الضابط الكندي الذي أشترى 143 فداناً في نهايات القرن التاسع عشر في منطقة عزبة معادي الخبيري، ليجعله سكنًا للأجانب، وأشرف على تخطيط شوارعه، وحرص على تشجير الكثير من المساحات به، مازال من أفضل أحياء القاهرة، وإن كانت كل شوارعه مهدمة.
من الممكن أن يكتب الواحد عن فوائد استعمال الدراجات، وأثرها على الصحة، وعلى خفض نسبة التلوث البيئي، وعن أهميتها في تخفيف التكدس المروري الذي تحيا به القاهرة، وأيضا عن مبادرة الرئيس لتشجيع ركوب الدراجات.
أو أكتب عن جولتي حول حي المعادي، التي تؤدي به إلى المرور بجوار سجن طرة، تقول الحكاية أن مصطفى النحاس (1879- 1965)، خليفة سعد باشا زغلول (1858- 1927) في رئاسة حزب الوفد وحب الجماهير، أمر في 1928 وكان وزيرًا للداخلية بإنشاء سجن طرة ليتم التخفيف عن سجن أبو زعبل القديم.
وهكذا جاورت الضاحية الهادئة السجن الذي نما وتضخم وأصبح سبعة سجون، أمرُ عليه.. تم تجديد أحد أسواره، تمت العملية في وقت قياسي، طُلي السور بلون أصفر يشع في الشمس، يكسر العين، وارتفعت لافتة ضخمة “الإدارة المركزية لسجون طرة” فوق البوابة الضخمة، التي بدأت تخلق تجمعات ما، ربما موظفون، بالتأكيد ليسوا من أهالي السجناء، باب الزيارة يقع هناك في “طرة البلد” بعيداً عن عيون أهل المعادي الوديعين.
إذن الجولة في المعادي ستفضي إلى السجن؟ لا أرجو ذلك، رغم أن السجن يتسع، كل يوم أقرأ أخبارًا عن منضمين جدد لمن هم في الداخل، وفي الخارج تخفت الأصوات، تخفت الحركة..
إذن من الأفضل أن ينتهى التفكير هنا حول الحركة وأيضاً المدينة.
ربما لست الشخص المناسب للتفكير في خطوط تخترق الحياة اليومية للفرد، فالطعام يؤدي إلى الفشل الكلوي، والدراجة تمر بجوار السجن، واليوم انتصف، ولم أعمل شيئاً ذا قيمة سوى الثرثرة مع نفسي كيف يمكن أن أرد على دعوة المشاركة.
ربما الاعتذار هو الرد المناسب، من الأفضل أن أغمض عيني وأن أشاهد كيف يمكن للخط أن يصبح شبكة كثيفة التعقيد تربط الكثير ببعضه البعض.