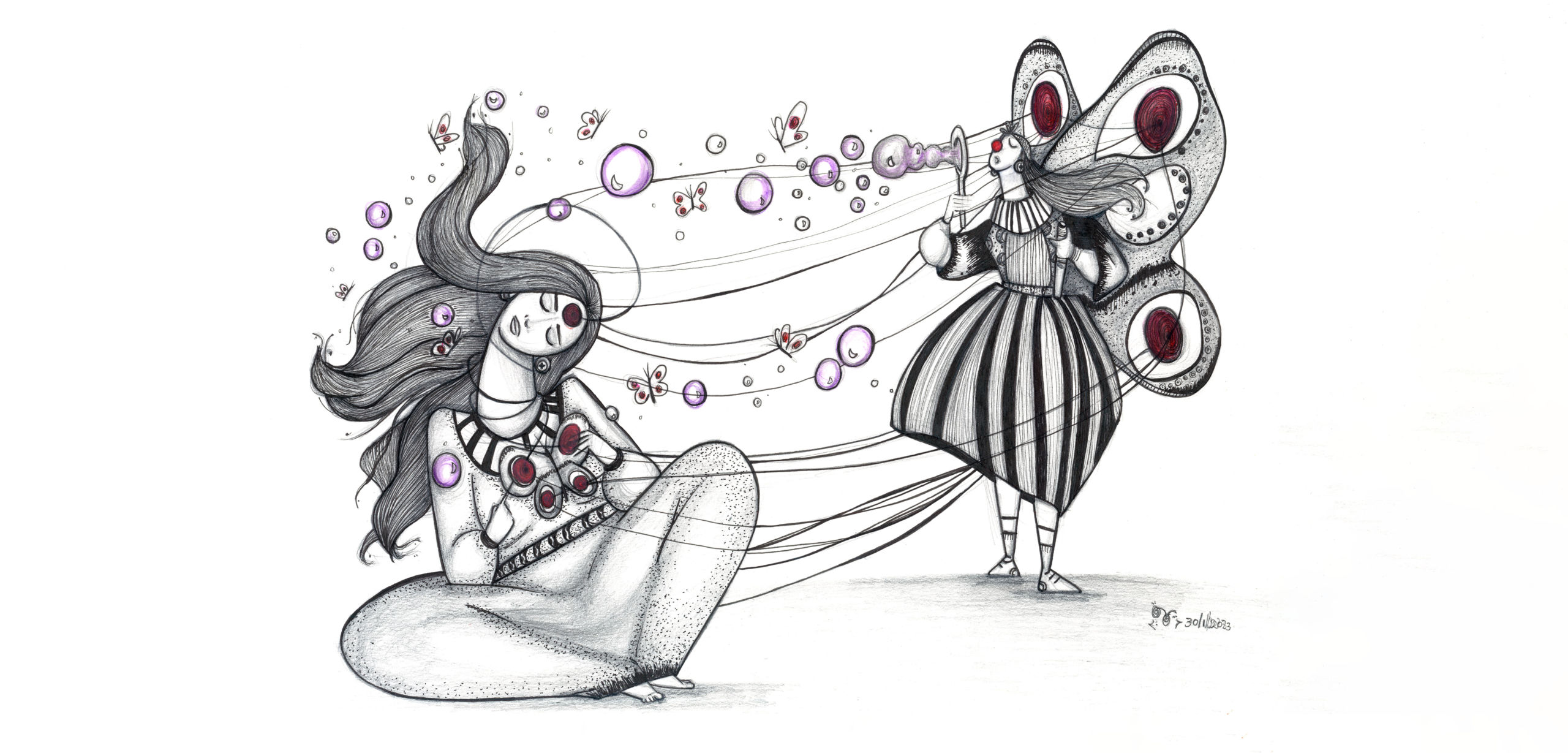عند سؤاله في مبنى الفيدرالية بعد تقديم استقالته، يقول هنري بطل رواية “مكتب البريد” لتشارلز بوكوفسكي إنه استقال من عمله ساعياً للبريد ليمارس مهنة. ما المهنة التي سيمارسها رجلٌ على عتبة الخمسين؟ ردّ هنري الذي يجسّد سيرة المؤلّف.. سأصطاد. يصطاد السمك ويربّي الخنازير والدجاج ويحلم أن يجني عشر آلاف بل عشرين خلال ثلاثة أشهر.
حين حلّ عيد ميلادي الثالث والأربعين قبل أسابيع، استعدتٌ السؤال ذاته وأنا أحدّث نفسي كيف ضللت الطريق إلى الصحافة منذ نحو عقدين، وظننت أنها الوظيفة الملائمة لكسولٍ خائبٍ مثلي أراد أن يُمضي حياته في القراءة والثرثرة، حيث يمكنني الاستيقاظ حوالي العاشرة والذهاب إلى الجريدة لأعالج صداع الشراب باحتساء كميات مهولة من القهوة والكتابة عن محاضرة أو معرض أو حفلٍ موسيقي تابعته في الأمس، ثم الخروج متسكعاً في المدينة التي أعيد فيها لياليّ وأيامي، تماماً مثل بطل بوكوفسكي الذي قضى أحد عشر عاماً يوزّع الرسائل ويجد مساحة كافية لممارسة الحماقات و”الرذائل”.
لكن أية مهنة أصلح لها اليوم كوني لا أتقن الصيد، ولا نهر يؤنس عمّان! ربما أصبح مزارعاً. سارعت بالاتصال بربيع محمود ربيع، الباحث في تراث منسيّ لبلدٍ طُمست ذاكرته أو تكاد، وأخبرته أن يؤمّن لي مجموعة من الأصص وتراباً وشتلات بندورة وباذنجان وفلفل وكوسا وثوم وبصل وكزبرة ونعنع، ولم أعلمه بهواجس منتصف العمر، مدعياً أنني سأبتدع هواية تسلّيني بمنأى عن “النمائم الثقافية” ومناكدة الحظ العاثر.
أرقب حركة الناس في الشارع من شرفة بيتي، وأختلس نظرة إلى الأصص التي لم تغادر مكانها على مكتبي المهجور، منصتاً إلى أصوات أهالي الحيّ الذين يتعاركون بسبب كتابات خطّها أبناؤهم المراهقون على جدران عبّروا خلالها عن مشاعرهم حيال جاراتهم اللواتي كُتبت أسماؤهن بوضوح، إضافة إلى قلوب حب تخترقها السهام.
أرقب حركة الناس في الشارع من شرفة بيتي، وأختلس نظرة إلى الأصص التي لم تغادر مكانها على مكتبي المهجور، منصتاً إلى أصوات أهالي الحيّ الذين يتعاركون بسبب كتابات خطّها أبناؤهم المراهقون على جدران عبّروا خلالها عن مشاعرهم حيال جاراتهم اللواتي كُتبت أسماؤهن بوضوح، إضافة إلى قلوب حب تخترقها السهام.
ما الذي يشغل رجل وحيد مثلي بكلّ هذه الترّهات؟ وما الذي يدفعني للتلصّص على مشاجراتهم؟ لم أمتلك إجابة محدّدة، إلا أنني تواجهت مع شريط ذكرياتي الذي مرّ سريعاً وتوقّف عند إيناس، ذات العينين العسليتين الواسعتين، والسن الضحوك، وقوام رفيع كانت تختال فيه بين الصبايا؛ المرأة الأولى التي قرّرت أن أواجه الدنيا من أجلها، وكنت فتى غضّاً في الثانية والعشرين ناقماً على قيود العائلة والمجتمع والمؤسسة، حتى التقاني شقيقها عصر ذات يوم، وقال بنبرة متعالية إن أصولي تحول دون التقدّم لخطبتها. شرق أردنيون وذوي أصول فلسطينية يتقابلون في معركة دونكيشوتية!
أيقنت باكراً أن غضبي الذي يملأ الكون لا ينقر ثقبًا في جدار تشيّده أوهام إقليمية مقيتة، وأذكر أنني أستسلمت إلى قصيدة بدر شاكر السيّاب الذي أخفق لأسباب خارجة عن إرادته أن يحصل على حبّ امرأة، ووجدتني أردد معه، ورأسي مدفون بين وسادتين: “وما من عادتي نكرانُ ماضيَّ الذي كانا/ ولكنْ.. كلُّ من أحببتُ قبلكِ ما أحبّوني/ ولا عطفوا عليَّ، عشقت سبعاً كنّ أحياناً/ ترفّ شعورهنَّ عليَّ، تحملني إلى الصين..”.
ظلّت الأصص متروكة على المكتب تذكّرني بعجزي عن هجران مهنةٍ لم تعد تشكّل مأوى، وغدت حملاً ثقيلاً كلما سعيت إلى التعريف بهويّتي، ولم يعد بإمكاني تصديق أيّ شخص يبدي تقديره بمقالاتي الرديئة، وهممت بالتفكير بسموم تنهي أقداراً لم أخترها، لكن صرخة هنري هزّت دواخلي: “.. وضعت سكّيناً كبيرة حول حلقي في المطبخ، وقلت في نفسي، مهلاً، يا رفيق، لعلّ طفلتك أرادت أن تصطحبها يوماً إلى حديقة الحيوان. الآيس كريم، وقرود الشمبانزي، والنمور والطيور الحمراء والخضراء، والشمس الآخذة في الارتفاع، زاحفة نحو شعر الذراعين، تمهّل، يا رفيق”.
تتذكر بابا لما كنا صغار
نتالي.. نتالي ابنتي التي أحتفي بعيد ميلادها الخامس بعد أيام، تباغتني على الدوام بأسئلتها حول عمري، وعبثاً أحاول معها عدّ السنوات، بأصابع يدها ويدي، وجمع الأرقام وطرحها، لكنها تخرج كلّ مرة بجواب مختلف لا صلة له بحساب العمر.. بابا، انت أكبر مني، وترفع ثلاثاً من أصابعها أو أربعاً أو خمساً، ثم تعاود الكرّة بالاعتماد على طول قامتي وقامتها للتعبير، فتشير بيدها إلى مسافة معينة على الحائط باعتبارها فارق الأعوام بيننا.
كيف سأُفهم صغيرتي أن حضارات بلاد الرافدين قبل نحو خمسة آلاف سنة، هي من اخترعت الزمن وقسّمته إلى أيامٍ وساعات ودقائق، وهي لا تزال تستعمل إلى زمننا هذا مع قليل من التعديلات. وأن البايليين ابتكروا أيضاً اثني عشر برجاً وفق نظام فلكي يصنّفني ضمن مواليد الحوت هارباً من الواقع إلى الخيال، ويضعها مع مواليد الأسد الذين يبرعون في القيادة والتحكّم، لنكون وفق النظام ذاته ذا برجين متوافقين بعد رسم مواضع اختلافهما.
نتالي ابنتي التي أحتفي بعيد ميلادها الخامس بعد أيام، تباغتني على الدوام بأسئلتها حول عمري، وعبثاً أحاول معها عدّ السنوات، بأصابع يدها ويدي، وجمع الأرقام وطرحها، لكنها تخرج كلّ مرة بجواب مختلف لا صلة له بحساب العمر..
إنها لعبة مخصّصة للكبار فقط لطالما وددت نسيانها وربما إيقافها، فانساق وراء غواية نتالي في ابتداع أحداث تمضي خارج زمنها.. “تتذكر بابا لما كنا صغار، كنّا نقطف ورد وناكل”، و”تتذكري بابا واحنا صغار، لما عملنا عصفور من الطين وطار”.
تقفز الصغيرة بعد التلاعب بالزمن إلى مناكفتي على طريقتها. “الكرش” الممتلئة كما تحبّ أن تجسّها براحة كفّها الصغير ما تحسّه من علامات تدلّ على تقدّم عمري، فأنا أكبرها ببطن مكوّرة، ولأني أطلق شعر ذقني الذي سيملاً وجهها شعراً مثله لمّا تكبر، ولا تسعفني الكلمات لأخبرها أن وزني الزائد محصلة خمولٍ وبلادة لا طاقة لي على التخلّص منهما، وأنني أطلقت لحيتي حداداً على الوباء الذي مسّ عقولنا ولم نشف منه بعد، ولن تنمو الشعيرات على وجنتيها بالطبع، لكن أؤثر على ذلك كلّه مزيداً من المشاغبة وإطلاق الضحكات على عالم مجهول بالنسبة إليها وترغب استكشافه، وعلى عالمٍ يتداعى أمامي ولا أدعي رباطة الجأش تجاهه إلا في حضورها.
لا زلت لا أعرف
فقدتُ أعز الرفاق في سنة الوباء، على درب طويلة لا زلنا نمشي عليها ولمّا نصل بعد. إنه الروائي إلياس فركوح الذي تعلّمت منه أثر المحو والإضافة في الكتابة باعتبارهاً فعلاً يشيد المعنى وينقضه في آن، ولا تزال مقولته ترنّ في أذني “لا زلت لا أعرف. لا زلت أكتب”.
في الخامس عشر من تموز/ يوليو من العام الماضي، صفنت إزاء الموت المهيب دافقاً بأسئلة لا تكترث البتّة بانتهاء الأجل، إذ لم يشكّل لي هاجساً حتى اللحظة، غير أني استوحشت المضي في حياة يسقط منها صديق عتيق على غفلة.
متدثراً بقلقي تقاذفتني الأرياح في الأربعين، وبتُ أكثر قادراً على رسم خوفي في اتجاهين؛ أولهما الخرف أداة الزمان الحادّة في هدمها ذاكرةً اتكئ عليها في توثيق الحدث وتأمّله، عدّة وأدوات طوّعتتها في مهنة الصحافة، وفي مقاربة الحال والأحوال، وثانيهما فقدان صوتي حيث تتراءى كلّ سنّي الطفولة أمامي بلساني المربوط الذي فكّ قيده متاخراً، فقادني تأخّر النطق إلى العزلة والانطواء والاستعاضة عن التواصل مع الآخرين بخربشات على ورق ستشكّل لاحقاً معنى الكتابة لديّ.
صفنت إزاء الموت المهيب دافقاً بأسئلة لا تكترث البتّة بانتهاء الأجل، إذ لم يشكّل لي هاجساً حتى اللحظة، غير أني استوحشت المضي في حياة يسقط منها صديق عتيق على غفلة
في قصة “خارطة السهو”، يتساءل فركوح.. “من يسعفه ليجتاز الوقت الكثيف، ويأخذ بيده ليقطع الشارع المزدحم؟”، ولكن بطله أضاع عدّه لعمره الفائت، فلم يعد يمتلك يقين الآتي. لا يقين يواجهه سوى أرقام الوقت بزواياها المنكسرة، يبتلعها الظلام المحيط بلوحتها الشاخصة ليلفظ، على الفور بنأمة اصغر من أن تخضع لأيّ قياس، رقماً منسوخاً يدعي سيطرته وتحكّمه بحسابات الزمن.
ما هذه المتاهة يا صاح؟ سنون تمرّ والرجل هو الرجل. تلك ورطة أكبر، رغم أنني فعلت مثلك مفلتاً من الأرقام والعدّ، إلا أنني بقيت برفقة “أثر من يقين مفقود”، كما قلتَ يوماً. هذه هي معادلة الأربعين، وعليّ استعيابها أو التعايش معها. أما إنغمار بيرغمان فلاذت بطلة فيلمه “بيرسونا“، الأثير على نفسي، بالصمت احتجاجاً على فظاعة الحياة وفجاجتها، فأرسلها إلى بيت مطلّ على البحر ترافقها ممرضة في محاولة منها لاستنطاق مريضتها، وهنا تنطلق في اعترافات وبوح بكل أسرارها وآلامها وأحلامها وخيبات أملها، وترتبطان بحالات حسّية وتفاعلية متعدّدة وغريبة؛ غضب وحزنٍ وانجذاب واشتباك وتماهٍ، لتغادرها الممرضة بعد أن قررت إليزابيث المكوث في صمتها المثالي إلى الأبد.
حمية منتصف العمر
نجوت حتى اللحظة من الزهايمر وفقدان صوتي. نجوت من كابوسيْن يكبّلاني في الأربعين، لكني استسلمت إلى تعبٍ شديد ونعاسٍ لا يفارق نهاري وليلي، وحين تواجهت مع الطبيب وبيديه الفحوصات والأشعة، وهو يرمقني بنظرة نصفها تعاطف، ونصفها الآخر تهديد، وأشار لي بسبّابته، قائلاً.. الدهون على الكبد تقارب الأربعة سنتمرات، ونسيجه في بدايات التلّيف. سكونٌ سادَ المكان لبرهة، ثم واصل.. أنت تواجه الأمر في منتصف العمر، ما يعني التزامك بالحمية الغذائية متخلّصاً من نزعات طفولية تحاصر الصبيان وكبار السن كذلك، ليستدير عقب ذلك بكرسيه تجاه النافذة، ويعدّد قائمة الممنوعات.
أمقت النصائح والتعليمات منذ الصغر، لكنها تبدو أكثر وطأة في منتصف العمر، خلاف ما يحسّ به طبيب يقرأ لغة مجرّدة من أرقام ومعطيات ويخفق في تأمّل الرغبات، فماذا يعني أن يحيا المرء بلا ملحٍ ولحم الضأن والخمر! أنصاع إلى حميةٍ تخالف مزاجي وعادات الطعام والشراب لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، وأشتمّ رائحة المستشفيات تتسلّل إلى مطبخي وتعمّ المكان؛ الرائحة المتخيّلة إذ تلقننا درساً.
لكني أراود نفسي عن هفواتها، فأسدّ أنفي في لحظات مسروقة وأرشّ ملحاً على صحن “السلَطَة”، وأحضّر كأساً وثانية وثالثة نهاية كلّ أسبوع وأتظاهر بعدم العدّ، وأتخيّل لحماً أحمر في طبق الخضار الذي تتراءى فيه قطع اللحم الأبيض، وفي البال الفيلم الكرتوني “هروب الدجاج Chicken Run” للمخرجين نيك بارك وبيتر لورد، حيث تقوم فيه الدجاجات بأول ثورة لهن في التاريخ، ويخرجن عن وصاية أسيادهن الذين يريدون لهن العيش في القن إلى الأبد. في هذا “القن”، سأستقرّ أنا!
نجوت حتى اللحظة من الزهايمر وفقدان صوتي. نجوت من كابوسيْن يكبّلاني في الأربعين، لكني استسلمت إلى تعبٍ شديد ونعاسٍ لا يفارق نهاري وليلي
بين النمط الغذائي الجديد وبين تمرّداتي عليه، أستذكر موروثاً أردنياً يرى في عقْد الأربعين ذروة الفحولة للرجال، وإن كان يقايضهم قوّتهم الجنسية المفترضة بالتخلّي عن زيغ سنيّ الشباب الأولى وفورته، حيث الفحول عليهم أن يصبحوا أكثر اتزاناً و”عفّة”، وتلك مفارقة لا تدركها الثقافة الشعبية التي تحبس الجسد حين بلوغ اكتماله في “رزانة” متوّهمة من أجل إخضاع صاحبه لمعايير اجتماعية تقبل رأيه بعد تصدّره “مجالس الرجال”.
شهوةٌ بدئية تسيطر على مخيّلة الأربعيني الذي استطاع أخيراً أن يتساوق مع حيوانه، فلا يسبق أحدهما الآخر، أو أنها باتت مفتوحة لأقصى مدى لم يكن سهلاً وصوله من ذي قبل، حيث يتحضّر الشبق على نار هادئة من لسع قبَلٍ وأنفاس تتصاعد وحمّى أجساد لا ترتوي، والحواس تترصّد مكامن اللذات في نشوة لا حدود لها، مثلما يصفها يانيس ريتسوس.. “جسدٌ عارٍ/ يستلقي أو ينهضُ/ جغرافيا مجهولةٌ/ دُرِسَتْ ألفَ مرّةٍ/ حُفِظَتْ عن ظهرِ قلبٍ/ مجهولٍ-/ أسمعُ الطَّقْطَقَةَ -/ مَنْ رمَى النّردَ/ على بلاطِ الحمَّامِ؟”.
أستيقظ كل أحد بدمٍ حار، وخلايا دماغي تستلبها رعشات غامضة تملأ جسدي المثقل بالانتظارات والوعود، كأنه سباق دائم لإثبات كينونته لحظة خضوع مركّبة، في وظيفة محرّر ثقافي تتحوّل بحسب منظور ماركس إلى أداة لقهر الذات في ظلّ شروط إنتاج يتمّ فيها شراء قوة العمل، وقهرها في ساعات عمل تنوف الأربعين ساعة أسبوعياً، وتوتّر وإرهاق وشدّ أعصاب بلا طائل، لتشكّل عطلة نهاية الأسبوع هروباً من البؤس النفسي نحو إشباع حاجات بيولوجية صرفـة.
الحلم بكل شيء ولا شيء
وكذلك خضوع يتصل بمثقفٍ يعاين أحوال مجتمعه بالقطعة، دون أن يراها مترابطة، ويعجز عن قراءةٍ تُحيط بالتغيُّرات المستمرّة في طبيعة علاقته بمكانه وهويّته وتراثه ومستقبله، ويغلب عليه تفكير رغائبي يعكس أهواءه ومصالحه من جهة، وانحيازاته الإقليمية والمذهبية والطائفية وغيرها، ما يخلص إلى فشل ذريع في ما يتَّصل بدوره الأساسي الذي يفترض أن يجمع الفكر والإبداع بمناقبية أخلاقية، وبمعنى أدق أن يشكلّ ضمير المجتمع.
مكاشفات قرّرت الذهاب إليها عندما طُرح عليّ سؤال تقادم العمر، ربما ينقصها جردة حساب إضافية تتعلّق بعبء الدين في مجتمعاتنا العربية إذ انتهى مشروعه الاجتماعي السياسي، منذ قرون عديدة، ويعود مستحيلاً أن يكون الإيمان شأناً فردياً خالصاً، لا وصاية عليه لسلطة أو حزب أو ميليشيا، لعلّنا نتمكّن من بناء دول حديثة قبل أن تتحوّل جميعها إلى مقابر جماعية أو ملاجئ للعاجزين.
بماذا أحلم في الأربعين؟ بكلّ شيء ولا شيء. أعود إلى بوكوفسكي في إحساسه بأن.. “شرب الكحول هو شكل من أشكال الانتحار حيث يُسمح لك بالعودة إلى الحياة والبدء من جديد في اليوم التالي. إنه أشبه بقتلك نفسك، وبعدها تولد من جديد. أعتقد أنني عشت عشرة أو خمسة عشر ألف حياة”. حيواتٌ منزوعة من اليقين المبتذل، ومنذورة لشواردها، محفوفة بالغضب والأمل، ومليئة بهذر وصخب وضجيج مهدور، اختار بوكوفسكي لبطله، الذي يمثّله بالتأكيد، أن يكتب رواية أولى على عتبة الخمسين، وها أنذا أبدأ بكتابة يومياتي وهذا مفتتحها.