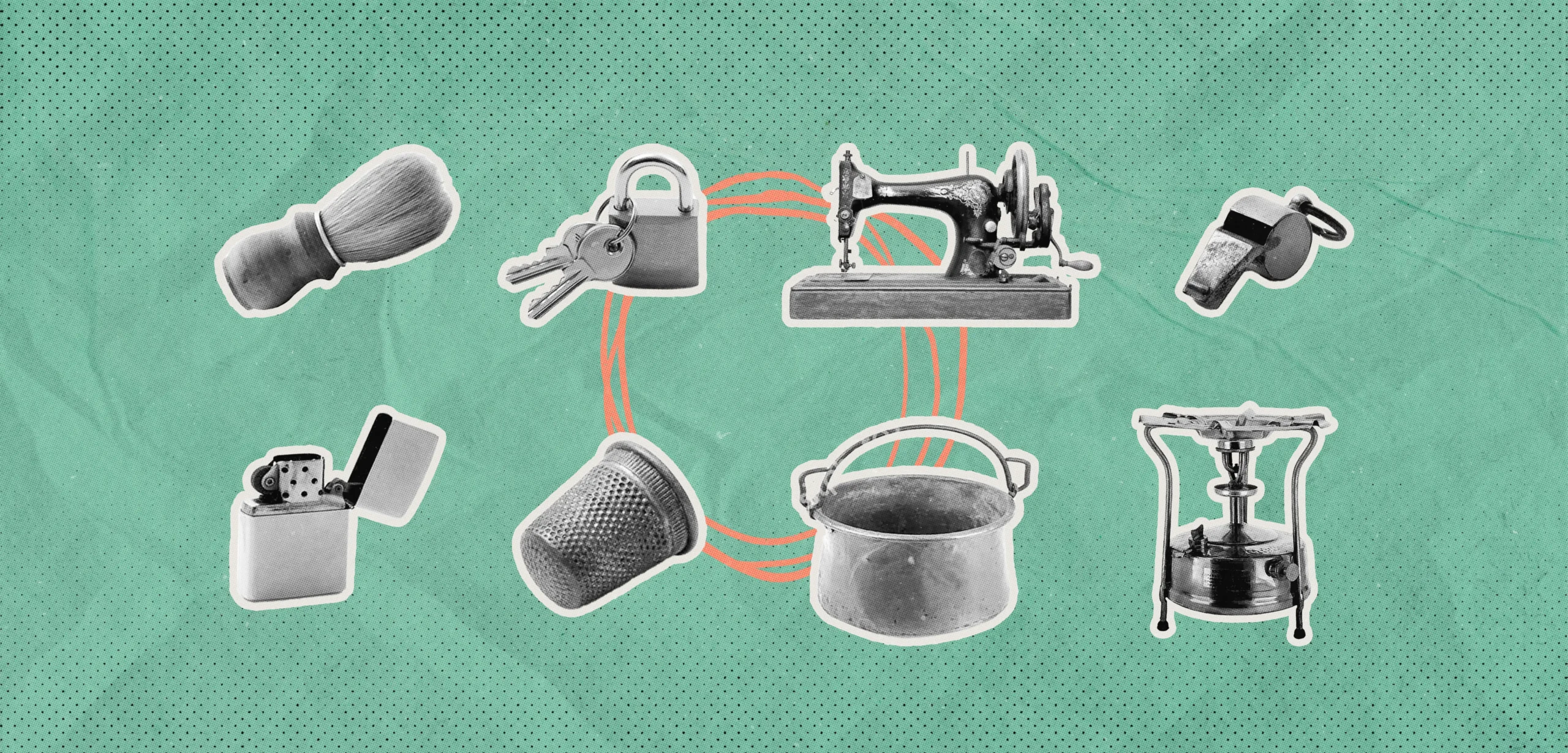شدّالقلوع، يامراكبي
مفيش رجوع، يامراكبي
تراث نوبي. أحمد منيب
(1)
مالمو تقع في أقصى جنوب السويد، ثالث أكبر مدن المملكة، ويتجاوز تعداد سكانها الثلاثمائة ألف بقليل.
مدينة لاجئين، هذا ما يقوله الجميع. أكثر من ثلاثين بالمائة لاجئون. وأنا أسكن على بعد دقائق من الحي الفقير الشهير “روزنغورد”، الذي تنتشر فيه المافيا، قريباً من ساحة “مولن”، مركز تجمع العرب. تحوم هيلكوبتر الشرطة فوق المنزل والمنازل المجاورة، في عملية تفتيش غير مقنعة. على بعد دقائق، قُتل عضو في عصابة مافيا على يد زملائه. الشمس ساطعة، وسوق الخضرة يذكر بالوطن: عمليات بيع ومساومة سريعة وذكية ومملة. أسعار رخيصة، ووجوه مكتئبة، وكسل طبيعي تتسم به المدن الصغيرة. في المطعم السوري، امرأة عراقية تنهر أخاها الذي سينتهي به المطاف في البوسنة: لماذا البوسنة يا أخي؟ الرجل تجاوز الستين، ولا يفكر بالعودة إلى العراق. يقول إنه يريد بلداً مسلماً. تنهره بقسوة: “العراق بلد مسلم، الجزائر، مصر، لبنان: هل تستطيع العيش هناك؟” لا أفهم التفاصيل. أغادر متذمراً من غياب الجودة في الأكل.
فلسطينيون كثر أتوا بعد اقتحام بيروت 1982، ينافسهم عراقيون هربوا تدريجياً منذ أيام الحرب العراقية الإيرانية ثم عاصفة الصحراء فالحصار الوحشي الهمجي الطويل والعقوبات الذكية التي أبقت الطاغية على عرشه أكثر من عقد؛ واليوم، السوريون.
إن مشيت بخط مستقيم، من “روزنغورد”، الحي الأعنف في الشمال البارد، بغالبيته من المهاجرين المسلمين، إلى الميناء وما بعده من أحياء سكنية حديثة، ستقطع الكوكب الأرضي من الجنوب إلى الشمال: تدريجياً، يختفي السود والمحجبات، وتتحسن الحالة المادية للأبنية والمتاجر والبشر والكلاب والأرصفة: في قلب المدينة، منتصف المسافة بالضبط، مطعم لبناني فاخر، بأسعار مرتفعة: معظم الزبائن بيض شقر بأجساد عمالقة؛ بعده مطاعم “ستيك” و”سوشي” وبار أيرلندي وغيره مما لا تجده في “مولن”.
أما الميناء، حي الطبقة الوسطى العليا، فيفصله عن حي المافيا ربع ساعة على الدراجة الهوائية، وقرون من التقدم العلمي والكولونيالية البيضاء؛ ولكن يجمع الطرفين تشدد ديني وعرقي ونفسي: يشبه الميناء في صفائه ونقائه العرقي “الكومباوند” الإنكليزي في الهند منتصف القرن التاسع عشر. على البحر، تصل إلى أحياء لا يسكنها إلا أبناء السويد: حتى الأوروبيون يختفون هنا، حيث يلطم الموجُ الميناء بقسوة، صيفاً وشتاءً.
أعود إلى البيت، لأتأمل لوحة غير مشهورة لإدغار ديغا فيها امرأة تدير ظهرها لنا فيما هي تتأمل لوحات في متحف. بجانبها صورة فوتوغرافية التُقطت عام 1982 في طهران، لامرأة منقبة تمشي تحت مبنىً يحمل ابتسامة ضخمة للخميني الذي عُلّقت صورته كشبح هائل يغطي كل المبنى. ورق جدران لم يتغير منذ أنشئ المبنى سنة 1948، يحملني إلى ورق الجدران الوحيد الذي عشت في ظله: “ملحق” صغير عشنا فيه طفولتي في حي الأكراد في دمشق.
أتحسس الكتاب الذي استعرته من المكتبة، مكتبة مالمو التي كانت قلعة في ماضي الأيام لملوك البلد البروتستانت المتزمتين: كتاب للاجئ آخر، ألكسندر كواريه، وهو يهودي روسي عاش في فرنسا، واشتهر كأحد أهم مؤرخي فلسفة العلم: لجأ إلى صديقه طه حسين الذي استضافه في جامعة القاهرة وأمّن له عملاً محترماً في جامعة كانت مميزة، عندما اجتاح النازيون باريس، قبل ان ينتهي به المطاف في أمريكا. عدوٌ لدود للوضعيين وللماركسيين، وصاحب رؤية للعلاقة الوثيقة بين الميتافيزيقيا والعلم. عاد إلى باريس لاحقاً، وقاد حملة كبيرة ضد زيارة هايدغر للعاصمة المحررة، هايدغر الذي رأى فيه نازياً غير مقنّع.
نسيم خفيف، وصوت عاصي الحلاني من الحديقة يعلو مغنياً أغنية عراقية ساحرة شدا بها فؤاد سالم مراراً، للطير والنصيب والحيرة: “أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني لهلي ولاني لحبيبي.” أجلي الصحون المتراكمة، وأدندن، بدون رغبة ولا متعة، الأغنية العراقية، في انتظار قدوم ابني من الروضة، كي ألعب معه “طميمة”، وأختفي…
الصور: Christer // Antti Lipponen. وفق رخصة المشاع الإبداعي
(2)
بين مالمو وكوبنهاغن جسر كبير جداً، وشهير؛ موضع فخر للسويد والدنمارك، يسمى “جسر أوريسند”. كل ثلث ساعة تقريباً يتحرك قطار بالاتجاهين، يحمل الناس إلى أعمالهم ومشاغلهم. مع بداية ما سماه الأوروبيون “أزمة اللاجئين” سنة 2015، أي هجرة وتهجير نصف الشعب السوري، التي ترافقت مع تدخل سلاج الجو الروسي بعد فشل مرتزقة إيران الأفغان والعراقيين واللبنانيين في حسم المعركة لصالح النظام السوري، أعادت الدنمارك والسويد العمل بمركز مراقبة الحدود بين البلدين، مخالفة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع التفتيش بين بلدان الاتحاد. أصبح العبور ممنوعاً بدون جواز السفر، لكل المسافرين بلا استثناء، في إجراءات مؤقتة طالت كثيراً.
أربع سنين تقريباً، أعيش بين كوبنهاغن ومالمو: أربع سنين، لا يحمل البيض جوازات سفرهم، ويبتسم لهم موظفو الحدود معظم الأحيان، على الطرفين السويدي والدنماركي، غامزين لهم بمحبة؛ في حين يضطر الراكب الأسمر، سواء كان مهاجراً -أم أجنبياً أم سويدياً أم دانماركياً من أصول غير بيضاء، ان ينزل من القطار بذل. الكل يعرف بهذه التصرفات: الحكومتان السويدية والدنماركية، والركاب البيض، والركاب “الآخرون” غير البيض، والموظفون الذين يمارسون العنصرية علناً وبدون أدنى خجل.
يعرف الأوروبيون والأمريكيون هذا الجسر جيداً، فقد كان محور مسلسل بوليسي سخيف جداً (أليست كل المسلسلات والأفلام والروايات البوليسية سخيفة؟) عن جريمة وقعت عليه، حقق نجاحاً هائلاً بين المشاهدين: في المسلسل كله، لا يشير أحد، بالطبع، إلى العنصرية الممنهجة التي تمارس يومياً، ويكتفون بتصوير براعة وحنكة الشرطة على الطرفين، في حبكة ذكية جدا، وتافهة تماماً، ولا تمتّ بصلة إلى الواقع الذي يعيشه الناس على طرفي الجسر.
(3)
في عاشوراء، مر الموكب الحسيني الكبير نسبياً، أمامنا في الحديقة الصغيرة التي يؤمها السويديون والمهاجرون، وهي إحدى الأماكن القليلة التي يختلط فيها الطرفان.
علائم الرعب على وجوه السويديين، والمرح والسخرية على وجوه المهاجرين، خصوصاً السنّة منهم، لا يمكن تجاهلها.
اللطم خفيف، رايات حمراء وسوداء كبيرة تلمع، يتقدمها علم واحد عليه صليب كبير: علم السويد الذي يسير وحده في المقدمة، بمسافة واضحة تفصله عن الموكب، يحمله شاب ملتح مفتول العضلات ينظر حوله بثقة وغضب، كأنه يحمي الحسين وصليبه من نظراتنا العدائية الهازئة.
سألت أحد المشاركين عن فكرة الموكب، قال لي: “اجتمعنا نحن المسلمين وقررنا أن نتجه إلى قلب المدينة لنحيي ذكرى الشهيد والعدالة الغائبة”. سألته بفزع: “من نظم الموكب؟”. لم يجب. سألت رجلاً يركض بين الناس وبيده هاتفان. ضحك وقال: “لا أحد”. سألت مراهقتين، فقالتا: “الحسينيات قررت تنظيم الموكب.”
“حسينيات؟ شو يا أختى نحنا عايشين بكربلاء؟ حسينيات شو لك عمو؟”
ضحكتا وانصرفتا.
الرجال في المقدمة، يتبعهم النساء. نسبة واضحة من الشيعة الآسيويين. الأغلبية عراقيون ولبنانيون. يوزعون مناشير تشرح قصة الحسين. القصة غير واضحة وغير مفهومة على الإطلاق: “كيف يقتل المسلمون حفيد الرسول؟ ولماذا يجب أن يكون الحكم بيد آل البيت؟” يسألني بعض السويديين. أقول العلم بيد الله.
والله القصة غير واضحة.
يختفي الموكب، تاركاً خلفه شعوراً غريباً جداً: سواد في سواد، ولطم وهمهمات حزينة صادقة عن قتيل شاب متقد صادق طموح خانه القدر وأتباعهُ، قبل 1400 سنة، وأسئلة كثيرة عن الليبرالية، وكوني من أصول سنية هارب من أولئك الذين نظموا هذا الموكب بالسر -السفارة الإيرانية وحزب الله اللبناني- وأخاف الموكب الحسيني أكثر مما يخافه السويديون العلمانيون الملاحدة.
على الأرض، عشرات المناشير السوداء الداكنة، باللغة السويدية، رماها السكان الأصليون: “ياحسين” كبيرة تلمع مساءً في كل زاوية تحت ضوء القمر الخابي، بعبث غير مفهوم…
المصدر: M Rasoulov. وفق رخصة المشاع الإبداعي
(4)
زرتُ مكتب العمل مرةً واحدة. مهاجرون ولاجئون أجانب، وفقراء سويديون. فتاة مرحة تساعدني في طلبي. لغتي السويدية سيئة. تشجعني. أنتظر في ساحة عصرية كبيرة داخل المبنى، بكراسٍ ودواوين حداثية غير مريحة. خلفي، ثلاثة شبان عرب يسخرون من مكتب العمل، وأحدهم يشرح كيف خدع المكتب أربع مراتٍ.
يأتي دوري بعد ساعة تقريباً، لأدخل مكتباً صغيراً لتستجوبني موظفة تضحك باستمرار.
تأخذ مني بعض المعلومات. تهز رأسها بسرعة.
تقول أكثر من مرة:
“لا يوجد عمل في مالمو.”
لا أعلم لماذا تكرر تلك الجملة، كلازمة موسيقية في أغنية شعبية.
فجأة، تكبر ابتسامتها، وأنا أجيب على السؤال حول شهاداتي. تقول ببطء، بإنجليزية واضحة:
“لا، لا. أقصد حقيقةً دراستك أنتَ.”
لم أفهم.
أعدتُ الكلام عن الدكتوراة في الفلسفة، وأنني أعرف أن مكتب العمل لن يجد لي عملاً كمحاضر جامعي؛ ولكن، أود أن أعرف الخيارات المتاحة، لو أمكن. لا أمانع في عمل يدوي، ولكنني أفضل شيئاً ما قريباً من التعليم والكتابة.
تكرر، بدون ابتسامة، للمرة الأولى منذ دخولي المكتب:
“شهادة الدكتوراة بحث علمي يأخذ وقتاً طويلاً بين ثلاث سنين وخمس سنين، وربما أكثر. وهي أمر صعب ومعقد، خصوصاً عندما يقول المرء إنها شهادة دكتوراة في الفلسفة من بريطانيا العظمى. هل تفهم؟”
هذه المرة، كنت أنا من ابتسمَ.
“عندي شهادات أخرى.”
عادتْ ابتسامتُها العريضة.
“لا مشكلة. اتركْ لي ملفك وسأتصل بكَ في غضون شهرين أو ثلاثة. هناك مطاعم كثيرة بحاجة إلى عمّال.”
وأنا أخرجُ، غمزتني ثم هزت رأسها يميناً ويساراً، كدليل ثانٍ على ذكائها أنها كشفتْ الغش والخداع.
ذهبتُ إلى الفتاة المرحة. أخبرتها أن السيدة العنصرية تتهمني بأنني أكذب.
ارتبكتْ، وأصبح وجهها أحمر كاللفت. قالتْ إنني أستطيع تقديم شكوى. عليّ أن أملأ الطلب باللغة السويدية، ثم أعود إلى مقابلة حول الشكوى بعد أيام. ولكن هذه الشكاوى تأخذ وقتاً طويلاً، وعادةً تُشكّل لجنة لبحث الموضوع. بعد ذلك، ربما بأشهر، سيطلبونني مرة أخرى من أجل تقديم شهادتي. ثم…
أوقفتها هنا. قلتُ لها إنني لا أريد تقديم شكوى.
اعتذرتْ، وقالت إنها تفهم كل شيء.
لم أصدقها.
غادرتُ المكتب، ولمّا أجد عملاً بعدُ.
تكرر هذا الموقف في مدرسة اللغة أيضاً مرتين. لم يصدقونني، ولكنهم قالوا إن الشكاوى ممنوعة هناك، كلياً.
على الطريق إلى البيت، كنتُ أفكر بحزن بأن هذه الفتاة الطيبة ستتحول، بعد سنوات، إلى تلك السيدة العنصرية.
المصدر: mariel drego. وفق رخصة المشاع الإبداعي
(5)
في السويد، جنة الله على الأرض، كما يصورها المخيال العربي، وغير العربي أيضاً، يُمنع شراء الكحول إلا في محال خاصة، لأن الشعب لا يؤتمن على نفسه: محاولة في أكثر الدول تقدماً وديمقراطية لضبط جموع الناس.
لا يتذمر الناس من القيود التي تفرضها عليهم الحكومة: بل يجدون الأمر مسليا ومضحكاً. مع وصول النيوليبرالية المتأخر جداً والقلق إلى الدول الاسكندنافية، والرغبة بتحرير الاقتصاد وتفكيك دول الرفاه الأكثر نجاحاً في التاريخ وأقربها إلى الاشتراكية، لا يُطرح موضوع الكحول للتداول.
الدولة أيضاً تتدخل في تنظيم حياة الناس في كل التفاصيل: التعليم الحكومي المجاني الموحد (الذي انتقده الليبراليون والفوضويون) والضرائب الكبيرة على المداخيل وفرض إجازة رعاية الطفل وتوسيعها بشكل ممنهج ومقصود لتشمل الآباء، بالإضافة إلى ارتباط الكنيسة بالدولة بشكل رسمي، في بلد علمانيته شديدة الوضوح، ولكنها قليلة الصخب.
في السويد، جنة الله على الأرض، يعاني الناس من الاكتئاب المزمن، ويؤمنون بضرورة تدخل الدولة لحمايتهم من أنفسهم، ومن تعطشهم الشديد للكحول، وللشرب حتى الثمالة، كي يحتملوا الجنة التي يحسدهم عليها اكثر من ثلاثة أرباع سكان الكوكب!
(6)
الطرق الرئيسة مغلقة في المدينة، ربما للمرة الأولى، والأخيرة. مؤتمر يهودي كبير. سيارات الشرطة والإسعاف في كل مكان. مالمو واحدة من أخطر مدن أوروبا على اليهود. هناك وجود نازي قديم متعاطف مع هتلر في جنوب السويد. واليوم، اللجوء العربي المسلم والمشايخ المتعصبون. عصابات المافيا العربية تتمدد في المدينة بشكل مقيت. المؤتمر محاولة لمد الجسور مع العرب وحكومة السويد. بالطبع، دولة إسرائيل لاعب رئيس في المؤتمر.
قبل أشهر كانت ذكرى الهولوكوست. تحيي السويد هذه الذكرى، في الإعلام وفي المدارس وفي المؤسسات. لا يذكر أحد أن دولة السويد وقفت على الحياد في الحرب العالمية الثانية، وأن الانتعاش الاقتصادي، الذي ما زال مستمراً، كان أحد أسبابه هذا الحياد، والصفقات الاقتصادية مع هتلر. على أن الحياد ساعد عشرات آلاف اليهود على الهرب إلى السويد لينجوا من المحرقة.
في دورة اللغة السويدية المجانية، يعرضون فيلماً لواحدة من الناجيات. مجموعة من الطلاب العرب، بصفاقة لا حدود لها، يضحكون، ساخرين من الناجية التي تجاوزت التسعين من العمر.
جاري في الحارة يهودي، سوري: هاجر جده أيام مجاعة “السفر برلك” في بدايات القرن العشرين إلى اسطنبول، ثم الاسكندرية، فالقاهرة، فإيطاليا: أبوه وصل السويد. يقول إنه يشعر بأنه غير منتم هنا: معظم اليهود يقولون ذلك. في دراسات في السويد والدنمارك يتذمر اليهود من دولهم هذه: ويتذمرون، بكثرة، من القادمين الجدد: المسلمون. يقول إنهم يكرهونه، ويعاملونه بتعال غير منطقي، بل يقولون إنه مسؤول عما جرى، منذ خيبر. يختم جاري، اللطيف جداً، بأنه لا يهتم بالسياسة، ثم يضيف أنه سيزور إسرائيل الشهر المقبل، ويتمنى لو توقف الفلسطينيون عن المشاكل. “لماذا يمارسون العنف بحق هذه الدولة الصغيرة المسالمة اليهودية؟” يبتسم ببلاهة. أقاطعه، محاولاً ضبط نفسي قدر الإمكان، وأقول انني يجب أن أعود إلى البيت لأطبخ. أغادر مسرعاً بدون وداع، وطفله يردد كلمات عربية وعبرية وسويدية وإنكليزية، بطلاقة عجيبة.
أقرر أن اشتري فلافل، وهي سندويشة ثقيلة على المعدة لا تشبه الفلافل السوري أو المصري كثيراً. بجانبي، فتاة صومالية محجبة تفصفص البزر مع صديقتها، وتتذمر من جيرانها العرب: لبنانيون ومصريون، عنصريون جداً مع السود، بالرغم من أنهم فقراء لاجئون مثلها.
تغيب الشمس النحيلة أصلاً، ورائحة زيت الطبخ، البشعة جداً والمؤذية، من المطعم الوسخ المكتظ، تملاً الحديقة الصغيرة: ضباب خفيف، يجعل البرد القارس، الدافئ نسبياً هذا الشتاء بحسب السويديين، غير مفهوم وغير محسوس بشكل فعلي!
المصدر: Robin. وفق رخصة المشاع الإبداعي
(7)
أجلس في العيادة مع الطبيب المسنّ، نتكلم الإنجليزية.
يبتسم، يقول إنه ايضاً لا ينام جيداً، ولكنه لا يفكر في الانتحار.
يعطيني وصفة لحبوب النوم. يخبرني أنه لا حلول لمشاكلي.
يتنهد.
يقول إن مالمو في السبعينيات كانت مدينة مختلفة. الأجانب كانوا الألمان أو الدنماركيين… قبل الجسر، وقبل موجات اللجوء. كان شاباً حينها.
يبتسم وهو يتذكر شبابه.
يتابع:
“كانت مملة. التنوع هذا أفضل بكثير. ولكن…”
يتوقف في منتصف الجملة.
يقول إنه يتفهم. ولكن لا يجوز أن أنتحر. ماذا عن ابني؟
لم يجد سبباً آخر.
أنا أيضا لا أجد سبباً آخر: ليس عندي أصدقاء، ولا عمل، ولا مستقبل.
أقول إنني ممتن للسويد، خصوصاً النظام التعليمي والصحي…
أصمت في منتصف الجملة.
يسألني عن سوريا.
أتمتم بغباء عن الفقر والشوق والحرب الطويلة بخليط مبهم من السويدية والعربية والإنجليزية.
أكاد أبكي.
يقول إنه لم يفهم الوحشية التي تعامل بها النظام مع الناس. كل هذه الوحشية…
أبتسم له، تاركاً ما أتمتم به.
أغادر، والوصفة السحرية للنوم تطمئنني، وذلك التقارب المريب بيني وبين المسن السويدي الهادئ يجعل الشمال البارد أليفاً تقريباً، على الرغم من الأرق الطويل الممض الدائم.
الصور: Christer // erik forsberg. وفق رخصة المشاع الإبداعي
(8)
التقيت البارحة بفتى أفغاني كان يقاتل مع الإيرانيين في سوريا. انتمى إلى إحدى ميليشيات الشرطة التي انتشرت في سوريا بعد سنة 2014. فرح جداً حين عرف أنني سوري. قال إنه يحب سوريا، وشرح لي أن كل المعارضة “دواعش”.
يقلب دراجتي الهوائية رأساً على عقب. يدفع العجلة الخلفية، ثم الأمامية. تدوران بسرعة.
بلغة سويدية مكسرة، شرح لي قصته. خدم في سوريا مرتين: الأولى ستة أشهر، والثانية ثلاثة أشهر. لم يفعل شيئاً إلا الحراسة، والنوم. في المرة الثالثة، كانت الامور مختلفة. قالوا سيرسلونه إلى حلب، قبل سقوطها. شعر هذه المرة أن الأمور جدية، من التدريبات على السلاح إلى الصرامة في توزيع المهام. رفض، قال إنه لا يريد أن يحارب في حلب. لا يوجد مراقد شيعية هناك.
هددته الحكومة بأن توقف المساعدات التي يأخذها أبوه المريض وأمه العجوز. احتار. قال لي إنهم يعيشون في مخيمات حقيرة منذ الثمانينيات. هم شيعة، شيعة أباً عن جدّ، ويؤمنون بالخميني والخامنئي. ولكن النظام الإيراني لم يخرجهم من المخيم، لم يعطهم أوراقاً كي يعملوا. لماذا لا يرسلون الشباب الإيراني إلى سوريا؟
قبل يوم واحد من السفر إلى سوريا، هرب. مشى من شرق إيران إلى السويد. لا يعرف ما حلّ بأمه وأبيه. يأكله تأنيب الضمير، ولكنه لا يريد أن يموت في سوريا. سمع قصصاً مريعة من الأفغان عما يحدث هناك. يموتون كل يوم. ويقتلون الكثير من السوريين. هذه ليست حربه. حتى لو كانت داعش ستحكم سوريا، يشرح لي.
الفتى في الثالثة والعشرين من العمر. أتى هنا قبل خمس سنوات. لا يريد أن يدرس في الجامعة، لا يريد أن يعود إلى إيران. لا يعرف شيئاً عن أفغانستان: ولد وعاش في مخيم في إيران. يخاف البرد، يخاف الأوروبيين البيض، يخاف السوريين كثيراً. يخاف من كل شيء. يضحك بمرح. ويصلح الدراجات الهوائية بأسعار أرخص بكثير من أقرانه البيض.
نسكن، أنا وهو، في حي أغلبيته مهاجرون. كلهم يخافون من كل شيء.
يسألني عن سبب هروبي من سوريا.
أبتسم، وأقول، بصوت أحاول جعله واثقاً، إنني معارضٌ للنظام.
تلمع عيناه، وهو ينظر إلي بشكّ.
يودعني بحماسة ومحبة، يصافحني ويربت على كتفي. يتمتم معتذراً عن شيء ما.
اتمنى له صحة طيبة، وأتمنى أن يعرف قريباً ما حل بأبيه وأمه.
أتمتم معتذراً عن الكثير من الأشياء.
أخرج مع دراجتي، التي أصلحها بمهارة وسرعة، وأتجول في المدينة لمدة طويلة، محاولاً أن أتغلب على الخوف الذي يكتسحني بشكل كامل، كأنني عشبة في مخيم صحراوي..