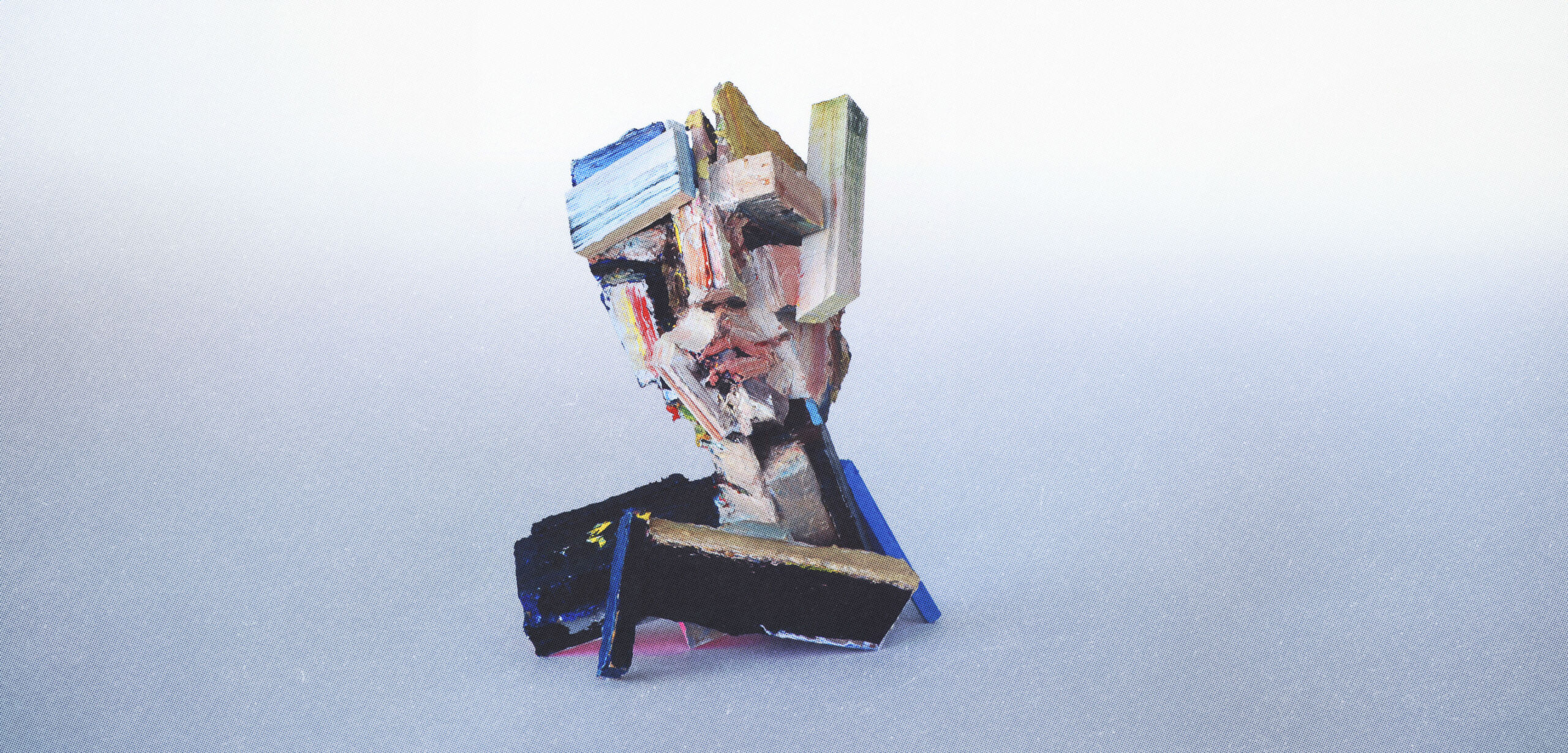لا أمد واضح للحرب الإسرائيلية على لبنان، ولو نجا النازحون من الموت، إلّا أن كلّ ما يحيط بهم يهدّدهم باستمرار. يقول فرانز كافكا «إن انعدام النوم لا يعني سوى التساؤل؛ فلو حصل المرء على إجابةٍ لنام». وفي حالة اللبنانيين والنازحين اليوم، تكثر الأسئلة؛ هل سيسقط صاروخ أثناء النوم؟ متى تنتهي الحرب؟ هل لا يزل المنزل صامداً؟ هل سيعودون ويجدون ذكرياتهم، أم أنها صارت أنقاضاً؟ هل سيعثرون على مأوى قبل قدوم الشتاء؟ وهل ستتوقّف آلة الحرب الإسرائيلية قريباً؟ دون كل هذه الأجوبة، يستحيل أن يجد أبناء الحرب طريقاً لنوم هانئ.
بين الشوارع والمدارس والمنازل المستأجرة، توزّع النازحون من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، هرباً من الحرب الإسرائيلية الأشدّ قساوة على لبنان. ورغم أنّ الحكومة اللبنانية أعلنت أنّها جهّزت خطة طوارئ للحرب، منذ عام، تبيّن أن القطاع الطبي وحده من كان حاضر لهذا السيناريو، فلم يجد النازحين مراكز إيواء تكفي، ولا فرش، ولا أسقف تحميهم من المطر حين سيهطل.
خارج البيت… خارج السرير
ليل بيروت اختلف، بأصواته، وروتينه، وأسرّة نيام المدينة وحركة عيونهم. على منطقة عين المريسة، المحاذية لبحر بيروت، تجلس هيام وشقيقتها وشقيقها، تحاول بابتسامتها الخجولة إخفاء دموع انهمرت لحظة سؤالها عن الوضع. هربت هيام من بيتها في الضاحية ليلة اغتيال السيد حسن نصرالله، عصر27 سبتمبر، بعدما اهتزّت العاصمة بأكملها جرّاء أطنان القذائف التي ألقيت. تسكن الشابّة العشرينية الآن في مكانٍ قريبٍ من منطقة عين المريسة، لكن نادراً ما تجد سبيلاً إلى النوم. تُحاول أن تُحصي أسباب أرقها: الحرب، صوت الطيران، تردّد أصوات القصف في ذهنها، خوفها مما سيأتي، والقهر من واقعها الجديد.
على بعد أمتار، تفترش فاطمة وشقيقتها الرصيف لاستنشاق بعض الهواء قرابة البحر. هربت فاطمة من قرية أرنون الجنوبيّة، وشقيقتها من البقاع، يوم اشتدّ القصف نهار 22 سبتمبر. تُقارنا الواقع اليوم بنزوح حرب تموز عام 2006، «كان الوضع مختلفاً» تقول فاطمة التي نزحت مع أختها حينها إلى منطقة طريق الجديدة في بيروت. لم تكن أموال الناس محتجزة في المصارف، وكانت لا تزال هناك مناطق محيّدة عن القصف. في الخمسينات من عمريهما، اجتمعت الشقيقتان اليوم مجدّداً تحت سقفٍ واحد، سقف فندقٍ مهجور بالكاد تم إيصال الكهرباء والماء إليه، أمّا الفراش، فهو عبارة عن قطعةٍ مستطيلة من الإسفنج.
يسهل تلمّس أوجه الاختلاف بين الحربين، من خلال إجماع النازحين والمواطنين على وصف الحرب الحاليّة بأنّها «الأغرب» على الإطلاق من بين كلّ الحروب الإسرائيليّة التي عاشوها. الاختلاف ظاهر جلياً بحدّة القصف، وأمكنته، ومناطقه، وبنك أهدافه. في حرب تموز، تركّز القصف على الجنوب والضاحية، وطال بعض البنى التحتية مثل الطرقات ومحطّات الكهرباء خارجهما. واليوم، بات كل لبنان مستهدفاً، كما أنّ مراكز إيواء النازحين، أينما وُجدت، هي هدف محتمل لإسرائيل. لا مكان آمن تحت سماء لبنان.
كانت فكرة مغادرة البيت والمنطقة مؤجّلة بالنسبة إلى حسين، أحد سكان منطقة الشيّاح في الضاحية الجنوبية لبيروت، على قاعدة «أنّنا اعتدنا على القصف». وحين اتّسعت رقعة النار مع بداية يوم 22 سبتمبر، كان لا يزال يُمارس حياته اليومية في الضاحية؛ بعد انتهاء دوام عمله، يتّجه إلى مقهى على أطراف الضاحية، يجلس مع أصدقائه لمتابعة الأحداث. ظلّ هذا روتينه اليوميّ حتى بعد اغتيال السيد حسن نصرالله، حافظوا على نفس الطقوس، حتى جاء التهديد بضرب منطقة الليلكي في الضاحية. تشاور حسين مع ذويه، وقرّروا ترك البيت، لينتقلوا بعدها إلى منزل أحد أقاربهم. خرجوا عند الساعة 12 إلا ربع من منتصف الليل، وبدأت رحلة التهجير التي تزامنت مع بدء القصف العنيف على الضاحية.
نزح حسين إلى الأشرفية، شرق بيروت، ولا يذكر أنّه نام للحظة واحدة في تلك الليلة. روتين نومه اختلف، وبعض التفاصيل التي قد تبدو غير مهمة في الأيام العادية، تصبح نوعاً من الترف بفعل القصف والتهجير؛ من خسارة الشخص لسريره، والاعتياد على النوم مع ثلاث وسائد بدلاً من واحدةٍ مثلاً. لازمته الأفكار المؤرقة في تلك الليلة، تفكيره بأهله وأقاربه، وبجيرانه الذين قضوا ليلتهم على الطريق، وبالمنزل ومصيره، وأيقن أن الحرب دخلت في مستوى جديد.
في السابق كان يحب السهر، حتى الرابعة فجراً، أو أكثر. وفي بيته المؤقّت يهرب إلى النوم باكراً، كي لا يتابع الأخبار التي لا تتوقف، وكمحاولة لخلق روتين ضمن اللا–روتين في الحرب. وبفعل تواجده في منطقةٍ أقل خطورة، وخارج دائرة الاستهداف، لا يفكر بإمكانية تعرضه للقصف أثناء نومه. يعود إلى ذكريات حرب تموز عام 2006، يومها نزح إلى البقاع، التي كانت تعد منطقة آمنة مقارنةَ باليوم، ولم يشعر بالقلق المرافق لأيامه ولياليه، كما يحدث اليوم.
جغرافيا النوم
افترش النازحون وسط بيروت، في محيط تمثال الشهداء. تلك الساحة الممتلئة بالسيارات المركونة خلال الأيّام العاديّة، كانت تتحوّل في حالات لبنان غير العادية الكثيرة، إلى ساحة للتظاهر والاعتصام. والآن باتت نقطة نزوح للبنانيين والسوريين، ولنساء من إثيوبيا وسيراليون، تُرِكنَ بمفردهنّ، بعدما أُخرجن من المنازل التي خدمنها لسنوات، وهرب أرباب العمل إلى أماكن آمنة، آخذين معهم أوراق النساء وجوازات سفرهن.
في آخر الساحة، بالقرب من ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وجد النازحون في باحة مسجد الأمين مأوى لهم. وصلت إليه عائلات، افترشت الأرض واحتمت بسقف الباحة، بعدما استطاعت بعض الجمعيّات والمجموعات التي شُكّلت بمبادرات فردية، من تأمين فرش وطعام ودواء لهم. بقيت العائلات هناك لأيام، قبل أن تأتي القوى الأمنية وتطرد أفرادها. وضع عناصر الأمن حواجز حديديّة فاصلة تمنع أيّ أحد من الوصول إلى المسجد، أو حتى من الجلوس بجانب بابه. من تجمّعوا في الباحة للاحتماء بهيكل المسجد الضخم، كانوا من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لم يكونوا ينتظرون شيئاً ولا يحلمون سوى بالحصول على سقفٍ، ووجدوا أنفسهم مُجدّداً مضطرين إلى النزوح مجدّداً بعدما هجروا بيوتهم. هكذا، توجّه بعضهم إلى كورنيش عين المريسة والمنارة بجانب البحر، خصوصاً أن باب المسجد ظلّ مُغلقاً في وجوه النازحين، رغم مساحته الشاسعة التي قد تتّسع لأعداد كبيرة منهم.
داخل المدارس، توزع النازحون على الغرف، الرجال في غرف منفصلة عن تلك التي تقبع فيها النساء. وحين يتعذّر هذا التقسيم بسبب ضيق المكان، يسكنون غرفة واحدة، ويضعون عوازل مصنوعة من قطع قماش كبيرة، خصوصاً أنّه ليس هناك رفاهية استحواذ كلّ عائلة على قاعة منفردة. الحياة الليلية للمدارس المُستجدّة، حتّمت ظهور تضاريس جديدة في القاعات الدراسيّة. يقوم النازحون يوميّاً ببعض التعديلات والإضافات لكي تلائم حاجاتهم الصغيرة، كالطبخ والغسيل والنوم إن طال عيونهم. فقد تحوّل ليل لبنان إلى ترقّب لساعات القصف. ينتظر المواطنون بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لمعرفة الأمكنة والأحياء المُهدّدة. يحتاج الأمر بضع دقائق لكي تظهر الضربات على شاشات، إذ تقوم التلفزيونات بتثبيت كاميراتها في موقع مرتفع يطلّ على الضاحية الجنوبيّة لبيروت، فيكون المواطنون على موعد من بثّ مباشر للقصف. ويوم يتأخر الإعلان عن التحذيرات الجديدة، تبدأ موجات القلق مما يُحضّر خفية مع حلول الليل الذي وجد فيه العدو الإسرائيلي التوقيت الأفضل ليمارس قتله. إذ تواصل طائرات المراقبة والاستطلاع دورانها في السماء، قبل وبعد القصف، لتُبدّد النعاس.
وجدت هذه الأزمة فضاءات جديدة للسكان، وغيّرت من طابع بيروت ما قبل الحرب. منذ شهر مثلاً، كانت ترتاد كورنيش عين المريسة فئات محدّدة: من يمارسون الرياضة، من يتنزّهون برفقة كوب قهوة، من يأخذ استراحة من صخب المدينة قرب البحر، صيادي السمك، والأطفال بدراجاتهم الهوائية. لا يزال الكورنيش اليوم وجهة للجميع، لذلك من لم يجد له ملجأ في الحرب، نصب خيمة على الكورنيش، أو افترش الأرض دون غطاء. وفي الشارع المقابل، تتوزّع المطاعم والمقاهي التي استقبلت النازحين الباحثين عن المراحيض وأمكنة الاستحمام.
طوال جولتنا على كورنيش عين المريسة، لم تهدأ الطائرات الحربية أو الاستطلاعيّة الإسرائيلية. المشهد هناك طافح بالحياة لأطفالٍ يلهون، ولعربات بيع الذرة، ولبائع البالونات، والسيارات المركونة التي تنبعث منها موسيقى شعبيّة.غير أنّ الطيران يأبى إلا أن يذكر النازحين بأن إبادة ترتكب على بعد بضعة كيلومترات. ولولا اخبار القصف وصوت الطيران الحربي، لاعتقد العارف بالمدينة، أننا في بيروت قبل الحرب وقبل الانهيار الاقتصادي والأزمات المتتالية.
أصوات الأرق
بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 8 أكتوبر 2023، مع قرار حزب الله فتح الجبهة الجنوبية لمساندة قطاع غزة بوجه آلة القتل الإسرائيلية. وفي 17 سبتمبر 2024، بدأت جولة إسرائيلية عنيفة من تفجير أجهزة البايجرز وأجهزة نداءٍ أخرى أدّت إلى إستشهاد أكثر من 40 شخصاً، وإصابة الآلاف. لتبدأ من بعدها موجة اغتيالات لقيادات حزب الله العسكرية، حتى وصلت إلى رأس الهرم. تزامنت هذه الاغتيالات، مع اتّساع رقعة القصف العنيف على الجنوب، والبقاع، والضاحية. خلال هذه الفترة، كان الصوت وحده من يُنذر بالأحداث والتحوّلات القادمة؛ أصوات الغارات العنيفة، الطائرات الحربية حين تخرق جدار الصوت في السماء، الغارات الوهميّة، وأخيراً طائرات الاستطلاع التي تحلّق على علوٍّ منخفض في كافّة المناطق اللبنانية.
تقطن ماري – جوزي في قرى قضاء الشوف. ورغم أّنها بعيدة جغرافيّاً عن دائرة القصف، إلا أن أصوات الغارات على الضاحية الجنوبيّة تهزّ منزلها بفضل نوعية القذائف المستخدمة. منذ عامٍ تقريباً، باتت تشعر بقلقٍ مستمر على الناس الذين يموتون جراء كل غارة تسمعها، وعلى عددد المنازل التي دمرت، والناس العالقين تحت الأنقاض. ومراراً أسقطت هذه الأفكار على نفسها، وتساءلت «ماذا سأشعر خلال اللحظات الأخيرة، إن حصل هذا معي؟ الفكرة مرعبة».
جميع هذه الأفكار والأصوات باتت تمنعها من النوم. بعد اشتداد القصف على الجنوب، توجّهت ماري إلى ضاحية بيروت الشمالية، التي تُصنّف منطقةّ آمنة. لم تستطع النوم، رغم أنّها لم تسمع دويّ الانفجارات هناك. لعلّ أصوات الأيّام الماضية ظلّت عالقة في أذنيها. استمرّ هذا الوضع لعشرة أيام، وانتظرت حتى بدأت تصل إليها أصوات الغارات، ما ضاعف قلقها مجدّداً، فعادت إلى قريتها، ونامت ليومين متتاليين. أقسى ما شهدته كان يوم اغتيال نصرالله، فحجم الخوف كان مشابهاً لما شعرت به يوم إنفجار مرفأ بيروت، بسبب الصوت الهائل وارتجاج البيت. لم يكن أمامها سوى خيار اللجوء إلى الحبوب المنوّمة، لتساعدها على إغماض عينيها.
وإن لم تطل الضربات مناطق بعض سكّان لبنان، فإن الصوت يُدخل الحرب إلى بيوت الجميع، من خلال طائرات الاستطلاع التي تحلّق على علوّ منخفض خصوصاً في عزّ الليل. في تناولها للحروب، توقّفت العديد من الدراسات الأكاديمية عند موضوع النوم وأحلام الناس وكوابيسهم التي تعكس نوعاً من اللاوعي الجماعي. في دراسته «منتصف الليل في أميركا: الظلام، والنوم والأحلام خلال الحرب الأهلية» (2017)، يرصد الأكاديمي جوناثان وايت، دلالات أحلام المواطنين الأميركيين خلال الحرب الأهلية في بلادهم، ويتوصّل إلى أنّ «العبيد» السود خلال تلك الفترة، كانوا يتعاملون مع أحلامهم كرؤى أو وحي سماوي يرسم أمامهم طريق الهرب من حقول البيض. وبعد سنوات من نجاحهم في الهرب، ظلّ الكثير منهم عالقين في تجربة العبودية، كما تدلّ الكوابيس التي واصلت مطاردتهم.
إذا أسقطنا ذلك على الحالة اللبنانية، فما الذي قد يقود الناس أو يُهدّئ من روعهم حين يُجافي النوم عيونهم؟ أو ماذا قد تخبرنا الكوابيس الحالية والمستقبلية عن تجربة الحرب نفسها في حين يعجز الناس عن النوم؟ لقد بات الكابوس يحتلّ مساحة اليقظة بأكملها.
يتلازم النوم والموت في الأساطير الإغريقية التي تعتبر النوم (Hypnos) والموت الذي لا يعرف الشفقة (Thanatos)، ابنين لإلهة واحدة هي إلهة الليل (Nyx). حتّى فيزيائيّاً يتشابه الشقيقان، لناحية برودة أطراف جسديّ النائم والميت على السواء، إذ تنتج برودة جسم النائم من انسحاب الدم إلى المناطق الداخليّة من الجسد، وفق «أبو الطب» أبقراط. في الحالة اللبنانية، لن يلتقي الشقيقان (الموت والنوم). وإذا كان النوم موتاً مزيّفاً، يصبح الصحو خلال هذه الحرب دمغةً قهريّة على الحياة، كأّنما العيون المفتوحة والمترقّبة هي تعويذة لطرد خطر الموت، خصوصاً مع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2350 شهيداً وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في 16 أكتوبر 2024.
«يقظة» الحرب
بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عملت يوليا بافلوفا والكسندرا روغووسكا على دراسة بعنوان «التعرّض للحرب، وكوابيس الحرب، والأرق، واضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالحرب: تحليل شبكي بين طلاب الجامعات أثناء الحرب في أوكرانيا». بحسب الدراسة، يُعاني نصف البالغين من أعراض الإجهاد، والقلق، والاكتئاب، وأعراض الأرق، كما تبين زيادة الغضب والعصبية والإرهاق والاكتئاب والشعور بالوحدة وتعاطي المخدرات لدى 97.8 في المئة من طلاب الجامعات والأفراد من المناطق التي شاركت في الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الدراسة إلى أنّ التعرض لحادثٍ صادم، يؤدي إلى ظهور الأرق والكوابيس المرهقة، مما يساهم في تعزيز اضطراب ما بعد الصدمة، وهذه غالباً عوارض تصيب المحاربين القدامى، والمدنيين من البلدان المتضررة من الحرب. وقد تشمل أعراض الأرق صعوبة النوم ليلاً، والاستيقاظ مبكرًا جدًا أو أثناء الليل، والنعاس والتعب أثناء النهار، ومشاكل الانتباه، والحساسية الشديدة، والقلق.
وفي الخلاصة، تُبيّن الدراسة أن معظم المواطنين الأوكرانيين الآتين من المناطق الأوكرانية الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية مباشرة، أفادوا بتعرّضهم إلى صدمات وكوابيس مرتبطة بالحرب. كذلك، سجّل انتشار أعراض الأرق واضطراب ما بعد الصدمة بين الطلاب الأوكرانيين نسبةً مرتفعة. إضافةً إلى ذلك، أظهر التحليل أن التعرّض للحرب له تأثير على الأرق والكوابيس بشكل منفصل، مما يزيد بشكل غير مباشر (من خلال أعراضهما) من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالحرب.
وبحسب كتاب «مكونات الغذاء لتحسين الأداء: تقييم مكونات الغذاء المحتملة لتحسين الأداء في الحصص التشغيلية» الصادر عن لجنة أبحاث التغذية العسكرية التابعة لـ «معهد الطب» في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الحرمان من النوم يُضعف اليقظة والأداء الإدراكي والمزاج. وتتراجع القدرة على القيام بعمل عقلي مفيد بنسبة 25 في المئة، لكل 24 ساعة متتالية يظل فيها الفرد مستيقظاً. وخلصت إلى أن النوم المتقطع والحرمان منه أثناء الحروب، يقلل من الإنتاجية، ويظهر عوارض للفشل المفاجئ والخطير في القيادة والسيطرة.
فراش أصغر من جسد
يُعاني لبنان من أزمةٍ إقتصادية دخلت عامها الخامس هذه السنة. أموال الناس لا تزال محتجزة في المصارف، والرواتب متآكلة. من نزح لم يتمكّن من أخذ أمواله، ومنذ الأيّام الأولى، فشلت الحكومة في تنظيم النزوح، فعلق أبناء الجنوب في سياراتهم لأكثر من 18 ساعة في طريقهم الطويل للخروج منه. الوجهة بعدها لم تكن معروفة، مع غياب مراكز مؤمّنة للجوء. هكذا افترش الناس أرصفة بيروت، في وسط العاصمة، وعلى كورنيش عين المريسة وفي باحات الكنائس والمساجد.
بحسب الإحصاءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد فُتح 1059 مركزاً للإيواء، معظمها من المدارس والمعاهد الرسميّة، وبلغ ما يُقارب 876 منها القدرة الاستيعابية القصوى، كما وصل عدد النازحين في هذه المراكز إلى قرابة 123 ألف شخص، فيما تخطّى إجمالي عدد النازحين من بيوتهم الـ 600 ألف شخص بالمجمل، ومعظمهم استأجروا بيوتاً في مناطق يقدّرون أنّها آمنة. مقابل هذه الأعداد الهائلة، وزّعت «الهيئة العليا للإغاثة» (التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة) 24,847 فراشاً فقط، و21,077 بطانيّة على كلّ المحافظات اللبنانية، لتنفجر الأزمة بين النازحين على الأرض.
حاول الناس مساعدة بعضهم قدر المستطاع. أطلق عبدالله وأصدقاءه مبادرة فردية، وشكّلوا مجموعة إغاثة للعمل على تأمين المساعدات للنازحين في الوسط التجاري. وحين تم سؤالهم عن احتياجاتهم، كانت الإجابة هي المأوى أوّلاً، وثانياً الفرش والبطانيات.
وهنا بدأت أزمة جديدة لمسها أصحاب المبادرات، وهي أزمة الأفرشة التي تعرّضت للاحتكار، وتراجعت جودتها إلى درجة لم تعد مؤهّلة للنوم.
تنبّه عبدالله إلى الاحتكار بعد ثلاثة أيّام على بدء الحرب، فانفجرت اسعار الفرش، وارتفعت من 6 دولارات إلى 40 دولار، مقابل تراجع الجودة من صوف مطرز بقماش، إلى قطعة إسفنج لا يتعدى طولها 160 سنتم، ولا تتّسع لجسد شابّ مكتمل النموّ.
وعلى الرغم من أن بعض المساعدات شملت أفرشة قدّمها الناس من منازلهم، وأصحاب بعض المصانع أحياناً، إلا أن جزءاً آخر وجدها طريقة لكسب المزيد من المال، مستغلاً حاجة الناس. فكانت بعض المجموعات تجمع التبرعات المالية، وتقوم بطلب عدد معين من الفرش وفق سعر معيّن، وعند استلامها يُصدمون بأن السعر تضاعف، حتى وصل في البقاع إلى 60 دولار للفرشة الواحدة! في المقابل، وصلت من سوريا بعض الأفرشة التي لا يتعدّى سعر الواحدة منها الـ 12 دولار، حتى مع احتساب كلفة النقل. أزمة الفرش لا تزال قائمة حتى اليوم، ومعها أزمة المبيت، بالتزامن مع قيام القوى الأمنية بطرد النازحين وملاحقتهم في شوارع بيروت، من دون تأمين مأوى لهم، وهذا ما لم يحصل خلال حرب تموز، حيث كانت عملية النزوح منظمة أكثر، وكان للناس قدرة على سحب أموالهم لاستئجار منزل، وحتى القصف لم يكن بمثل وحشية اليوم.
«ليالٍ بلا نوم»
في فيلمها التسجيلي «ليالٍ بلا نوم» (2013)، تختزل المخرجة اللبنانية إليان الراهب ذاكرة الحرب اللبنانية الطويلة، بشخصيّتَي مريم وأسعد. كلاهما خسر القدرة على النوم؛ مريم تنتظر إلى اليوم عودة ابنها المفقود ماهر، إمّا من الخطف أو الموت، فيما لا يستطيع أسعد إغلاق عينيه على الجثث التي أمر بقتلها أو قتلها بنفسه. صراع الذاكرة الهائلة، يصبح صراعاً على النوم، والجرح الغائر يتمثّل بعيونٍ مفتوحة على اتّساعها لكنها تعجز عن الرؤية. تزجّ الراهب بالمتفرّج أيضاً في هذه الدوامة من الأرق، حين تُجبره على مواجهة وجوه مخطوفي الحرب، بعيونهم المفتوحة التي تنظر مباشرة إلى الكاميرا. إذ تُفرد لقطاتٍ طويلة لصور المخطوفين الشخصية، وتجول بها في شوارع بيروت.
من جهته، نقّب المخرج اللبناني الراحل برهان علوية كأركيولوجيّ عن بقايا الحرب في ليل بيروت، في فيلمه «إليك أينما تكون» (2001). بحث عن النوم في عيون الشخصيات التي قابلها، ولم يجده. تظهر أحلام يقظة هذه الشخصيات كبديل قاتم عن غياب الأحلام الليلة، بسبب عجز الشخصيات عن النوم حتى بعد مرور أكثر من عقد على انقضاء الحرب الأهلية اللبنانية، كأنّ الحروب الفعليّة حين تنتهي، ستتكرّر كأصداء في معارك النوم واليقظة.