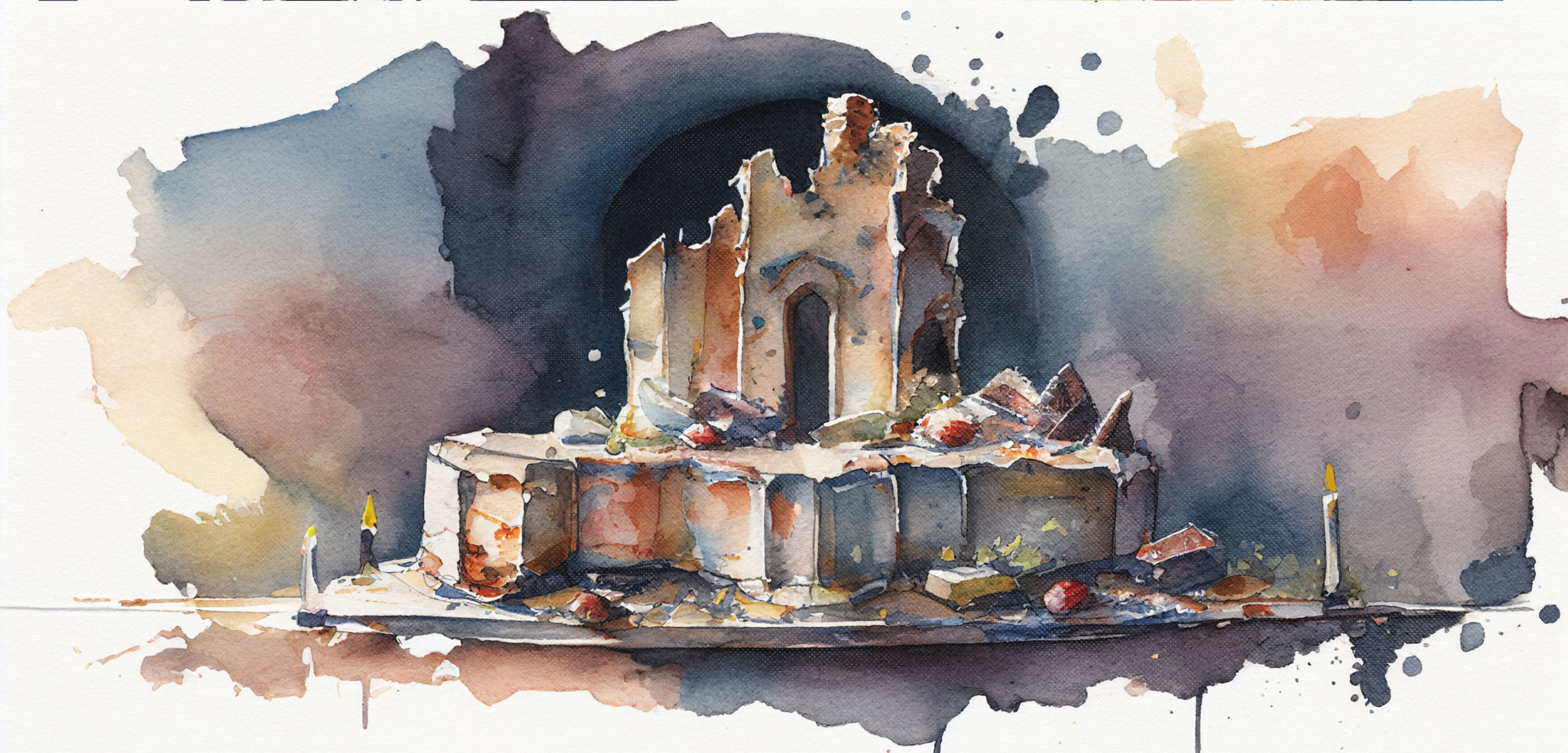في يوم شبه حارّ وخلال إقامتي في مدينة رام الله، زرتُ كهفاً يعود إلى العصر الحجري، يقع في بلدة شقبا الواقعة غرب المدينة، في تدريب ميداني على كتابة التقارير الصحافية. الفصل الجامعي في نهايته والعلامات على الأبواب. وكان سبب زيارتي الصحافية ليس الاطلاع على تاريخيه وأهميته فقط، وإنما لتوثيق الدمار وتهديده بالمحو بسبب كسارات الاحتلال المحيطة به.
مشيت مع زملاء آخرين مساراً وعراً من الحشائش والأشواك والحجارة، إلّا أننا في نهاية المطاف وصلنا كهفاً مهملاً ومثيراً للخوف والرعب بجدران شاهقة سوداء، وفتحتين في السقف، وتجاويف على شكل حجرات داخلية ينقطع عنها الضوء.
ينتمي هذا الكهف للحضارة النطوفية الممتدة حتى جبال الكرمل في فلسطين، وقد أثبتت تنقيبات المتخصصة في العصر الحجري القديم البريطانية دوروثي غارد، أن “المجتمع النطوفي في كهف شقبا تميز بممارسة نمط مستقر من نشاط الصيد وجمع الغذاء”، دلّ على ذلك شفرات منجل الصوّان التي وجدتها دوروثي في الكهف وقد استخدمت في حصاد الحبوب البري والقشّ من قبل مجموعات متعاونة. تخلّى النطوفيون لاحقاً عن الصيد واستقروا في مجتمعات صغيرة بدأت تعرف الزراعة. كان يتوارى أثناء زيارتي للكهف صوت أستاذ التاريخ في إحدى قاعات الجامعة وهو يقول إنّ الحضارات الأولى التي قامت فلسطين من أوائل الحضارات التي عرفت الزراعة.
تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في فلسطين حسب “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني” (2021) نحو 575167 دونمًا، تمثل ما نسبته 85% من أشجار البستنة؛ منها 552534 دونمًا في الضفة الغربية، و22633 دونمًا في قطاع غزة؛ وتحتل محافظة جنين، المرتبة الأولى (بواقع 151950 دونمات)، وذلك بفعل جغرافية الضفة الغربية التي تطغى عليها الهضاب المنخفضة.
حكايا فلاحية تقليدية
نشأتُ في عائلة مزارعة في بلدة كفرراعي تملك حقولاً من الزيتون نعتمد عليها بشكل أساسي في مصدر رزقنا ودخلنا، كمعظم العائلات الفلاحية الفلسطينية استطعنا دخول الجامعات، وبناء بيت أوسع، وتزويج الأبناء الذكور وكذلك الإناث. لكنّ ذلك كله مرّ بفترات عصيبة عشنا فيها فقراً وعوزاً.
اكتسبت عائلتي خبرة طويلة ومتوارثة في الزراعة التقليدية اعتمدت فيها على كل ما هو بلدي وطبيعي، والتي تعرف اليوم في سياق فلسطيني جديد بالزراعة البيئية، وهي توجّه بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة بين شريحة من المزارعين الشباب في المنطقة الوسطى من الضفة الغربية، وتحديداً مدينة رام الله وقراها، إلهاماً من أحد روّادها.
لطالما اعتمدنا في عائلتنا أسلوب الزراعة البيئية حتى وقت قريب، ففي موسم التعشيب أو قطف الزيتون كانت والدتي تشحذ همم جاراتنا للعمل معنا بمقابل، وتتواصل مع أمهات الشباب ممن يرغبون العمل في الأرض. كنا نمضي أياماً طويلة مع بعضنا في العمل بالأرض نتآنس بالحديث والضحك حتى تعمّقت فيها علاقتنا الإنسانية وفهمنا لبعض بشكل مختلف تماماً.
كان العمل متواصلًا في الأرض صيفاً وشتاءّ، حتى أن والدي كان في كل عودة له إلى البلاد يتكفلّ بشراء شاحنات من “زبل” الأبقار من بلدة الرامة القريبة ويشرف على فرده حول جذوع الزيتون كسماد عضوي أساسي في محاصيلنا، حيث كان يرفض باتاً إدخال أي كيماويات إلى أراضينا.
توارثنا أساليب وطرق تقليدية وبيئية لخدمة كل موسم، مثلاً أثناء قطف الزيتون كانت الأوراق المتساقطة توضع غذاء للبهائم، وعندما نعصر الزيتون نستخرج “الجفت” الذي طالما استخدمناه في “كوانين” النار وإشعال الطوابين، أو سهرنا ليالي ونحن ننتج الفحم من خشب الزيتون بخبرتنا المتوارثة. كانت هذه الحياة شاقة ومضنية في شكلها، وصحية في جوهرها.
الوقوع في الفخ
مع بداية الألفية، بدأ والديّ يتقدمان في السنّ، وجاراتنا أيضاً. وفي هذه المرحلة، وعلى نحو غير مسبوق، أصبحت كافة العائلات ببلدتنا تعمل من أجل تعليم أبنائها في الجامعات. شيئاً فشيئاً بدأت علاقة جيلنا مع الأرض والفلاحة تتفكك، وتأزمت هذه العلاقة لاحقاً لقلة فرص العمل في السوق الفلسطيني، فتوّجه معظم الشباب للعمل في الداخل المحتل.
دفعت هذه الظروف الفلاح إلى بيع أرضه، أو إدخال التكنولوجيا الحديثة من أسمدة وكيماويات حتى توفر عليه الوقت والجهد وعناء البحث عن العمّال. فعائلتي أدخلت الكيماويات إلى طقوسها الفلاحية عندما وجدت أبنائها في لحظة يتوجهون للجامعات ثم الزواج أو العمل أو السفر.
لم يعد أحد يتفرّغ للعناية بالأرض، بتنا نستأجر شخصاً يمتلك جراراً زراعياً يلحقه “تنك” للماء خاص برشّ الحشائش. يقوم الشخص بخلط مبيدات الرشّ بالماء دون أن نعرف ما هذه المواد، ودون أن نعرف إن كان صاحب الجرار يعرفها أيضاً، لأنه بالعادة يتبع إرشادات باعة المبيدات دون استشارة المهندسين الزراعيين أو حتى دون النظر إلى ملصق الإرشادات فوق العبوة. أدخلنا الأسمدة إلى الزيتون، ثم إلى أشجارنا المثمرة. لا يمّر عام دون أن نرشّ زهر الخوخ لحماية الثمار من الدود، أو قطوف العنب، أو اللوزيات.
تتوفر الكيماويات بشكل مخيف حتى أنها ترافق دورة حياة الشجرة أو النبات في كافة مراحلها، وتتجدد كل عام. أجسادنا صامتة وصامدة أمام هذه السموم التي أفقدتنا غذائنا الصحي وهويته، وأفقدتنا ذكرياتنا الطفولية التي احتضنت مذاقات لنباتات برية متنوعة. قد يستحيل أن نعثر اليوم على الزعتر البرّي أو العكّوب أو الصيبعة أو الحلبة البريّة أو أوراق السلك والحميض التي تنتشر في حقول الزيتون والأراضي البرية وفي الوديان، والتي شكّلت أطباقنا الرئيسية في المواسم السنوية.
كان الخروج للبحث عن تلك النباتات قراراً سرياً، تتفق والدتي مع جاراتها أو قريبتها على “السراحة” باكراً إلى الجبال البعيدة والمتاخمة لبلدة يعبد دون اصطحابنا لأنها رحلة شاقة وطويلة. كنّا ننتظرهن بفارغ الصبر، وبعد الظهيرة يكنّ قد عدن محمّلات بـ”شوالات” مرصوصة بالعكّوب والزعتر. انقرض العكّوب من الجبال بفعل ممارساتنا، أو بفعل استصلاح الأراضي البور وإدخال الكيماويات لها. وفي استعادته، أصبح العكّوب نباتاً ذو قيمة، إذ يباع الكيلو في السنوات الأخيرة بما يقارب (40 شيقلاً- 11 دولار أمريكي).
أمّا النبات الفوّاح الذي عرفناه بـ”المجنجن” أو “تفاح المجانين” الذي ملأ بيوتنا برائحته الزكية وبحكايا الرعب إن تناولناه، قد انقطع تماماً، وأصبح العثور عليه شبه مستحيل. فقدت أراضينا جزءاً كبيراً من تنوعها البيولوجي، وكلّما أسأل عن سبب ذلك، يقولون: “أكيد بسبب الرشّ (بالمبيدات)”. لقد أبدنا بسواعدنا بقصد أو دون قصد حياة فلسطينية برّية نادرة.
عظام موتى الحروب كأسمدة
في الجزء الأول من القرن التاسع عشر، انتشر في أوروبا سماد الفوسفات وكان عبارة عن طحين العظام، وعندما نقصت الكميات الواردة من عظام الحيوانات تم جمع العظام البشرية من ساحات المعارك أو أماكن الدفن.
أضيف للفوسفات عناصر أخرى طوّرت فعاليته، ولم ينتهِ عام 1842 حتى كانت إنجلترا وحدها تفتح 80 مصنعاً بدائياً تخلط الفوسفات بالكبريت وتقدمه للمزارع. ثم بدأ العالم يشهد أنواعاً متعددة من الأسمدة التي ارتبط تصنيعها بانعدام أخلاقيات كيمائيي ومُصنّعي الغازات السامة في الحربين العالمية الأولى والثانية.
كان ذلك نتاج تجارب علمية متعددة لفهم طبيعة النبات دخلت عالم الزراعة عن طريق علماء كيمياء بالأساس، منهم الألماني غسطس لاييبج، الذي أرسى عام 1840 أساس الصناعة الحديثة للأسمدة عندما أكد أن العناصر المعدنية يأخذها النبات من التربة لذلك لابدَّ من تجديدها حفاظاً على خصوبتها. ثم هناك الألماني، فريتز هابر، مخترع غاز الكلور السام الذي تسبب بمقتل حوالي 5 آلاف جندي فرنسي في الحرب العالمية الأولى، وهو نفسه من اخترع السماد النيتروجيني الصناعي، ونال على جهوده تلك نوبل للكيمياء.
يقظة ملّحة
يتركز استخدام الكيماويات في فلسطين في الزراعات المروية بهدف مضاعفة الإنتاج، وتبينّ الدراسات التي تجريها معاهد اقتصادية ومؤسسات بحثية حجم الكوارث في القطاع الزراعي، ففي عام 2013، أجرى معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” دراسة حول اعتماد التكنولوجيا الكيماوية (الأسمدة والمبيدات الكيماوية) بين مزارعي الضفة الغربية وقطاع غزة ليتبين أن الأخير وحده يستخدم الكيماويات بنسبة 74% بينما في الضفة بنسبة 23% في الزراعات المروية أكثر من البعلية بهدف مضاعفة الإنتاج، في حين تنتفي الدراسات حول مدى استخدام الكيماويات في حقول الزيتون.
تظهر “بوستات” الأصدقاء وهم يتسوقوّن المنتجات الزراعية البيئية من الأسواق الأسبوعية في مدينتي رام الله والبيرة، أو يشاركون في إحدى الفعاليات الثقافية التي تسوّق للغذاء الفلسطيني التقليدي، أو ينخرطون في مجموعات شبابية تبحث أنثربولوجياً في أصل ومكونات الطعام الفلسطيني، أو يزورون مزرعة بيئية في إحدى القرى.
تعرف رام الله بالخصوص فعاليات سنوية ترسخ لمفهوم كل ما هو فلسطيني، من التراث للطعام للإكسسورات حتى الكتب، ومن هذه الفعاليات “سوق الكريسماس” السنوي أو “سوق الحرجة”، أو حسبة “التعاونيات” التي تنظم بين فترة وأخرى. هذه التوجهات تشير إلى أن البعض في رام الله وفي مناطق أخرى بدأ يعي بنوعية غذاءه ومصدره. وتتقاطع تلك مع أصوات حقيقية ذات خبرة طويلة في الزراعة البيئية قولاً وفعلاً، مثل تجربة المهندس الزراعي، سعد داغر.
المزرعة الإنسانية
صادفت سعد داغر في ندوة تتحدث عن “السيادة الغذائية”، وكان يعرض تجربته في الزراعة البيئية، وكيف حققت له الاكتفاء الذاتي والتحرر من قيود عدّة، ورفع قيمة المنتج المحلي الفلسطيني البيئي في بلد تتضخم بمنتجات الاحتلال، والمنتجات الزراعية الكيماوية التي تنتج كسلعة حسب السوق.
بحثت عن اسم داغر على الإنترنت، وقفزت بين مقالاته وفيديوهاته الإرشادية، حتى شعرت أنني فهمت تجربته، لكن الفضول في عقلي يبحث عن أجوبة أخرى. وصلت صفحته عبر “فيسبوك”، ولأن هذا الأخير يعطينا تعريفاً أوضح للشخص، كان داغر في الـ “Bio” يعرّف نفسه بـ “مهندس زراعي إيكولوجي، مدرب واستشاري، مدّرس يوغا، ريكي”، التي توحي جميعها بمفهوم واحد: الحياة الصحيّة.
درس داغر العلوم الزراعية في الاتحاد السوفيتي، وعاد إلى فلسطين يجرّب في حديقة منزل عائلته بقرية “مزارع النوباني” قضاء رام الله. بعد محاولات فاشلة، فهم تدريجياً أن الزراعة البيئية تعتمد أولاً على إيجاد التوازن للتربة، والاكتفاء بقصّ الحشائش دون حراثة الأرض، واستعمال الأسمدة العضوية.
لم يصدق والد داغر أحاديثه، فقد تعوّد بدوره على حراثة الأرض مرتين حسب رزنامة الفلاح الفلسطيني. حرثة في نهاية موسم قطف الزيتون وتكون عميقة، وحرثة بداية آذار تكون سطحية تسمح للتربة بالتنفس وتخفيف الرطوبة، لكنّ داغر لديه قناعات أخرى، وهي ما شكّلت لاحقاً جوهر منهجه البيئي.
بعد سنوات، وفي عام 2002 تحديداً أنشأ داغر أول مزرعة بيئية في فلسطين على طريقة المساطب الزراعية المرتفعة، وكان توجهه آنذاك فرديًا قبل أن يتوجه إلى مجتمعات المزارعين بمنطقة جنين في محاولة إقناعهم بالتوقف عن استخدام السموم الكيماوية، وفي 2010 توصل إلى نموذج “المزرعة الإنسانية”.
العودة إلى الطبيعة
أمام أرضه، نصب داغر لافتة كتب عليها “المزرعة الإنسانية”، ويزرع فيها الخضار والورقيات حسب المواسم. أتخيّل مزرعته وهي تشبه “حاكورة” بيتنا التي لم نترك شيئاً إلّا وزرعناه فيها. أنتجت عائلتي لسنوات طويلة غذاء صحياً كافياً وفائضاً في مرات كثيرة. أتذكر الفول أخضر يانع وصغير، اللوبياء تملأ الحوض وتمتد على الجدران، النعناع الأخضر في حوض ثلاجة قديمة، التفاح السكري، والعنب الحلو، والكرز البلدي، والزعتر الفوّاح، والبندورة الحمراء البلدية، والقرنبيط، والعصفر وغيرها.
كانت والدتي تخزّن البذور لزراعتها في العام القادم، أغلبيتها بذور بلدية. وهذه أول قاعدة في منهج “المزرعة الإنسانية” التي تشجع الفلاح على تخزين وزارعة الحبوب البلدية في سبيل استعادة الحبوب الأصلية الفلسطينية بعد اختفائها لعدة أسباب، سياسات الاحتلال التي يمارسها ضد الزراعة ومزارع الفلسطينيين، وهيمنة شركات البذور العالمية المحسنة والمهجنة التي أدت إلى اختفاء البذور الأصلية من أيدي المزارعين.
تشجع “المزرعة الإنسانية” على عدم حراثة الأرض، يشرح داغر أنه للحراثة “تأثير سلبي على المادة العضوية للتربة وعلى قدرتها على الاحتفاظ بمياه الأمطار، وإرباك عمل الكائنات الحية داخلها، محدثة خلل في توازنها الطبيعي. فضلاً عن أن الحراثة قادرة على تغيير بنية التربة بعد انجرافها وتعريتها”.
في فيديوهاته عبر يوتيوب، يوضح داغر كيفية الاعتناء بحقل الزيتون بطريقة قص الحشائش وتركها فوق سطح التربة. مطمئناً متابعيه أن “تهوية التربة تحدث دون محالة بفعل ديدان وجذور النباتات الميتة، فضلاً عن تحول الحشائش لسماد عضوي، وهذا كفيل بخلق حقول محايدة للتغير المناخي وصديقة للبيئة”. قد يوحي منظر الحشائش غير المعتنى بها بالفوضى وقلة اهتمام الفلاح بأرضه، ويقع ضحية الأحكام المسبقة مثل عدم الاستحقاق، ففي العرف الفلاحي الفلسطيني يُنظر إلى الحشائش نظرة عداء، فسخّر لها المناجل قديماً، والمبيدات حديثاً للقضاء عليها.
أما القاعدة الأهم في “المزرعة الإنسانية” فهي منع استخدام الكيماويات قطعياً إعلاءً لقيمة المنتج البيئي وقيمة الإنسان وصحته وغذاءه. ويصبح الفلاح حرّا في ما ينتجه ويبيعه مباشرة للمستهلك دون وساطات أو هيمنة التجار.
ملتقيات وحسبات بيئية
ألهمت تجربة داغر شريحة من الشباب الخريجين الذين لم يجدوا فرصة عمل ملائمة، فباشروا باستغلال المساحات الصغيرة من حولهم في الزراعة حتى أصبح أغلبهم يملكون مزارع تنتج كميات يمكن تسويقها. من هذه النماذج ، مزرعة “الفلاح” للشاب محمد خويرة الذي استغل خبرة والدته التقليدية في الزراعة، فأصبحت عائلته اليوم تملك أول مزرعة بيئية في كفر نعمة قضاء رام الله.
وهناك مزرعة “البيان” للشابة بيان اقطيط من بلدة رابور في الخليل، ومزرعة “أم سليمان” لشابين من الضفة وغزة. أمّا المبادرات المجتمعية يوجد “الملتقى الفلسطينيّ للزراعة البيئيّة” وهو مجموعة من المتطوّعين/ات، منهم المهندس الزراعي داغر، يهدفون إلى توفير منصّة لمن يؤمنون بإعادة النظر في الأنظمة الغذائيّة الحاليّة، وإعادة صلتهم بالأرض.
استعادة الأصل
قد يرى البعض في العودة إلى الأرض من خلال نماذج “المزرعة الإنسانية” نزعة رومانسية لا أكثر، وخاصة أنها تنمو في وسط اجتماعي مرفّه، لكنّني أراها شخصياً عودة إلى الذوق الأصلي والصحة المعمرة دون أمراض كما كانت تفعل جدتي في طقسها “العصرونيّ” عندما كانت تغلي بذور الحلبة أو الشومر البريّ وتجلس مع جدي للشرب تحت شجرة كرز. لقد توفيّا على الأقل دون أقدام معتلّة.
تستحضر تجربة عائلتي وتجربة “المزرعة الإنسانية” أسئلة كثيرة في داخلي: من يخزنّ اليوم في بيته بذور الخبيزة- طعامي المفضل في الطفولة-؟ أظن لا أحد، لكنها يوماً كانت دواء لعلّة خواصر جدتي المصابة بالتهابات حادة غير قابلة للشفاء. من يقطف اليوم أزهار النرجس ويهديها لمعلمته؟ لا أظن لأنها أصبحت على قائمة الانقراض بسبب كيماويات الرشّ التي لا تخضع للرقابة الصارمة من طرف وزارة الصحة ووزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة الفلسطينية لأسباب كثيرة.