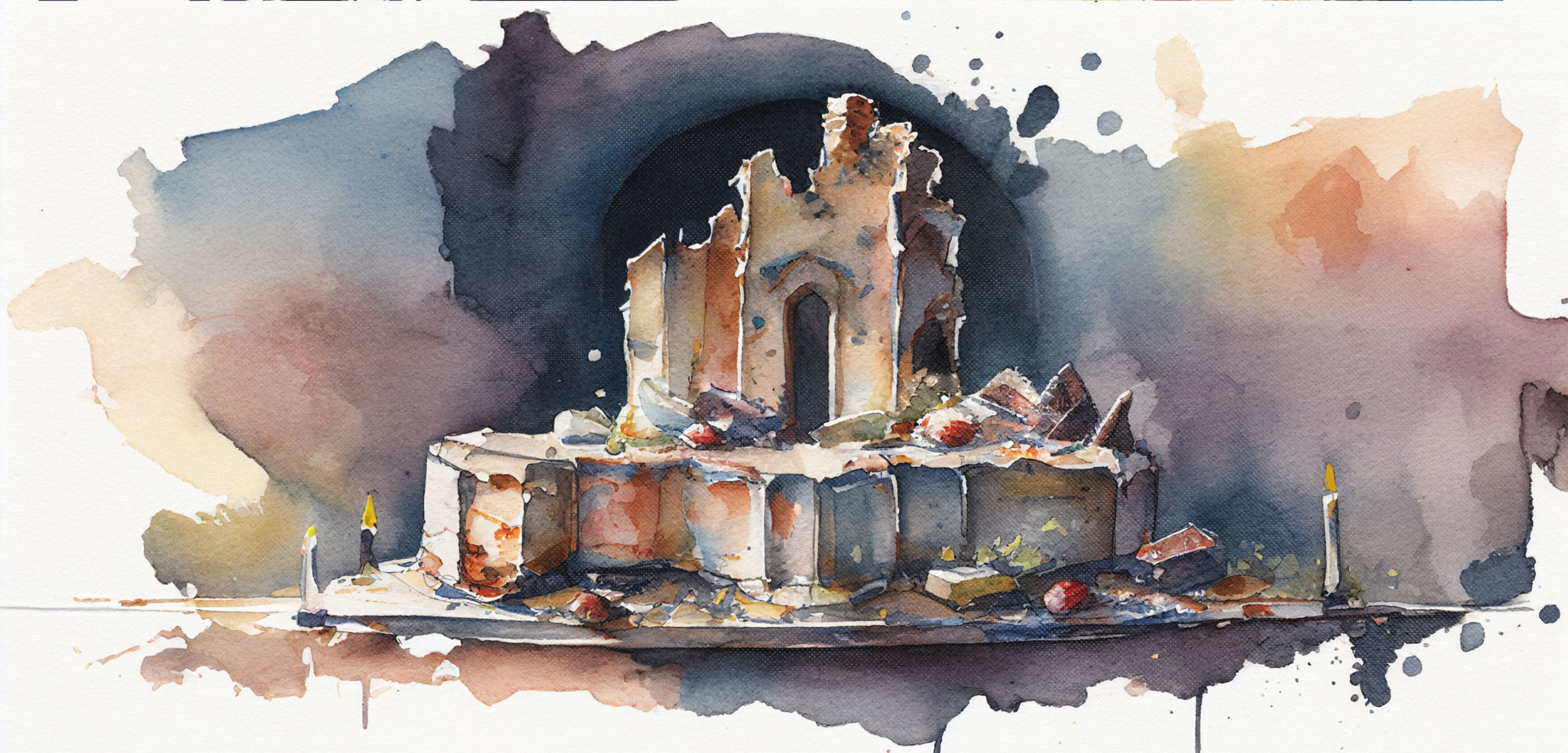وسط حالة غضب عامة خيمت على التفاصيل المعيشية للمصريين خلال الشهور الماضية بمناسبة انقطاع الكهرباء، وما أدت له من انقطاع الكهرباء في المنازل في أكثر أوقات السنة حرارة، وإرباك المخططات الدراسية للطلاب، وتوقف في المصالح والمنشآت العامة والخاصة، وتعطل الإنتاج في صناعات ضرورية للأمن الغذائي وللصناعات التحويلية، تطايرت تساؤلات في الفضاء العام لا تزال تبحث عن إجابة مقنعة: متى تحولت مصر من دولة لديها أزمة فائض كهرباء وتفكر في تصديرها، إلى دولة تقطع التيار الكهربي يومياً عن مواطنيها ما بين ساعتين إلى 6 ساعات؟ ولماذا يستمر الانقطاع رغم تخفيض الدعم وزيادة الأسعار؟ والأهم رغم المضي في مشروعات الطاقة المتجددة الضخمة؟
لم تصمت الدولة تماماً. تأرجح خطابها بين كلام تقني مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وقدرة تحمل شبكة التوزيع القومية، قاله رئيس الحكومة، المهندس مصطفى مدبولي، وبين بعض البيانات المالية عن قدر الدولارات التي وفرها قطع التيار على الدولة نتيجة تحويل دفعات من الغاز الطبيعي للتصدير بدلاً عن الاستهلاك المحلي. ولم يخلو الخطاب الحكومي بالطبع على استهلاك نسخه القديمة المعتادة وقت الأزمات الكبرى: سلوككم أيها الشعب هو السبب، انظروا ارتفاع درجات الحرارة العالمي وأزمة الطاقة العالمية، انظروا كيف تنقطع الكهرباء في الولايات المتحدة والكويت دون ولولة.
وسط فقر التحليلات وسخافة الخطاب الحكومي، انتشر كلاماً لأحد رواد الأعمال في مجال الطاقة الشمسية، يقول فيه إنه، وبالعكس من التصور العام، فإن الطاقة الشمسية للمنازل ليست حلاً لانقطاع التيار في مصر، التي قال إنها تعاني فقراً في مصادر الطاقة لديها. وأن «الطريقة الوحيدة لجعلها (الطاقة الشمسية) بديلاً لشبكة الكهرباء هو دمجها مع بطاريات لتخزين الكهرباء والتحول بالكامل للطاقة الشمسية وده مكلف جداً حالياً وغير عملي»، مضيفاً أن المشروعات الكبيرة المركزية المخصصة لإنتاج الطاقة الشمسية (مثل مشروع بنبان في مصر) هو خطوة على الطريق الصحيح، كما أنه ضروري من أجل الحصول على التكنولوجيا، نافياً الأبعاد السلبية عن المشروع خصوصًا في الضغط على العملة الأجنبية.
تلقف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المنشور المستند على تخصص صاحبه، في التقنية وفي استثمارات الطاقة المتجددة في نفس الوقت، وتداولوه كاقتراح لحل أزمة الطاقة. لم يقترح الرجل شيئاً واضحاً، لكنه أيضًا كان معبراً عن تصور يمكن تسميته بـ “الرأسمالية الخضراء”، وهو يمثل توجهات الشركات الخضراء الناشئة والشركات الكبرى وكذلك الدول الغنية، ويقوم على التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال السوق وحوافز التسعير والاستثمارات الخاصة الكبرى. وعلى مدى السنوات الماضية، كان ذلك التوجه هو الغالب على تصورات التعامل مع التغير المناخي عالميًا، وكانت أسواق الكربون هي التجسيد المركزي له للتحفيز على تخفيض الانبعاثات، وهو الأمر الذي ثبت فشله فشلًا ذريعًا.
لعل نقاش التأقلم مع التغيرات المناخية في مقابل تخفيف انبعاثات الكربون أحد أكثر النقاشات قدماً في التغير المناخي، حتى أنه تحول في سنينه الأخيرة لفرصة صراع دولي حقيقي بين دول الشمال الصناعي، التي راكمت الثروات منذ الثورة الصناعية، في مقابل دول الجنوب العالمي التي تتمسك بحقها في التنمية الناجزة لمعالجة مشكلات عميقة مثل الفقر وسوء استخدام الموارد واللامساواة ..
بل إن الحركة المناخية الآن، بالذات في دول الجنوب صارت تعتبر هذه التوجهات محاولة للغسيل الأخضر لنفس الممارسات التي أدت في الأصل إلى التغير المناخي، وترى فيها إعادة إنتاج لنفس علاقات القوة، وأشكال التمويل، ومعايير تقاسم العمل الدولي بين دول الشمال ودول الجنوب، بالإضافة إلى أنها تقف على النقيض من مصلحة عموم السكان أو مصلحة الدول الأكثر فقراً التي عانت قرون كاملة من الاستغلال والنهب المنظم لمواردها، وتصدير الأرباح لمراكز الاحتلالات الدولية.
غابت هذه النقاشات عن الحوار الذي تم أونلاين بخصوص الطاقة الشمسية بسبب أزمة الكهرباء، وتغيب عمومًا عن الحوار العام البسيط فيما يخص الطاقة المتجددة في مصر. وما ظهر كعلامة خطيرة أيضًا كان غياب التسييس والتحليل المادي لإدارة ملف الطاقة، وما أدى له من مبالغة في أهمية الموضوع من جانبه التقني. هذا غير ما أبداه هذا النقاش المحدود من أن الخيال العام الخاضع لسطوة النظام العام لا يقوى على الإفلات من إشكاليات الإدارة، التي تعيد إنتاج نفسها بدأب، بالإضافة لتجاهل تام لعدد واسع من الجدالات والمبادئ البديهية في أسئلة الطاقة والمناخ والتنمية والعدالة المناخية.
عند هذه النقطة، وقبل الحديث عن مشروع بنبان، كنموذج لاستعجال المضي في اتجاه محدد للتحول الطاقي يخدم توازنات القوة القائمة ويحافظ على أسباب التأزم، ويعمق فخ الديون العالقين فيه، ربما يكون من الضروري البدء من الإشارة لبعض الجدالات والمفاهيم في سياق قضية تغير المناخ، وتأثيرها على ملف الطاقة، والتي أتعرض لها من موقع صاحب المصلحة، كأحد سكان دول الجنوب العالمي الباحث عن حل جماعي لوضع دفعنا ثمنه حروب إقليمية وأهلية واستبداد سياسي وفقر وانعدام المساواة وتبعية مكلفة للدول الغنية والمؤسسات المالية الكبرى.
لا تحلم بالعفو عند المقدرة
لعل نقاش التأقلم مع التغيرات المناخية في مقابل تخفيف انبعاثات الكربون أحد أكثر النقاشات قدماً في التغير المناخي، حتى أنه تحول في سنينه الأخيرة لفرصة صراع دولي حقيقي بين دول الشمال الصناعي، التي راكمت الثروات منذ الثورة الصناعية، في مقابل دول الجنوب العالمي التي تتمسك بحقها في التنمية الناجزة لمعالجة مشكلات عميقة مثل الفقر وسوء استخدام الموارد واللامساواة.
يمكننا الحديث عن مقاربة أولى، هي الأقوى والأوسع انتشاراً وهي التي تسيطر على مشروعات التغير المناخي والطاقة النظيفة هذه الأيام. مقاربة تصب لصالح الدول الغنية، ومعها في نفس الفريق كبريات شركات الطاقة والتحول الأخضر والمؤسسات المالية الدولية والشركات الناشئة ومراكز الأبحاث الخاصة. تقوم هذه الرؤية على أن الكوكب وصل لمرحلة بات معها المضي في اتباع نفس السياسات مستحيلاً، وعلينا جميعا البدء من هذه اللحظة (وهذه اللحظة تتغير حسب التفاوض)، في التحول نحو الطاقة النظيفة، والاستغناء عن الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي مثلاً) بإدعاء الوصول إلى المستوى صفر في الانبعاثات الكربونية في العام 2050. مع ذلك، تبدو هذه المقاربة غير فعالة مع ما يحدث في الواقع خصوصاً مع زيادة السكان والانهيار المتسارع في البيئة الطبيعية في الجنوب العالمي، علماً أنها تعتبر حجر الزاوية في قدرات امتصاص الكربون.
عبّر تود موس وفيجايا راماشاندران عن منطق الدول الغنية هذا في مقال هام، قالا فيه: «كان من المفترض أن يثير التطور السريع في الصين والهند، ومسارات الانبعاثات الحادة هناك مخاوف الحكومات الغربية. لكن بدلاً من ذلك تم التركيز على أفريقيا، حيث لا يزال استخدام الطاقة منخفضاً بالفعل، وحيث ترى البلدان الغنية فرصة جيدة لممارسة الضغوط والمضي في وقف التنمية وقطع التمويل، وهذا يؤدي بالفعل إلى سياسات ضارة تصيب ملايين الأفارقة الفقراء من خلال إبطاء التنمية الاقتصادية في قارتهم في حين لا تفعل إلا القليل، إن وجد، للمساعدة في مكافحة تغير المناخ والتأقلم مع آثاره».
في مقابل تلك المقاربة، التي تبدو مسؤولة وصديقة للبيئة ومتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، نجد مقاربة أخرى تتبناها عدد محدود من دول الجنوب العالمي، بالإضافة لتيار عالمي صاعد من جماعات يسارية ونسوية وجماعات لدعم السكان الأصليين، ترى أن منطق الدول الغنية يعيد إنتاج علاقات القوة نفسها، وقواعد تقاسم العمل الدولي الذي فرضه اكتشاف النفط واكتشاف أهميته العسكرية والسياسية والاقتصادية إبان الحرب العالمية الثانية، وهي علاقات أنتجت أولاً: دولاً أكثر فقراً تُمنع عنها ملكية التكنولوجيا، تعتمد في اقتصادها على القروض والمنح، تتخلف في سلم التنمية نتيجة السياسات المفروضة عليها، وثانياً: المجتمعات المهمشة داخل هذه البلدان، فهي تتعرض لاستغلال مضاعف.
لا يرى النظام العالمي، وخريطة العلاقات الاقتصادية الدولية، مانعاً في تعطيل تنمية أفريقيا كلها، بل يريدها طرفاً خاضعاً دوره يقتصر على استخراج المواد الخام والأرباح، ونقل الطاقة النظيفة ورؤوس الأموال إلى دول الشمال مضاف لها خدمة ديون موجعة. علماً أن القارة الأفريقية،إن واصلت مساعي توليد الطاقة بما يتضمن مصادر الوقود الأحفوري، فإن الزيادة في انبعاثات القارة كاملة لن تزيد عن الانبعاثات الحالية لألمانيا وحدها الآن ..
بناءً على ذلك، تفترض المقاربة المنحازة لدول الجنوب العالمي أن الفارق الكبير بين حصة الفرد المحدودة في دول الجنوب في الانبعاثات الكربونية ونظيرتها الضخمة في الدول الصناعية الغنية، تفسح المجال الزمني للأولى أن تواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري (الأرخص) لسنوات أطول من تلك المتاحة أمام دول الشمال. وأن المسؤولية التاريخية للدول الصناعية في إطلاق غازات الاحترار تفرض أن يكون تمويل إجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية أو تقليل انبعاثات الكربون ممولة من تعويضات تدفعها دول الشمال لدول الجنوب، وليس ودائع أو قروض.
إذن الخلاف على نقطتين أساسيتين: 1- ترى دول الشمال أن علينا الاعتماد على تخفيف انبعاثات الكربون وتتجاهل عملية التكيف مع آثار التغير المناخي، وفي هذا السياق تُقيَد التمويلات عن مشروعات الطاقة الأحفورية، وكذلك عن مشروعات التكيف مع التغير المناخي. 2- يكون تمويل مشروعات التخفيف هذه من خلال التعويضات أم من خلال المزيد من الديون.
عبّر الباحثان أحمد العدوي وصقر النور عن المقاربة العاملة لصالح دول الجنوب العالمي وفي القلب منها الدول الإفريقية في مقال شديد الأهمية: «عن «الرواية الموحدة» وأولوية التكيف في إفريقيا»، وقالا فيه: « من الممكن أن نلجأ لحل أكثر عدالة ومنطقية، وهو أن تلتزم كل الدول بنصيبها «العادل» من الانبعاثات «الإجمالية التاريخية»، بحيث نحافظ على أهداف البشرية في حياد كربوني في 2050، ونصل بعدالة إلى 1.5 درجة فقط زيادة في درجات الحرارة تنخفض إلى 1.2 درجة بنهاية القرن. إذا اتبعنا هذا النهج العادل، فعلى سبيل المثال قد يسمح هذا لدول مثل الهند بالعمل كالمعتاد حتى عام 2040، وبالتأكيد مصر والدول الأفريقية غير مطلوب منها الاستثمار من مواردها الوطنية أكثر في التخفيف غير المرتبط بتأثيرات بيئية إيجابية محلية معتبرة حتى عام 2040».
يمكننا القول ببساطة، أن النظام العالمي، وخريطة العلاقات الاقتصادية الدولية، لا يرى مانعاً في تعطيل تنمية أفريقيا كلها، بل يريدها طرفاً خاضعاً دوره يقتصر على استخراج المواد الخام والأرباح، ونقل الطاقة النظيفة ورؤوس الأموال إلى دول الشمال مضاف لها خدمة ديون موجعة. علماً أن القارة الأفريقية، كما يقول نور والعدوي، بحسب مقارنتهما للإحصاءات، إن واصلت مساعي توليد الطاقة بما يتضمن مصادر الوقود الأحفوري، فإن الزيادة في انبعاثات القارة كاملة لن تزيد عن الانبعاثات الحالية لألمانيا وحدها الآن، حتى بعد أن شرعت الأخيرة في الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 41٪ من خليط الطاقة الكلي لديها.
التحول في مصادر الطاقة والتنويع بين خلطاتها الممكنة يفرض مصطلح شديد الأهمية، «الانتقال العادل» في الطاقة. في قلب صراع «التكيف» و«التخفيف» هذا نسجت تيارات عدة ناشطة في قضية تغير المناخ مفهوماً للعدالة في الانتقال من مصدر طاقة أحفوري لمصدر طاقة متجدد، ومع أن صياغة المفهوم وسياقاته باتت متنوعة بتنوع الرؤى المهتمة، إلا أن شرح حمزة حموشان وكايتي ساندويل في مقدمة كتاب: «تحدي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية»، يبدو الأكثر شمولا ووضوحاً.
يرى الكتاب أن «مقترحات الانتقال العادل التي تقدمها الحركات الاجتماعية التقدمية مدفوعة بقناعة أن الناس الذين يتحملون أعلى كلفة للنظام الحالي، يجب ألا يصبحوا هم من سيدفعون كلفة الانتقال إلى مجتمع مستدام، بل يجب أن تكون تلك الفئات مشاركة وفاعلة في صدارة الأطراف التي ستشكل مسار هذا الانتقال»، وفي هذا السياق، يعرّف الكتاب الانتقال العادل في الطاقة على أنه «تقديم حلول قادرة على إبداع تحولات جذرية في ملف الأزمة المناخية، بما يشمل التصدي للأسباب الجذرية، مع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومواجهة التدهور الإيكولوجي وسيادة الشعوب».
يتقاطع هذا المفهوم مع مفهومين آخرين أشار لهما حمزة حموشان في نفس الكتاب، في فصل «الانتقال الطاقي بشمال أفريقيا… حضور الاستعمار الجديد مجدداً» وهما «الاستعمار الأخضر» و«الاستحواذ الأخضر». ينطلق حموشان في كلامه بداية من وصف الصحراء، كما يراها امبرياليو التغير المناخي كساحة لإنتاج الطاقة النظيفة، إذ يرونها كـ «أرض شاسعة، وخالية، وذات كثافة سكانية منخفضة، وأنها جنة للطاقة المتجددة». يرى حموشان عن حق أن هذا وصفاً مخادعاً إذ يتجاهل جوانب بالغة الأهمية مثل الملكية والسيادة على الأراضي وعلاقات الهيمنة والسيطرة العالمية، وكلها أمور تسهل وتصون الاستغلال والنهب المنظم لصالح الطرف الأغنى.
وهنا طرح حموشان مفهوم «الاستعمار الأخضر»: استمرار العلاقات الاستعمارية القائمة على النهب ونزع الملكية ونقل الكلفة الاجتماعية والبيئية إلى بلدان الأطراف. كما مفهوم «الاستحواذ الأخضر»: الاستيلاء على الأراضي والموارد لغايات بيئية مزعومة.
فماذا عن بنبان؟
لنبدأ أولاً بالحديث سريعاً عن مشروع بنبان، الموصوف من أجهزة دعايا النظام السياسي المصري، والمتناسب مع الدعايا البيضاء المهيمنة على خطابات قضية تغير المناخ، كأكبر مشروع لاستخراج الطاقة الشمسية في العالم، (أحياناً أخرى يكون الأكبر في أفريقيا فقط). تقول عنه الدولة أنه يعكس «الرؤية الثاقبة للرئيس» الذي استشرف منذ العام 2011 أزمة الطاقة في مصر، وبالطبع لم يتجاهل فكره أزمة المناخ، فرعى بنبان.
غير أننا حتى اليوم نشهد انقطاعات يومية في الكهرباء تصل ل 12 ساعة في المناطق البعيدة عن دائرة الاهتمام، ويصل في العاصمة إلى 6 ساعات، وأسوأ من ذلك، شهدنا جميعا وفاة عشرات المواطنين في أسوان، نفس المحافظة التي تم اقتطاع جزء من أرضها لإقامة بنبان، فقط لأسباب مرتبطة بانقطاع التيار الكهربي، علماً أن المحافظة شهدت أعلى درجة حرارة منذ أيام ووصلت إلى 49.8 درجة.
تناوب على مشروع بنبان عدد من المؤسسات التمويلية الدولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، منحوا جميعاً قروضاً لتحالف من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وأنفقوا 2 مليار دولار على تأسيس المشروع. وهو المقام على أرض صحراوية مساحتها 9 آلاف فدان منتزعة من مركز دراو في محافظة أسوان، يضم 32 محطة توليد من بينهم أربع محطات مخصصة لنقل الطاقة المنتجة إلى شبكة التغذية القومية، على أن تتكفل الدولة بإنشاء الطرق والمرافق ومرافق التوصيل المرتبطة بالمشروع، ويباع التيار الناتج للدولة بسعر مقوم بالدولار وفق معادلة تم تحديدها في الاتفاق الأصلي، تنص على سداد 70٪ من المبلغ بحسب سعر صرف الدولار في يوم البيع، و30٪ بحسب سعر صرف الدولار وقت توقيع الاتفاق. ويفسر هذا اختلاف المدفوعات الشهرية لبنبان، فنجدها في شهر بضع مئات الملايين وفي البعض الآخر تصل إلى أكثر من مليار جنيه شهرياً، هذا بالطبع دون تجاهل تأثير عوامل أخرى على قدر الطاقة المنتجة والمباعة للمشروع، والمرتبطة بمسائل تقنية وطبيعية في الغالب.
وفق ما نعرفه عن المشروع، جرى التالي: نزع ملكية الأراضي المفتوحة من الملكية العامة، نقل السيادة على أرض المشروع لجهات مستدينة، تمويل المشروع من خلال القروض والمزيد من الديون، الحفاظ على تقسيم العمل المعتاد (ممول أوروبي ومقترض جنوبي)، وأخيراً المعاجلة بتنفيذ «أكبر مشروع في العالم» أو «أكبر مشروع في أفريقيا» للانتقال الطاقي نحو الطاقة النظيفة… كل هذا حدث قبل أن تتصاعد أصلاً مواجهة دول الجنوب والشمال في قمة باريس المناخية في 2015، وقبل تأسيس صندوق «التعويض عن الأضرار والخسائر»، الذي أقرته قمة شرم الشيخ المناخية في 2022، وهو أول آلية تعترف فيها الدول الصناعية بمسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فهي تلتزم بالتعويض عن الضرر الملحق بدول الجنوب، وليس إقراضها وزيادة عبء الديون عليها.
البعض يتفاخر بأن قروض بنبان موجهة للقطاع الخاص وليس للدولة، ولا ضرر على الدولة، وفي هذا الكلام اجتزاء وبعض التضليل. فكون القرض موجهاً للقطاع الخاص لا يعفي الدولة، التي بات الإفلاس فيها خطراً يتهددها وليس مجرد شعار، من مسؤولية السداد في حال تخلفت تلك الشركات، بالإضافة إلى أنه في كل الأحوال، وبغض النظر عمن يسدد، فإن الدولة وحدها منوط بها توفير العملة الأجنبية اللازمة لأقساط ديون المؤسسات الأوروبية والدولية.
يختبئ المتفاخرون وراء أزمة المناخ ووراء حيوية مطلب خفض الانبعاثات الكربونية لدفعنا نحو المضي في مشاريع التحول السريع نحو الطاقة النظيفة دون نقاش أو دراسة كافية، وذلك يناقض حدود التزاماتنا التاريخية العادلة، فبحسب ما خلصت مقارنات وتحليلات أحمد العدوي وصقر النور في المقال المشار إليه، «فإن متوسط انبعاثات الفرد في مصر يبلغ 2.32 سنويًا، وهو أقل من نصف المتوسط العالمي. على المستوى الإقليمي يمثّل متوسط انبعاثات الفرد في قطر 16 ضعف مثيله في مصر، وفي السعودية سبعة أضعافه. وعلى المستوى العالمي يبلغ متوسط انبعاثات الفرد في الصين ثلاثة أضعافه في مصر، وفي الولايات المتحدة ستة أضعافه، وفي ألمانيا أربعة أضعافه».
هؤلاء المتفاخرون يحلو لهم أيضاً تذكر كارثة التغير المناخي كأننا اكتشفناها للتو، أو كأن المعارضين لهم يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه، أو ككارثة طبيعية لا دخل فيها للسياسات العامة ولعلاقات الاستغلال والنهب التاريخية للاستعمار القديم والجديد.
ما الحل إذن؟
هل هناك بدائل لتلك العلاقة الاستعمارية؟ ربما يكون البديل في بعض التجارب الأوروبية (وللمفارقة) التي أتاحت ربط خلايا الطاقة الشمسية المنزلية بشبكات التغذية المركزية، دون الحاجة لوجود بطاريات وبالتالي دون الحاجة لتحمل تكاليفها، على أن تنتج الخلايا طاقة كافية للاستخدام المنزلي، ويحول الفائض لبيعه في الشبكة المركزية. صحيح أن هذا لا يساعد على تخزين الطاقة وقت الانقطاع، لكنه من باب آخر يزيد نوعية وكم مصادر الطاقة المؤدية للشبكة المركزية وبالتالي تقل مبررات الاحتياج لقطع التيار الكهربي.
ماذا عن التجربة الكينية، وهي بالطبع الأقرب لنا في الواقع. في كينيا حيث عمل الاستغلال الاقتصادي منذ عقود طويلة على نهب الموارد الطبيعية، بما فيها المواد الخام المرتبطة بتصنيع الخلايا الشمسية. كان يعاني السكان في المناطق الزراعية من ندرة التيار الكهربي، عمل تحالف نسوي يضم 5 جماعات و200 عضوة من نساء قبيلة الماساي على عقد اتفاقات مع مبادرات محلية لشراء خلايا الطاقة الشمسية بأسعار مخفضة، تم توزيع الخلايا على الفلاحين في الأقاليم البعيدة، في بعض الأحيان نقلوا الخلايا تلك باستخدام الحمير، وكانت النساء نفسهن هن من يقمن بأعمال التركيب والصيانة بعد التدرب عليها والتعلم من الخبرة العملية. أثر ذلك على العديد من النواحي في حياة هؤلاء المزارعين والمزارعات، قلت بحدة ساعات انقطاع الكهرباء، باتت مواشي الفلاحين أكثر أماناً من هجمات الحيوانات البرية، وانخفضت وتيرة قطع أشجار الغابات لاستخدامها في التدفئة، وانخفضت وفيات الدخان المنزلي.
مع ذلك وبكل صراحة البحث عن بدائل عادلة لأزمة الطاقة في مصر أو في ضمان انتقال طاقي عادل يحتاج جهود المختصين في ذلك، وهي متوفرة بالفعل. هذه التجربة أو تلك قد تكون صالحة لكينيا، لكنها غير قابلة للتنفيذ في مصر، أو في لبنان، التي شهدت تجارب لإنتاج الطاقة الشمسية وبيعها لشبكة التغذية وتجارب أخرى للإنتاج والتوزيع بشبكات ضيقة على الأحياء والبلدات الصغيرة، غير أن مافيا الفساد هناك قضت عليها.
النضال من أجل مواجهة آثار التغير المناخي، بما يعنيه من النضال ضد شبكات الهيمنة العالمية، ليس ترفاً، ولا ينفصل عن مواجهة معضلة الاستبداد السياسي والحكومات التي تسهل آليات سيطرة الأطراف الأغنى في العالم. ما نقف أمامه ليس تحدياً بسيطاً يتجاوزه الاستثمار أو الانتقال للاعتماد على طاقة نظيفة وحسب، ولكنه يعبر عن أزمة مركبة تلتقي فيها مسائل الطاقة والتغير المناخي مع الفقر والتنمية وحرية الاشتباك السياسي، والدفاع عن كوكب أكثر عدالة ..
قد تكون تلك التجارب في السياق المصري مجرد كلام نظري. وهنا لابد أن نشير للجهود المتفرقة التي عكف عليها تقنيون وباحثون في الاقتصاد والبيئة والتغير المناخي، حاولت أن تتخطى عقبات شبكات إنتاج الطاقة الشمسية بشكل لا مركزي، كحلول الربط الكهربي بين الدول، ومشروعات إنتاج وتوزيع سخانات المياه الشمسية، والتي لا تحتاج لتكنولوجيا مستوردة ولا بطاريات تخزين. وبالطبع، دعم هذه المجهودات وتشبيكها والعمل على تخطي العقبات الهندسية المعقدة والحقيقية في إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية، هو ما يستطيع نقل التكنولوجيا، وخلق مسارات تكنولوجية خاصة، وليس بالضرورة الاستثمار الأجنبي والاستدانة، الحريصة بالفعل على احتكار التكنولوجيا وقصر ما يُنقل على تقنيات التشغيل والصيانة الدورية.
في ضوء كل هذا ربما يقع على عاتق كل إطار جماعي، وفي القلب منه الأحزاب والجماعات السياسية، ممن هم خارجين عن حسابات الربح والخسارة للشركات الخاصة أو حسابات السيطرة لدى الدول الكبرى، أن نعي أولاً موقعنا في خريطة توازنات القوة الدولية، وأن نتمسك جماعياً بألا تنظف الرأسمالية نفسها على حسابنا. ألا تكرر شركات النفط والمؤسسات المالية الكبرى، والمتعجلين وراء التحول الأخضر، وأصحاب شركات البيزنس الأخضر، وأصحاب شركات السينما الخضراء، نفس ميزان القوة الذي خلقته منذ قرن، ودفعت شعوب العالم كله أثماناً باهظة في مقابله، ودفعت شعوب هذه المنطقة أثماناً مضاعفة، فقط لأنها كانت كنز النفط لأرباب جرائم الحرب ومراكمة أرباح الفقراء ورواد الرأسمالية، السوداء أمس، الخضراء اليوم.
هناك خبران في هذه القضية، الخبر السيئ أننا نلاقي تحديات حقيقية ومركبة، في مسار التنمية ومواجهة الفقر وإدارة الديون والحفاظ على ما تبقى من سيادة للمواطنين مضافاً لذلك كوارث التغير المناخي. الخبر الجيد أن كل تلك القضايا ليست مفصولة عن بعضها، ولا تعبر عن أزمة استبداد بقدر ما تعبر عن أزمة توجه سياسي واقتصادي دولي لا يعمل، ولا يريد لبدائله أن تعمل. والمضي في اتجاه الحل الأكبر لتلك التعقيدات، يقوم على عكس توازن القوى المعتاد، المسؤول أولاً وأخيراً عن الوصول لهذه اللحظة الحرجة، أن تعود الموارد المشاعية لملكية السكان بما يصون سيادتهم عليها، أرضاً ومصدراً للطاقة، وأن يجري ذلك من خلال تعويضات من الدول الصناعية عن عقود كاملة من الاستغلال والنهب المنظم والحروب الكبرى والاقتتال الأهلي والفقر واللامساواة.
النضال من أجل مواجهة آثار التغير المناخي، بما يعنيه من النضال ضد شبكات الهيمنة العالمية، ليس ترفاً، ولا ينفصل عن مواجهة معضلة الاستبداد السياسي والحكومات التي تسهل آليات سيطرة الأطراف الأغنى في العالم. ما نقف أمامه ليس تحدياً بسيطاً يتجاوزه الاستثمار أو الانتقال للاعتماد على طاقة نظيفة وحسب، ولكنه يعبر عن أزمة مركبة تلتقي فيها مسائل الطاقة والتغير المناخي مع الفقر والتنمية وحرية الاشتباك السياسي، والدفاع عن كوكب أكثر عدالة.