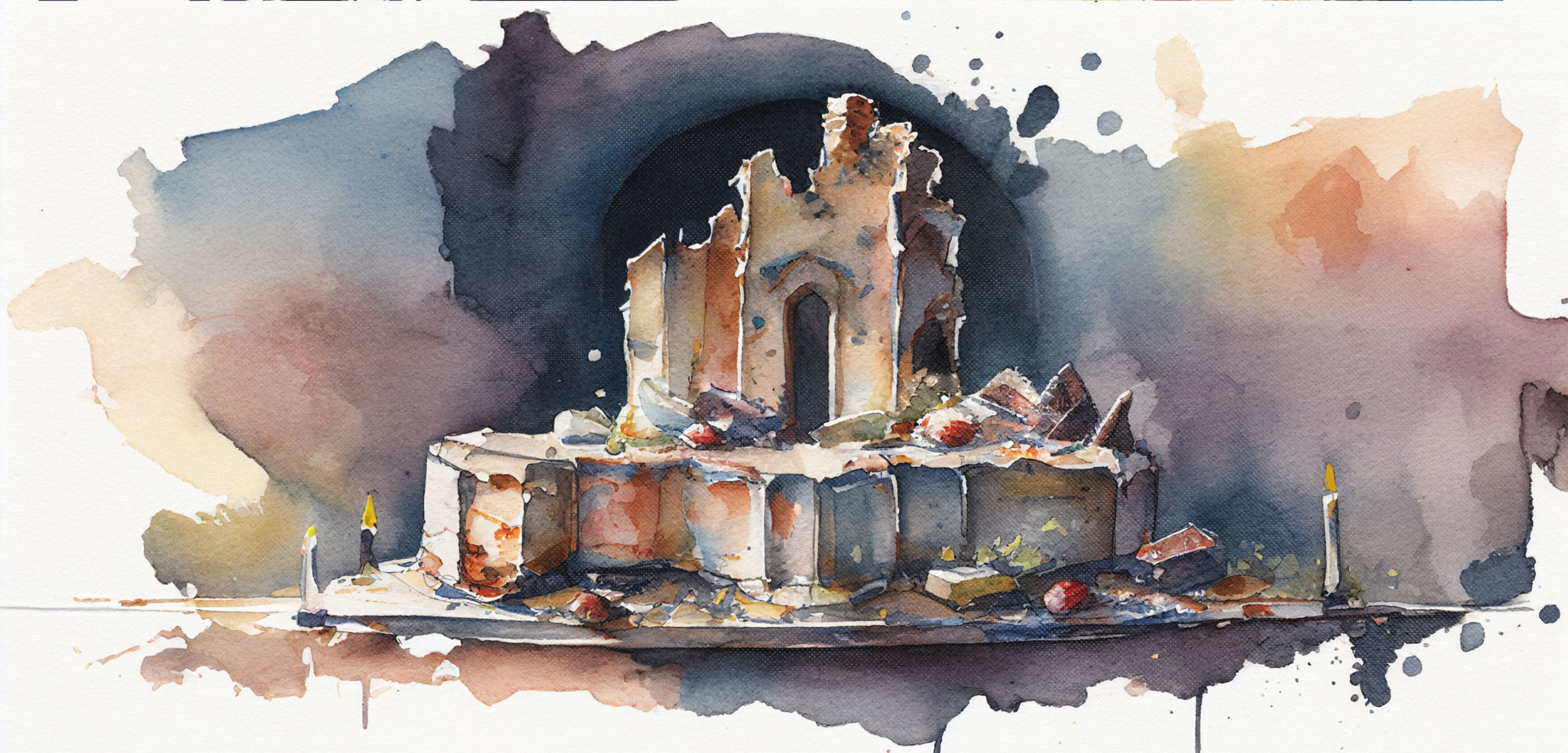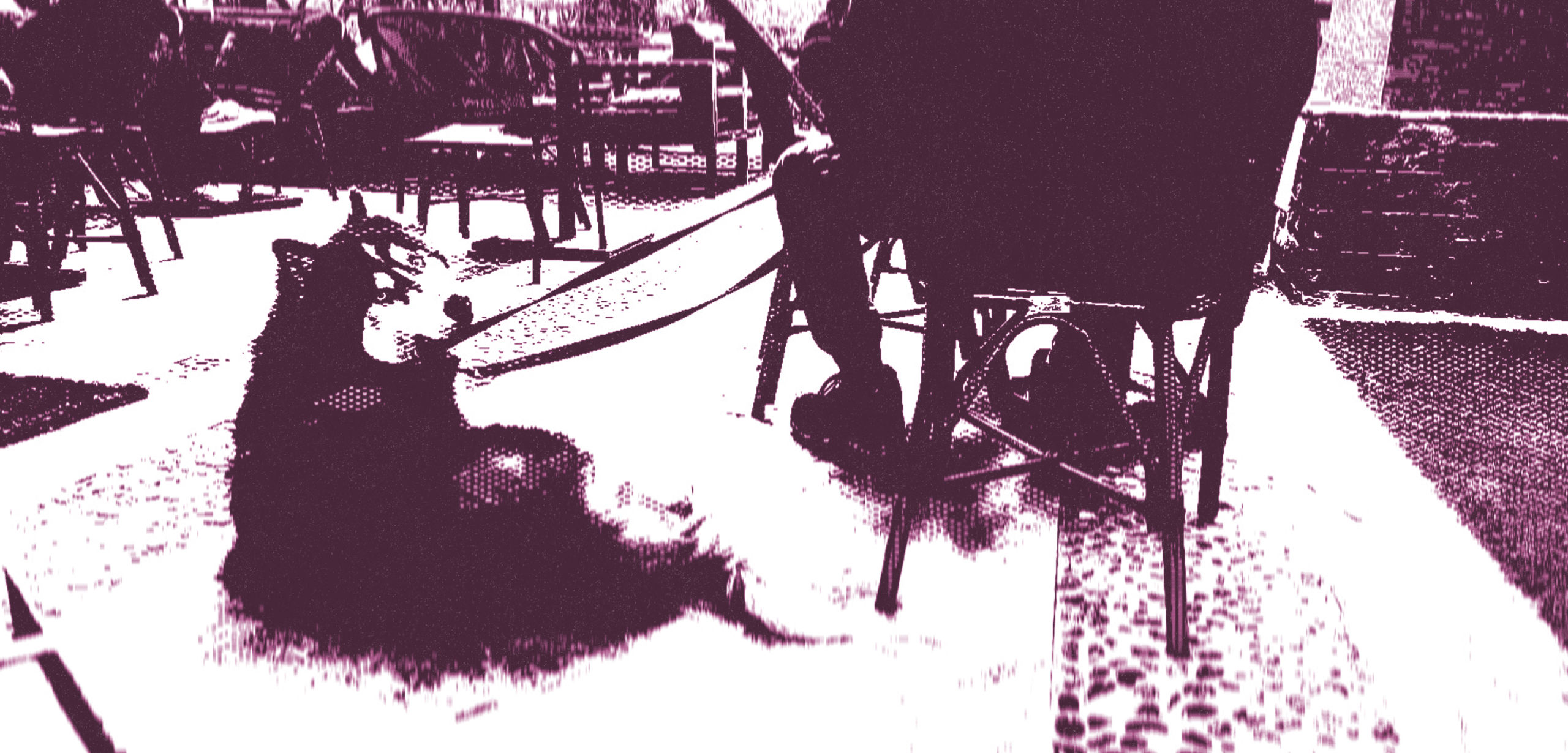لم أره من قبل وربما لن أراه طيلة حياتي. ها هو يوشك أن يختفي من الوجود، ووهل كنتُ سأكترث لأمره لولا أنه كذلك؟ ولكن كيف أكتب عمّ لم أقابله ولم أعرف عنه الكثير من قبل؟
بدأتُ من ذكرى عادية لطفل تحذره أمه: “أسكت لا يجي الرفش ياكلك”.كان الخوف أشبه بعلاقة ذهنية متخيلة ربطتني بالسلحفاة الفراتية منذ صغري، كنت أتخيل الرفش وحشًا عملاقًا ومستعدًا لأكل لحم الأطفال، ولم يكن هناك مصادر أخرى للمعلومات عنه، ولا حتى صورة في كتابٍ مدرسي، هناك فقط اسمه المخيف ووعيد أمي وخيالي.
ليس من السهل أن نكتب عن حياة حيوانٍ ينقرض، نحن لسنا مدَرّبين كصحافيين على الكتابة عن الحيوانات.
تطلّب الأمر مني الكثير من الجهد، ليس في البحث والقراءة فقط، بل في التعامل مع قصةِ حيوانٍ كموضوع، ذلك لأننا تأثرنا بما سمعناه من محيطنا، وكان هذا قد شكّل بمرور الزمن علاقة خصومةٍ مع بيئتنا الطبيعية الحاضنة، علاقة تقوم على أمرين: العداء والاستغلال، وساهمت العادات والتقاليد المترسخة إلى جانب المتطلبات المتزايدة في تفاقم الإثنين، وصولًا إلى توحشهما في كثير من الأحيان.
لم يكن ثمة حيوانات في طفولتي سوى قطة كان يربيها جدي، ويعلّمني العناية بها، لكن حبي لتلك القطة لم يمحُ شكل الرفش الذي تصورته بنفسي، وكان تراودني هواجسي منه في الليل، أو حين أرتكب أي زلة فأخوّف نفسي بنفسي: سيراني الرفش ويأكلني!
كارثة بيئية لأسباب سياسية
كانت بيئة الأهوار والمسطحات المائية في جنوب العراق أنموذجًا حيويًا شاهدًا على وفرة الحيوانات بتنوعها، عاش مع تلك الحيوانات والطيور سكان المنطقة الذين كانوا يشغلون مساحات واسعة منها، إلى أن بدأت أعدادهم تقل نتيجة الكوارث السياسية والبيئية والاجتماعية التي عصفت بهم.
ففي تسعينيات القرن الماضي، قام النظام السابق بتجفيف الأهوار على مراحل، عن طريق بناء سدودٍ ترابيةٍ تمنع تدفق الماء إلى المنطقة الممتدة بين محافظات البصرة وميسان وذي قار، والتي كانت تعدّ واحدة من أكثر البقع الرطبة المتنوعة بيئيًا في العالم.
تنوعت أسباب التجفيف في كل مرحلة بعضها في الثمانينيات بهدف إعداد الأرض للتنقيب عن النفط. وبعضها في مطلع التسعينيات، حين أخذ نظام البعث آنذاك قرار القضاء على الأهوار إثر معارك اختبأ معارضوه خلالها بين متاهات المنطقة السبخة والمخفية بحقول القصب.
أدى التجفيف الممنهج إلى موت عددٍ هائلٍ من الحيوانات والنباتات، وباتت الأرض الخصبة موطنًا لا يصلح لعيش كثير من الكائنات الحية، وهاجر سكانها الأصليون الذين يمتد تاريخ وجودهم فيها إلى مئات السنين، والمعروفين بـ “المعدان”، إلى المدن بحثًا عن حياة جديدة بعدما كانوا يعتمدون على الزراعة والصيد وتربية الجاموس ومواشي أخرى.
لسوء حظها، لم تلق السلحفاة الفراتية ذات الدرع الناعم والجميل بلونه الأخضر الزيتي، باهتمام من المجتمع العلمي مثلما حظي غيرها من فصائل السلاحف في العالم. مرد ذلك وجودها المنعزل بالنظر إلى التوزيع الجغرافي المحدود لحياتها إلى حد ما. إنها حيوان همشته الدراسات الطبيعية ولم تنتبه إليه بالفعل إلا بعد اقتراب تجمعاته من النهاية
انتهت علاقة المصالحة والسلام التي جمعت أهل الأهوار بالطبيعة المحيطة بهم حين كانوا يعيشون منها وفيها بلا أذى وتحولت إلى علاقة من الفقدان والمنفى.
أبادت جريمة تجفيف الأهوار أعدادًا كبيرةً من الرفش الفراتي ومن كلب الماء (ماكسويل) وهو حيوان عراقي آخر آيل للانقراض، هذا غير الحرائق التي التهمت المنطقة واستمرت مشتعلة لأشهر على امتداد 90 كيلومترًا، مُهجّرةً حيوانات أخرى إلى مناطق أبعد.
رغم هذه الخسارة المروّعة، لا يمكن أن نعزو تدهور أعداد الرفش إلى كارثة التسعينيات فقط، ولا لوجوده في العراق وحسب.
فللتغير المناخي دورٌ كبيرٌ في تهديده، إذ اعتاد أن يعيش في المياه العذبة والضحلة ذات التدفق البطيء مثل الأنهار والجداول والبحيرات والبرك الممتدة من جنوب شرق تركيا وصولًا إلى الشمال الغربي للخليج العربي، مرورًا بدجلة والفرات والأهوار الجنوبية، معتمدًا على أكل الحشرات والأسماك والنباتات المائية، والجيف أيضًا.
هذه البيئة التي تشكل المحيط المثالي للسلحفاة الفراتية، تغيرت بسبب التبدل في المناخ وشح المياه وجفاف بعض المناطق وتناقص عدد الأسماك والتلوث في الماء والهواء الذي خلفته النفايات التي تُلقى في المياه، وقبل منها الحروب منذ الحرب الإيرانية العراقية وصولًا إلى حروب الألفية الثالثة على اختلافها. كل ذلك تسبب أيضًا في زيادة ملوحة المياه التي كانت تتميز بعذوبتها.
تحمينا.. تداوينا.. تخوّفنا
لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن السلحفاة الفراتية تشكّل خطرًا أو تهديدًا على حياة الإنسان، لكن هذا لا يمنع الخرافات الشعبية من مطاردتها وتصويرها في أبشع صورة إلى يومنا.
مما يتناقله الناس ويصدقونه أن الرفش يهاجم السباحين فجأة وينتزع بأسنانه أعضاءهم الذكورية، معتقدين أنه في الأصل كان تمساحًا. وأن لديه القدرة على التحوّل في الليل إلى كائن مخيف آخر يطلقون عليه “عبد الشط“. وأنه يسحب الأطفال بمخالبه بينما يلهون بالقرب من ضفاف الأنهر ليسد جوعه بلحمهم.
ربط الناس في تلك المناطق بعض حوادث غرق الأطفال بالرفش البريء من دمائهم، فكرهوه في نفس الوقت الذي آمنوا أن جسده يخفي علاجًا لبعض أوجاعهم! المفارقة، أنه وقبل أربعين عامًا فقط كان سكان جنوب شرق تركيا إذا اصطادوا سلحفاة فراتية أو عثروا على بقاياها، علّقوا عظامها حول أعناق الأطفال لحمايتهم من “العين الشريرة”.
لم يكن الرفش معروفًا خارج منطقة انتشاره، قبل أن يلتقي به العالم الفرنسي غيوم أنطوان أوليفييه في نهايات القرن الثامن عشر في بلدة “عانة” في منطقة الأنبار، وقد فسّر الاسم كما نقله إليه السكان المحليون آنذاك بأنه يعني المجرفة باللغة الدارجة. كذلك أخبروه أن لحم هذا الحيوان ليس صالحًا للأكل، لكن دهنه يعتبر دواءً لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية.
ما زال عدد من الناس يلجأ إلى نوافذ الطب الشعبي هنا وهناك ومحال العطارة والتداوي بالأعشاب، مثلما فعل آباؤهم وأجداداهم من قبل، حيث يباع الزيت المستخلص من شحم الرفش الفراتي، الذي يُعتقد أنه يداوي من آلام في المفاصل، دون أن يكون هناك دليل طبي حول ذلك.
لقد عُرض مبلغ ثلاثين دولارًا على الشاب محمد البدري، الذي يسكن قضاء الشطرة بمحافظة الناصرية (جنوبي العراق)، بعد أن عثرَ على رفش فراتي في قصبة مائية قرب منزله.
يقول البدري: “كنت أعرف أنه من الفصائل المهددة بالانقراض، لم أعرف كيف أتعامل معه لذلك قمت بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت من الناس مساعدتي في كيفية التصرف معه. عرض عليّ بعضهم شراءه من أجل دهنه”. انتهى الأمر بأن لفّ البدري السلحفاة بقطعة قماش وأخذها إلى نهر الغرّاف حيث بيئتها الطبيعية.
مما يتناقله الناس ويصدقونه أن الرفش يهاجم السباحين فجأة وينتزع بأسنانه أعضاءهم الذكورية، معتقدين أنه في الأصل كان تمساحًا. وأن لديه القدرة على التحول في الليل إلى كائن مخيف آخر يطلقون عليه “عبد الشط”. وأنه يسحب الأطفال بمخالبه بينما يلهون بالقرب من ضفاف الأنهر ليسد جوعه بلحمهم
ليس صيد السلاحف لاستخلاص دهنها إلا واحدًا من أسباب مختلفة لمهاجمتها؛ فالصيادون يعدّونها خصمًا لهم، من حيث أنها تنقص حصتهم من الأسماك التي تناقصت أعدادها أصلًا بشكل ملحوظ بسبب تلوث الماء الذي أدى إلى نفوق الكثير منها. يترصد الصيادون للرفش عبر جذبه عن طريق إنزال كيس من النايلون مليء بدم الضأن في الماء ويقتلونه كي لا يأكل الأسماك ويشاركهم رزقهم.
لكن دراسة هذا النوع من السلاحف- المدرج في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة- أثبتت أنها إلى جانب أكلها الأسماك يمكنها أيضًا أن تتناول الأعشاب والطحالب والحشائش إن وُفّرت لها، بل وقد تسير إلى الحقول القريبة وتأخذ حصتها من الخضروات المزروعة، وهو أمر كان يشكو منه المزارعون ليس في العراق بشكل أساسي، ولكن في موائلها القليلة الباقية، حيث ما زالت السلاحف تقاوم الفناء في محافظة خوزستان بإيران.
التهديد الأكبر الذي عرفه الرفش هو بناء السدود، فهذه تغيّر في مستويات الرواسب ودرجة حرارة المياه ونسبة ملوحتها. وحيث أن نطاق الانتشار الجغرافي لسلحفاة الفرات يقتصر على حوضيّ دجلة والفرات في تركيا وسوريا والعراق وإيران، فقد اختفت من الأماكن التي أنشئت فيها السدود. مثلًا، رحل الرفش عن موئله في مجرى الفرات الذي يمر من مدينة أورفه التركية، فعقب إنشاء سد أتاتورك طُمرت المواقع الرملية المثالية التي يضع فيها البيض. وكلما بُني سد جديد على امتداد الفرات شدّت السلاحف رحالها تاركة بيضها ميتًا في أرضه.
ومع بناء تركيا لسلسة من السدود بين عامي 1975 و2000 في إطار عمل مشروع تطوير شامل معروف باسم “GAP”، شُرّدت السلاحف ولم توجِد المؤسسات الرسمية بدائل لها تبني فيها بيوتها. لا سيما وأنها كانت تبيض بشكل أساسي في نهاية أيار (مايو) إلى أوائل حزيران (يونيو) في منطقة بيرشيكين أي في الجزء التركي (العلوي) من الفرات، حيث الضفاف المناسبة لأعشاشها، والتي اختفت تقريبًا بسبب السدود التي كان لها آثارٌ قمعيةٌ على تجدّد الرمال.
على الرغم من كونها مهددة بالانقراض، ورغم كل الأصوات البيئية العالمية التي تنادي بصونها، لم يبادر أحد إلى إطلاق مشاريع جديّة للمحافظة على نوعها، مثل بناء الموائل الاصطناعية، من ذلك إنشاء القنوات المناسبة- من حيث مستوى الماء والحرارة- لحياة سلاحف الفرات، باستثناء مشروع واحد في مقاطعة خوزستان الإيرانية.
بالنسبة إلى إحصائها في العراق، “لا توجد أعدادٌ واضحةٌ وثابتةٌ عن ما تبقى من الرفش الفراتي” يقول عالم الحياة البرية العراقي عمر الشيخلي متابعًا “نعمل الآن على إجراء مسوحات لإحصاء عددها، لكن هناك دراسة قام بها فريق مشترك من الباحثين العراقيين والأجانب، وجدوا فيها أن أعداد الرفش تتراوح بين 200-400 في الأهوار الوسطى”.
هنا يذكر الشيخلي أن أهمية السلحفاة الفراتية تكمن في أنها تعمل مثل رادارٍ طبيعي يكشف أيّ تلوث مائي، ويتخلص من الفضلات في المياه، ويشعر بأيّ تغير مناخي ويحافظ من خلال وجوده على التوازن البيئي للمناطق التي يقطنها.
لسوء حظها، لم تلق السلحفاة الفراتية ذات الدرع الناعم والجميل بلونه الأخضر الزيتي، اهتماماً من المجتمع العلمي مثلما حظي غيرها من فصائل السلاحف في العالم. مردّ ذلك وجودها المنعزل بالنظر إلى التوزيع الجغرافي المحدود لحياتها إلى حد ما. إنها حيوان همشته الدراسات الطبيعية ولم تنتبه إليه بالفعل إلا بعد اقتراب تجمعاته من النهاية. لذلك لا يوجد الكثير من المعلومات في ما يتعلق ببيولوجيا هذا النوع وسلوكه، فهل نخطئ لو أضفنا التجاهل العلمي إلى قائمة الأسباب التي أدت إلى وضعها الراهن؟
مشروع GAP التركي. المصدر: iraqwithoutwater
السلحفاة الفراتية.. حارسة العبور إلى العالم الآخر
تقوم العلاقات القديمة بين المجتمعات البشرية والحيوانات البرية التي تعيش في مستوطناتها وحولها على مزيج من المصالح الاقتصادية والطقوس والمعتقدات الدينية والتقدير الذي يصل إلى التقديس في بعض الأحيان، صحيح أن هذا المزيج ما زال موجودًا إلى حد ما، لكن الكثير مما هو جيد فيه قد بتخّر.
وعلى عكس الحيوانات التي جسدتها الرسومات والنقوش القديمة في الحضارات الأولى، لم تُجر دراسات حقيقية لفهم العلاقة بين السلحفاة الفراتية والمجتمعات البشرية القديمة في بلاد ما بين النهرين. لكن ذلك أخذ مسارًا آخر عام 2016، حين اكتُشفت مقبرةٌ أشوريةٌ في كافوشان هويوك جنوب شرق تركية، وأظهرت أن الآشوريين كانوا يرسلون موتاهم إلى الحياة الأخرى مع حرّاس يحمونهم أثناء العبور، ولم يكن هؤلاء الحراس إلا السلاحف الفراتية.
تأكد هذا لدى التنقيب في تلك المقابر الأشورية التي تعود في تاريخها إلى 700 و300 قبل الميلاد، حيث كشفت الحفريات عن هياكل عظمية لامرأة وطفل و21 سلحفاة، 17 منها من الرفش الفراتي.كتب عالم الآثار المسؤول وقتها أن علامات الذبح على عظام الرفش تشير إلى أن السلاحف أُكلت في وليمة جنائزية على الأرجح. هناك دلائل أيضًا إلى استخدام عظامها كتعاويذ لحماية جثمان الطفل.
اليوم نعرف أن حضارات ما بين النهرين اعتقدت أن عظام الرفش تمنع الشر وأنها تدرب الأموات على الحياة الأبدية. ويشير العدد الوفير منها في المقبرة إلى المكانة الاجتماعية الرفعية للمتوفي. بعض الحفريات أظهرت تغطية قبور الأطفال بدرع السلحفاة الفراتية أحيانًا، وفي حالات أخرى وضعت جمجمتها بالقرب من وجه الميت.
لكن مهلًا، ربما أن مخيلة العراقيين -التي تصور السلحفاة الفراتية وحشًا يسحب الإنسان بأظافره القوية إلى القاع ويلتهمه- لم تأت من فراغ. فها هي الملحمة السومرية “نينورتا والسلحفاة” تصف كيف يصنع الإله إنكي سلحفاة من الطين لتنقذ لوح الأقدار من يد نينورتا بعد أن استولى عليه. أمسكت السلحفاة بنينورتا وعضته من كاحله وسقط في حفرة صنعتها في الأرض بمخالبها التي ثبتته بها، قبل أن تبدأ في قضم قدميه.
اليوم في بعض المناطق التركية، كما في الماضي، تُعلق رفات السلحفاة في المنازل والسيارات وفوق مهد الرضّع، أو تصنع منها التمائم. خلال مسح أجراه باحثون أتراك عام 2010 وجدوا عائلاتٍ في منطقة بسميل بديار بكر (القريبة من موقع المقابر الآشورية)، تعلّق درع سلحفاةٍ صغيرةٍ على مدخل المنزل لإبعاد الشر عن الأسرة، أو تعلقها مع زجاجةٍ فيها ملح لتجلب الخصوبة للمرأة والرزق للرجل، وفي مدينة توقاد التركية يدفنون سلحفاةً في الحقول لزيادة خصوبة التربة.
في حكم أكل السلاحف
لا وجود لدليل قاطع على تناول لحم السلاحف الفراتية في الحضارات القديمة، لكن باحثين في تاريخها شاهدوها تباع في بعض أسواق السمك في العراق في فترات متقطعة من العصر الحديث، وكذلك في جنوب شرق تركيا، مما يشير إلى أن احتمال استهلاكها كلحوم واردٌ على الأقل من قبل بعض المجتمعات الصغيرة.
بأسف، يلفت عمر الشيخلي إلى أن السلحفاة الفراتية اليوم باتت مكونًا لبعض الوصفات التي انتشرت في مناطق عراقية محددة، موضحًا “أصبح الرفش الفراتي طبقًا يوضع على موائد الطعام في مناطق بشمال العراق، وهذا أمرٌ مقلق للغاية حول كائن لم نعد نرى الكثير منه. يأكل بعض الناس هذا الرفش، فيحبون طعمه، ثم يروجون له ليصبح طبقًا مألوفًا في موائد الأهالي”.
الأخبار التي يجري تناقلها ومقاطع الفيديو التي تنشر من مناطق مختلفة، تكشف أيضًا أن أغلب أكلة لحم السلاحف هم من عمال الشركات الآسيوية المنتشرة في البلاد، دون أن ينفي ذلك أن هناك من يأكل لحم الرفش في المناطق الممتدة لوجوده باعتباره نوعًا من الأسماك.
التهديد الأكبر الذي عرفته السلحفاة الفراتية هو بناء السدود، فهذه تغيّر في مستويات الرواسب ودرجة حرارة المياه ونسبة ملوحتها. وحيث أن نطاق الانتشار الجغرافي لسلحفاة الفرات يقتصر على حوضيّ دجلة والفرات في تركيا وسوريا والعراق وإيران، فقد اختفت من الأماكن التي أنشئت فيها السدود
وساهم انتشار شائعة القيمة الخاصة للحم السلاحف، دون وجود براهين علمية عليها، في أن تباع في بلاد عربية مختلفة، فقد أصبحت تباع في مصر أيضًا بسعر وصل إلى 200 جنيه للكيلو (أكثر من عشرة دولارات)، صحيح أن هذه نوع آخر غير الرفش، لكنه نوعٌ مهددٌ بالانقراض هو الآخر.
ثمة من يستفيد بربط الندرة بالقيمة الغذائية والعلاجية الوهمية للسلاحف، ويعرضها للبيع بسعر مرتفع نسبيًا. حتى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بتحريم أكلها لأسباب تتعلق بطريقة ذبحها وبندرتها والضرر الواقع على البيئة بالقضاء عليها.
أثارت طريقة ذبح السلاحف الجدال في العراق أيضًا، بعد أن كشفت مقاطع فيديو لقتل الرفش الوحشيةَ التي يتم التعامل بها مع هذا الحيوان الذي قدّسه العراقيون القدامى.
تكشف هياكل السلاحف التي عثر عليها في المدافن الآشورية طريقة ذبح السلاحف الفراتية التي لا يلتحم فيها الدرع (أسفل البطن) مع الحامية (على الظهر)، وذلك بقتلها سريعًا من خلال قطع من الجانبين. أما ما نراه اليوم فهو قتل بطيء وتعذيب مطوّل، حيث توضع السلحفاة على ظهرها، وهذا يصيبها بالشلل، ثم تترك مقلوبة لتموت من الجوع تحت الشمس. بعضهم يقلبها على ظهرها ثم يقطع ذيلها تاركًا إياها تنزف حيًة إلى أن يتصفّى دمها ثم تُذبح بعد ذلك.
المصدر: ويكيبيديا تحت رخصة المشاع الإبداعي
حسبة بسيطة
تعدّ النظم الإيكولوجية للمياه العذبة أكثر النظم البيئية المهدّدة في عالمنا اليوم، وذلك لأنها بيئة ثرية قريبة من المناطق المأهولة بالناس، ولطالما كانت عُرضة بتنوعها البيولوجي الكبير إلى النشاط البشري العنيف أكثر من غيرها (تلوث، صيد جائر، زحف عمراني).
بحسبةٍ بسيطةٍ، فإن أكثر من عشرة آلاف نوع من الأسماك يعيش في المياه العذبة، وهذه تشكّل 40% من التنوع السمكي العالمي. وإذا أضفنا البرمائيات والزواحف المائية (التماسيح والسلاحف) والثدييات (ثعالب الماء، والدلافين النهرية، وخلد الماء، وكلب الماء وغيرها) إلى إجمالي أسماك المياه العذبة، يصبح من الواضح أن ما يصل إلى ثلث أنواع الفقاريات في العالم محصورة في المياه العذبة.
مع ذلك، فإن موائل المياه العذبة تشكل 0.01٪ فقط من مياه العالم وتغطي فقط حوالي ثمانية بالألف من سطح الأرض. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن أي خلل بسيط في بيئة المياه العذبة هو خلل كبير في حسابات البيئة العالمية.
ربما من هنا يذهب القائمون على الكتاب الضخم “دجلة والفرات: من المنبع إلى المصب”، إلى أن منطقة الأهوار على امتدادها وإيكولوجيا المياه العذبة في العراق وفّرت للسكان مجموعة واسعة من خدمات النظام البيئي الطبيعية والتي عادت عليهم بالماء والغذاء والدخل. وأن اعتماد الإنسان على النظم البيئية الصحية للمياه العذبة لم يكن أكثر وضوحًا مما كان عليه ذات يوم في العراق.
إلى أبعد ما يمكن
لقد بنى الناس في مخيلتهم صورة وحشية للرفش، لكن الحقيقة أن سلاحف الفرات خجولة في تصرفاتها، فتميل إلى أن تظل مكسوة بالماء حين تشعر بوجود البشر، ولا تحب أن تكون معرّضة للعيون ولا قريبة من الأصوات.
وحين تشعر بحركتنا بين غابات القصب المحيطة فإنها، على عكس الاعتقاد برغبتها في مهاجمتنا، سرعان ما تتراجع إلى الماء محافظةً على أن تكون عند أدنى درجة من خطر العالمين البرّي والمائي. وما أن تسمع حركة قوارب الصيادين تشق ماء النهر حتى تسبح إلى أقرب نقطة من القاع وأبعد نقطة ممكنة عن وجود الإنسان.