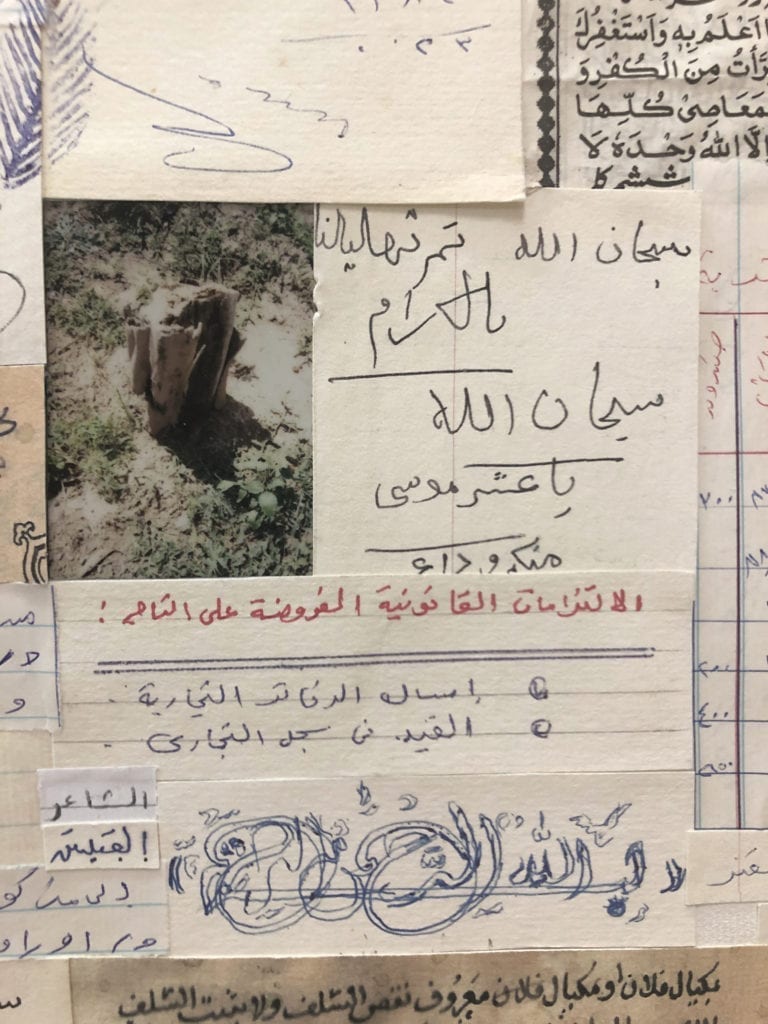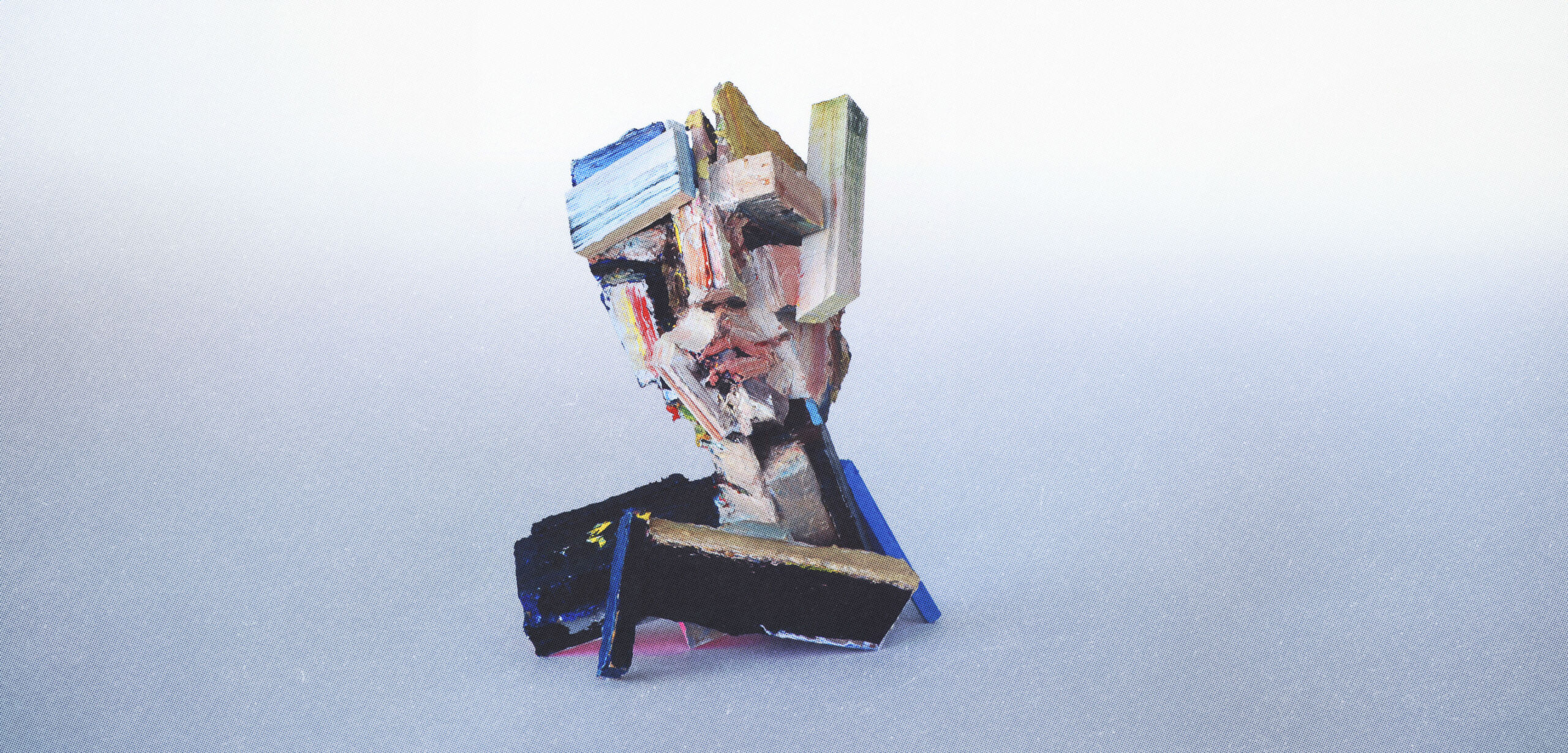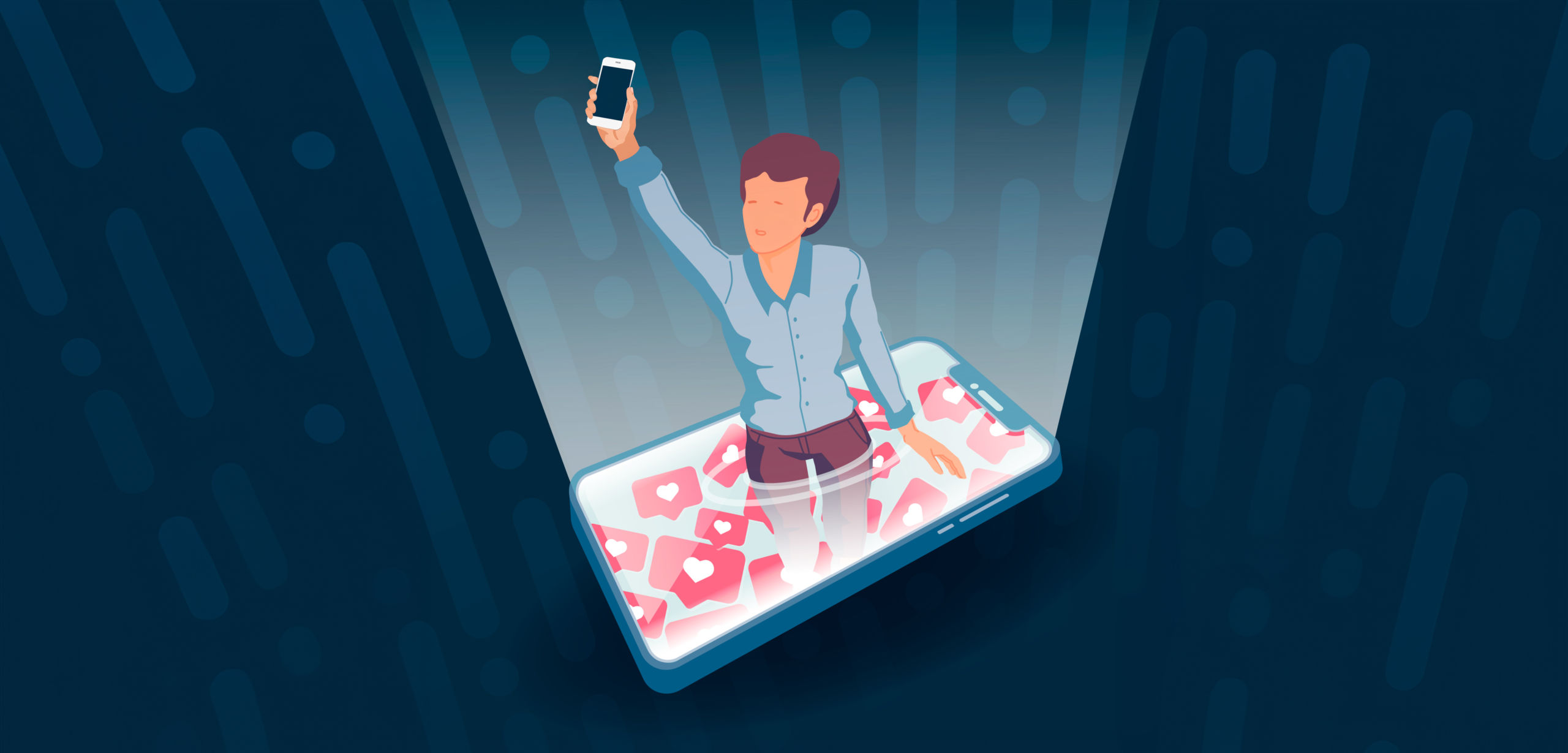بيتنا لا يظهر في خارطة جوجل، وعندما أرسلته لصديقي ليستخرج إحداثيات البيت بينما أكتب، قال لي هل تسكنون بجانب البحر؟ قلتُ لا، أبداً، ويبدو أن الأقمار الاصطناعية قررت أننا لا نعيش في مكان معروف، آخر صورة التقطت للموقع قبل عام، استدرك صديقي: هل تعيشون هنا بالفعل؟ وحدقتُ ملياً في الفراغ، حاولتُ أن أفصل الذاكرة عن الواقع، أن أتعامل مع الحقيقة لمرة واحدة، وهذه كانت البداية ليس إلا.
أبيض وأزرق
رأيتُ في المنام أنني في صالة الطعام المفتوحة في البيت، أبي يوجهُ لي إهانة ناتجة عن سوء فهمه لتصرفي، ولكنني على خلاف ما مضى، رددتُ هذه المرة بكل إرادة، أنني لن أسمح له بإهانتي، وعندما جاء ليضربني غاضباً، هددتهُ بالشرطة، فقرر أن يسكب فوق رأسي كوب ماء، إذ أن بلل الشعر لن يترك دليلاً على العنف.
وفي ليلة أخرى، وبغير ترتيب يُذكر حلمتُ بأن ما يفصلني عن الشارع والبيت، وادٍ عميق، وأن كلفة الوصول لعتبة البيت، تتطلب الإقدام على السباحة، والتعامل مع المجهول، وكنتُ على غير عادتي أيضاً قويةً ومندفعة، دائماً باتجاه بيتهم، بيتي.
***
لون البيت أبيض، إطارات النوافذ زرقاء، هكذا يختلف عن بقية بيوت المنطقة، إذ أن البلدية لا تسَمحُ إلا بلونين الأبيض و (البيج) وهكذا فأننا ندخل العالم كأسرةٍ وفق ضوابط الحكومة.
في مساحة قدرها ٦٠٠ متر مربع تحصل عليها أبي من الحكومة أيضاً، وكنا نرى في تلك الأيام الناس يمدون من مقدمة بيوتهم شبكاً لأمتار، ويزرعون فيها أو يربون الأغنام، وتبين أن حيلتهم كانت، لأنهم خافوا من الجوار القريب، وفضلوا نوعاً من الحاجز، ولضمان أن لا تذهب أرض مقدمة البيت لآخرين، نهبوها بالأشجار وحيوية الحيوانات المنزلية، وقالوا أن ذلك حقهم.
بيتنا كان مختلفاً، إذ أن أبي لم يخف مثل البقية ولم يبالي. وأنا للأسف لم أكن أعاني من هشاشة العظام، لأفسر عدم قدرتي على أن أواجه هذا كله، بل كنتُ عاديةَ جداً، صحيحة البدن، ربما كان لي قلبٌ يشبه تلك الحدائق المزعومة خوفاً من جوارٍ ما.
ماتريوشكا
أدركت منذ وقت مبكر ما دافع عنه باشلار طويلاً، أنني لستُ بحاجة للبيت، هذا الواقع الصلب، لأستمد صورتي عنه، بل إن الصور التي أخلقها باستمرار عنه هي شيءٌ يخصني، مستقلةٌ تماماً عن الواقع المادي لهذا البناء الذي أسميناه بيتًا لوقت طويل جدًا.
ومع ذلك عندما أفكر في الأمر أجد أنني عاجزة تماماً عن فهم الرحلة الطويلة التي قطعتها إلى هذا النوع من التأمل، ولذلك لا يكون البيت في هذه الحالة أكثر من ماترويشكا، تلدُ أخرى بلا نهاية، وإن العلاقة بين حميمية الرؤية التي أنظرُ بها للبيت، هي واحدة من تلك الماتريوكشات التي ستلدُ بيتاً هي الأخرى بعد قليل. وإنني لا أشير هنا لعلاقة أمومية إلا بقصد، بكل التباسات هذه العلاقة وقهرها اللانهائي.
سنبقى بالقرب.. رغم الكراهية
سقط أخي من على عربة الأطفال، وشُق جبينه، وركضتُ يومها لعمي مستنجدة، لأن أبي خارج البيت، تركتْ الدماء أثراً حتى عادت أمي لمعسكرها المفضل في تنظيف البيت، والاهتمام بصورة مضاعفة بعتبات البيت التي سقط عليها أخي، فركتها طويلاً، بصبر، وهدوء فاجأني.
المستشفى قريب من البيوت، التي نزح أصحابها من جبال “الحجر” مسافة لا تتجاوز الـ١٥ كم، ولو أننا قدرنا هذه المسافة من كل البيوت، حتى التي يسكنها أهل الساحل، لوجدناها متطابقة تقريباً، وبهذا فإن المستشفى هو مركزُ المكان، والناس رغم أنهم لا يحبون العيادة، إلا أنهم وبلا وعي منهم يبنون بيوتهم على مقربة منها.
كنا جميعاً نحل نزلاء على المستشفى، ولم يكن الأطباء يأتون إلى البيت إلا في المسلسلات المصرية التي نتفق على مشاهدتها عفوياً، وتخبرني أمي أنها تأكدت من أنني يجب أن أكون طبيبة عندما أكبر حتى قبل ولادتي، عندما زارها وفد من أطباء الامتياز وهي على سرير المستشفى، وكانت من بينهم فتاةٌ فهيمة كما أدركت أمي من إطراء الطبيب المسؤول عنهم، يذكرني هذا على الفور، بميشيل فوكو الذي كتبَ عن نشأة هذا النوع من الدراسة لضمان كفاءة الطبيب، ومع ذلك لم أصبح طبيبة، ولم أفهم فوكو تماماً، على الرغم من أن اللجنة التي مرت على أمي، كانت قد حددت أشياء كثيرة عن مستقبلي وعن المعاملة التي سأحظى بها. كان البيت دون أخي وأمي وأبي، جميلاً جداً وفاتناً بلا حد!
توتر يليه صمت
الريحُ تتجه غرباً عند درجة حرارة ٣٩ درجة فوق الصفر، ورقعةُ الخلاء هذه مبقعة بثلاثة بيوت ومزرعتين، رطلٌ من الجبال يطلُ على نحو باهت وخادع، من جهة واحدة، وعلى الوجوه التي تمشي بين هذه البيوت لطخة دموية مشتركة، إذ أنهم جميعاً ينسلون عن جدٍ واحد. ليست أرضاً خالية بيضاء كتلك التي يكتبون عنها المعلقات، بل شيء بنيٌ مبالغٌ به، خشبيٌ، أجمل ما فيه الفراغ، ومع أنه يبعث على الصفاء، ويتوائم مع البيوت، ومع ذلك يثير التوتر في الناس، ولهذا يقابلونه برغبة عارمة في الصمت، تلك التي سيعرف عنها فيما بعد أنها “طبيعة مسالمة”.
شيءٌ أثق به
تترك الحقب الزمنية توقيعات خاصة، ونتعامل في الزمن مع طبقات متراكمة من المزاجات المختلفة، لكن لا يبدو أن هذا المكان مسكون بالكثير من التأويلات المختزنة، ويمكن في هذه الحالة أن نعود للدليل، الأرشيفات الشخصية المتروكة دون قبضة السلطة – وهي محكمة – وأكثر شيء أثق به فيما يتعلق بهذا هو الملل المنزلي!
البيت محدوداً بملله الخاص، ذو نزعة نحو التحرر والرضوخ في الوقت نفسه، أرسم عندما أكون ساهمة في مللي المنزلي مكعب أو أكتب إسمي مكررًا في كل الصفحة وفي مرحلة لاحقة سأرسم نجمة، وزهرة صغيرة، بتلاتها رقيقة للغاية.
في الجامعة انتابني نفس هذا الملل المنزلي فرسمتُ الأشياء نفسها، أسماني زملائي طوال سنوات الدراسة أمل مكعب!، والآن هل يجب أن أعتبر حالتي هذه فريدة من نوعها؟ بالطبع لا، هنالك طبقات من الخيال القادم من الملل، موقع منذ زمن بعيد وفي لوحة كوثر الحارثي، يتجلى ضجر البيت في الثمانينات والتسعينات لرجل يدعى “محمد” رحل عن عالمنا عام ٢٠٠٦م وفي قصاصاته المتناثرة في كراساته ودفاتر الهاتف، وفواتيره وما شابه كتب التالي:
سبحان الله
سبحان الله
تعارف
كتبت أمي في دفاترها الشخصية يوميات متفرقة، لكن بعد ولادة إبنتها الثانية تخلت عن تدوين اليوميات، وصار هاجسها جمع الألغاز وألعاب سين جيم من الجرائد وبعض القصائد المقفاة، تقصها من الصحف وتلصقها في دفتر اليوميات نفسه.
عندما انتقلنا لهذا البيت، من غرفة في منزل جدي الذي يبعد عن البيت الجديد ٢٠٠ متر، احتفظت ْبالدفاتر في غرفة السطح، وبعدها بسنتين أتلفتها كلها لأنها تجذب الحشرات وقد باضت عليها وتركت خرائها.
في هذه الأثناء كنتُ أتعرف على الاستسلام، والاذعان، وشعور الإنسان بالضآلة، شيء أقرب لأرضية مستوية كانت إحتمالاً، ثم بقيت أرضاً مستوية ليس إلا. أنا إسمي أمل، وعليّ وفقاً لأمي أن لا أشبهها. أي أن لا أسمع، كما يقول بارت.. “صوت تمزق الدفاتر الناعم”.
***
تعلمتُ المقارنة بين البيوت أيضاً، كنتُ مسكونة بفكرة العزاء، ومثّلَ الإيمان بعدم كمال الأشياء عزاءً لي فترة طويلة.
كلما رأيتُ فتاة جميلة، شعرها مسدلٌ ولديها غمازة، فكرتُ: يا تُرى ما الذي ينقصها؟ وركزتُ جهدي على الإجابة، حتى وإن كنتُ أنظر إليها من بعيد.
في البيوت لا يختلفُ الأمر كثيراً، في التسعينات لم يكن أثاث البيت الداخلي مهم بالنسبة للأسر متوسطة الدخل أو الفقيرة، ثمة تصميمٌ واحد بقبة مرتفعة، مثلتها كل البيوت تقريباً، ولم تكن المنازل ذات الطابقين منتشرة بعد، كان ملعب الزهو بالبيت، يكمن في اختيار نوع الصبغ الخارجي، إذا كان زيتياً فهو يكلف أكثر، وإذا استبدل بالرخام، كان ذلك أكثر لفتاً للانتباه، كانت العوائل تلجأ للحدادين لتفصيل أبواب البيت الخارجية، والأبواب الداخلية.
في طقس افتتاح البيت، الذي مازال موجوداً، حيث يتمشى الضيوف في كل الغرف حتى الحمامات وغرف النوم، يمسكون مقابض الأبواب للتأكد من جودتها، ويتحدث الجميع عن المحلات والكلفة التي تحملها الأب في عملية البناء.
قبل فترة من الزمن، أمسكتُ نفسي عندما زارني صديق في شقتي التي استأجرتها من airbnb في إحدى سفراتي، من أن أفرجهُ على البيت، على الرغم من أنني سكنتُ فيه ١٧ يوماً وسأغادره بعد عشرة أيام.
ربما بدأت فكرةُ الحنين تتولدُ في البيت، في ذلك التوق لبيوت القرميد الأحمر، التي كانت بيوت شخصياتنا المفضلة في مسلسلات الأطفال المدبلجة للعربية في استديوهات أردنية غالباً. لكن بعد مرور بعض الوقت، بدأت المقارنة تأخذ منحى آخر.
أبو صديقتي مثلاً، يحفظ وهو غير متعلم قصائد لـ أبي مسلم البهلاني وقص لهم غير ذات مرة عن مشاركته في جيش السلطان الذي أخمد الثورة في ظفار، وأنه حوكم محاكمة عسكرية في تلك الأثناء عندما دافع عن امرأة تعرض لها ضابط بريطاني في سوق شعبي في صلالة، فضربه ضرباً مبرحاً. على الأقل سمعت صديقتي هذه القصة التي تضحكها دائماً.. على الأقل هناك حديثٌ عن الثورة،
أما في بيتنا فإن أقصى ما تداولناه عن الماضي، أن أبي يشكُ كثيراً بالنساء، لأنه عمل في عمر ١٢ في ظفار هو الآخر وتُرك ليعيش مع مجموعة من الرجال يزيد عددهم عن ٥٠ رجلاً في حوش، يبلون البسكويت بالماء فترة تدريبهم. عندما واصل والد صديقتي خدمته في ظفار حتى بعد الثورة، كان أبي صغيراً يتعلمُ كيف يتلاعب الرجل بالنساء الساذجات اللاتي يبحثن عن الحب في ظفار أيضاً!
***
ما زلتُ أبحث عن إحداثيات هذا البيت، هل التهمها الصمت الشتائي البارد، الذي لم يحركه طوال سنوات سوى نزعات أبي الشكوكية، حرارتنا الوحيدة الباقية من العالم الخارجي، من طفولته، ومما عليه أن يطبع بالضرورة طفولتي! أشعرُ بأنني في هذه التحديقة الطويلة، أقف في أماكن مهجورة من إحساسي بالعالم، ضربٌ من الرؤى، سريالية رخيصة، ضآلة معترفة بضآلتها، أين البيت؟ هل يصحُ أن أقول بيتي، مع أنه لم يكن لي لوحدي، متى يكون بيتي إذن؟ هل ولدتُ ونشأتُ وكبرتُ وكسرتُ في بيت ليس بيتي في آخر الأمر! لو عدنا لزمن الغابة، عندما كان الإنسان طليقاً، هل سأكبر تحت شجرتهم لا شجرتي؟!
هنا ربما يفسر كل شيْ
طعام البيت، قد يكون الحجرة السرية التي تفسرُ كل شيء، ليس هذا جديداً، في رواية “غرفة مثالية لرجل مريض” ليوكو أغاوا تشرحُ الزوجة كل النفور التي تحس به من زوجها وهما على طاولة الطعام بينما يتناول الغداء.
لا يختلف الأمر كثيراً في أي مكان، عدا أن هنالك طقوساً جمعية، وأحياناً منزلية جداً، كانت صالة الطعام مفتوحة، بعد أن تم بناء المطبخ بعد انتقالنا للبيت الجديد بثلاث سنوات، حيث ظل طوال تلك الفترة عبارة عن كوخ خشبي، مفصول عن البيت، وفي الليل كنتُ أفضل البقاء عطشى بدلاً من مواجهة الأشباح المفترضة في تلك الزاوية القصية من بيتنا.
***
وفي الصالة الجديدة كنا نجلسُ على الأرض نأكل بأيدينا من طبق واحد، وكنتُ الوحيدة من بين اخوتي ممن لا يطلبون شيئاً مخصصًا، آكل كل شيء، وكنتُ أزهو بنفسي لذلك، ظننتُ بأنني أسهلُ المهمة على أبي وأمي، وأنهما سيفضلانني لذلك، وكان أبي يعدُ لنا من حليب الغنم اللاتي يربيها أرز بالحليب وكان يعجبني خصوصاً في ليالي الشتاء الباردة.
في الصباح تجبرنا أمي على تناول بيضة واحدة وملعقتي عسل منذ أن دخلتُ الروضة وحتى وقت متأخر من مراهقتي، لطالما شعرتُ بأنها قرأت عن ذلك في مجلة زهرة الخليج التي كانت تقرؤها قبل أن تعود من زيارتها للعمرة وتُحرق كل الأعداد.
انتابني هذا الشعور لأن هذا كان مختلفاً عن “الريوق” في كل الأسر التي أعرفها والتي تطبخ أطباقاً شعبية مثل الشكشوكة والسويويا، وكانت أمي تخبئ في دولاب مُقفل، علب الجبن المثلثة، والعسل، ولا تعطينا منه إلا اذا قررت ذلك، وقد ربى فيّ ذلك نهماً للطعام، وشعوراً مستمراً بعدم الاكتفاء.
أشعر أني أشبه “يامبو” الذي فقد ذاكراته في رواية “الشعلة المخفية للملكة لونا” لإمبرتو إيكو، فبعد أن فقد ذاكرته وهو في الستين من عمره، كان يلتهم الطعام التهاماً، حتى نبهته زوجته باولا بأن عليه أن يعرف متى يجب أن يتوقف! و قال “لقد بقيتُ كالأطفال آكل كل ما أشتهي” وكم حزين ومخزي أن أعترف أنني أشبهه جداً حتى كتابة هذا النص.
رائحة
ومنذ ذلك الحين تغيرت أشياءٌ كثيرة، أو أن إحساسي تجاهها هو الذي تغير، فالطريق الذي كنت أقطعه مشياً على الأقدام من المنزل وحتى بوابة المزرعة المحاذية للبيت، باتَ اليومُ أقصر، وقد كنتُ أحسه طويلاً جداً، وقد أحيطت كل مزارع المنطقة بجدران طويلة من الطابوق والإسمنت، بينما كانت في أيام طفولتي من سياج شبكي، وفتحات صغيرة، تنقل ليُ الخضرة المقابلة كما لو في لوحة فسيفساء أتممتُ تكوينها.
كنتُ في الطفولة، أنظرُ لشجرة جوز الهند وأتعجب من أن كل ثمارها فاسدة، وفهمتُ بعد ذلك أنها لا تتحمل طقسنا الحار، ومع ذلك، احتفظ أبي بهذه الأشجار بل وحرص على زراعتها، وكنتُ فور دخولي إلى المزرعة، أشمُ رائحة شجر السدر الفواحة، وكانت بجانبها شجرة حناء ظننتُ لفترة طويلة أن الرائحة تصدرُ عنها، لكن تلك الرائحة لم تكن واحدة في كل أوقات اليوم، كانت أكثر فوحاناً في الصباح المبكر، وهي ممتزجة بالرطوبة الندية.
كم اشتقتُ لتلك الرائحة عندما كبرت، من بين كل الأشياء كنتُ أميز الطفولة والبيت بتلك الرائحة الزكية التي لم يضاهيها شيء في حياتي. حزنتُ للغاية عندما قررت أمي في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، تبديل حصى البيت، بالسيراميك، عنى ذلك الاضطرار للتخلص من أشجار عديدة، ميزت بيتنا، وبدت وحدها غير الصماء في مكان يطبقُ عليه الجفا، نبهني البرنامج الذي استخدمه للكتابة بأن كلمة الجفا غير موجودة في القاموس، فبحثت عنها عبر الانترنت ووجدت أنها جفاء بالهمزة وهي: “جفا/ جفا على يَجفُو، اجْفُ، جَفاءً وجَفْوًا، فهو جافٍ، والمفعول مَجْفوّ (للمتعدِّي) • جفا الشَّخصُ: قسا، غلُظ طبعُه أو ساء “أصبح جافيًا مع أسرته- أجاب بجَفاء”.”
هل هو نفسه؟
في الليل لا نسمع من البيت إلا جوقة من ثعالب “العوس” التي تعيش في تجويف الوادي الكبير جداً بجانب بيتنا مباشرة، في جحور صغيرة رأيتها في جولاتي النهارية، وأتذكر جدتي الميتة التي اشتكت كثيراً من ضياع دجاجها وكل الحيل للانقضاض عليه، وكنتُ أقضي نهارات طويلة داخل قن الدجاج مختبئة من العائلة التي ظننتُ أنها تُخفي سر تبنيّ، لكنني في الليل لا أستطيع التفكير في ذلك المكان كما لو كان المكان نفسه، مرة ألقيتُ نظرة خاطفة من نافذة غرفة جدي، وبدا لي الليل هناك أكثر من أي مكان آخر، ينسلُ من تنهداتي التي تركتها، ومن أنفاسي التي أحبسها كلما مرَ أحد من هناك لكي لا يُكتشفَ حزني.