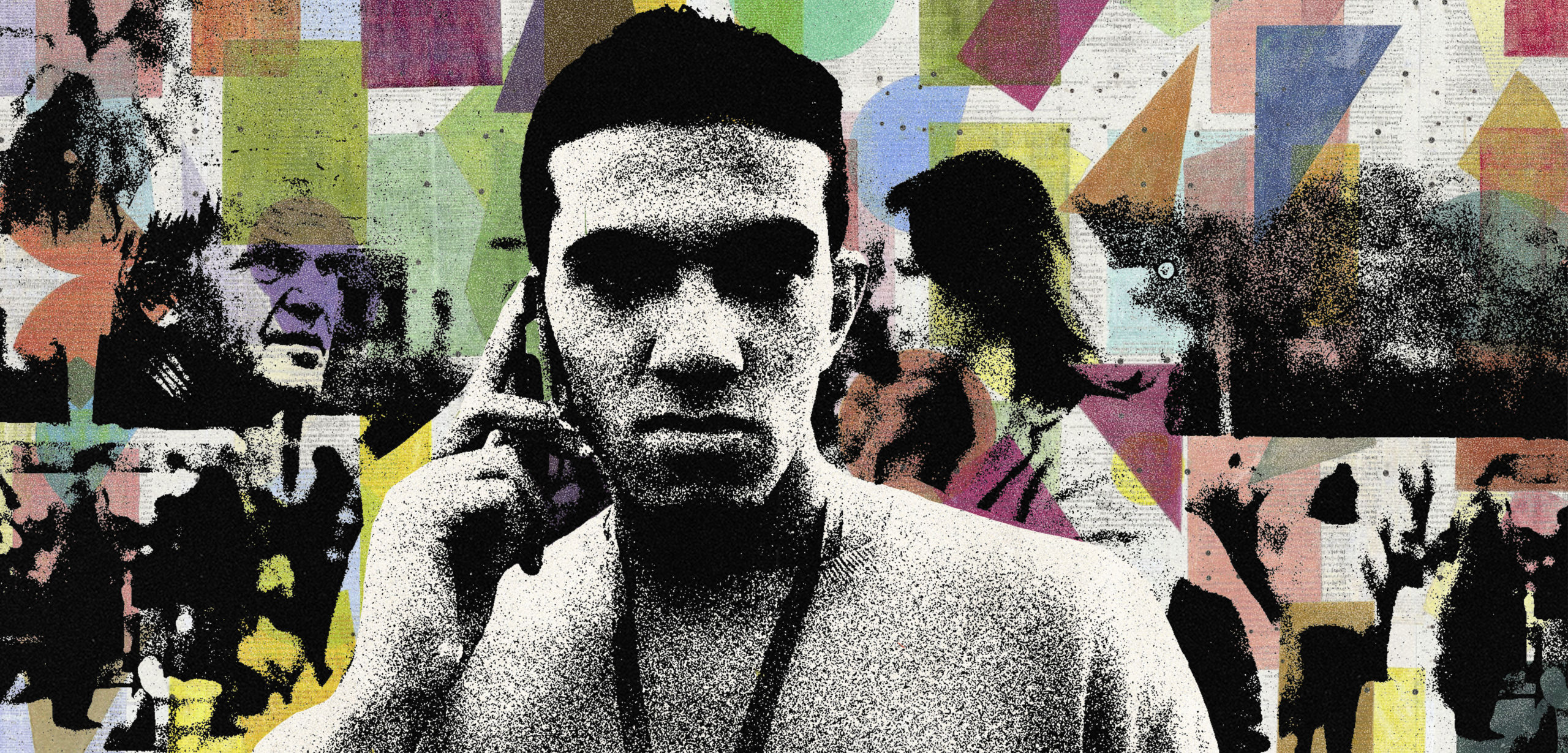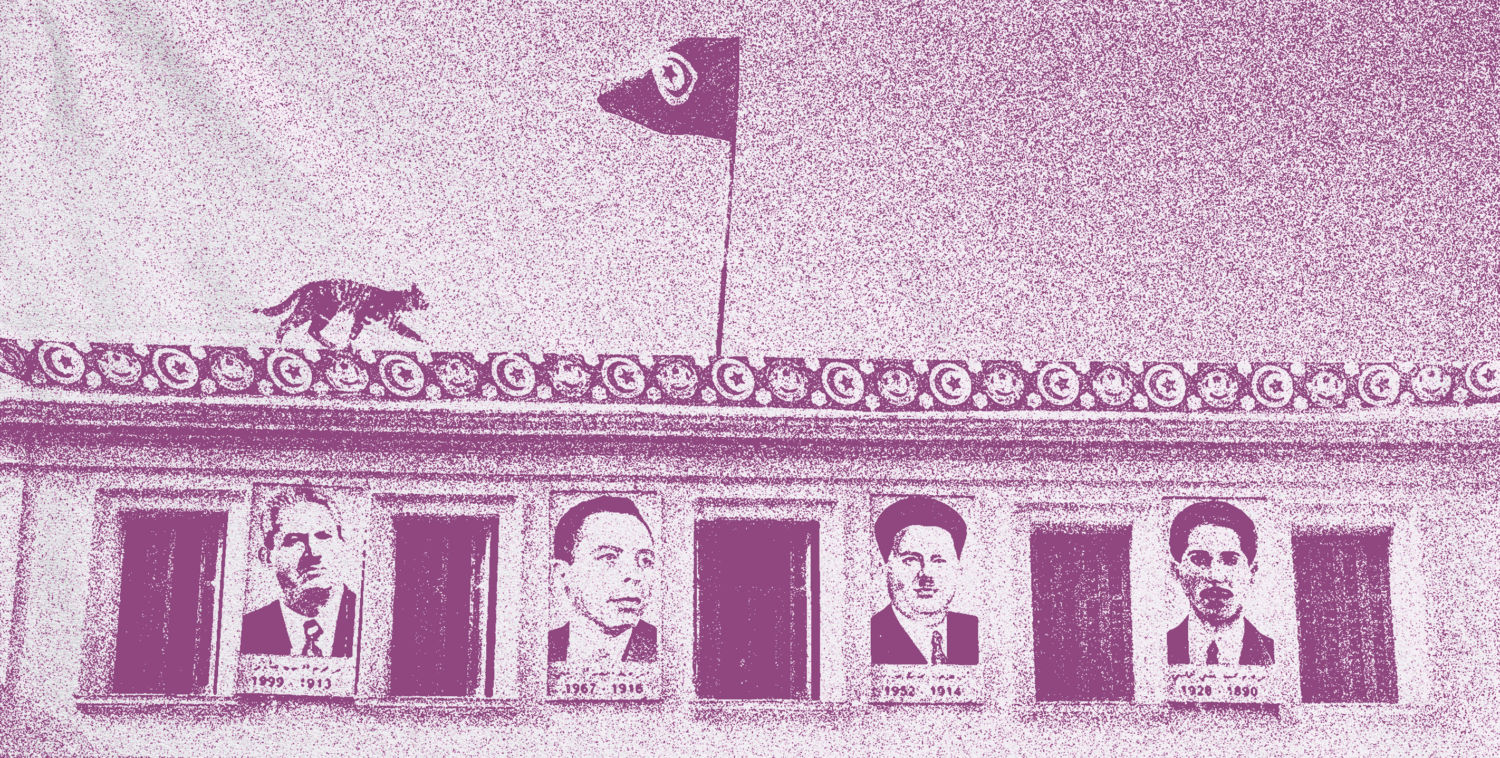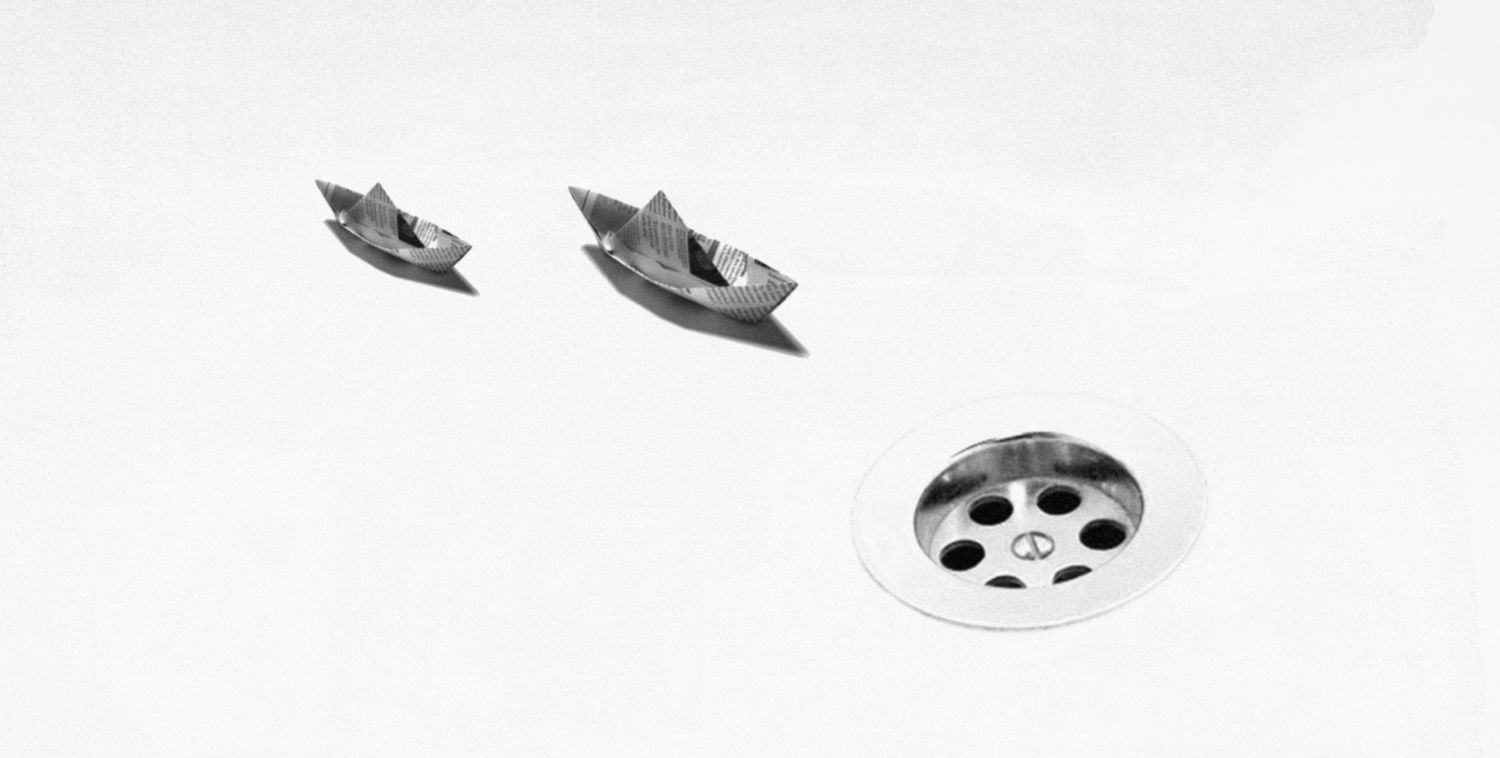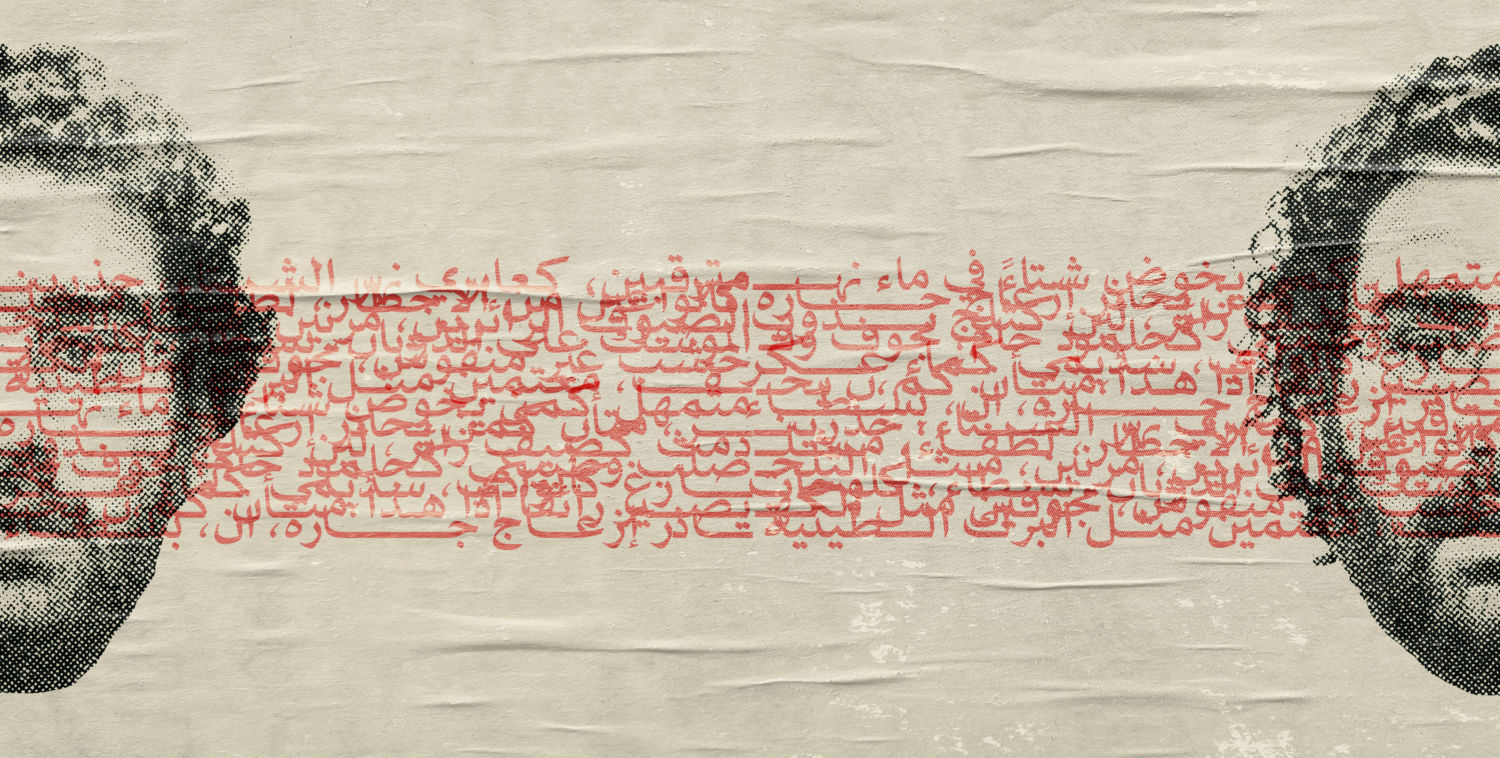العزيز آي ويوي،
أخي في الإنسانية، والهروب والعودة، والانتظار والعجلة، والعائلة والشارع.
أكتب لك الآن بعد أسبوع من إطلالتك علينا في سيغوبيا، مدينتي الجديدة في إسبانيا. قالوا لنا إنك ستتحدث إلينا في مهرجانها الثقافي من شاشة واسعة تنقل صورتك من كامبريدج، مدينتك الجديدة في بريطانيا، وإن فناناً بقامتك سيجذب العديد من المهتمين بالفن، بهواجسه، وباندماجه بقضايا إنسانية لا مفر من مواجهتها.
قلت لنا ولمحدّثتك أنك ستفتح قلبك كتفاحة نرى فيها مائة عام من الأفراح والأتراح، تماماً كما عنونت كتابك الجديد. تتحدث عن أبيك ونضاله لحريته وحرية غيره، عن هجرتك، عن عودتك، وعن معرض بذور عباد الشمس في لندن.
أجلس متعباً قبل حديثك، أفكر: كيف سأرفع رأسي المثقل اليوم نحو شاشتك ساعة كاملة؟ هل ستقول لنا تلك الجملة المعتادة والهرئة في الفن المعاصر عن “اهتمامك بكشف العلاقات بين كذا وكذا”؟ هل ستتحدث عن الاحصنة؟ كل الفنانين يتحدثون عن الاحصنة..
لم تمض الدقائق كثيراً لأدرك كم نشبه بعضنا. لا أعني أنا وأنت كشخصين، بل أعني عذابات واقعنا لقدر معركيّ مزمن طويل الأمد ضد القمع والاحتلال والركود وحتى السأم من السلطة والثورة معاً. أمدّ كلتا ساقي إلى الأرض، أميل صدري لأقابل المذبح التكنولوجي الذي تطل منه وأسمع.
جزء من جدارية لـ آي ويوي في البرتغال-لشبونة 2021. تصوير: jaime silva ، تُنشر تحت رخصة المشاع الإبداعي
الحياة في الغرب مدن، وفي الشرق انتماءات. تتعدد المدن في حديثك كفنان مهاجر لتقيم في برلين، نيويورك، كامبريدج، لكن موطنك الصين تلفظها شعباً وجغرافياً، لا مكاناً وتجربة. مَواطننا أكبر من التجارب وتجاربنا أكبر من المدن. هل خطر لك ذلك في دراستك في نيويورك؟ كنتُ هناك منذ نصف سنة، أطل على المدينة من مبنى أحمر يحمل من الطوب ما تحمل السماء من نجوم لا يمكن عدّها. قال لي صديق هناك على سطح هذا المبنى “يمر من هنا الكثير”.
يذكر صديقي تهافت السوريين منذ عشرة أعوام هاربين من الاعتقال والتعذيب، والحرب أيضاً. فنانون مثلك وكتاب معنيون بالثقافة وآخرون ليسوا مثلك، معنيون بنقيض الثقافة الذي يصعب تعريفه لكن يسهل العيش معه، يأتون بأعين تلتهب حماسة ولابتوبات مفتوحة دائماً للأخبار والتنسيق، للبكاء والرقص، للنقاشات السياسية والعلاقات العاطفية.
“ثمّ خفُت بريق عيونهم وتبعثروا.” قالها بعجلة كأنه يخبرني عن حالة الطقس غداً. خفت بريق عيونهم وتبعثروا كجملة تعني الكثير، قد تصدفهم في المترو يجلسون بنباهةٍ حالمة وهم ذاهبون الى عملهم. قد تجدهم في افتتاح معرض مؤقت لفنان يشرّح شرقيتنا في متحف الفن الحديث Moma ويصورها بمجازات قبيحة تستجدي زواراً لا يعرفوننا ولا نعرفهم، قد تجدهم في الغرفة الدمشقية في متحف المتروبوليتان يتصنعون معرفة تفاصيلها.
أنا لا أعرف تلك الغرفة عزيزي الفنان، لا أعرف ألوانها ولا صدفها ولا خشبها، لم أر صدفاً محفوراً في خشبٍ إلا في مرآة جدتي التي أخذتها كهدية عرسها في ثلاثينيات القرن الماضي. ظلت هذه المرآة مائلة على حائط البيت الطيني في قاعة شاهقة لبيت ريفي قرب دمشق لأكثر من ثمانين عاماً، ثم هاجرت إلى شقة صغيرة عندما قررت مخططات التنظيم العمراني هدم البيت والتمدّن.
في تلك الشقة، حاولنا أن نعلقها مائلة، لكن الجدران القصيرة لم تسعف الانعكاس الذي صار يُظهر أقدامنا بعجزٍ مضحك، ففشلت كل محاولات جدتي في عرضها لزوارها. انتهت المرآة في مستودع المبنى مغطاة بقماش أبيض كان يصفرّ في كل عام أكثر، قبل أن يُقصف البيت والمرأة والقماش. أنا والمبعثرون والغرفة الدمشقية في المتروبوليتان نشبه مرآة جدتي، متروكون في أركان هذا العالم وملتحفون بقماش أبيض يخفينا ويخفي ماضينا.
شاشتك المعلقة في الكنيسة أيضاً مائلة عزيزي الفنان، لكنك لا توبخ محاوِرتك التي قاطعتك بعجالة محلل نفسي يريد الإجابة: كيف تترك حرية التعبير في نيويورك وتعود لبلاد القمع التي نشأت فيها؟
أحرك قدميّ متململاً من سؤالها، أثنيهما تحت المقعد. ألعن غاضباً تنظيرها لـ “جغرافيا الحريّات” الذي يرسم حدوداً سهلة في حيواتنا. يشبه سؤالها مبضع المشرّح، يغوص في تعقيدات أجسادنا بعبث فضولي. تجيبها قائلاً إن الحياة في نيويورك “متعبة وغالية”، وأنك لم تعد قادراً على دفع إيجار غرفتك. أضحك في سري من إجابتك العملية التي تشبه نصائح المهاجرين لبعضهم البعض عن أماكن العيش في المدن.
لا تجادلك محدثتك عن قوانين مدن الاغتراب وعن تعبك وتعبنا من تفاصيل أنظمة العمل، من بطاقات القطارات ومساعدات السكن، من مراجعات مجالس المدينة، تصوير الفواتير ومقابلات الاندماج. تعود بتناحة لثنائية الحرية والقمع لتؤطّر عودتك بالعمل البطولي، كأنك رمح روماني يغوص في خاصرة الشرق المليء بالوحوش.
هل ترى نفسك هكذا عزيزي الفنان؟ هل كنت تمشي في شوارع بكّين كالفاتح المعلّم المنوّر والكاشف، يحيط بك المريدون ويتدافعون لمساس إعجازك. هكذا تراك محدثتك وتريدنا نحن أن نراك.
عاد العديد من السوريين المنفيين لبلدهم في مطلع القرن، ومنهم من خرج من سجن مزمن، كنّا لا نعرف عنه شيئاً إلا بالهمس، كانوا قد انتهوا إليه لمقاومتهم تسلط النظام الحاكم. كم كانوا متأنيين عند خروجهم، في أحاديثهم ومجالسهم واختيار دوائر عملهم، يناقشون ويحللون وينصحون، يذهب إليهم من يبحث عن حقائق لا يجدها في السرديات اليومية، في محلات الحلويات، مقاعد المدارس، والركض خلف الباصات. كانوا يعملون كإبرة النساج لا كرمح المحارب. ثم قامت ثورة في البلاد عصفت بالإبر والخيوط والنساجين معاً.
لم يدرك أحد أن خشبة مسرح السرديات اليومية لم تكن إلا غطاءً رقيقاً لعالم ينوح ويصرخ من الألم، يغلي ويفور من الظلم لينتفض هكذا دون تأطير ولا أيدلوجيا. الآن وبعد عشر سنوات، يعود هؤلاء النساجون يسألون هل العاصفة هي الثورة؟
Copehnagen diversity park .تصميم وسام العسلي
الثورات في الغرب أحزاب وفي الشرق عواصف. هي الثورة. هي نفسها التي اعتقلت أنت فيها في الصين ثلاثة أشهر. هي نفسها امتدت من ساحة الشمس في إسبانيا لساحة اللؤلؤة في البحرين، ومن سانتياغو في تشيلي لوول ستريت في نيويورك. هي نفسها التي انتفضت فيها نداءات حرية وعدالة بلغات مختلفة قبل أن يتم اجتثاثها بكل ما يلزم، من تشكيل أجساد سياسية لتشكيل فصائل، من الطلقات المطاطية إلى القنص الممنهج ومن القنابل المسيلة للدموع إلى القصف بالهاون. هي نفس الثورة التي تجاهلتها محاورتك تماماّ لتركز عليك، هذه المرّة كمهاجر ماهر ومفيد وضحية بالغة السخاء.
أسقط رأسي مرة أخرى على صدري تعباً من تناوب دوريّ الضحية والبطل في قصتك، كمبخرة تنوس بين عقود الكنيسة في عيد الفصح.
“اتعبتني برلين”، كانت هي المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها حدة صوتك لتتذمّر من عاصمة ذهبت اليها بعد اعتقالك. تتذمر من استقبالك كبطل في قارة كانت هي نفسها تركل من فرّ إليها أكواماً في السفن والباصات، أحياء وأمواتاً، غرقى وخنقى. ألهذا مثّلت دور الطفل الميت في ليسبوس لترى نفسك وتُري والعالم أنك أيضاً ضحية؟ كم كرهتك حينها وكرهت الفن المعاصر في استجدائه مقتلة تصرخ بوضوح، ولا حاجة لها لممثل أو صوت.
مقتلتنا واضحة للجميع عزيزي الفنان وهنا المشكلة كلها. والمشكلة كلها تتلخص في أن محاورتك ناورت الكلّي بالفردي، لتسأل عن أسباب أكثر شخصية لتركك برلين، فتذكر أنت بتململ أن بائعاً طلب منك أن تتأدب بآداب ولغة ألمانيا، فقررت ترك المكان واللغة والآداب.
أبتسم في سري وارفع رأسي لشاشتك مرة أخرى. أذكر خمس سنوات عشتها في كوبنهاغن التي تشبه برلينك كثيراً، وتتجاوزها جوراً في طلبها أن نمتثل لقيم تضمن لنا سعادتنا كأننا لوحات فارغة بحاجة لألوان، أو طين مهمل بحاجة للتشكيل.
يقول لي صديق آخر كنت أمشي معه في حديقة الملك في كوبنهاغن: “كان من الصعب جداً أن نكون عاديين هنا، اليسار يريدنا ضحايا سعيدة، واليمين يريدنا جناةً حزينين”. يذكر خيبات أمل العديد من قصة هجرته التي لا تُذرف الدموع ولا تُثير شهقات الشفقة. تتلخص بأربع أو خمس جمل عن عقد عمل مؤقت وطائرة فارغة، لتنتهي القصة دون حبكة، دون بداية ولا دون نهاية. يمضون منها على عجل كسائحين في محطة قطارات لا تثير أحلامهم.
يخفض رأسه بسأمٍ ويسأل: “ألا يسعدهم أنني أعمل وأتزوج وأشتري أغراض البيت والثياب؟ ألا يسعدهم أنني حي؟ أنني لم أمت عبثاً لكنني أفكر بالموت كل يوم؟ ألا يمكن للنجاة أن تكون عادية، يومية وغير ملحمية؟”
النجاة عملية مركّبة وطويلة. المدن كالحدود ليست مفتوحة لأجناس البشر كما تدّعي نقاشات العمران التي تتغنى بالمدن وتنوعها الثقافي، كأن المدن معامل إنتاج هويات متعددة الأوجه. هي نظرة رومانسية عزيزي الفنان، هاربة من أمميّة لطالما فشل القرن الماضي في صياغتها، لكننا لا نعترف بامتداد هذا الفشل في فراغات العمران.
في أكثر الأحياء المتنوعة عرقياً في كوبنهاغن، هناك ساحة كبيرة صممها مكتب دنماركي لتتغنى بهذا التنوع، فتتجاور فيها لائحة لبيع النودلز من كوريا الجنوبية مع نافورة مغربية، تمشي منهما لمرجوحة من بغداد. يثير مشهد هذه العناصر المختلفة صورة المهرجان، لكنه مهرجان ببداية ونهاية.
تصبح هذه المساحة الاستثناء الذي يسمح به التنوع، كأنّ المدينة تضحي بجزء منها للآخرين، فيصبح المهرجان قفصاً معزولاً بحجم حيّ بأكمله. تخرج من هذا الحي إلى المدينة العادية التي تبغض الغرباء وتلفظهم كل يوم.
نجوت من كوبنهاغن العادية، من اعتقال احترازي في آخر أسبوع لي في المدينة لأنني أحمل “كاميرا وهوية سورية معاً” كما قالها لي الشرطي بعيون معتمة ولهجة بطيئة. في القسم كان المحقق يقلب صور الهاتف المحمول. أشاهده يعرّي ملامح كل شخص في كل صورة. المحققة تنظر لي بشفقة قبل إطلاق سراحي لأبتسم. أخيراً أصبحت ضحية واضحة، لكنني ضحيتهم.
Ai Wei in Church .تصميم وسام العسلي
التنوع في الشرق تزاحم وفي الغرب عزلات. أنا أيضاً فررت إلى كامبريدج، لا لأختبئ مثلك في مدينة مشغولة بانقسامها بين الجامعة والجميع، لكن لأكون جزءاً من هذا الانقسام.
على المهاجر الناجح في المدينة أن يقوم بتصميم عزلته كما يريد دون زيادة أو نقصان. يمكنك مثلاً أن تختبئ في كامبريدج في أماكن مكشوفة، بين جماعات السياح في بحثهم الشغوف عن أصل المعرفة، على أي مقعد مهمل تحت أي جسر على النهر، وراء محطة القطارات، أو في بيت أحد أصدقائك.
جد لنفسك أصدقاء جيّدين، حتى لو كانوا عابرين، في كامبريدج. سيطمرونك بأسئلة أفضل بكثير من أسئلة محاورتك، وقد لا يحبون فنّك كثيراً لكنهم قادرون على فصفصته بعمق ومحبّة. العزلة هي أصدقاء جيدون لا يحتفلون بانسجامك ولا يهملون اختلافك، أن تكمل مشوار عمرك منتجاً، منجزاً، محباً ومحبوباً. أن تسأل عائلتك عن خطط المستقبل وتسلّم لأغلبية أحلامهم. تماماً كما سألت ابنك عن جغرافيا أحلامه وسلّمته عمرك إيماناً به واعتذارا له عن عالم كنت تريده أجمل.
هكذا تصمّم حياتك إلى أن تعود.. “أتعود؟”، سألتك محاورتك في نهاية الجلسة لأدرك أن ساعة مضت على حديثك معنا ومع صدى الكنيسة. أتعود؟ أسند رأسي على كلتا يديّ وراء ظهري مستسلماً لجوابك قبل سماعه. لتجيب: “نعم، المطلق هو العودة”.
هل سمعت همهمات الحضور كما سمعتها أنا؟ بعضهم شهق من فداحة الإجابة. كان هذا الجواب الوحيد الذي لم تستطع محاورتك تفاديه فأنهت الجلسة على عجل. جوابك عزيزي الفنان لا يأبه بخطة زمنية، المطلق في العودة يعني تحرير فكرة الرجوع من سياقها الزمني فتصبح هدفاً تعمل به وله دون التفكير بحدوثه. هكذا يعمل الكثير من أصدقائي الذين “خفت بريق عيونهم وتبعثروا” في علاقاتهم الغريبة مع عوداتهم المطلقة وحوارهم بين الغد والأبد.
العزيز آي ويوي، أخي في الإنسانية، والهروب والعودة. أنهي هذا النص بعد شهر من إطلالتك علينا من شاشة الكنيسة في سيغوبيا. أذكر مرور ساعة من حديثك عن نفسك، عن الفن المعاصر والحرية، وعن كشف العلاقات بين كذا وكذا.
ساعة ركبّت فيها محاوِرتك نظرة فنية تقليدية بالغة الاستشراق عن الحرية والقمع وعن الهجرة والعمل الثقافي، وتفادت حواراً قد يكون أكثر جديّة مع فنان مثلك عن الفن واشتباكه مع قضايا حاضرة خارج إطار التسويق وركوب الموجات، عن التضامن خارج إطارات ضيقة وهويات بالغة التحديد.
أنا لم أستطع تفادي ذلك، لا لأكتب لك رسالة عن واقع قدر معركيّ مزمن طويل الأمد ضد القمع والاحتلال فقط، ولكن لأفكر معك في الغد والأبد. فاليوم وأنا أنهي هذه الرسالة، وقبل شهر عندما بدأت بكتابتها، وغدا عندما أراك مجدداً في كنيسة أو معرض: سيبقى الأبد أبداً والعودة مطلقة.
- كُتب هذا النص في سياق مداخلة الفنان الصيني أي ويوي في مهرجان Hay Festival السنوي المقام في سيغوبيا- إسبانيا منتصف أيلول/ سبتمبر 2022.