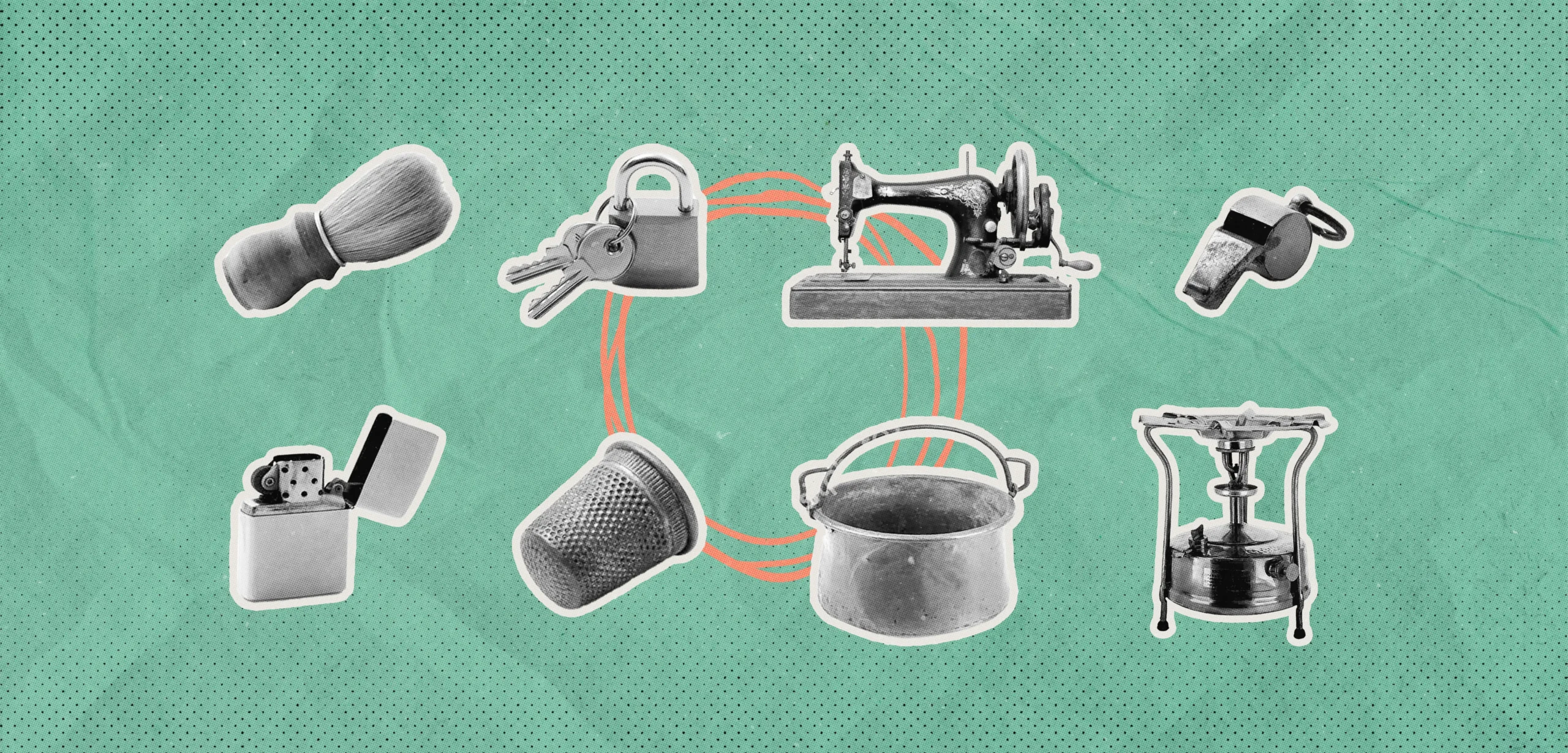ستة كيلو مترات تفصل منزل سعيد الأبيض في حيّ المطار القديم عن مكان عمله في مصنع الطلاء، غرب مدينة تعز اليمنية، لكن الوصول إليه يتطلب السفر ست ساعات. في السابق لم يكن يحتاج أكثر من عشر دقائق لقطع المسافة نفسها عائدًا في حافلة المصنع، ومنذ أن أسقطت الحرب المدينة في قبضة الحصار، انتهت الحياة كما كان يعرفها سعيد من قبل.
بات المصنع في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي، فيما يقبع البيت- الذي ما تزال جدرانه شاهدة على أعنف معارك حربٍ ستكمل ثماني سنوات في نيسان (أبريل) المقبل- في منطقة تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
إن أراد زيارة عائلته، على سعيد، مثل كل العمال الذين تسكن أسرهم داخل مثلث الحصار، أن يحصل على ترخيصٍ من إدارة المصنع مرةً في الشهر، وهذه ستوفّر لهم سيارة دفعٍ رباعي تقلّهم مساء الخميس وتعيدهم صباح السبت. ولأن أقلّ رحلة إلى قلب تعز أضحت تستغرق ست ساعات- لا مناص من الالتفاف حول المدينة والمرور عبر طرق جبليةٍ وعرة- تصبح الإجازة كلها 12 ساعةٍ فقط إذا حُسمت ساعات التنقل والنوم.
من المألوف في هذه الطرق مصادفة مركبةٍ انقلبت أو أخرى تعطّلت في منطقةٍ ضيقة وهناك مَن يحاول زحزحتها جانبًا. أما إن كانت هذه المركبة من الناقلات الكبيرة فمن المتعذر جرّها الى جانب الطريق، ما يعني توقّف حركة السير لساعات. ولأنها طرقٌ ترابيةٌ شُقّت على حافة الجبال تخرّبها الأمطار والسيول معظم الوقت وتعطّل السير أيامًا.
الوقوف على الحواجز الأمنية والعسكرية قصةٌ أخرى، هنا ينبغي إبراز الوثائق وتفتيش الهواتف وأي اشتباهٍ في أحدهم قد يقوده إلى السجن. يتذكر غمدان، العامل والنقابي، المرة الوحيدة التي انتقل فيها مضطرًا إلى الجانب الآخر مع أسرته، حين أُوقفت السيارة ثلاث ساعات في نقطةٍ عسكريةٍ تسيطر عليها جماعة الحوثي لمجرد وجود شخص بين الركّاب مكتوب في جواز سفره أنه من مواليد السعودية.
زمن التلفزيون والتنمية
يتذكر سعيد الأبيض نفسه وهو مراهق يتوق للخلاص من المدرسة والالتحاق بالعمل في إحدى مصانع تعز التي رآها على الشاشة. كان ذلك في مطلع التسعينيات، حين كان التلفزيون اليمني يبث برامج التنمية باستمرار.
الكاميرا تتجول على أرض مصنع بين مكائن عملاقة يقف خلفها شغيلة فخورين كأنهم هم مَن اخترعوها. هذه المكائن هي التي جذبت الفتى بعيدًا عن المدرسة وعن أن يتبع خطى أبيه الموظف الحكومي (من منتصف التسعينيات فصاعدًا، لم يعد الالتحاق بوظيفة حكومية لغير أصحاب النفوذ أمرًا متاحًا بسهولة ).
ما أن عرض عليه صديقه الالتحاق بمصنعٍ يستقبل التلاميذ الراغبين في العمل خلال الصيف، لم يتردد سعيد وبذل جهدًا كبيرًا لإقناع والده؛ المصنع يبعد عن المنزل عشر دقائق في الحافلة، أقل من المسافة التي يقطعها أباه للعمل وسط المدينة. تمر حافلة الشركة لأخذ العمال عند السادسة والنصف صباحًا وتعيدهم عند الثانية والنصف، وهناك وردية أخرى من الثانية وحتى الثامنة مساء. يتقاضى سعيد، وغيره من الطلاب الباحثين عن فرصة في “العمالة الموسمية”، أجورًا أقل من العمالة الرسمية، ويحصلون في المواسم (رمضان وعيد الأضحى) على ذات أجر العامل الرسمي وفوقه إكرامية.
في اليوم الأول، جاء موظفٌ لتسجيل العمّال الذين يطلبون وجبة غداء، سيفهم سعيد لاحقًا أن الدوام في الصيف يستمر لاثنتي عشرة ساعة وليس ثماني ساعات. ولم يكن هذا ما أزعجه، بل لأنه وجد نفسه يعمل في تغليف المنتجات ولم ير الآلات الضخمة التي كان يتطلع إلى التحكم بها.
قبل أن ينتهي الأسبوع الأول كان حلم المراهق قد تبدّد وترك العمل. لكن الظروف أجبرت صاحبنا بعد وفاة والده على العودة إلى المصنع، ولم يعد يكترث إن كان يقف وراء المكائن الجذابة أو خط تغليف المنتجات. المهم أن لديه مهنة تعيله وأن بيته كان على مرمى حجر من مكان عمله.
لم يتجاوز راتب سعيد الـ 200 دولار شهريًا، لكن عزاؤه ورفاقه أنهم متشابهون وخلفياتهم واحدة؛ فهم إمّا أبناء صغار الموظفين أو الحرفيين الذين فشلوا في منافسة السلع القادمة من وراء البحار، أو أن آباءهم كانوا ممن ظلّوا في تعز ولم يتغرّبوا، بل كانوا مرتاحين للعمل في مصانع يقطنون بالقرب منها، يعودون إلى عائلاتهم مساءً وينامون في فراشهم ويعاودون الكرّة في اليوم التالي. ربما ورث أبناؤهم عنهم هذه الرتابة المطمئنة التي جعلتهم يقبلون العمل مقابل رواتب ضئيلة وروتين لا ينتهي، وبدا لهم أنهم يحفظون حياتهم غيبًا، وأنها لا تخبئ لهم إلا التكرار.
شبه خريطة لحصار تعز
على مدخل مدينة تعز الشرقي، هناك تجمعٌ صناعيٌ لأكبر مجموعةٍ تجاريةٍ في اليمن؛ مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التي توظف نحو عشرين ألف شخص. لم يتوقف خط إنتاج بعض تلك المصانع البعيدة نسبيًا عن جبهات الحرب، لكن معظم عمالها كانوا يسكنون وسط المدينة حيث دارت المعارك في البداية، وسرعان ما أصبح التنقل شديد التعقيد، فقد تبدّلت خرائط الحصار مع تبدّل مسار المعارك العسكرية.
جرت العادة أن يرجع عبد الباقي (35 عامًا) إلى منزله على متن حافلة الشركة من أحد المداخل الرئيسية الأربعة المؤدية إلى وسط المدينة. ومع تفاقم المعارك أصبح الذهاب إلى العمل والعودة منه يتطلبان عبور طريق فرعي أقصى الجنوب الشرقي للمدينة. لاحقًا سيجري إغلاق هذا المدخل، بعد أن حاصرت جماعة الحوثي وسط المدينة من جهتيّ الشمال والشرق.
أصبح هناك مدخلٌ فرعيٌ وحيد يفتح في النهار بعد عملية تفتيش دقيقة للمارّة وجملة من الانتهاكات، إلى درجة أطلق معها السكان عليه اسم “معبر الدحي” الكلمة الأولى تعلموها من فلسطين والثانية من اسم المكان الذي يوجد فيه المدخل جنوب غرب المدينة.
بالنسبة للعمّال القاطنين وسط تعز، كان عليهم المرور من “معبر الدحي” ثم الوصول الى أطراف المدينة الغربية، ومن هناك يقومون بالالتفاف شمالًا عبر طريق الشاحنات الثقيلة وصولًا إلى المدخل الشرقي حيث المصانع. كان المشوار يستغرق نحو ساعتين ذهابًا وساعتين إيابًا. ولكن حتى هذا المشوار لم يكن مضمونًا، فكثيرًا ما منع المسلحون القائمون على “المعبر” المارة من الدخول أو الخروج. لهذا اضطر عبد الباقي أكثر من مرة إلى كسر الحظر مخاطرًا بحياته ليرجع إلى البيت. كان يلتف ويقطع مسافات متشابكة عبر أزقة بعيدة عن الأعين. يذكر “كنت أمر من الحارات شبه الخالية من الناس، في يدي قطعة ثلج وكيس خضروات، كنت أعرف عن القناصة الذين اتخذوا من أسقف بعض الأبنية منصاتٍ لهم”. مع هذا، مشى عبد الباقي وهو يحبس أنفاسه ويُغرق الخوف تحت رغبته الطاغية في العودة إلى البيت.
سياساتُ “الصدمة والرعب” التي يمكن استخدامها لوصف ما يحصل في تعز تتطلب إيقاف “المدينة العدوّة” عن العمل عبر تدمير بنيتها التحتية وجعل التنقل فيها والحصول على الأساسيات أمرًا شبه مستحيل
كانت قطعة الثلج التي تبرّد يده تخفّف عنه وطأة القيظ الممزوج بالتوتر. وكذلك هي ألواح الثلج التي تباع لتبريد ماء الشرب في ذروة حرارة الصيف بعد أن انقطعت الكهرباء وتوقفت الثلاجات المنزلية عن العمل. انعدمت المشتقات النفطية أيضًا وأصبح مصدر كثير من السلع يأتي من مخزون سكان جبل صبر المحيط بتعز من الجهة الجنوبية. وحين أصبح الغاز معدومًا أو متاحًا بأسعار خيالية في السوق السوداء فقط، شوهدت الحمير في الشوارع وهي تحمل الحطب بين البيوت، وبدا كما لو أن المدينة أٌدخلت آلة الزمن عنوةً وأعيدت بقسوة إلى الوراء.
يقود كل هذا العنف ضد تعز، ضد حضريتها، سياساتُ “الصدمة والرعب” التي يمكن استخدامها لوصف ما تقوم به جماعة الحوثي وتسبّب في شلّ المجتمع وخنق تفاصيل العيش اليومي لأصحاب المكان. هذه السياسات أو “العقيدة”- كما يشرحها ستيفن غراهام في كتابه “مدن تحت الحصار”- تتطلب إيقاف “المدينة العدوّة” عن العمل عبر تدمير بنيتها التحتية وجعل التنقل فيها والحصول على الأساسيات أمرًا شبه مستحيل.
في أغسطس 2016، تمكّنت المقاومة الشعبية من استعادة الأطراف الغربية للمدينة وفُتح “خط الضباب” الذي يربط تعز بالريف الجنوبي وبمحافظة عدن، ولكن الحصار ظلّ مطبقًا من الجهات الثلاث الأخرى وبات واضحًا أنه سيطول. صار لزامًا على العمّال الراغبين في الاستمرار في أشغالهم نقل سكنهم خارج دائرة الحصار، حيث معظم المصانع، سواء في الجهة الشرقية أو الغربية من المدينة.
مَن كانت مساكنهم في مناطق اشتباكات كانوا قد نقلوا أسرهم من البداية. أما من يسكنون في مناطق شبه آمنة فيعني لهم النقل البحث عن شقةٍ جديدةٍ والابتعاد عن المحيط الاجتماعي الذي يجعل الحياة ممكنة. كان على هؤلاء رغم الأجور الزهيدة الرضوخ لفكرة العيش في مساكن توفرها المصانع، والتي لم تخلُ مواقعها من المنغصات، إذ يشكو عمال المصانع الواقعة غرب المدينة أن المساكن تبعد ساعة عن أماكن عملهم، في حين يشكو عمال المصانع الواقعة شرق المدينة أن المساكن بعيدة عن الخدمات ساعة أيضًا.
خريطة النفوذ في اليمن (ديسمبر 2022). خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft
غربة لم تخطر في بال
يروي عبد الباقي، ساخرًا، كيف رفضت أمه وزوجته، قبل أعوام، أن يتخلّى عن عمله ويذهب عبر التهريب للعمل في السعودية كما يفعل كثير من شباب المدينة. كانت القصص تتردد عن المخاطرة التي يقوم بها الشبان لاجتياز الحدود وغالبًا ما تكون نتيجتها القبض عليهم وإيداعهم السجن مدةً قبل ترحيلهم. الآن، لا تقلّ مخاطرة عبد الباقي اليومية في التنقل داخل تعز نفسها عن أولئك الشباب. يضحك معلقًا: “من كان ليصدق أننا سنتغرّب داخل مدينتنا!”.
اغتراب الرجال عن تعز قديم، فهذه مدينةٌ من أساسها مدينة العمّال في البلاد بسكانها البالغ عددهم قبل الحرب 600 ألف نسمة. ساعدها على لعب هذا الدور الخزان البشري الكثيف المتمركز في المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن ككل، حيث يقطنها ما يقدر عددهم بـ 4 مليون نسمة، أي 12.2% من أصل ثلاثين مليونا هم تعداد سكان اليمن.
زاد على ذلك الطبيعة الجغرافية القاسية وندرة الموارد ما دفع الناس إلى التوجه لتعلّم الحرف والمهن وتعوّدت الأسر على تغرّب الرجال عبر العقود إلى مدن يمنية أخرى أو إلى بلاد أخرى طلبًا للقمة العيش.
خلال النصف الأول من القرن العشرين، لم يكن أمام كثيرين من خيار لتحسين ظروفهم والهروب من استبداد دولة الإمام سوى السفر، إما إلى عدن بعد أن أصبحت ميناءً عالميًا تحت الاحتلال البريطاني وإما إلى الحبشة حيث عملوا في التجارة. تغيرت الوجهة خلال النصف الثاني نحو الخليج، واستثمر العمّال المغتربون مدخراتهم واثقين في عقارات دكّت الحرب الحالية معظمها.
يبدو لمن يقرأ التاريخ الاجتماعي للمدينة اليوم، أن الاغتراب للعمل خارج تعز بدا اتجاهًا إجباريًا لمن يتطلع إلى تحسين معيشته، حتى أنه أصبح موضوعًا لرواياتٍ يمنية، مثل رواية “يموتون غرباء” لمحمد عبد الولي، التي تسرد مأساة شابٍ يمني سافر للعمل في الحبشة سنواتٍ طوال لتحقيق حلمه في بناء أفضل بيت في قريته، لتنتهي الرحلة بموته وحيدًا في المغترب.
اليوم يعيش الناس غربةً لم تخطر في بال أحدٍ من سكّان تعز من قبل، يجسّدها عبد الباقي الذي ينام في مساكن المصنع، يشارك غرفة واحدة مع أربعة عمّال وأكثر أحيانًا. حتى المطابخ التي لم تعد تستخدم في هذه المساكن صارت مناماتٍ. أما الكهرباء فتصل خمس ساعات كل 24 ساعة.
أول غُربته الجديدة، مُنح عبد الباقي وزملاؤه ألف ريال ( دولارين) مقابل وجبة يومية، ورغم أنها ليست كافية للحصول على وجبة فعلية أوقفتها بعض المصانع في السنوات الأخيرة، مع أن الراتب فقد ثلثي قيمته الشرائية. المفارقة أن المصانع لم تنس أن ترفع أسعار منتجاتها لتواكب تدهور قيمة العملة. يرسل عبد الباقي سبعين دولارًا لعائلته آخر كل شهر، وهذه الدولارات هي ثلث راتبه.
12 ساعة في تغليف البسكويت
عندما التحقت شكرية كعاملةٍ في أحد مصانع مجموعة هائل سعيد أنعم، لم يكن يوم العمل طويلًا بهذا الشكل، لسببٍ ما أطالت الحرب ساعات العمل، وها هي الآن تغلّف علب البسكويت منذ 12 ساعة.
تركت الأرملة الخمسينية منزلها في حارة إسحاق في المدينة القديمة لتقيم في مساكن المصنع، تاركةً خلفها بناتها الثلاث اللواتي لا تراهن إلا مرّة كل شهرين. إحداهن مطلقة وتعمل في عيادة، واثنتان تدرسان في الجامعة. لكن شكرية تعبر عن امتنانها لأنها ما زالت تعمل ولأن المصنع وفّر لها مأوى.
على عكس العمال الذكور الذين يأكلون في المطاعم ما يكلفهم جزءًا معتبرًا من أجورهم، تقوم شكرية مع زميلاتها بإعداد وجباتهن بأنفسهن لتوفير أجورهن التي تبلغ ثمانين ألف ريال شهريًا (أقل من 200 دولار).
مصانع مجموعة هائل سعيد أنعم، الواقعة شرق المدينة، من المصانع القليلة التي تشغّل النساء، في حين تتحاشى المصانع الأخرى توظيفهن. مردّ ذلك، بحسب النقابي غمدان، إلى كثرة إجازات النساء المنصوص عليها بالقانون؛ إجازة الوضع، وإجازة مدفوعة لأربعين يومًا في حال وفاة الزوج، وتحقّ لها إجازة بدون أجر لتسعين يومًا لتكملة فترة العدّة إن رغبت، بحسب المادة (87) من قانون العمل. إلى جانب مواد أخرى كثيرة تحدد عدد ساعات العمل وتمنع العمل الإضافي في حالة المرأة المرضع والحامل، وغيرها من القوانين التي تجعل أرباب العمل يتحاشون تشغيل النساء.
بالنسبة لمجموعة أنعم، يعود وجود النساء إلى سبعينيات القرن الماضي، آنذاك كان عدد العاملات أكثر من العمال. دفع اغتراب الرجال في الخليج بالمصانع، التي كانت في حاجةٍ ماسةٍ لأيدٍ عاملة، إلى توظيف النساء وسهّل الأمر أن المجتمع في تعز أقل تشددًا مقارنة بمحافظات يمنية أخرى.
“النساء ينتجن بشكل أفضل وهن أكثر التزامًا”، في رأي غمدان الذي يؤكد أن هذا ما اكتشفته إدارة مصانع الشيباني التي لم تكن تميل إلى تشغيل النساء في السابق، لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت تفضّل توظيفهن في الأقسام الإدارية.
خريف فبراير وأحلام العمال
لسنواتٍ وعمّال القطاع الخاص في تعز يطالبون بزيادة أجورهم. توجهوا من خلال النقابات التي تمثلهم إلى مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، فـ”الرواتب المعتمدة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات أدنى متطلبات الحياة العادية”، وفق بيان مجلس تنسيق نقابات القطاع الخاص في محافظة تعز.
صدر البيان (1) في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) العام الماضي، واشتكى من تجاهل “معاناة العمال وإقامتهم بعيدًا عن أسرهم وصرف أكثر من نصف الراتب على الأكل في المطاعم وعدم قدرتهم على زيارة أبنائهم داخل المدينة”. ومثلما اشتمل البيان على تهديدات بالتصعيد لم يخلُ من التوسلات. لكن الشركات لم تستجب ونقابات عمال القطاع الخاص لم تصعّد.
أساسًا ما الذي يمكن للنقابات عمله في زمن الحرب؟ يغرق العمال المهددون بالبطالة في معاناةٍ لا تترك لهم لحظةً لالتقاط أنفاسهم، بينما يشلّ الحصار طاقة المدينة بل إنه يقتلها ببطء.
منذ قيام النظام الجمهوري في الستينيات، لم توجد نقابات لعمال شركات القطاع الخاص التي بدأت تنتشر في السبعينيات. أسّس غمدان وزملاؤه هذه النقابات لأول مرة في تعز عقب ثورة فبراير في 2011، إذ كانت حمّى تأسيس الحركات الثورية في ذروتها، والظروف مؤاتية لتجسيد حلمهم. هكذا تأسّست “الحركة العمّالية المستقلة”، وضمّت عمّال شركات القطاع الخاص العاملة في تعز وبعض العاملين في المهن الحرة.
عامل المصنع في اليمن يجرب حظه، مرة يرمي نرد حياته للوصول إلى ربّ العمل، ومرة للرجوع إلى البيت، قطعة ثلج في يده تتبدد دون أن تطفئ الحرّ، طفلته في البيت تنفر منه ويفشل في استمالتها. ذكرى الروتين الذي توارثه أبًا عن جد تتلاشى، فقط لو أنه يُستعاد، ذلك الروتين البليد والقاتل، أيام كان يرجع من المصنع إلى البيت في عشر دقائق فقط
قبل خريف الثورة، نجحت “الحركة العمّالية” في تكوين لجانٍ تحضيريةٍ وإعداد نظامٍ أساسي، وعقد اجتماعاتٍ في ساحة الثورة، ثم قدّمت طلبًا للشركات لإنشاء نقاباتٍ عماليةٍ بحسب ما ينص عليه القانون. جوبهت هذه الطلبات بالرفض طبعًا، وأوقف عمالٌ كانوا ضمن اللجان الثورية عن العمل وفُصل بعضهم. فانتقلت المطالب إلى الشارع إلى أن سُمح بإجراء انتخاباتٍ وبدء مرحلة العمل النقابي.
انتُخب غمدان ليقود نقابة عمال الشركة التي يعمل فيها وبدأ الدفاع عن حقوقهم، أصبح هناك عقود عمل تحمي العمال من الاستغلال والعمل لساعات طويلة، وحُدد يوم العمل بثماني ساعات، وهو ما لم يحظَ به عمال بقية المدن اليمنية.
استطاعت هذه النقابات الوليدة فرض نفسها وبدأت تحضير مشروعٍ بديلٍ لقانون العمل لتقديمه إلى مجلس النواب. “لولا الحرب لكان ذلك القانون قد أصبح ساريًا ويحمي حقوق العمال في كل اليمن”، منكسرًا يوضح غمدان برنامج الضغط الذي كان سيرافق تقديم مشروع القانون، والمواد التي حُذفت وتلك المُضافة، وخطة التواصل من أجل تنظيم الاحتجاجات والإضرابات والتوقف عن تسديد اشتراكات التأمين وغيرها من الخطوات.
كان لدى عمال القطاع الخاص في تعز قضايا كالتي يواجهها العمال في أي مكان من العالم، ثم أصبح لديهم قضايا من نوع آخر؛ صعوبة التنقل، مخاطر الطرق الفرعية، عيون القنّاصين، الأسر سنواتٍ لمجرد اشتباه أو لتهمة كيدية سببها خلاف شخصي أو حزبي، إلى جانب المعتاد من التهديد بوقف العمل النقابي ومنع إجراء دورات انتخابية أو اجتماعات الهيئات النقابية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وليت الأمر اقتصر على ذلك، فوفقًا لغمدان، بات العمال مجبرين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تنظّمها جماعة الحوثي من وقت لآخر مثل يوم الغدير وذكرى مقتل الحسين وغيرها من المناسبات التي يصبح فيها العمال حشودًا تستعرض بها الجماعة وتبعث من خلالها برسائل سياسيةٍ تخصّ الجماعة وحدها.
مصدر الصورة: UN Women. تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي
حارس مصنع يواجه المسلحين
واحدة من قصص الانتهاكات المروّعة ما تعرّض له خلدون. اقتحم مسلحون أحد مصانع الشيباني الذي يعمل فيه حارسًا. كانت محاولاته في الدفاع عن مكان عمله عبثية طبعًا، ولم تنجح إلا في تأجيج غضبهم. دخلوا وقبضوا عليه ثم اقتادوه إلى غرفة مظلمة تحت الأرض سيظل فيها خمسة أعوام. في غمضة عين تغيّر يوم خلدون المعتاد من ممارسة عمله كحارس مصنع إلى أسيرٍ لدى أفرادٍ من جماعة الحوثي.
انقطعت أخباره، من يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. مُنع من التواصل مع أحد ومن رؤية الشمس وكان طبق البطاطا والرز شبه النيء طعامه اليومي. لم تتوقف محاولات والدته في العثور عليه وتحريره، وبدا كما لو أنها كانت أسيرة لأسر ولدها. أوقفت حياتها على تخليص خلدون إلى أن نجحت في بيع قطعة أرضٍ دفعت ثمنها لقياديٍ في الجماعة.
طوال فترة اعتقال خلدون (38 عامًا) لم تبدِ الشركة التي حاول الدفاع عن مصنعها أي اهتمامٍ بمصيره. كل ما فعلته أنها قدّمت لأسرته مبلغ 44 ألف ريال في أول شهر من غيابه فقط، وهو مبلغٌ استعادته الشركة من خلدون بقيمة 88 ألفًا (بعد أن حسبت فرق قيمة العملة) بعد رجوعه. ليس هذا وحسب، بل استلزمت عودته إلى العمل وساطات وتدخل أقارب ووجهاء ومسؤولين إلى أن قبلت الشركة توظيفه من جديد.
يحاول خلدون جاهدًا تجاوز فترة السجن، لكن هناك ما يحول بينه وبين النسيان؛ كان عمر طفلته، النافرة منه اليوم، عامًا وثلاثة أشهر حين وقع في الأسر. ورغم مرور أكثر من عام على رجوعه ما تزال علاقته بها مضطربة. مع ذلك لا ينكر خلدون أنه لم يعدم الحظ إذا ما قارن حاله بما آل إليه مصير عمالٍ آخرين. بعضهم قُتل، البعض الآخر أصيب بعاهات مستديمة أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه تحت قصف طائرات التحالف أو رصاص القنّاصين.
في 29 أكتوبر 2015، قتل طيران التحالف العربي (تقوده السعودية) عشرة عمال، وهم في طريقهم إلى عملهم في أحد المصانع الواقعة شرق المدينة، حين قصف الحافلة التي تقلّهم. بالمقابل كان مسلحون من الحوثي يحتلون مصانع ويجعلون من أسطحها متاريس للقنّاص. يُقال إن هذا يعلّق في يده سلسلةً مرقّمة ليسهل التعرّف عليه لو سقطت عليه قذيفة.
أرباب العمل هاربون متهربون
يذكر النقابي غمدان، وهو أيضًا عامل في أحد المصانع الواقعة داخل المدينة، أن مسلحي الحوثي تمركزوا، في بداية الحرب، على سطح أحد مصانع الشركة التي يعمل فيها. تفاوض ملّاك المصنع مع المسلحين، فطلب هؤلاء 50 مليون ريال (تساوي 200 ألف دولار في 2015)، وغادروا فعلًا بعد دفع المبلغ.
بدورهم، غادر كثير من ملاك المصانع المدينة مع اندلاع الحرب، فحوّل المسلحون المصانع الى ثكنات عسكرية تقصفها طائرات التحالف. نُهبت مصانع أخرى أو ابتزت أصحابها جماعاتٌ مسلحةٌ داخل المدينة، الأمر الذي دفع بكثير منهم إلى إيقافها وبعضهم غادر تعز ليجد مئات العمال أنفسهم بلا عمل أو حتى تعويضٍ عادل.
في قضية ضدّ إحدى الشركات التي نقلت نشاطها خارج المدينة، وقفت نقابة عمال القطاع الخاص بجانب العمال الذين سُرّحوا من وظائفهم، وجرت التسوية بدفع رواتب ثلاثة أشهر لكل عامل. كان هذا هو المتاح، يقول غمدان، لكنه ليس عادلًا بالمرة، ويضيف “حدّد قانون العمل الصادر عام 1990 تعويض الفصل التعسفي براتب ستة أشهر، كانت هذه تقديرات المشرّع للوقت الذي قد يستغرقه العامل في الوضع الطبيعي للعثور على عمل. بينما قد يظل العامل الذي يفقد عمله في ظروف الحرب عاطلًا لسنوات”.
مع هذا، يتحايل أصحاب الشركات لئلا يدفعوا للعامل أكثر من شهرين تعويضًا. البعض يتهرّب عبر إعلان إفلاسه، رغم أن الجميع يعرف أنهم أصحاب استثمارات كبيرة في تعز وخارجها.
مدينة العمّال المحفوفة بالألغام
من ثماني سنوات وقعت تعز في الأسر وقطّعت أوصالها. طوّقت حدودها بالألغام. حتى السماء العادية المسالمة أصبحت خطرة. الأثرياء كلهم هجروها تقريبًا والعمّال جربوا طرقًا جديدة وقاسية للوصول إلى لقمة العيش. عند كل مدخل من مداخلها تقف سيارة دفع رباعي أو اثنتان يتحكم من فيها بدرجة الرعب، برضاه عابرٌ يمر، وعابرٌ آخر لا.
عامل المصنع يجرب حظه، مرة يرمي نرد حياته للوصول إلى ربّ العمل، ومرة للرجوع إلى البيت، قطعة ثلج في يده تتبدد دون أن تطفئ الحرّ، طفلته في البيت تنفر منه ويفشل في استمالتها. ذكرى الروتين الذي توارثه أبًا عن جد تتلاشى، فقط لو أنه يُستعاد، ذلك الروتين البليد والقاتل، أيام كان يرجع من المصنع إلى البيت في عشر دقائق فقط. لم يكن غريبًا بعد كل هذا أن يتخوّف العمّال من ذكر أسمائهم الحقيقية في هذا التقرير، فاستبدلت بأخرى مستعارة.
أنتجت هذه المادة ضمن فترة الدراسة في “الأكاديمية البديلة للصحافة العربية” الذي تشرف عليه فبراير، شبكة المؤسسات الإعلامية العربية المستقلة وينشر بالتعاون مع خطـــ ٣٠