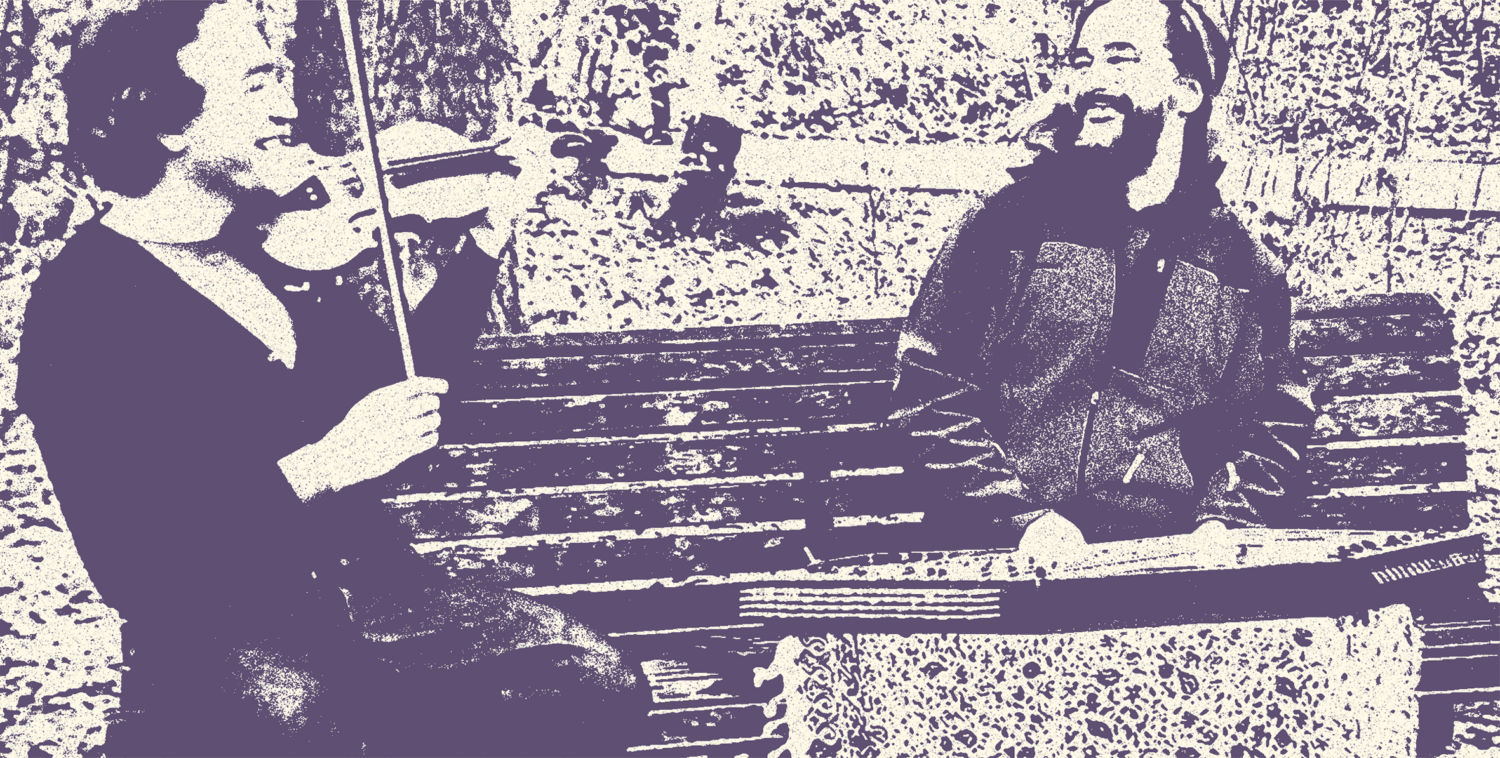يسودُ في الجزائر رأيٌ، عابرٌ للطبقات والأعمار والجنس، مفادُه أنّ الرّاي اليوم هو موسيقى ساقطة بل ميّتة، وبذيئة ولا فنّ فيها.. ويصِلُ حدّ احتقار سمّيعة الرّاي الجُدد، واستكثار عددهم على هذا الفن. وعكس هذا الرأي نجده مع الرّاي القديم، حيث يُعتَبَرُ سمّيعته من المتذوقين للفنّ.
ما هو الرّاي القديم؟ وما هو بالضبط الرّاي الجديد؟ تقريباً، لا أحد يعرف تماماً. هنالك فقط رأيٌ جامع يُقال في المجامع والجلسات الواقعية والافتراضية، يُفيدُ بأنّ الرّاي ميّت منذ زمن. ولكن أحداً لم يحضر جنازته.
كأنّه، وبعد صعود الرّاي للعالمية في التسعينات، وبعد دخول نجومه حظيرة مؤسسات صياغة الذوق الرسمي بعد أن أحدثوا كسوراً في مشهد الرّاي القديم تسرّبوا منها وكسبوا أراضٍ، ما عاد مُمكنِاً لآخرين أن يُحدثوا من بعدهم كسورا جديدة. منذ بداية الألفية، نسمع ونقرأ أنّ الرّاي مات، وفقدَ بريقه وكلامه ولحنه. بل هناك حتى من انقلبَ على الشاب خالد بحُكم أنّ “الشاب خالد القديم أحسن من الشاب خالد الجديد”. و”الشاب خالد الجديد الجديد أسوأ من الشاب خالد الجديد”. بمنطق، كلّما تقدّم الزمن صار الخمرُ أفضل.
مئات النجوم والنجمات الرايوية تبرقُ في سماوات الكباريهات وغابات اليوتيوب، لكن لا عينٌ رأت ولا أذُن سمعت. ملايين المشاهدات لفيديوهات الأغاني الجديدة، وحضور كثيف لحفلات المغنيين، وصناعة كاملة تقوم بين الليل والنهار على أصوات الشبّان والشابّات، أغانٍ وكلمات تنطلق فاتِحةً طرقاً ومُدناً من المعاني والمجازات والشعر الحي، دقّات وألحان مُرتجلة وأخرى مدروسة ترمي الموسيقى إلى بحار وبرارٍ جديدة.. بلا فائدة؛ فالرّاي ميّت.
لكن ماذا لو عرفنا أن الرّاي، وبعد تسعيناته النوستالجية، شهد فعلا عصره الذهبي ولازال؟ ماذا لو رأينا بأن الرّاي الذي وُلِدَ غريباً ما عاد كذلك، وصار أهم وأقوى فاترينة عرض لغليان مجتمع يظنّ الجميع أنّه جامد ومشلول؟
ماذا لو عرفنا أن الرّاي في العقدين الأخيرين حقّق، وبمهارة، ثنائية الجمهور والفن وبوسائل محلية ومن دون توجيهات عُليا من الدولة وبعد أن غربت عنه شمس شركات الموسيقى العالمية الكبرى؟ وماذا لو عرفنا أن معاداة “الحاضر”والتمسّك بالماضي هو سلوك شائع وطبيعي في العالم، فما بالك ببلد يعيش بالكامل في الماضي؟
عهدُ بوتفليقة.. بين المحروقات والكباريهات
لتتبّع خلفية الرّاي اليوم، علينا العودة قليلاً إلى بداية الألفينات، وبالتحديد في الفترة الزمنية التي يحصرها “فيصل صاحبي” وهو ناقد وأستاذ في جامعة “أحمد بن بلة” بوهران، بين 1999 و2009، أول عهدتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيُنبِئُنا أيضاً عن الولادة الجديدة وأسبابها.
يربط “صاحبي” بين ما تسميه الصحافة بـ “البحبوحة المالية” (التي بدأت من قبل احتلال العراق وصعود أسعار النفط) التي جعلت نظام بوتفليقة يُنفِق بسخاء (لا يعادل اختلاساته) على كل ما هو دعم اجتماعي، من غذاء ومحروقات ومشروع المليون مسكن وحتى قروض المشاريع الصغيرة للشباب. كما لا يجب أن ننسى، يقول “فيصل صاحبي”، فتح الموانئ وبداية “اقتصاد الحاويات“الذي أصبح بعد 20 عاماً أحد أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسية الحاصلة الآن في الجزائر.
هذه الظروف سمحت لطبقة من التجار والحرفيين الصغار بالنهوض والالتحاق بنمط معيشي ميسور نسبياً يمكنها من حجز مقاعد في كباريهات على طول الساحل الغربي، كما استفادت هذه المحلات والملاهي نفسها من هذه القروض لترميم سقفها الذي أثقلته وأضعفته الحرب الأهلية، وسنوات الخوف التي ساحت وتدلّت من تاريخ اغتيال الشاب حسني وحتى عتبة الألفينات.
الأمن والاستقرار بدءا يعودان بشكل نسبي، والفنانين الذين قذفت بهم الحرب الأهلية نحو الغربة أو الصمت، عادوا ومعهم جيل جديد. ورأى الجزائريون لأول مرّة، وعلى القناة الرسمية الوحيدة، الشابّة جنّات نجمة صيف 2003 تغني في برنامج “عائلي”، وهو ظهور تسبّب لاحقاً في وقف البرنامج وإقالة بضعة مسؤولين.
ظهرت جنّات في البرنامج بصبغة شعرها الصفراء الرخيصة وبقميص رُسمت عليها صورة موناليزا، وقدمت أغنيتها الأشهر “ما تجبدوليش على اللي نبغيه“، وكانت تلك أيضاً بداية حُمّى “الراي لايف”، من طاولة الميكساج مباشرة إلى آذان المراهقين والشباب، في سيديهات منخفضة السعر أو كملفات رقمية MP3.
صار اسم الدي جاي يسبق اسم الشابـ/ـة حيث صار هو حلقة الوصل، وصارت ألبومات دي جاي نسيم أو دي جاي سهيل تبيع كما باعت ألبومات نجوم تلك الفترة: الشابة جنّات، الشاب هواري دوفان، الشابة خيرة، الشاب عقيل، الشاب عبّاس وآخرين. هكذا، وبطريقة غير مباشرة، استفاد الرّاي من سياسات إنفاق الرّيع لشراء السلم الاجتماعي.
أخيراً، قرّر جيلٌ كامل بأن يعيش، من بعد سنين الخوف. مواطنون فقدوا عشرينياتهم في حرب أهلية، حاولوا أن يتداركوا سنين حياة الليل والسهر التي خسروها. في تلك الليالي الجديدة ظهرت أيضا شخصية البرّاح، والتي كانت في ما مضى شخصية ظريفة تُعلن عن بداية السهرة وتذكر أسماء المغني ومرافقيه.
الآن أصبح البراح ينادي باسم الزبون النجم الذي يأتي ليصرف ملايين الدينارات على عرق الشاب أو على ردف الشابة، فقط ليهزم منافساً أو يُعلن اسمه ملكاً للسهرة. مَن مِن جيلي ينسى الخبر الذي حملته الصحف ذات صباح: “التاجر جمال بسكرة يُبرِّح بمليار سنتيم في ملهى مزغنة!” والحديث وقتها كان عن رجل أعمال كان تاجر خضار وفواكه ثم توسع نشاطه ليشمل النقل والتصدير، وأعلن لاحقاً في برنامج تلفزيوني سنة 2018 عن “توبته” وتطليقه حياة الملاهي و التبريح.
وصول الـ 3G.. وملكات اليوتيوب
بقينا على هذا الحال سنوات. علاقتنا بالراي سماعية في الغالب، نزور أقرب مقهى انترنت لم يتأخوَن بعد، ليُحمِّل لنا في شرائح الذاكرة أو في الـ MP3، جديد الميكسات والألبومات الرايوية، ولا نعرف مما يحصل في الكباريهات سوى الأصوات المصاحبة للغناء والتبراح، ولا يصلنا من مادة سوى صور أغلفة الألبومات – عندما تجود بها تراكات الموسيقى وتضعها كغلاف لها.
في حالات نادرة، يُسافر فيديو –عبر البلوتوث– مئات الكيلومترات ويصل إلى القلة التي تملك هاتفاً يشغّل فيديوهات صوّرت في العاصمة وضواحيها، أوبقية مدن البلاد.
يمكننا أن نُسقِط سنتي 2009 و2010 من الحساب، بسبب تداعيات حُمى “مباراة الجزائر ومصر” المعروفة أيضًا باسم“ملحمة أم درمان“، والتي امتدت حتى كأس العالم في جوهانسبورغ. كانت تلك سنوات صعبة للرّاي، ليس لأن العديد من نجومه تفرّقوا بين مساندة بوتفليقة الذي عدّل الدستور وبين الغناء للمنتخب الوطني الذي غطّت نجاحاته على العملية السياسية؛ بل لأنّ الرّاي نزف دماء كثيرة، بعد موت عازف الكيبورد والموزّع الأشهر تاج الدين عينوس. كثيرٌ من النجوم “تابوا” عن الغناء بعدها أو توقّفوا لفترة.عند عودتهم، كانت الساحة قد امتلأت بنجوم جُدد، وفي غضون سنوات قليلة، كان بوتفليقة قد فتح فيها عدد العهدات في الدستور ثم ضربه الشلل، تغيّرت قواعد اللعبة.
بعد سنة من شلل بوتفليقة، أي في 2013 دخل الجيل الثالث من الإنترنت الجزائر. متأخراً كالعادة مقارنة بمحيطنا. صورة الجزائر البوتفليقية تعملقت وتغوّلت، وصارت الصور والمآثر التي تغنّى بها الرّاي في السنوات القليلة الماضية تعتبر قواعد لمجتمع لازال عالقاً في الحرب الأهلية: العنف، السرقة، صورة الحب كمزايدات ومشاحنات داخل الثنائي، دخول أصناف مخدرات جديدة، الثراء كهدف بحد ذاته والتباهي به.
تغير المجتمع الجزائري، وكان الرّاي سباقاً في عادته وفي طليعة هذا التغيير. اشترى الأثرياء فنادق بملايين اليوروهات في إسبانيا، بينما اشترت، بعد الأزمة العالمية لعام 2008، الطبقة الوسطى هناك شققاً ومنازل أملاً بالحصول على إقامة، واستثماراً لمدخراتها في أمان أوروبا. هذه الحالة كان الرّاي قد غنّاها على لسان الشاب بلال الصغير الذي قال: ”نبيعو الفارماسي ونروحو لسبانيا“، لكن بعد أن يبيعا السُكنى و”يشروهم ويسكي”.
التجار الصغار -والكبار- الذين سافروا إلى فرنسا أسبوعياً لملء حقائبهم بما غلا ثمنه وخفّ وزنه، سواء من سلع نادرة أو مسروقة، رافقهم الرّاي أيضا، بل وفتحوا له ولنجومه ملاهي وشيشات (مقهى شيشة) ضواحي باريس وليون ومارسيليا ليصنع جسورا جديدة جزائرية–جزائرية لراي ما بعد 123 صولاي (حفلة شركة باركلي الشهيرة سنة 1998 للثلاثي: الشاب خالد وفضيل ورشيد طه).
وصلنا كل هذا بالصوت والصورة على الهواتف الذكية التي أغرقت السوق. فجأة لم يعد غريباً أن نرى صور الكباريهات والرقص والأضواء والأجساد المتلاطمة والأوراق النقدية الماطرة فوق الرؤوس.
وفيما بقي البعض يتساءل عن مستقبل الصناعة والألبومات أمام وحش الإنترنت، تغيّرت المعطيات مرّة أخرى وصار اليوتيوب مقياساً لنجاح الأغاني والمطربين. ليس فقط عن طريق نشر فيديوهات الكباريهات “الفضائحية” التي بالكاد نسمع فيها صوت المغني، بل بنشر فيديو كليبات الأغاني داخل الاستوديوهات. مثلما رأينا وصول شخصيتي الديجاي والبرّاح في بداية الألفينات بقوة، صرنا مع أغاني الأستوديو نكتشف عالماً كان في الكواليس حتى وقت قريب.
أولاً، لاعب السانتي (الكيبورد) والذي حظي دائما بمكانة مميزة في تاريخ الرّاي منذ أن تكهرب، صار في العالم الجديد نصف الأغنية، لاعب آلة وملحنٍ وصاحب استوديو (مثال تيبو بلعباس)، بل تطور وأصبح مغنياً كما في حالة هشام سماتي.
ثانياً: الشاعر، صرنا نرى في المشهد وضمن الواقفين داخل الاستوديو رجلاً يحمل ورقة للمغني، أو يقف بورقة لا يقرأ منها أحد، ونعرف أنه الشاعر. وهنا يمكننا القول إن الرّاي الألفيني عرف نقلة كبيرة في الكلمات تجاوزت الطريق المسدود الذي وصله راي التسعينات (في الداخل والعالمية) الذي كان يطرزُ حول جمل وبونشلاينات من التراث الرّايوي القديم، فالشاب خالد أو مامي حلبوا مخزونهم التراثي، وكرّروه حتى اهترأ. في حين أن الشباب والشابات الجُدد فتحوا بكسورهم مساحات مهمة للغة اليومية بكل درجاتها، فغذّوا منها أغانيهم لتعيد أغانيهم تغذية هذه اللغة ومدّها بالصور والمجازات والحكم، ولنذكر: يا زهري تقطع/ والخيّاط هارب.
ثالثاً: المخرج أو المصوّر، الذي غالباً ما يعمل مع صاحب الاستوديو، والذي يدخل اسمه قائمة الأسماء الطويلة التي تسبق اسم الأغنية.
رغم هذا بقيت شخصية الفنان هي المركزية، مثلما هو الحال مع أشهر اسم نسوي في الرّاي اليوم: الشابة وردة شارلومانتي، والتي اشتهرت لعاملين: شخصيتها المرحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغانيها التي نافست على المرتبة الأولى لترندات الجزائر على اليوتيوب، والتي تستعرض فيها قوامها الذي يستأثر بأغلب التعليقات.
صارت ملكة اليوتيوب، وصارت حياتها الفنية والشخصية تحت أنظار الجميع. فيديوهاتها على أنستغرام وفيسبوك صارت تروّج لأغانيها، والعكس بالعكس. تابع الجمهور قصة زواجها الرابع (الأول في حياتها كنجمة) ثم موت زوجها مقتولاً، ثم حدادها ولبسها السواد وتحوّل التنمّر والسب إلى تعاطف، فعودتها بقوة إلى الكباريهات ومعها موجة الشتم وملايين المشاهدات.
تزامن هذا مع زواجها الخامس التي قدمت معه صورة المرأة العاملة وربّة البيت، لتتطلق مرة ثانية مؤخراً (يناير 2021) بعد تصوير زوجها لفيديو يهدد فيه بالانتحار إذا لم “تُرجع له أوراقه وأشياءه”. صورة لم تكن معروفة من قبل عن شابّات الرّاي، وربما دشنّتها الشابة خيرة واكتمل نضجها مع الشابة دليلة وزوجها الملياردير أمين شيطانة.
زجاجات في البحر
من الصعب أن تُنقِذ المستقبل في بلد كل ما فيه ماضوي، بدءاً بعقيدة الدولة نفسها ومروراً بالشرائح المعارضة، والتي تُزايد على الدولة أو تهادنها باستعمال الماضي أيضاً. بعكس كل هذا التوجّه نحو الماضي، لم يُلغِ الرّاي المستقبل أبداً، طيلة عقود، وحده (مع الرّاب) من بين طبوع الموسيقى الكثيرة. أحدث الرّاي كسوراً في الصورة الجامدة التي صنعها له الجمهور، وتسرّب منها نحو أراضٍ جديدة، مستعينا بخيال جديد.
الرّاي كان دائماً ضدّ النوستالجيا. حتى وهو يستعمل النوستالجيا، ويُدَوِّرُ كلمات أو ألحان قديمة، لم يكن ذلك استعادة للتذكر والحنين بل لصنع الجديد. هوسُ مطربي الرّاي بآخر خبر، وآخر صورة، وآخر حدث جعلهم يعلّقون على الأخبار في سهرات الكباريهات قبل تعليق الصحف ونشرات الأخبار في الصباح.
وسط الركود الذي تشهده الموسيقى في الجزائر اليوم والمستمر من عقود، نجدُ أنّ الرّاي يُنقِذُ دائما شرف المحاولة. فنجِدُ أنّ الحراك الشعبي مثلاً لسنة 2019، ورغم أنه انطلق على أنغام نشيد ألتراس نادي “اتحاد العاصمة” الأشهر، لا كازا دل مرادية، لم ينتُج عنه تعابير وخيالات موسيقية جديدة، ليس للتغنّي به كحدث بنفسه، ولكن تعابير وخيالات من حوله وعلى هامشه.
في حين أنّ شباب وشابّات الرّاي أخذوا شعارات الحراك وأغاني الألتراس، والتي تهجو الماضي في مجملها ولكن لا أفق لها سوى الموت أو السجن أو الأفق المتخيّل لأوروبا، أخذوها وفتحوها على أرض جديدة لا أفق لها سوى شروق الشمس. كان هذا الاستيعاد أو “الخطف” أكثر حرفية وذكاء من استعادة و“تقليد” مغنيي الطبقات الوسطى الذين يتنقلون بين وكالات الإعلانات والإذاعات الوطنية، الذين – وفي لحظة حماسة ثورية– أعادوا تهذيب وتوزيع ألحان أغاني الألتراس وغنّوها بلمستهم هم.
كسور الرّاي لم تتوقف هنا، بل رأينا الشاب بيلو، أحد الأرقام المهمة في الجيل الجديد، يغنّي أغنية صيف 2019: “كنت خارج للمسيرة / قتلتني هاذ الشيرة (البنت)/ تعيّط السلمية / وأنا نقول هي هي“.
بين الكسور والأراضي الجديدة، يتقدّم الرّاي، يغذّي ما حوله ويحمل معه أسماء وأنواع جديدة، ثم يعود ويتغذى على الجميع ويكسرُ الصورة ليتسرّب نحو أراضٍ جديدة.