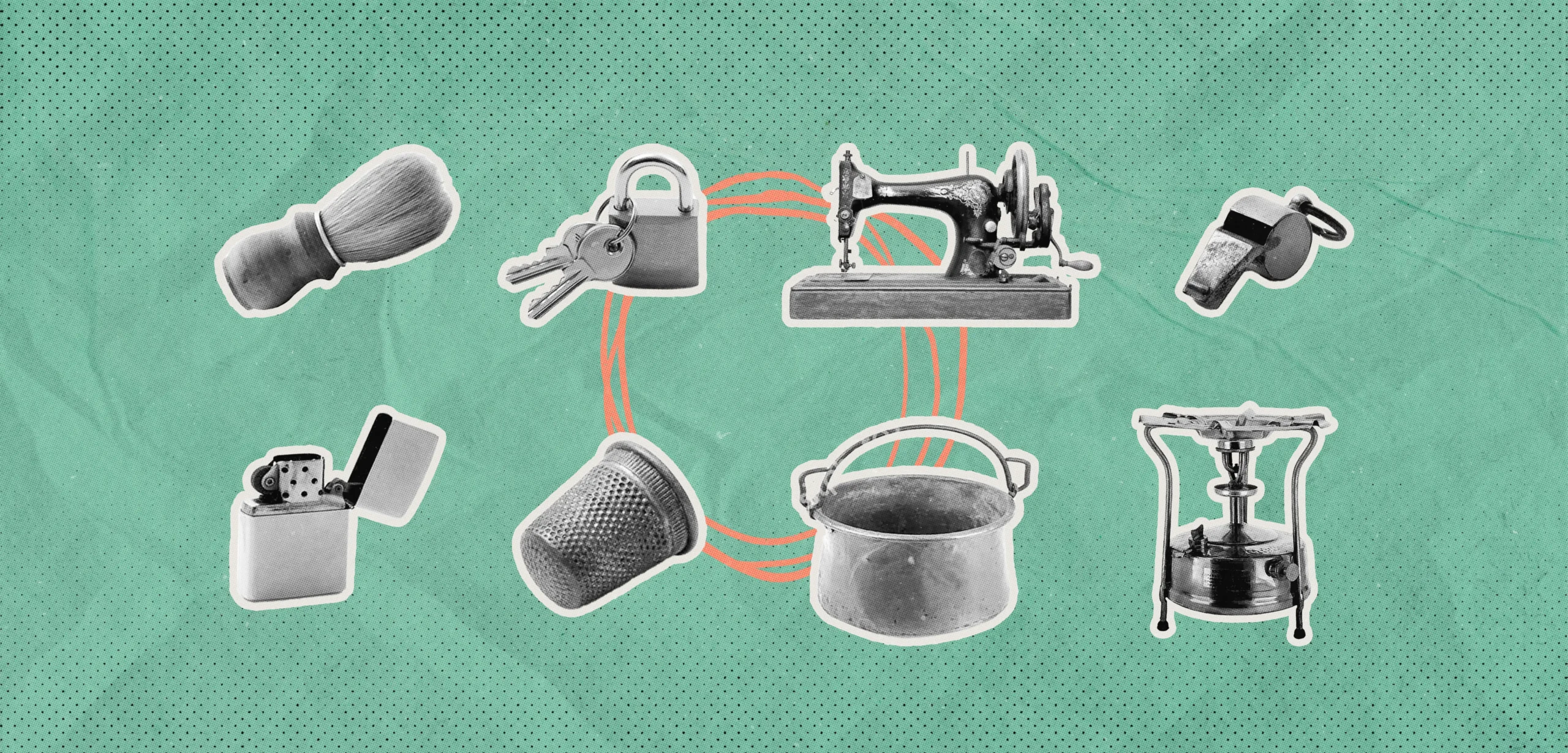عددٌ كبيرٌ من السرفيسات يربط بيروت ببعضها وينقل أهلها من مكان إلى آخر. إنه نظام التنقل العمومي الوحيد تقريبًا. يصعب قول كلمة “عمومي” دون تحفظ كثير على سيّارات الأجرة التي ظهرت نهاية الخمسينيات، وأصبحت أعدادها مهولة في السنوات التي تلت نهاية الحرب وحتى قبيل الأزمة الاقتصادية، وقلّت أعدادها اليوم بسببها، إلى جانب انتشار التطبيقات التي تقدّم خدمات التوصيل.
في 2018 كانت تسعيرة الراكب المعتمدة ألفيّ ليرة لبنانية، أما اليوم فكل سائق يطلب قيمة مختلفة بسبب تقلب الأسعار وارتفاعها وغياب الرقابة، وقد تصل الأجرة إلى خمسين ألفًا، نفس المبلغ الذي كان يدفعه الراكب إذا استقل السيارة كتاكسي لا يشاركه فيه راكب آخر مثلما هو الأمر في السرفيس، كان هذا قبل سنوات قليلة فقط.
ينشط السرفيس في العاصمة بشكلٍ أساسيٍّ وفي بعض المدن الكبيرة كطرابلس وصيدا وصور. لكنّه يقلّ كثيراً بين البلدات والقرى اللبنانيّة مما يقطع إلى حدٍّ كبير حبل الوصل بينها، في ظلّ غياب نظام نقلٍ مشتركٍ في لبنان.
ركبنا سيارات وبعنا الترامواي للصين
يتحدث المسنّون عن قطار كان يقطع رحلات من بيروت لطرابلس، والترامواي الذي ظلّ يعمل ستة عقود إلى أن انتهى في 1964، ويشاع- دون أن يؤكد أحد المعلومة أو ينفيها- أن عرباته بيعت إلى الصين وأن بعضها بيع لتجّار الحديد، لكن الشباب يجد صعوبة في تخيل حياة كهذه في البلاد. يتذكر أجدادنا هذا الماضي كما لو أنهم يخبروننا بأنه ليس أمرًا مستحيلًا، ولكن لماذا يبدو لنا كذلك؟
عندما أتنقّل بالباص من طرابلس إلى بيروت، أجلس على المقعد ذي النافذة القريبة من البحر. أضع سمّاعاتي، وأحاول كلّ مرّةٍ أن أعيد تركيب مشهد القطار من خلال ما يتوفّر لي من معطياتٍ على الطريق: بقايا السكك الحديدية، عربات القطار الصدئة المحاطة بالأعشاب، خزانات المياه والجسور الحديدية فوق الأنهار التي كان يمرّ فوقها القطار. كانت المشهديّة تتحسّن كلّما ازدادت الزحمة وخفّف الباص من سرعته.
ترتبط المناطق ببعضها في لبنان من خلال عددٍ من الباصات و”الفانات” المبعثرة على الخطّ البحري. إذ أنّ المناطق الأساسيّة لتجمّعها وانطلاقها محصورةٌ فقط في أكبر ثلاثةِ مدنٍ: طرابلس (في الشمال)، بيروت (العاصمة)، وصيدا (في الجنوب). من بعدها يقلّ عدد المركبات الّتي تتجّه من صيدا إلى صور جنوباً، ومن طرابلس الى عكّار شمالاً، ومن بيروت إلى البقاع والمتن داخلاً.
من الأطراف إلى المركز
انتقلتُ وأنا في السابعة عشرة من بلدتي الأمّ شمال لبنان إلى بيروت للدراسة، مثل معظم الطلاب، فالتنقل ليس سهلًا، وهذا قد ساهم أيضًا في تركّز الحياة العمليّة والكثافة السكّانية في العاصمة التي ينزح إليها معظم أبناء الأرياف والأطراف. في ظلّ نظامٍ كهذا تعتبر معظم المناطق اللبنانيّة “أطراف” ويصبح مشروع عطلة نهاية الأسبوع يقتصر عند كثيرين على اكتشاف تلك الأطراف، بينما كان مشروعي الخاصّ حينها اكتشاف بيروت نفسها.
سكنتُ في مجمعٍ للطلاب لثلاث سنوات، في منطقةٍ بعيدةٍ نسبياً عن وسط العاصمة. كان هذا البعد الجغرافي وهميًا لكنه مرتبط بصعوبة الوصول، الذي يأخذ مساحة كبيرة في تفكيري اليوميّ.
مع تزايد ملكيّة السيارات طالب اللبنانيون بإزالة خطّ الترامواي داخل بيروت لتصبح الشوارع مهيئة أكثر لحركة مركباتهم، أي أن مالكي السيارات أنفسهم كانوا سببًا في التخلص من وسيلة مواصلات عامة مريحة ورخيصة ليتمتعوا بملكياتهم ووجاهتهم ..
كنت أنتهي من صفوفي عند الرابعة مساءً، ثمّ أركض إلى الطريق مقابل الجامعة محاولةً أن أفهم كيف أنتقل من الشارع الّذي أنا فيه الآن إلى شارعٍ آخرٍ في المدينة أختاره عشوائيًا بناءً على خريطةٍ حديثةٍ حصلت عليها من أحد المتاجر. بعد عدّة محاولاتٍ، والكثير من الأسئلة، بدأت باستيعاب “سيستم” السرفيسات المرهق عمومًا، لأنّه تطلّب التنقّل من سرفيسٍ إلى آخر حتى أصل إلى وجهتي، ولم يكن التنقّل سلسًا.
في خمسينيات القرن الماضي بدأت السيّارة بالانتشار في لبنان، ومع دخولها بدأ نظام السرفيسات. حينها كان القطار لا يزال فعّالاً، لكنّه كان بطيئاً مقارنةً بالسيارة. وبما أنّه في تلك الفترة تدفّقت الرساميل العربيّة إلى لبنان، أصبح عددٌ كبيرٌ نسبياً من اللبنانيين لديه القدرة على اقتناء مركبةٍ خاصّةٍ.فأصبح وجهاء البلد والأغنياء آنذاك ينتقلون من الأطراف إلى العاصمة لأشغالٍ معينةٍ ينتظرهم سائقهم ويعيدهم، وأصبح هذا ينقل معارفه من البلدة إلى وفي داخل بيروت ويأخذ تعرفة لتغطية نفقة المحروقات.هكذا بدأ السرفيس، ثم أصبحت له مواقف واضحة وتعرفة موحّدة. في المقابل، ومع تزايد ملكيّة السيارات طالب اللبنانيون بإزالة خطّ الترامواي داخل بيروت لتصبح الشوارع مهيئة أكثر لحركة مركباتهم، أي أن “مالكي السيارات أنفسهم كانوا سببًا في التخلص من وسيلة مواصلات عامة مريحة ورخيصة ليتمتعوا بملكياتهم ووجاهتهم، ولم يكن كل اللبنانيين طبعًا يمتلكون سيارة.
أطلال سكة حديدٍ دمَّرها مد البحر، على ساحل مدينة صيدا
من الحرب الأهلية إلى اليوم
مع ثورة السيارات بدأت رحلات القطار تقلّ، وأصبحت قاطراته البطيئة تقتصر على نقل البضائع، وواصلت الدولة مسار التخلي عن مسؤولياتها. وفي عام 1961 أُممت سكّة الحديد في الوقت نفسه الذي أنشئت فيه مصلحة النقل المشترك والسكك الحديدية. لم تؤمّن هذه المصلحة الربح المطلوب للحكومات المتعاقبة، وفي عامّ 1973 أصدرت الدولة قراراً بالتوقف عن توظيف عمالٍ جددٍ بالمصلحة في محاولةٍ منها للقضاء عليها. لم يفلح الأمر مباشرةً، لكن الحرب الأهلية أنجزت المهمّة: قُصفت السكك، سُرقت القاطرات، ودُمّرت المحطّات الرئيسية وخمدت صافرات القطار.
مع بداية الحرب الأهليّة اللبنانيّة عام 1975، كان نظام النقل في لبنان شبه معدوم. كانت الحرب “الدفشة” التي انهارت معها المؤسسات العامة والخدمات التي كان على الدولة تنظيمها ورعايتها، ومن ضمنها نظام النقل المشترك. ومع نهاية الحرب، ولد النظام ابن اتفاق الطائف في تسعينيات القرن الماضي، وانقطع معه أي أمل في نظام نقل مشترك يخدم الجميع.
التنقل في زمن الأزمة
يجتمع تاريخ البلد كله مثل كتلة واحدة ويسقط على رؤوسنا، كل سقوط نعيشه يعيدنا إلى زمن الحرب وما قبله أيضًا. لذلك حين نفكر في مسألة مثل النقل العام، نجد أنفسنا نستعيد محطات مختلفة؛ لحظة دخول السيارات، توقف الترامواي ثم القطار، ثم نجد أنفسنا أمام أمام فشل حكومي وصراعات أهل المال والنفوذ، كل هذا الذي أوصلنا اليوم إلى الانهيار.
في إحدى اعتصاماتهم الأولى أخبرني موظفو المؤسسات العامة أنهم يحضرون إلى العمل يومين في الأسبوع فقط؛ لا الغلاء ولا أسعار الوقود ولا التنقل الصعب يجعل حضورهم إلى مكاتبهم أمرًا روتينيًا مملًا، بل معقدًا ومكلفًا يتخطى رواتبهم أصلًا، وفي غياب وسائط نقل عامة بأسعار تناسب ذوي الدخول المحدودة يصبح الأمر مستحيلًا. اليوم وصل الأمر إلى الإضراب الكامل عن العمل، وتعطلت غالبية مؤسسات الدولة.
التهميش لا يقتصر على الأفراد فقط، بل والمناطق. وهذا جزءٌ من سياسات التقسيم وتجذير الطائفية المتبّع بعد نهاية الحرب الأهلية. نعيش اليوم في بلدٍ ننسى أجزاءً منه لأننا لا نستطيع الوصول إليها
منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام السابق وموظفوا القطاع العام مضربين بشكلٍ جزئي. زادت الحكومة اللبنانية 65 ألف ليرة لبنانية كبدلٍ للنقل على رواتبهم ما يعادل اليوم ثلاثة دولارات في اليوم، في حين أنّ صفيحة البنزين تخطّت الـ 650 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22 دولارًا.
في منطقة الدورة، حيث تتجمّع الحافلات الذاهبة إلى الشمال، التقيت بعسكريّ. كان ينتظر “الفان” ليذهب إلى طرابلس، ليركب منها إلى عكّار، وهي رحلة يمكن أن تستغرق أربع ساعات.”أحاول أن أرتّب أوقات العودة إلى المنزل لتتوافق مع أوقات زملائي فنتشارك في دفع البنزين إن كان أحدنا يملك سيّارة. لكن التكلفة لم تزل عاليةً جداً وفي معظم الأحيان تنظيم هذه الرحلة أمرٌ صعب، فنادراً ما تتقاطع أوقاتنا. أستخدم الـ “فانات” (حافلات صغيرة/ميكروباص) بشكلٍ أساسيٍّ لكن كلفة النقل أصبحت أعلى من الراتب الذي أتقاضاه”، يقول العسكري.
يُحكى اليوم عن هروب أكثر من 2000 منتسبٍ للسلك العسكري، إلا أن هذا الرقم غير مؤكّد – ولا يمكن تأكيده – وإن كان ليس مستبعدًا.
مستديرة العدلية، بيروت. تصوير شيرين الحايك
التنقّل اليوم
تحتاج ياسمين التي تسكن قضاء المتن، نصف ساعةٍ لتصل إلى بيروت بالسيارة، لكنها لا تملك واحدة، فتضطر لاستبدالها بحافلةٍ تقلّها في مدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف حسب الازدحام.بالرّغم من أن ياسمين تعلم أن النظام الحالي مفكّك ومدمّر فعلياً إلّا أنّها اعتادت عليه. “أظن أنني إذا سافرت إلى أوروبا مثلاً، لن أعرف كيف أتنقّل. فعلاً لن أعرف كيف أستخدم النظام الكامل من باص ومترو وقطار”. جميع نشاطات ياسمين في بيروت تتمثل بالجامعة، العمل، الأصدقاء. تقول “كل شيء يحدث في لبنان نلمسه في تنقلنا في الحافلات، في فترة الانتخابات الماضية، قرّر مرشحٌ من منطقتنا خصم 5 آلاف ليرة من تعرفة الباص لجميع الركاب اللبنانيين. ومرّة رفض سائق الباص خصم هذا المبلغ لامرأةٍ ظنّ أنّها من سوريا لمجرّد أنّها محجبة”.
سألت شابّين يبلغان من العمر 17 سنة عن علاقتهما بالنقل. ينتقل الإثنان اليوم من جامعةٍ إلى أخرى لاختيار اختصاصهما الجامعي وخططهما المستقبلية. الملفت في إجابتيهما هو كلمة “التعب”.
يحاول الأول أن يتنقل بالدراجة الهوائية إلّا أن التنظيم المدني الحالي لا يسمح له باعتماد هذه الوسيلة كوسيلة نقلٍ أساسيةٍ باعتبار أنّها غير آمنة ولا أرصفة مناسبة لها ولا بنى تحتية جاهزة بالإضافة إلى أنها “متعبة” ولا يمكن أن يصل من خلالها الى جميع الأماكن الّتي يريد الوصول إليها.
أمّا صديقه، فبات مضطراً إلى استخدام سيارات الأجرة وخصوصاً “بولت” و”أوبر”، إلّا أنّ التكلفة باتت عالية جداً عليه، أمّا الباصات فـ “أقلّ مشوار بياخد ساعة ونصّ بالباص وبوصل تعبان!”.
ربّما لا ندرك أثر صعوبة التنقل في الفضاء العام علينا وعلى طاقتنا، لكن كيف يمكن لشابين صغيرين جداً أن “يتعبا” من التنقل؟
التهميش في صلب النظام الحالي
في ظلّ نظامٍ يتكّل إلى هذا الحدّ على ثقافة الملكيّة الخاصّة، ويعمل على تجذير ثقافة السيارة بشكلٍ مستمرّ، ويعطّل وظيفة الدولة بتأمين هذه الخدمة بشكلٍ شبه كامل، وبالتالي فإن معظم المواطنين اللبنانيين والمقيمين مهمّشين.
ثمة فئاتٌ ازدادت تهميشاً وانعزالاً بسبب صعوبة التنقل بين المناطق ومن ضمنها العمّال الأجانب واللاجئين والطلاب وطلبة الجامعات وموظفو القطاع العام.أحمد يعيش في بلدةٍ قريبة من صيدا، ولا يملك سيارة فيلجأ إلى المتاح. ساحة النجمة في صيدا هي أهم موقف للباصات، حيث هناك شركة خاصة توفّر النقل بحافلات كبيرة مزودة بمكيفات. “قبل الأزمة،كانت تعرفة الباص الكبير 2500 ليرة، أمّا الفانات والباصات الأصغر فتعرفتها 2000 ليرة”. التعرفة الآن أضعاف هذا الرقم.
التهميش لا يقتصر على الأفراد فقط، بل والمناطق. وهذا جزءٌ من سياسات التقسيم وتجذير الطائفية المتبّع بعد نهاية الحرب الأهلية. نعيش اليوم في بلدٍ ننسى أجزاءً منه لأننا لا نستطيع الوصول إليها. نعيش في بلد المواصلات العامة المتاحة للجميع مجرد ذكرى. نعيش في مدينةٍ محطّة القطار فيها خرابة، لكنها مساحة بعيدة عن الضوضاء تصلح كمكانٍ هادئ للشرب والسهر.