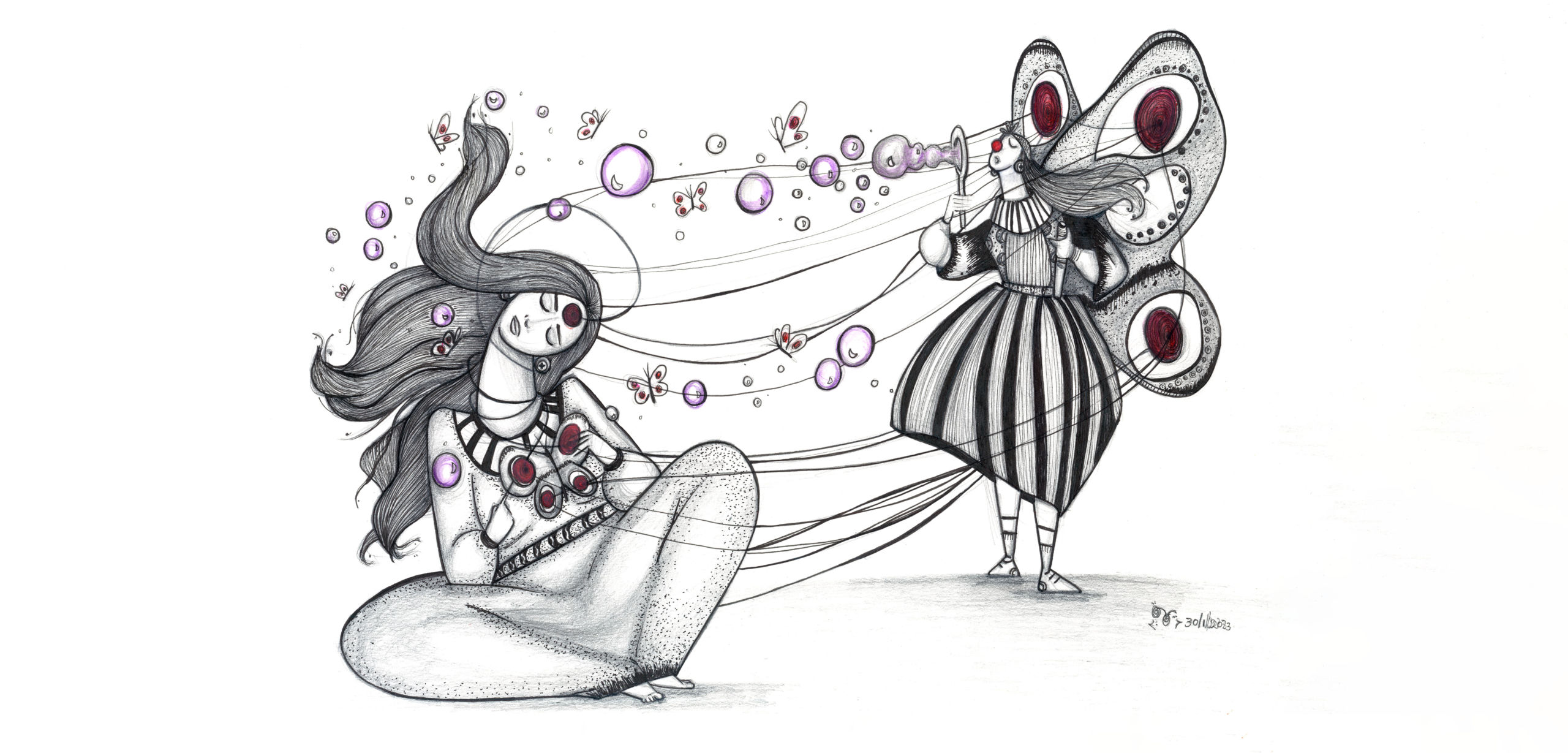أول مرة شممتُ فيها رائحة المسك الأبيض، حدث بداخلي شيء لم أخبره من قبل. لأول مرة تستحوذ رائحةٌ على روحي وجسدي وتصيب قلبي بخفة مرفرفة سرّعت من أنفاسي ونشرت في جسمي الخدر.
لحظتها لم يكن أنفي هو من يشمّ فقط بل قلبي أيضًا. تمامًا كما حدث لي ذات مرة حين وقفت أمام عازف تشيللو وعازف فلوت وشعرت بالموسيقى الحية تخترق جسدي وتمر عبر عمودي الفقري، تاركة أثرها على جلدي. وكأن العطر موسيقى.
تصوير: شيماء صالح
لما سألت صاحبة الرائحة عنها، أخبرتني أنها رائحة مرطب بشرة تستعمله وفيه خلاصة المسك الأبيض. ظنتُ أنني فور معرفتي بالاسم سأتمكن من الحصول عليه لكنني كنت مخطئًا.
ساعتها كنت أعمل في محل ملابس ويجاوِرني أحد محلات تركيب العطور، التي ظهرت في مطلع الألفية الجديدة لتقليدِ ماركات العطور الغالية. ومن خلال أصحاب المحل، تعرّفت على الفكرة الرئيسية لصنع العطر، ومقدار ما يوضع في الزجاجة من خلاصة عطرية ومقدار الكحول، وكيفية ضبط البخّاخ على عنق الزجاجة.
كنت على دراية بالعطور، لكنني من خلالهم تعرفت على خلفيات الاجتماعية للعطور كعطر one man show، الذي انتشر في ثمانينات القرن الماضي بزجاجتِه التي كانت تأتي مع كريم ما بعد الحلاقة، وكانت وقتها تمثّل عطر الشاب العملي الناجح. وعطرُ سيجار الذي قيل أنه كان عطر السادات المفضّل وأن تركيبته العطرية تحوي زيت الحشيش، وكانت تقبل عليه ذكور المناطق الشعبية. وعطر الأورجانزا وHot Couture، أنوثة الطبقات الأعلى، التي كانت مطلب فتيات الطبقات الأقل.
تصوير: شيماء صالح
لما سألتهم عن المسك الأبيض، أحضروا لي زجاجة معدنية تحمل خلاصة الزيت العطري وشمّوني إياها، لم تكن نفس الرائحة. قريبة على نحو ضعيف، وبها شيءٌ من الابتذال والبهرجة والشيوع، مقلدة ظاهريًا لكنها ليست هي. طلبت منهم أن يصنعوا لي معطّرًا للجو منها لأرشّها في المحل. فمن لا يجد الخوخَ يرضى بشرابه.
أخبروني أن المسك أنواع ثم شمموني النوع الأكثر شيوعًا وهو حجر المسك، عطر الأضرحة والمساجد الصوفية الذي يضعه المجاذيب من الدروايش على أكف المصلين كنفحة محبة وبركة. ثم أخبروني أن أجود الأنواع ما يأتي من الحرم المكي.
لما سألني صديق ذاهب لأرض الحجاز عما أريد من هناك؟ قلت له: قارورة مسك أبيض. وبالفعل عند عودته، قابلني بزجاجة صغيرة بغطاء ذهبي وهو يقول: آدي يا سيدي المسك الأبيض، شكرته وقربت الزجاجة من أنفي وأنا أستحضِر المرة الأولى لكنّي صُدمتُ، هذا ليس المسك الأبيض، قال لي: لا هذا المسك الأبيض مسك الحرمين، شكرته وقلتُ: يبدو أن الأنواع أكثر مما أعتقد.
ذهبت للبيت وأجريت بحثًا على الإنترنت لأعرف أن هناك: «حرمين مسك أبيض ملكي: يأتي برائحة رائعة وكمال متوازن، عطر من شأنه أن يلبي جميع احتياجات المستخدم الذي يتطلّع لأكثرِ مما يحتاجه الشخص العادي من الحياة».
لاحظوا اللغة وما تحمله من رسائل: «كمال متوازن»، عطرٌ يُلبّي احتياجات الشخص المتطلّع لما هو أكثر من العادي من الحياة، حالة تعبيرية متطايرة تسوقها الكلمات دون أن تقول شيئًا بعينه، كحال العطر حين يُشم، نعرفه ولكن لا نعرف ما هو تحديدًا، تحتاج للغة لا تنقل خبرًا بل شعورًا، وإلا فما هو إذن الكمال المتوازن؟ وكيف يكون الكمال غير المتوازن؟
أعترف أنني أتطلّع إلى ما هو أكثر من العادي، إلى حالة سريالية حسية يُحدِثُها المسك الأبيض بداخلي، لكن مسك الحرمين للأسف لم يصل حتى لعتبات الحالة. فالمسكُ الأبيض الذي شممته أول مرة لم يكن عطرًا ذكوريًا ولا أنثويًا، هو بين بين، حسيًا أكثر منه ذهنيًا، لكن مسك الحرمين رجولي دون أي حسية، مؤسساتي، عند شمه يأتي إلى ذهنك اللون الذهبي وجلباب الدفة الأبيض بملمسه الناعم وأجواء القصور والقاعات الملكية والمساجد الكبيرة.
بعد ذلك في زيارة لبروكسل وأنا في محل للعطور رأيت زجاجة عطرٍ تقف على تلٍ مرصوص من زجاجات متشابهة، مكتوب عليها «مسك أسود»، شدني الاسم. قلت لنفسي هناك مسك أبيض وآخر أسود، أمسكت بالزجاجة وبخختُ في الهواء بخة ثم قربت أنفي، إنها عالم آخر من المسك، ذكوري، حريف كالتوابل، فيه إثارة، غموضٌ وحزن كالذي يلازم اللون الأسود لكنه يفتقد إلى البراح والحبور الذي يملأ عبق المسك الأبيض.
تصوير: شيماء صالح
يأتي المسك من ذكور الغزلان في جبال التبت وأفغانستان والهيمالايا من داخل حويصلة غدّة بحجم كرة صغيرة تفرز سائلًا عطريًا يفوح بفيرومونات جنسية لجذب الإناث من الغزلان، رائحة غواية وصيد لنيل المتعة، تقارب رائحة التستوستيرون، إن كانت له رائحة، لذا لا غرابة أن يكون معنى كلمة مسك في اللغة السنسكريتية خصية. من أجل هذه الرائحة كانت تُقتل ذكور الغزلان، تُزال حويصلاتُها وتُجفّف لإنتاج جراب المسك، البودرة التي ينتج منها.
منذ اكتشافه قديمًا والمسك مثير جنسي يحفز الحواس ويهيئها للقاء وممارسة الحب. لكن ألسنا في الجنس نفرز روائحنا الحقيقية: رائحة العرق والريق والفرج والحيوانات المنوية. ألهذا نضع العطر حتى تفوح مكنوناتنا الحقيقية بروائحها الأصيلة لنشمّها مع من نحب؟
استمرت بعد ذلك رحلتي للبحث، وجدت محلات Body shop، التي تعتمد المسك في منتجاتها، لكنها لم تكن مطابقة تمامًا لدرجة المسك التي شممتها في السابق، الحقيقة أن ما قابلتُه بعد ذلك كان مجرد أشباه للرائحة. ويحدث من حين لآخر أن أشمّها بشكل خاطف ومفاجئ في المواصلات أو التجمعات وحين ألتفت لمصدرها أجده اختفى وانسحب، مرة شممتها على شاب سوداني في ميني باص نزل قرب منطقة بولاق الدكرور، لا أبالِغ لو قلت أنني عند زيارتي كل مرة لصديق يسكن هناك كنت أمرّ على محلات تركيب العطور وأشم ما تيسر لي من روائح المسك الأبيض لعلي أجد ضالتي، وكنت كلما عثرت على رائحة شبيهة أشتري منها زيتًا خامًا سرعان ما يخبو عبقه لاحقًا.
بعد سفري واستقراري بفرنسا، بلد العطور، قلت لنفسي ربما هنا سيمكنني اقتناص الرائحة في محلات البرفانات الباريسية، قلت بالتأكيد ثمة مسك هنا. لكني في كل مرة أسأل البائع أو البائعة أجدهم حائرين يحاولون عرض برفانات تحوي مسكًا أبيضًا لكن مع خليط من روائح أخرى ولا يصنع الأثر المنشود.
وبالمصادفةِ، عرفتُ أنني أسكن على مقربة من مدينة جراس، عاصمة العطور في فرنسا والعالم، وبدعوة من أحد الأصدقاء ذهبنا إلى مصنع فراجونارد، الذي أسسته عائلة يوجين فوكس احتفاء بالرسام الفرنسي Jean-Honoré Fragonard، ويقدم زيارة لمَن يرغب في التعرّف على طرق صناعة العطور. الفرصة سانحة الآن لسؤال أهل الصنعة عن المسك الأبيض.
خرجت لنا سيدة في منتصف العمر واستقبلتنا في كامل أناقتها وبنظرة واثقة مرحة عرفتنا بنفسها وقادتنا إلى داخل المصنع، في البداية حاولت أن تختبر قدراتِنا الشمّية على إدراك الروائح لذا دعت كل مجموعة منا إلى طاولة عليها علب معدنية كعلبِ كريم الوجه مرقّمة وطلبت منا أن نضع كل علبة عند اسم الرائحة الذي يخصها والمكتوب على الطاولة.
تصوير: شيماء صالح
كنت أنا أول مَن اكتشف اسم الرائحة في العلبة رقم 1، فما إن شممتها حتى هلّت عليّ عقود الفُلّ المباعة في إشارات المرور وعلى كورنيش النيل ورائحة بعض شوارعنا في نهايات الربيع. إنها رائحة الفُلّ، أو الياسمين المصري كما كان مكتوبًا على الطاولة. اكتشفتُ لحظتها ولأول مرة أنني أتعامل مع الفل على أنه نوع والياسمين نوع آخر. وكيف أن الفُلّ هو مسمى مصري أصيل لا يُعرَف معناه ودلالاته الكثيرة خارج المجتمع المصري، فهو في تحيّات الصباح والمساء وهو أيضا تعبير عن الإعجاب، وكذلك هو مصطلح لغوي يعني أن الأمور تسير على ما يرام. ومع ذلك لا نلحظ كثيرًا ونحن نستخدم كلمة فُلّ أننا نتعامل مع رائحة.
تصوير: شيماء صالح
وضعتُ علبة اللافندر في مكانها، ورائحة الليمون وروائح غيرها لكنني لم أعرف مكان علبة أو علبتين، عرفهما أصدقاؤنا الفرنسيون بكل سهولة، لأنها من أزهارِهم المعروفة. أخبرتنا مرشدتنا أن المصنع يحتفي كل عام برائحة تمثّل موضوع وشخصية السنة، وأن رائحة هذا العام هي النرجس. أسمع عن النرجس لكن لا أتذكر رائحته جيدًا، أتناول علبة النرجس وأشمها. رائحة باردة منعشة تلائم الصباحات الندية لما فيها من انبعاث وقيام، وكيف لا وزهرتها تتفتح في عيد الفصح، كما عرفتُ فيما بعد.
التعبير عن الروائح يحب المفردات الشاملة الكلية كـ”انبعاث” و”قيام” تعطي هالة من الدلالات التي يمكن للقارئ أن يهيم فيها ويشكّل ما يحلو له من معنى يتماشى وميوله الشخصية، لا يمكن الحديث عن الروائح بكلمات محددة ودقيقة، لأنها لا تستهدف الذهن بل الشعور.
تشرح لنا مرشدتنا الخطوات الأولى في صناعة العطور، وكيف تُجمع الزهور الواردة من بلدان متعدّدة وتُفرز ثم تُوضع في خزانات كبيرة بها مذيب “الهكسان” سريع التطاير، أو الإيثانول في حالة الزهور الرقيقة، لتُغسل عدة مرات كي يُستخلص منها أقصى الجزيئات العطرية، حيث يتبخّر المذيب وتظل المادة التي هي الأساس essence.
تصوير: شيماء صالح
تُغسل هذه المادة بالكحول لتخليصها من الشوائب كالشمع أو المواد الأخرى. فور غسلها، يتبخر الكحول، ويتبقى الزيت العطري الحساس.
تصوير: شيماء صالح
تُجمع خلاصة وجوهر الزيوت العطرية من لافندر، ليمون، نرجس، عنبر ومسك وغيرها، وتوضع في زجاجات وفق ترتيب معين فوق أرفف على طاولة أمام صانع العطر، الذي يسمونه “الأنف”. ولكي يكون الشخص أنفًا، عليه أن يتعلّم كيف يعمل باستخدام ذاكرته الشمية ومهاراته الكيميائية عبر ثلاث سنوات من الدراسة النظرية و7 سنوات من الممارسة. في فرنسا 10 مدارس “أنف” في جراس ، باريس ، وفرساي.
كما تقول مرشدتنا، يشبه عمل الأنف، عمل مؤلف الموسيقى، فزجاجاتُ الزيوت العطرية الخالصة مرتبة على أرفف في تشكيل هرمي من الروائح، أشبه بنوتات موسيقية، أو بمعنى آخر، نوتات عطرية: النوتة العليا ونوتة القلب والنوتة القاعدية أو الأساسية. تُعدّ النوتة العليا هي مقدمة العطر، أول ما نشمه عند الرشّة الأولى، ونوتة القلب هي ما يكشف عن حقيقة العطر وتميّزه، أما النوتة الأساسية فهي قاعدة العطر التي تتطوّر على الجلد وتفوح على مهل وتعيد من انبعاث العطر مرة أخرى بعد فترة من رشّه. كأن طاولة الأنف في تصميمها أقرب إلى آلة “الأورغن” الموسيقية، حيث يعزف عليها أعذب العطور.
تصوير: شيماء صالح
مرة أخرى، تتلاقى العطور مع الموسيقى، نفس الشعور حين تسمع الموسيقى وتشم العطر، حالة شعورية صرف بلا كلمات، كلما حاولنا التعبير عنها كلامًا انفلتت من بين أيدينا كمحاولاتِ الإمساك بالهواء، وعلى الدوام تصاحبها حالة من الاستعراض.
تماما كما تفعل الآن مرشدتنا في ختام الزيارة وهي تعرض علينا منتجات المصنع، في يدها دفتر عليه أسماء كل عطر، مقطَّع إلى أشرطة رفيعة ترشّ عليها بخات كل عطر مع اسمه بحركة سريعة ومتتالية ثم تسحب الشريط الورقي بذراعها إلى أعلى لتنشر العبير، إنها بشكل ما تقوم بعمل استعراضي، على نحو متكرر نفس المعلومات ونفس الأداءات كل يوم، كمضيفة طيران تلقي تعليمات النجاة أمام ركاب أو كموظفة الفندق عند استقبال مجاميع السيّاح، أو كممثلة مسرح.
تصوير: شيماء صالح
العطر لافت وفيه إعلان عن ذات واضعه. كأنه نداء للآخر يقول: أنا نظيف، محبّب، شهي، مبهج، غامض، حريف أو أنا سلطة، هناك أناس يضعون عطورًا نفاذة بإفراط ليفرِضوا وجودهم في هواء المكان. ورغم أنه إعلان غير حقيقي، كاذب ومزيف، ويستخدم لطمس روائح الجسم الحقيقية لكنه يملك سلطة وتأثير تستمر بحسب درجة ثبات ونفاذ العطر.
فماء الكلونيا ذو تركيز عطري يصل لـ 5٪، لا يدوم أكثر من ساعة، وهو أقل درجات العطر وتستخدم للنظافة الشخصية، يأتي بعده ماء تواليت يصل تركيزه 10 ٪ ويدوم ساعتين على الجلد، يليه ماء العطر، وهو متوسط التركيز حيث يصل جوهر العطر فيه إلى 15٪ ويدوم ثباته من 4 إلى 6 ساعات، وأخيرًا العطر، ويصل نسبة التركيز فيه من 20 ٪ إلى 30 ٪ وهذا يدوم من 6 إلى 8 ساعات.
مع استمرار فوحانه، يعطي العطر رسائل تتعلّق بالمكانة الاجتماعية، وطبيعة الشخصية، إذا يعمل كمثير للصور النمطية المتعارف عليها ضمن الطبقات الاجتماعية التي تتشكّل وفق موروث اجتماعي وثقافي، حيث ترتبط عطور وروائح معينة بمواصفات شخصية وانطباعات تتولد لدى الآخرين بحسب مقدار نفاذ وقوة العطر وهو ما يجعل لها تأثير في الدوائر الاجتماعية العامة والخاصة.
كل ذلك لأن روائح الجسم غير محبّب أن يشمها الآخرون، إنها تمثل كل مخاوفنا وقلقِنا من إطلاع الآخر على دواخلنا، لذا نضع العطر من أجل صنع ساتر أو جدار بين رائحتنا وأنوف الآخرين، إنه بشكل ما أو بآخر حماية وغطاء، وأحيانًا قناع لإخفاء الملامح الحقيقية من أجل إثارة انطباعات نمطية، للدفاع أو السيطرة.
أتشمّم الأشرطة الورقية التي وزعتها علينا مرشدة الزيارة، وأبحث عن المسك في مكونات كل عطر شممتُه داخل كتالوج صغير وزعوه علينا في أثناء الزيارة. أسأل المرشدة بعد أن فرغت من الشرح والعرض، عن وجود مسك خالص ضمن منتجات المصنع، فتخبرني أن هذا صعبٌ حيث أن العطور في فرنسا قائمة على التأليف بين مجموعة من الروائح وليس رائحة واحدة، ثم تضيف لما عرفت أنني من مصر، لديكم في مصر والشرق الأوسط جوهر الروائح والزيوت الأساسية.
تصوير: شيماء صالح
هل يعني هذا شيئًا، أو دلالة في سياق الفروق الثقافية بين العطور الشرقية والغربية؟ بمعنى أننا في الشرق أحاديو الرائحة: عود، عنبر، مسك، نرجس، فل، وغيرها، وفي الغرب خليطٌ من روائح يحمل اسم شخص أو لفظة أو عبارة كأسماء كريستيان ديور، جادور وشانيل وغيرها؟ هل لذلك علاقة بتعددية النظم الاجتماعية والسياسية في الغرب؟ وأحادية وشمولية النظم الشرقية والعربية؟ لا أدرى ولا أجد في ذلك قياسًا دقيقًا، ولكنها ملحوظة أثارت تساؤلي.
لكن إلى جانب ذلك هناك سؤال أهم يشغلني الآن وهو لماذا المسك الأبيض؟ لماذا هذا التعلّق الذي يقارب الهوس بهذا العطر تحديدًا؟ وهل يمكن تفسير ذلك بإرجاعه إلى جمال المسك نفسه؟ أم أنها عوامل أخرى أضافت على الرائحة وعلى ذكراها في رأسي طبقات من المشاعر جعلتها متخيلة بهذا الشكل الذي أتكلم عنه؟ ربما لم تكن بهذه الدرجة حين شممتها؟ وربما كانت رائحة مرطب البشرة يخلطها شيءٌ غير المسك؟ ربما أنا من صنع تلك الحالة؟ ربما هذه كانت رائحة رغبتي؟