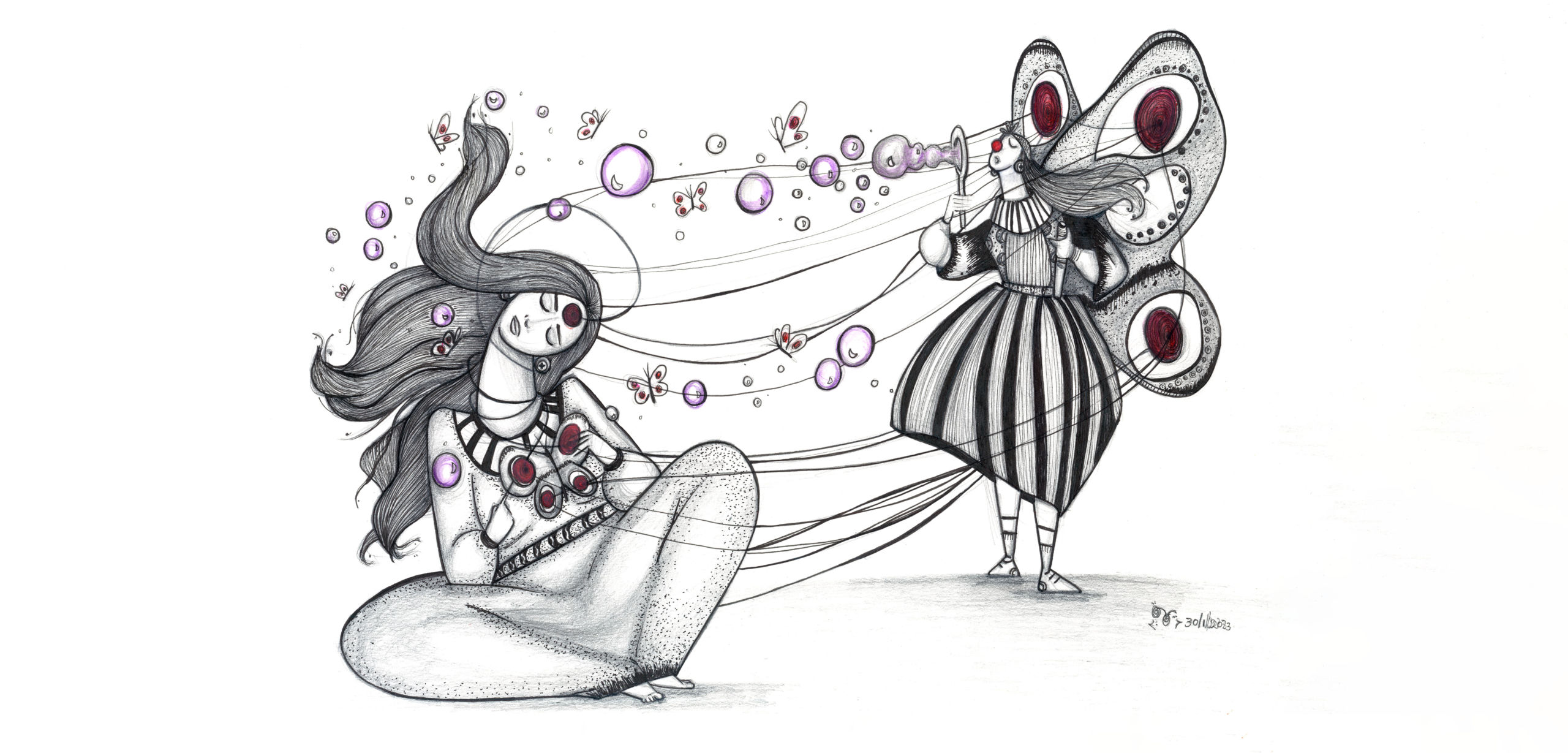في الغرفة الملحقة بمكتب الطبيب النفسي جلستْ مساعدتُه الشابة تتفرسني من خلف نظَّارتها السميكة. تسأل وتستمع إلى إجاباتي وتدون في مفكرة أمامها بعض الجمل بالإنجليزية. لم أكن متحمساً للقاء، لا معها ولا مع الطبيب. أريد أن ينتهي كل شيء بسرعة، فمائة طبيب نفسي لا يستطيعون نزع الوسواس المرضي من رأسي.
أتيت إلى هنا لأن زوجتي – بعد أكثر من عشر سنوات على رؤيتي أتخبط في هواجسي، من عيادة إلى عيادة، ومن مستشفى إلى مستشفى – انفجرت باكية في هيستيريا مرددة أن نفسيتها تحطَّمت وحياتها انتهت إلى الأبد. كانت تصرخ بحرقة: “ماذا أفعل يا ربي؟!”. وحتى أهدئها مددت يدي إلى فكرة مركونة على رف بعيد بذاكرتي، فكرة اقترحتها هي عليَّ منذ شهور، بأن أذهب إلى طبيب نفسي، فربما يكون عنده العلاج الشافي. ويبدو أنني نجحت في إلهائها فقد هدأتْ بعد قليل وأومأت برأسها بما يعني أنها ستُكمل معي الرحلة.
كنا قد جرَّبنا كل الأطباء، ذهبنا إلى عشرات من أخصائيي الباطنية، والصدر، والقلب، والدم، والمناعة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والحساسية والغدد الصماء وحتى الأسنان.. إلخ. عملت عشرات التحاليل وتعرَّضت لموجات السونار والأشعات بحثاً عن شيء غير موجود إلا في خيالي بدون فائدة. كلُّ زيارة كانت تنسيني الخاطر المزعج يوماً أو يومين، وكل زيارة تعيدني إلى التدخين باستمتاع شديد، فالأطباء يقولون إنني سليم وبإمكاني أن أبدأ حياتي كمولود جديد.
قال الطبيب: ممنوع الشكوي إلا لله أو لي شخصياً
ابتسمتْ مساعدة الطبيب النفسي ابتسامة بلا معنى. دخلت غرفته عبر باب مشترك، ثم عادت لتطلب منا الدخول. حينما طالعتُ الطبيب ارتجفت، فهذا الذي يجلس خلف المكتب ليس إنساناً، وإنما ديناصور. لا أعرف كيف وجدوا كرسياً على مقاسه. أغلب الظن أنه عملاق هارب من رحلة جاليفر في بلاد العمالقة، كما كانت عيناه حادتين مخيفتين. بمجرد أن جلست أمامه تلبَّسني هاجس بأنه يشك في سرقتي شيئاً من عيادته، لكني نفضت عن رأسي الهاجس، وقررت أن أتحداه بالنظر مباشرة في عينيه، غير أنني لم أستطع تثبيتهما أكثر من ثانية واحدة، بعدها حدقت في نقطة بجوار رأسه، ربما في كتفه أو الحائط خلفه.
شعرتْ زوجتي بارتباكي فحاولت الإجابة عن بعض أسئلته، لكنه نهرها طالباً منها عدم التدخل، وعدم الإجابة بالنيابة عني. كان تشخيص مساعدته: “وسواس مرضي”، ولم يحتج هو إلى كثيرٍ من النقاش ليكتب بعدها خمس تعليمات في روشتة بخط واضح وهو يقرؤها: “ممنوع الشكوى منذ هذه اللحظة لغير الله عز وجل أو لي شخصياً”، “ممنوع قراءة روشتات الدواء نهائياً”، “ممنوع البحث في الإنترنت عن أسباب الأمراض أو أعراضها نهائياً”، “ممنوع الذهاب إلى أي طبيب إلا بإذن خاص مني شخصياً”، “الخروج مع الأصدقاء مرة واحدة على الأقل أسبوعياً”، ثم ختم بجملة قرأها بنفس صوته العالي وإن أبطأه: “أي اختراق لهذه المحاذير ابحث فوراً عن طبيب نفسي آخر غيري”، ثم مد يده إليَّ بالورقة وهتف: “مفهوم يا حسن؟!”، وكنت أفكر في هذه اللحظة ماذا يُطعِمون هذا الطبيب الضخم في وجباته الثلاث فانتفضت بذعر حقيقي قائلاً: “مفهوم.. حاضر!”.
كان هذا مجرد فصل جديد من فصول التردد على العيادات. حاولت بكل الطرق مواجهة الوسواس لكنه كان أقوى مني، ربما لأن هناك أعراضاً مرضية حقيقية تصيبني، مثل ضبابية الرؤية لفترة طويلة، أو التنميل في ساقي، أو ذراعي، لكن متى بدأ الوسواس يحاصرني؟ أظن مبكراً جداً. عبد الناصر علام شاعر العامية المصري الراحل، كان أستاذاً لي في المدرسة الإعدادية ثم صار صديقي المقرَّب بعد أن كبرت قليلاً. كتب قصيدة عن شلة أصدقائه وتناولني فيها من زاوية الهاجس المرضي.
أول رسم قلب في حياتي
في تلك الفترة شعرت بنغزات في صدري وآلام في بطني، مع عدم رغبة في تناول الطعام، وتعرضت لأول رسم قلب لي في حياتي. ورغم أن الطبيب طمأن أمي إلا أنها ذهبت بي إلى عيادة أستاذ أمراض باطنية يأتي من محافظة أسيوط إلى مدينتنا نجع حمادي في صعيد مصر مرة واحدة في الأسبوع، كانت الفيزيتا الخاصة به أضعاف فيزيتا الأطباء الآخرين. في عيادته تعرضت – أول مرة – للسونار.
كنت خائفاً، وتخيلت أنه سيغرس إبرة في بطني لكنه طمأنني بأن الأمر بسيط، ووضع المادة الهلامية على بطني وقال لي ضاحكاً: “الكبد عندك مثل الجنيه الذهب”، ثم: “تمام يا بطل.. قولونك عصبي”، وسألته إن كانت هناك خطورة فقال لي بنفس نبرته الضاحكة: “لن تتزوج للأسف!” فصدقته. فكرت قليلاً، وقررت أنه لا مشكلة في عدم الزواج. عدت لأسأله إن كان بإمكاني إجراء عملية للقولون لأنتهي منه نهائياً، فانفجر مقهقهاً، وقال لي: “لو كانت هناك عملية تُجرى للقولون لكان كل الناس الموجودين في العيادة مستريحين الآن”.
كان الهاجس يأتيني فجأة، بدون مقدمات. وربما ساهمت مجلة “طبيبك الخاص” في تربيته وتسمينه حتى صار غولاً يلتهمني. قرأت فيها مرة إن واحداً من أعراض مشاكل الكُلى هو تضخم القدم، وصرت بمجرد استيقاظي أطالع قدمي، ثم أذهب إلى أمي وأسألها إن كانت طبيعية أم تلاحظ أنها متورمة؟ تطمئنني إلا أنني أعود لمراقبة قدمي مرة واثنتين وألفاً، ثم أقرر بعد يومين أو ثلاثة أنها متورمة.
أذهب إلى مستشفى “الوعي الإسلامي” من وراء أمي بعد أن أكون قد اختلست قليلاً من مال طلبات البيت. تطالعني طبيبة المعمل بدهشة. تبدي استغرابها حينما أطلب منها عمل تحليل وظائف كُلى، تقول لي: “أنت صغير على هذا الكلام، يبدو أن معك مالاً تريد أن تصرفه”، لكني أصرُّ فتمتثل. تطلب مني العودة بعد ساعات أو يوم لا أتذكر. أذهب في الموعد فتمنحني ورقة وتقول إن التحليل ممتاز.
كان الهاجس يأتيني فجأة، بدون مقدمات. وربما ساهمت مجلة “طبيبك الخاص” في تربيته وتسمينه حتى صار غولاً يلتهمني. قرأت فيها مرة إن واحداً من أعراض مشاكل الكُلى هو تضخم القدم، وصرت بمجرد استيقاظي أطالع قدمي، ثم أذهب إلى أمي وأسألها إن كانت طبيعية أم تلاحظ أنها متورمة؟ تطمئنني إلا أنني أعود لمراقبة قدمي مرة واثنتين وألفاً، ثم أقرر بعد يومين أو ثلاثة أنها متورمة ..
وكنت أعرف أن الهالات السوداء تحت العينين مرتبطة بكثير من الأمراض فأقف أمام المرآة كثيراً لأطالع وجهي، لكن أمي كانت تخوِّفني بالجن في المرآة وبأنه قد يسحبني إلى عالمه إن لم أتوقف. تنجح حيلتها، فأستعيض عن المرآة بأخوتي. أسألهم إن كانت هناك هالات سوداء حول عينيَّ. وكنت إذا لعبت الكرة حافياً في الشارع وجُرحت أذهب من تلقاء نفسي إلى المستوصف لأحصل على حقنة “تيتانوس”. وحينما لاحظ أبي ولعي بالدواء أحضر لي صيدلية. صندوق خشبي صغير جداً مطلي بالأبيض وله (باب جرَّاي) لأضع فيه مستلزماتي الطبية، وهي في الزمن القديم: القطن والشاش والميكركروم والسلفا والبلاستر وأحياناً مرهم التيراميسين وبعض قطرات العيون والأنف. كنت أصطحب بعض رفقاء اللعب إلى البيت لأطهِّر جروحهم أحياناً، فاعتبروني طبيب الفريق.
ورغم أنني كنت أفكر في كل الأمراض إلا أن البلهارسيا لم تخطر ببالي أبداً. كنت أحمل حذائي تحت إبطي وأسير على شاطي النيل، وحينما ألمح فأراً أتناول حصاة من المياه وأصوبه على رأسه، كما كنت أتزلج على الطين في مواسم الأمطار، وأخوض في برك الخراء لانتشال الكرة إذا ركلها أحدنا بالخطأ إلى هناك، واكتشفت إصابتي بالبلهارسيا بالصدفة، ومنذ تلك اللحظة شعرت بأن الله يرعاني.
ذهبت لإحضار ماكينة بسكويت لأمي من إحدى صديقاتها في شارع قريب فهجم عليَّ كلب بغتة وعقرني في فخذي، وأبي بدلاً من أن يطمئن عليَّ صفعني بالقلم واتهمني بأنني ضايقت الكلب. قال لي: “أنت ابني وأنا أعرفك ولا يمكن للكلب أن يؤذيك إلا إن كنت آذيته”، وفي اليوم التالي اصطحبني إلى المستشفى الأميري على حدود نجع حمادي. وقفنا في طابور طويل متعرِّج يبدأ من خارج المستشفى، يقف فيه عشرات المعقورين، وحينما دخلنا إلى الطبيبة انهمكا في حوار قصير، بدأته هي بسؤال عن الكلب وإن كان مسعوراً. بينما انشغلتُ بمطالعة قنِّيناتٍ داكنة على كل منها رسمة ثعبان. كنت أشعر برعب بالغ، فقد فهمت من كلام الناس بالخارج أن المصل يُحقن في البطن، وتخيلت أن الإبرة تُغرس مباشرة وبشكل عمودي. أي ألم؟!
طلبت مني الطبيبة التمدد على سرير الكشف الصغير. تسارعت نبضات قلبي وأنا أراها تحضِّر حقنة المصل. كدت أنفجر في البكاء لكنني تماسكت بالكاد. رأيتها تمسك بجلدِ بطني وتغرس الإبرة بشكل أفقي. لم أشعر بألم وحينما سحبتْ الإبرة انتابتني سعادة بالغة، ولم أبال حينما طلبت مني المرور عليها يومياً لمدة عشرين يوماً أخرى.
هيا لنفحص البلهارسيا
في اليوم التالي قابلت أحد رفاق اللعب متجهاً إلى نفس المستشفى ليجري فحص البلهارسيا. شعرتُ بالبهجة فذلك الرفيق سيهوِّن عليَّ مشقة الطريق. هناك اقترح عليَّ أن أجري الفحص أيضاً، وسألني حينما رأى التردد في عينيَّ: “ماذا تخسر؟!”. أجريته، وظهرت النتيجة سريعاً، صديقي سلبي، وأنا مصاب بالبلهارسيا. وزنوني ومنحوني ثلاثة أو أربعة أقراص، وبعد قليل سرت مترنحاً من هول تأثيرها.
في فترة الجامعة لم أتحمل الغربة، مع ملاحظة أن المسافة بين مدينة قنا حيث كليتي (التربية) ومدينتي نجع حمادي أقل من ساعة بالسيارة. كنت كاليتيم. زاد وجودي بالمدينة الجامعية – بعيداً عن أمي – من الوسواس المرضي. كنت أركز في صوت نبضاتي قبل النوم، وانتقالها من يدي أو رقبتي إلى الفراش، فأشعر بالاختناق وبأنني ما إن أغلق عيني حتى أموت. كان هاجس الموت يسيطر عليَّ، فأستدعي حكايات الناس عن الموت -أثناء النوم- إما بسبب أزمة قلبية، أو لأسباب غامضة لم يكتشفها الطب فيما بعد. (بعد ثلاثين عاماً سأضيف إلى قائمة مسببات الموت المفاجئ عدم تحمل الجلوتين).
وفي إحدى الليالي أصبتُ برعشة وهذيان وبدأت أرددُ بصوت عالٍ أنني سأموت فاستيقظ رفاقي بالغرفة هلعين. أنزلوني من سريري العلوي، ووضع أحدهم يده على رأسي وبدأ في تلاوة القرآن فهدأت. قررت منذ العام الثاني لي في الدراسة ألا أمكث في المدينة الجامعية وأن أذهب إلى الكلية بالسيارة. لا أريد أن أموت بعيداً عن أمي. كنت إذا أغمضت عينيَّ أقرأ الشهادتين، ثم أقول لنفسي إن الحياة جميلة وإنها تستحق أن تُعاش، وأدعو الله أن يطيل في عمري قليلاً. أستدعي أي موضوع أو فكرة، كالزواج مثلاً، أتخيل امرأة جميلة –ستصبح حبيبتي يوماً ما– أجمل من بنات الجامعة والجيران ومدينة نجع حمادي، وأتخيل أنني سأنجب فتاة، وأنني سأعاملها بشكل أفضل من معاملة أبي لي. كان قاسياً جداً، لأنه اعتقد أن القسوة ستجعل مني رجلاً، ولا ألومه، وأتذكره بمحبة. كنت أتخيل في تلك الأيام –مغمضاً عينيَّ– ابنتي وأنا أحملها وألاعبها وأضاحكها، ولا أنام إلا حين أهدأ وتنسيني صورتها فكرة الموت لسبب طبي غامض.
خطــ٣٠ // رسم إسراء صمادي
الوسواس داخل مدينة القاهرة
جئت إلى القاهرة سنة 1998، وهو عام تخرجي، لأعمل وأشق طريقي في مدينة أحببتها من بعيد، من الروايات والحكايات وأفلام الأبيض والأسود. وجدت في القاهرة ملعبي المفضل. إنها كوكب الأطباء. هنا مليون طبيب وعيادة ومستشفى وتخصص، صرت كالنحلة التي وجدت نفسها فجأة بعد بحث مضنٍ في حقل أزهار، أو كأسد وُضع في حديقة غزلان مسوَّرة. أنستني محاولة الصعود الوظيفي ومحاولة إثبات الذات في الصحافة الثقافية وسواسي المرضي قليلاً في البداية، وبعد استقراري برز الوسواس بأسوأ شكل ممكن. كنت أقطن وقتها في الطابق الواحد والعشرين من برج شاهق على بعد عدة طوابق من الشمس.
الحكاية في القاهرة بدأت بما يشبه “الحِيل” تحت إبطي، مع ألم كالوخز، يختفي إذا تعرض لبرودة التكييف. ذهبت إلى الطبيب فقال ساخراً: “ما هذا المرض الطبقي الذي يختفي مع هواء التكييف؟!” وأخبرني أنه لا يوجد شيء وأن أنسى الموضوع، لكنني لم أنس طبعاً. كنت أشاهد الناس في المترو سعداء، وأسأل نفسي: “هل يشعرون مثلي بوخز تحت الإبط ولماذا أنا بالذات دوناً عن هؤلاء جميعاً؟”.
كما صار “أنفي” بطلاً مستمراً معي، فأنا سليل أسرة عتيدة في الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية. بدأت السلم من أوله، حتى من قبل توصل الطب إلى بخاخات ماء البحر. لم يكن هناك سوى أكياس الملح الأبيض. أذيبها في المياه وأستنشقها، حتى تحمر عيناي وتصبحان على وشك القفز من رأسي لتلتصقا بالمرآة أمامي. منحني الطبيب ذات يوم حقنة كورتيزون وأخبرني ألا أكررها أبداً مدى الحياة. بالغ في تأكيده حتى لا أستسهل العودة إليها. كانت هذه الحقنة سبباً في سعادة نادرة، منحتني قوة وأشعرتني بأن في إمكاني هدم حائط بقبضة يدي. صرت قوياً لأسبوع أو أكثر، سعيداً كأنما امتلكت الصحة في أقوى تجلياتها، واثقاً من التغلب على وسواسي. لكن كانت كل هذه التفاصيل مجرد شخبطات في الصفحة الأولى من كراسة الوسواس داخل مدينة القاهرة.
لاحظت أنه، أي وسواسي المرضي، يؤاخي وسواساً قهرياً داخلي. حيث أدخل إلى المطبخ مراراً وتكراراً للتأكد من إغلاق محبس أنبوبة البوتاجاز، فلا أريد أن أموت مختنقاً بالغاز، لكن المشكلة أنني كنت أقضي قرابة الساعة في وضع فردة الحذاء اليمنى بموازاة اليسرى بالضبط. إذا شعرت بأن واحدة تسبق الأخرى بملليمتر واحد لا يهدأ لي بال حتى أطمئن إلى وقوفهما كندَّين، الرأس في الرأس بالشعرة. أيضاً أدور على الطاولات الخشبية بحثاً عن العملات المعدنية، أتأكد من قلْبِها بحيث تستقر صورة “الملك” من أسفل و“الكتابة” من أعلى. وإذا أهملتُ عملةَ بدون قصد ورأيتُها بالصدفة في اليوم التالي ينتابني خوف غامض رغم قيامي بدفن الملك بمجرد أن تقع في يدي. وقس على هذا كثيراً من التفاصيل الأخرى، كوضع فرشة الأسنان، ومن أين أبدأ تجفيف جسدي بعد الاستحمام، إلخ. لو قدر لأحد أن يسجل ما أفعله بالكاميرا سيحصل على فيلم لشخص مجنون ومهووس بعلاقته مع أشيائه الخاصة شديدة التفاهة.
البحث عن الأمراض في جوجل
أثناء تنقلي من طبيب إلى طبيب ارتحت إلى الدكتور طارق يوسف. تحول إلى صديق لي بمرور السنوات، وهو لسبب ما محبوب من الفنانين. قابلت عنده الراحل محمود عبد العزيز، وعمرو دياب وطارق لطفي وكثيرين غيرهم. يمتلك طارق – طبيب القلب والأمراض الباطنية – بالاً واسعاً، وكوَّن عني فكرة شبيهة بفكرة الطبيب النفسي، لكنه لكي يريحني كان يفعل ما أطلبه منه. ويضطر للرد عليَّ في أي وقت أطلبه، صباحاً أو مساء أو حتى في أوقات النوم. في العيادة أو الشارع أو السيارة أو حتى في غرفة العمليات، لأنني أعيد الاتصال به بدون كلل. يأتيني صوته وهو يطلب مني أن أتحدث بسرعة لأن هناك بطناً مفتوحاً تحت يده. ومرة قال لي إنني سأتسبب في طلاقه لأنه لا تحلو لي مكالمته سوى في العطلات. كان يردد دائماً: “كف يا حسن عن التفكير. لست مصاباً بشيء، لديك قولون مزمن يلعب بعقلك، ويجب أن تهدأ ليهدأ”.
ومرة حكي لي أنني لست الشخص الأكثر جنوناً وإنما الثاني في اللائحة. اندهشت وشعرت بالفضول لمعرفة هوية الشخص الآخر، فحكى لي طارق أنه كان في هولندا لحضور مؤتمر طبي، وحين وصل إلى الفندق وجد اسمه على شاشة معلقة في المكان. أخبرتْه إدارة الفندق أن هناك شخصاً اتصل وسأل عنه أكثر من خمس مرات وطلب أن تتصل به للضرورة. استغرب طارق حينما عرف اسمه كيف توصل إلى مكانه في هولندا. كان قلقاً فاتصالٌ مثل هذا يعني أن هناك مصيبة. اتصل به فعلاً وسأله: “ماذا هناك؟”، فقال الآخر بهدوء: “لا شيء يا دكتور، أردت أن أطمئن أنني أستطيع الوصول إليك في أي مكان بالعالم، وقد عرَّفني الموظف في عيادتك أنك في هولندا، وأنا تصرفت. عرفت من خلال أصدقاء في المطار رقم رحلتك واستطعت أن أتوصل إلى الفندق الذي تقيم فيه”!
لاحظت أن وسواسي المرضي، يؤاخي وسواساً قهرياً داخلي. حيث أدخل إلى المطبخ مراراً وتكراراً للتأكد من إغلاق محبس أنبوبة البوتاجاز، فلا أريد أن أموت مختنقاً بالغاز … وأدور على الطاولات الخشبية بحثاً عن العملات المعدنية، أتأكد من قلْبِها بحيث تستقر صورة “الملك” من أسفل و“الكتابة” من أعلى. وإذا أهملتُ عملةَ بدون قصد ورأيتُها بالصدفة في اليوم التالي ينتابني خوف غامض رغم قيامي بدفن الملك بمجرد أن تقع في يدي
كنت أذهب إلى طارق لا لأحكي له الأعراض، وإنما لأخبره بأنني مصاب بمرض معين. أستفيض في شرح الأسباب التي أدت بي إلى استنتاجه. فأنا أدخل على المواقع الطبية. صرت مدمناً لها، وأعرف بعض محرريها وأطبائها وأيضاً القراء الدائمين لها. أبحث عن الأعراض. أكتب مثلاً: أسباب العيون الدامعة، أو: أعراض إفراط هرمون الغدة الجار درقية، أو: أعراض التسمم بفيتامين D أو: أمراض خطيرة تشير إليها الحكة في باطن القدم، أو: ماذا يعني تنميل القدين والساقين؟ أو: أعراض الذبحة الصدرية، وطبعاً كل أنواع السرطانات، ومعنى تسمُّر الجلد (اسمرار الجلد في الذراعين) وأعراض جرثومة المعدة وداء السكري وتسمم الدم وانفصال الشبكية وأسباب تورم الغدد الليمفاوية أسفل الرقبة ومشاكل الحالب وتضخم البروستاتا إلخ، وفي إحدى المرات قلت له بخوف إنني مصاب بداء باركيسون فانفجر في الضحك. انتظرت أن ينتهي من ضحكه وقلت له: “أنا عندي كل الأعراض، رعشة في كفي، وعدم تركيز. حركتي بطيئة ولا أستطيع إنجاز الأعمال. لا أستطيع النهوض من السرير أو الكرسي، كما أن عضلاتي متيبسة، وأتلعثم حينما أتكلم”. تبادل طارق النظرات الضاحكة مع زوجتي وسألها: “ما آخر شهر ذهبتم فيه إلى مصيف؟”.
غذَّى طارق وسواسي دون أن يدري أحياناً. حكى لي مثلاً أن الفنان محمود عبد العزيز خلع ضرسه فاكتشف الطبيب أسفله سرطاناً، وبالتالي غبت عنه شهراً أو اثنين قضيتهما في فحوص بعيادة أسنان. كما كان يحكي لي عن أغنياء ينظفون قولونهم كل عام من خلال حقنة شرجية، فيتحول تركيزي بالكامل إلى القولون. قال لي مرة: “أنا وصفت لك كل أدوية القولون، وإن لم توقف عقلك فلن تجدي معك نفعاً. ارحم نفسك يا حسن وارحمنا معك”. ساءت حالتي في فترة ما، وشككت في الطعام، وقررت أن هناك مصيبة في القولون. حاول أن يثنيني عما أفكر به، لكنني أصررت على إجراء الفحوص، وتنقلت من غرفة السونار إلى غرفة الأشعة المقطعية إلى غرفة العمليات لأول مرة في حياتي. طلبت منه إجراء تنظير للقولون فوافق بعد أن رآني على وشك الانهيار. أخذت شربة أكثر من مرة لمدة يوم كامل أعادتني طفلاً مولوداً بمعدة خاوية وأمعاء نظيفة، ولازمتني زوجتي كظلي. كنت أراها طوال الطريق من البيت إلى المستشفى تتمتم بالأدعية. شعرت بأنها ملاكي الحارس رغم أن خوفها عليَّ يغادرها، كلما قال الأطباء إنني سليم، وتبدأ وصلة تهديد بأنها ستترك البيت بلا رجعة إن عدت إلى سيرة الأطباء.
استغرقت العملية أقل من خمس دقائق وجاءني طارق مبتسماً في حنو، واكتشفت أن صديقي محمد شعير في الغرفة ولا أدري كيف وصل إلى هنا. طمأنني طارق أن كل شيء على ما يرام وأنني يجب أن أقضي على الوسواس لمدة عشر سنوات. وأخبرني أنه أخذ خزعتين من القولون والأمعاء الدقيقة للفحص “الباثولوجي” فانهرت واتهمته هو وزوجتي ومحمد شعير بأنهم يخبئون عني شيئاً وإلا فلماذا أخذ مني عينتيْن؟ ولأول مرة أشاهد طارق غاضباً. تمتم بما معناه أنه لا يسمح بالتشكيك في أخلاقه المهنية، وأنه لا يُخفي شيئاً عن أي مريض ويجب أن أصدق أنه لا شيء يستدعي القلق. ظللت أربعة أيام على أعصابي في انتظار ظهور نتيجة الباثولوجي، وحينما وصلتنا على الواتساب أصابتني رجفة مزلزِلة مستمرة، لكني أرسلتُ الورقة إلى طارق، واتصلتُ به فركن سيارته وبدأ يقرأ وطمأنني بأن كل شيء نظيف.
التثدي بعد الأربعين
وبسبب أنواع من الأدوية النفسية وأدوية القولون كـ”دوجماتيل” كبر ثديي الأيسر. انتابني الخوف خاصة مع وجود شيء ناشف أشعر به بمجرد اللمس. قال لي طارق إن التثدي من الأمور العادية بعد أن يتجاوز الرجل عامه الأربعين، وإن أطباء التجميل يعتبرونها “بيزنس” ويقنعون الأغنياء – على عكس الحقيقة – بأن الجراحة أفضل من الأدوية، ونصحني لمزيد من الاطمئنان بأن أجري سوناراً على هذه المنطقة. أرسلني إلى صديق له يشبه أينشتاتين، قال لي بعد الكشف إن الورم بنسبة تسعة وتسعين بالمائة حميد لكنَّ هناك خطاً أسود ضعيف جداً لا يتجاوز مليمترات يتحرك بمفرده بعيداً عن الورم ولا أفهمه، والأفضل أن تتعرض لفحص الماموجرام. ولم أنتبه بينما أنا غارق في خوفي أنه بدأ يضع الجهاز على بطني ومثانتي ثم صاح: “ما كل هذه البروستاتا؟!”، وطالعني وجه مساعدته وهي بالكاد تحاول ابتلاع ضحكتها قبل أن تنفجر. كنت أقول لنفسي في هذه اللحظة: “هذا ما ينقصني، أنهيت كل فحوصات الذكورة وصار عليَّ أن أبدأ فحوصات الأنوثة”.
حددوا لنا موعداً في مركز للأشعة بعد أيام ظللت خلالها مكتئباً لا أقرب الطعام، وفي اليوم المشهود طلبوا مني أن أخلع كل ملابسي باستثناء شورت وأوقفوني أمام الجهاز الضخم. طلب مني الرجل وضع ثديي الأيسر داخل فجوة ثم حرَّك الجهاز بطريقة معينة فأطبق على ثديي كالفخ. كدت أصرخ من الألم. فهمت – في هذه اللحظة – أن ما كنت أتخيله فحصاً روتينياً للمرأة يمكن أن يسبب لها هذا الألم الفظيع. استمر الطبيب أمام الجهاز وطلب مني ألا أتحرك، حتى قال لي أخيراً: “اطمئن لا شيء يدعو للقلق” فحررت ثديي من الجهاز وسجدت عارياً لله.
تسبب نفس طبيب السونار في إرعابي مرة أخرى بعد أن أصابتني جرثومة المعدة، قال لي إنني تعرضت لخربشات منها جعلت جدار المعدة سميكاً، وطلب مني أن أزوره بعد شهر أو شهر ونصف، وحينما وقع الكشف عليَّ قال بلامبالاة إن الأمر صار على ما يرام، وقد عاد جدار المعدة إلى طبيعته. وحينما طلب مني طارق أن أذهب إليه مرة ثالثة قلت له: “كله إلا هذا الرجل”. حكيت له ما فعله معي فضحك وقال: “هو شخص لطيف لكنه يحب إرعاب الناس، ويوهمهم جميعاً بأنهم مرضى بسرطان المعدة، فقد أصيبت أمه به وماتت بسببه”، فضحكنا.
وسوس، اقرأ، واستمتع
وفي بدايات كورونا كنا نجلس أنا وزوجتي بترمومتر الحرارة، أقيس درجة حرارتي ثم تنزعه من يدي وتقيس درجة حرارتها، وأنزعه من يدها وأقيس درجة حرارتي، وهكذا، حتى مطلع الفجر. أصبح الوسواس المرضي قاصراً على الفيروس الجديد، ورفض طارق استقبال أي مريض في عيادته. كان يقف في بلكونتها المطلة على شارع أحمد عرابي بضاحية المهندسين، يكشف على الناس من أعلى.
شاهدت المرضى يقفون في طابور قصير، حينما يأتي الدور على أحدهم ينقل إليه أوجاعه بصوت عال، وكان مساعده يلقي بالروشتة من الطابق الأول بعد أن يقبض عليها بمشبك خشبي فتصير ثقيلة، وفي فترة لاحقة صار يكشف علينا من خلال تطبيق “زوم” حتى عادت الحياة إلى عاديتها، وعاد وسواسي إلى طبيعته، الوسواس الذي لا يتوقف عن التحور والتشكل والتجريب والإبداع ومفاجأتي بكل ما هو جديد.
يأتي من نقطة بعيدة في ذاكرتي. يتحدث بصوته الهامس ربما لكي لا ينبه زوجتي إلى وجوده: هذا الوخز في ذراعك ليس عادياً، يجب أن تتحرَّى عنه، هو شيء ليس ضخماً عموماً، كل ما عليك فقط هو أن تفتح موقعك الطبي المفضل، أمسك بالتليفون من فضلك، اضغط على نافذة جديدة. زوجتك تتابع التلفزيون، لن تنتبه إليك، لا تقلق، لو نظرت ناحيتك، لو سألتك كعادتها: ماذا تقرأ؟! قل لها: أخبار عن الأهلي أو المنتخب. أو قل لها إنك تتسلى كعادتك بمطالعة صور ابنتك. اجلس بشكل عادي حتى لا تشك فيك. انس الطبيب النفسي. هل تثق في شخص ساوى نفسه بالذات الإلهية؟ ماذا يعني قوله: “ممنوع الشكوى إلا لله عز وجل أو لي شخصياً”؟ لقد أراح نفسه وجعلك تدفن عقلك بالمهدئات. نعم.. حان وقت حبَّة “الزولام” الآن، أعرف يا سيدي، لكن يمكنها أن تنتظر نصف ساعة أخرى أو حتى ساعة. بل لا ضير أن تسقطها الليلة. صدقني لن يحدث شيء.
هيا عد إلى لعبتنا المفضلة واطمئن على نفسك. لماذا أنت بطيء في رد فعلك؟ أين حماسك القديم؟ أنت فتحت جوجل فلماذا لا تكتب: أسباب الوخزات في الذراع؟ أنا لا أقصد ما يدور في عقلك الآن؟ لا أقصد شيئاً مخيفاً، لا أفكر في الذبحة الصدرية. إنما في شيء عادي، لكنه قد يتحول إلى شيء خطير لو أهملناه، صدقني. هل كذبت عليك أبداً؟ ماذا ستفعل؟ ولماذا لا ترد عليَّ؟! لقد بدأت تتململ في جلستك. ويبدو أن الحماس بدأ يدب فيك. هذا هو صديقي الذي أعرفه أخيراً. نعم.. نعم. أنا قلت “أسباب” وأنت كتبت “أعراض“. لا مشكلة في استخدام تعبيراتك الخاصة. إنه تعبير أفضل. أنت أديب حقيقي. نعم.. أعراض الذبحة الصدرية. ممتاز يا صديقي. اقرأ الآن واستمتع.