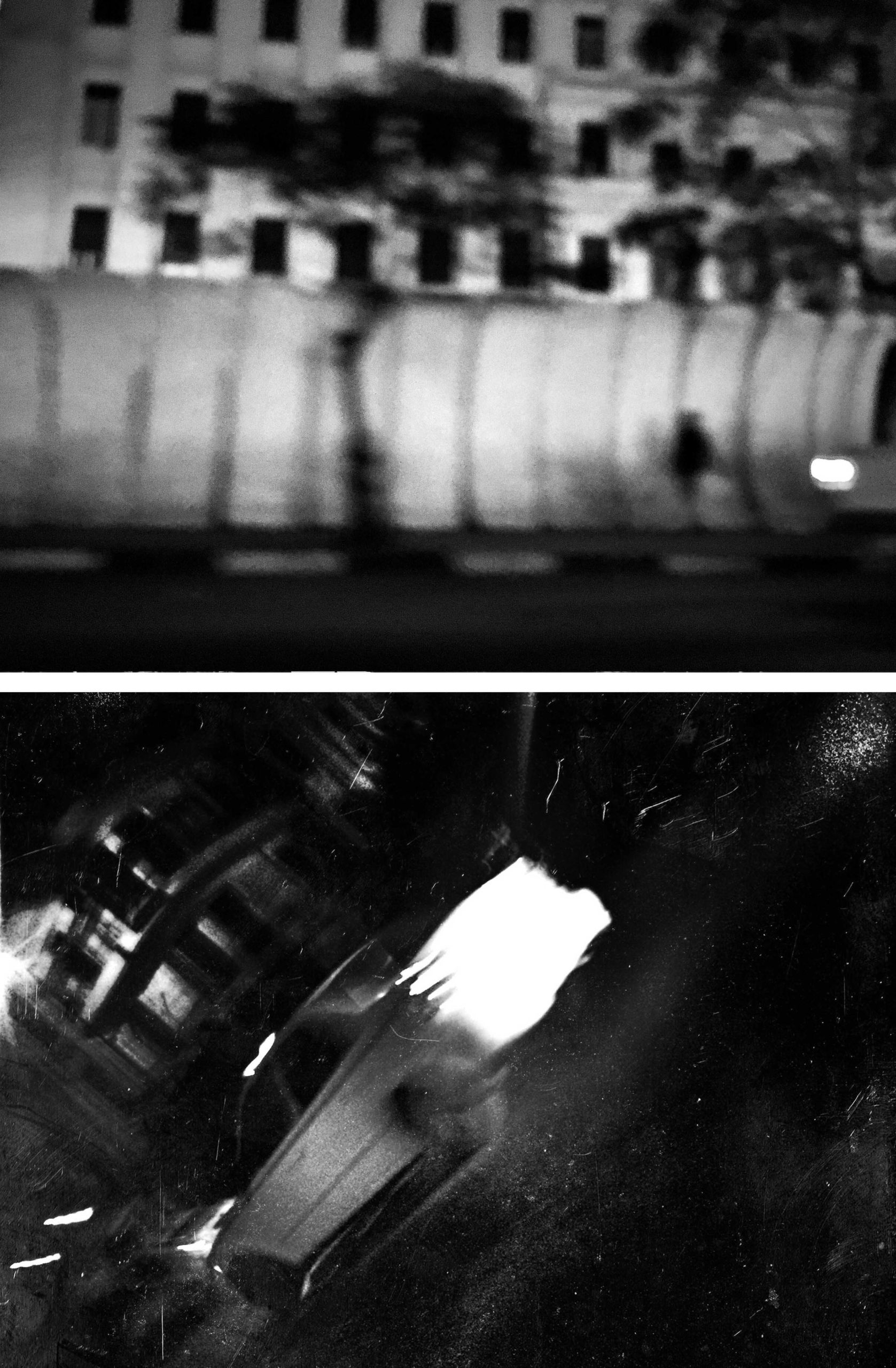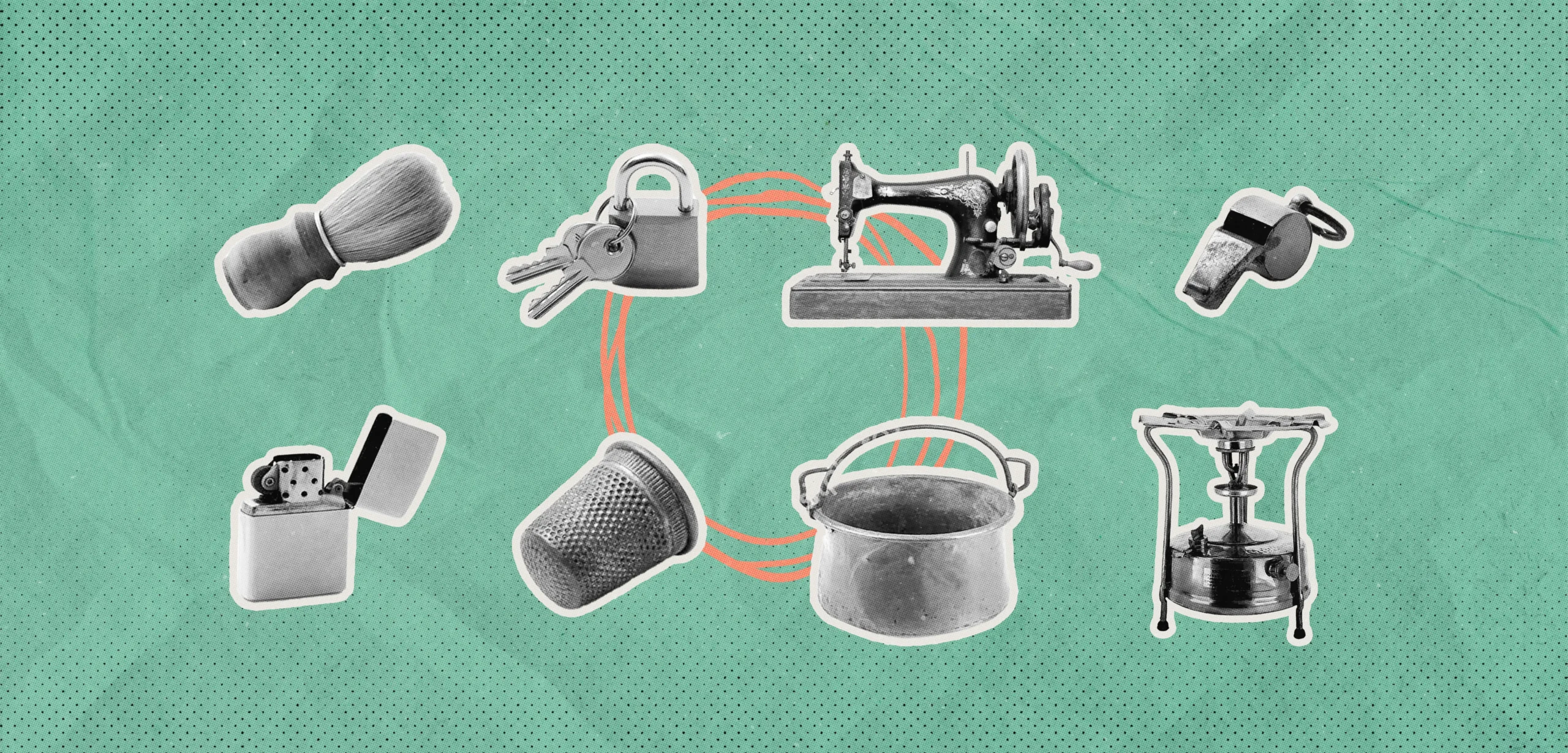لم يكن التصوير من داخل السيارة اختيارًا جماليًا في البداية. لم يكن قرارًا مسبقًا. فالصور المأخوذ معظمها بالتليفون من مقعد السائق أُخذت بهذا الشكل ليس فقط تحاشيًا للمواطن الشريف المرتاب في أي شخص يحمل كاميرا – الجاهز لاتهامه بالخيانة العظمى قبل أن يسأل ما هو الشيء الذي يتجسس عليه، أو لصالح أي عدو: منذ 2011 على الأقل وأنا واع بخطورة اللامنطق الذي يحركه التصوير في شوارع القاهرة لدى الناس والسلطات على حد سواء– ولكن أيضًا، وببساطة، تمريرًا للوقت في الزحام.
يُمكن التمييز بين توجّهين عموميين في استخدام الكاميرا أولهما – الأوسع انتشارًا – هو «الموضوعي». أنْ تذهب إلى موضوع ما موجود في الواقع وتنظر إليه “كما هو” بهدف توثيقه بصريًا. هذه الـ كما هو طبعًا تعني إيجاد إضاءة وافرة وجذابة، ثم استعمال فتحة عدسة ضيقة وسرعة غالق عدسة عالية ما لم تكن الكاميرا ثابتة. تعني تكييف خبرة النظر على ما يجعل الموضوع ليس فقط مضيئًا وجليًا بلا تشوّش وفي الغالب كذلك “جميلًا” بالمعانى المتعارف عليها ولكن أيضًا كما تريد له أن يبدو. التوجه الذي أتلاقى معه، على العكس، هو “الذاتي” الذي لا يقصد نَظَرًا متعمد إلى الواقع بقدر ما يجعل الكاميرا شريكًا في رؤية تحدث رغمًا عن الرائي. التصوير بهذا المعنى يعتمد بدرجة أكبر كثيرًا على الصدفة، ويستوعب مِزاج المصور ورغباته المختبئة المتأرجحة.
لم يكن التصوير أثناء القيادة اختيارًا جماليًا لكنه لم يكن بعيدًا عن جماليات الفوتوغرافيا التي أمارسها منذ بدأت، والتي تبحث عن ظرف غير موات: مشهد ليلي بدون فلاش، انعكاس على سطح مضبب، جسد جعلته الحركة بلا معالم، أو ضوء ضعيف يسيطر على مشهد متحوّل. فتحة العدسة واسعة وسرعة غالق العدسة بطيئة لأن الضوء – الآتي من الزاوية الخطأ أصلًا – غير كافٍ. أريد أن أحتفظ بشيء من خلل وخصوصية خبرتي البصرية المباشرة ليس فقط بالمكان ولكن بالزمن كذلك. ومن وسط ما أريد أو أحتاج أن أراه، أعيد اختراع تلك المساحة المرهونة بلامنطق العجل الدائر على الأسفلت كمكان مليء بالسر والإثارة: بداية الرعب التي يعرّف بها ريلكه الجمال في أشهر أبياته. قاهرة الكياروسكورو والغبش والأشباح الطائرة مدينة جميلة، لكنه جمال لا يكاد يتضح ما لم تعثر عليه عين أنهكها قبح ملازم.
هكذا تقلني سيارتي بما لها من سرعة وما فيها من زجاج ومرايا عبر ستوديو تصوير معد لالتقاط أحلام ليست وردية بالضبط، لكنها على الأقل أجمل وأجدى من كوابيس المدينة.