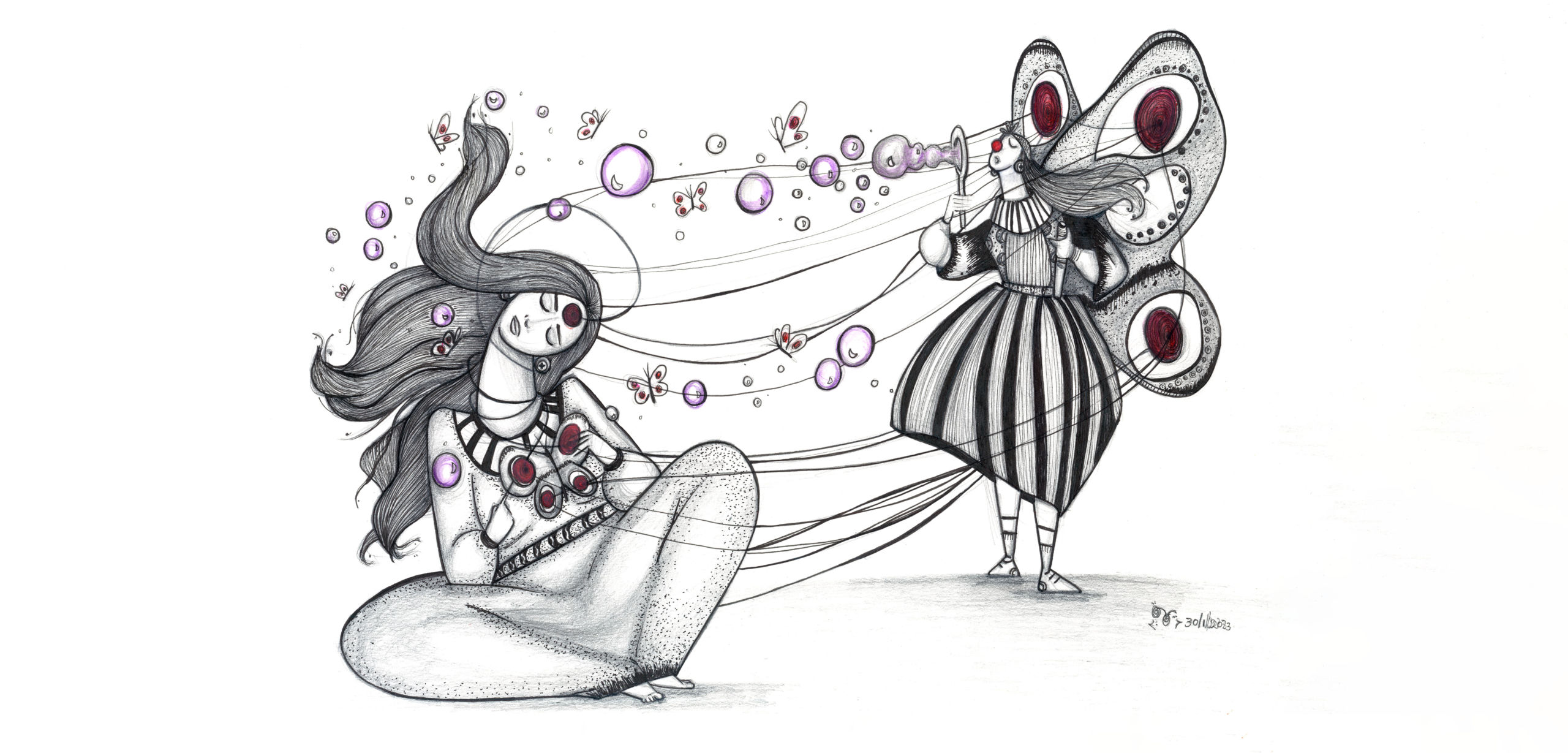لطالما اعتبرتُ فيلم “إنلاند“، الذي أخرجه طارق تقية (يُنطق “طريق”) سنة 2008 فيلماً بوصلة. عنوانه في حدّ ذاته اتّجاه، بالعربية: القِبلة من القبلي وهو عكس البحري. البحر هنا يعني الشمال والقبلة هي الجنوب.
“قبلة” رحلة عكسية لجزائري، يعمل في شركة مدّ خطوط الكهرباء، يتوغّل في “الجزائر العميقة”، ما بعد الحرب الأهلية، “العميقة” كما كانت تسمّى قبل 2019 والتي صارت تُسمى اليوم، في جزائر ما بعد الحراك، بـ “جزائر مناطق الظل”.
في إحدى مشاهد الفيلم، نرى شخصيتين هامشيتين تمشيان وسط الصحراء، ويصرخ أحدهما (وهو فتحي غرّاس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي يقبع في السجن منذ جوان 2021 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية) في صاحبه الذي يسأله لماذا نمشي؟ يقول: “المشي ثورة.. المشي يحرّرني.”
في الفيلم اللاحق لطريق تقية، “ثورة الزنج” (2013)، يلعب فتحي دور البطل، صحفي يطارد أحلامه وأوهامه في مدن المتوسط وقد اشتعلت بثورات 2011.. من جنوب الجزائر إلى بيروت فبغداد فالقاهرة مرورًا باليونان. أخ طريق، ياسين تقية، وشريكه في كتابة بعض أفلامه وإنتاجها، هو كادر في نفس حزب فتحي، لذلك نجد طريق يصوّر مع العديد من كوادر هذا الحزب، الذي يُعتبر -بشكل أو بآخر- وريثاً لممثل اليسار الستاليني في الجزائر (حزب الطليعة الاشتراكي PAGS).
أعتبر أفلام طريق تقية هدية لم يطلبها الجزائريون ولكنهم حصلوا عليها، خاصة فيلمه الطويل الأول “روما ولاّ نتوما” (2006)، لكنها ورغم قوّتها تحمل بعض المشاهد السياسية “من الدرجة الأولى” والتي يصعب هضمها، خاصةً عندما تشعرُ أن المخرج يريد أن يشرح لك العالم ويُبسّطه، دون مجهود. لكن ما علينا، يبقى تقية، الذي رأيته في مسيرات الحراك يصوّر (ربما يحضّر فيلما؟)، أحد أهم المخرجين والمنظرّين في مجال الصورة بالجزائر، والمنطقة.
كيف يسقط الشعر؟
خلال مسيرات الحراك، التي امتدّت من 22 فيفري/ فبراير 2019 حتى ربيع سنة 2020، التقطتُ مئات الصور (كغيري مِمن حضروا) ولكنّ أفضَلَ صوري –كما يحلو لي التفكير- كانت في بعض ما كتبت عن هذه المسيرات، أو عن فِعل المشي نفسه. صورٌ مكتوبة بالكلمات.
إذاً، كنت ألتقط الصور بكاميرا هاتف تهشّمت شاشته في خريف عام 2018، عندما سقط على طريق مصنوعة من الإسمنت المسلح على ضفاف نهر بمدينة آيوا سيتي الأمريكية. ظننتُ وقتها أنه لن يعيش. ولكنّه عاش وصوّر كل الرحلة في أمريكا وعُدت به إلى الجزائر، فصوّرتُ سنة الحراك كاملة، وظلّ معي حتى نهاية 2020. بهذا الهاتف كنت أصوّر. من بين عشرات الملاحظات التي خطرت في البال، وأنا أرى الصور التي كنت ألتقطها، واحدة تكرّرت أكثر من مرة: الصلع منتشر بقوّة في رؤوس الرجال الجزائريين.
أغلب الصور التي كنت ألتقطها من وسط مسيرة تتقدّم، فنرى المتظاهرين من ظهورهم. والرؤوس التي كانت في الصورة، أغلبها أصلع. بعضها في بداية الطريق والبعض الآخر قد فقد أغلب شعره منذ سنوات. وبالمناسبة، فحتى طريق تقية وفتحي غرّاس.. وبوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة وعوّضه عبد المجيد تبّون الذي اتُّهم غرّاس بإهانته.. أربعتهم، وبدرجات متفاوتة، صُلْعٌ.. وبالجزائري كلهم فراطس، ومفردها فرطاس.
زِد على هذا أنّ 2019 كان العام الذي بدأ فيه شعري بالتساقط أنا أيضًا، تمامًا في منتصف الرأس، بدأ يصيبني ما يسميه الأطباء الصلع المحوري. في المكان الذي تسمّيه العرب “القحف”، والذي يسمّيه جزءٌ من الجزائريين “الملغيغة”، لكنّي أظن أن هذه الكلمة تصلح لتسميه “قحفة” الرضيع خلال الأسابيع الأولى عندما تكون طرية ويمكن أن تتأذى. وحسب ما قرأت فإن كلمة “ملغيغة” أصلها أمازيغي وتعني المكان المنخفض، ولذلك يعتبر شط ملغيغ (بحيرة مالحة موسمية) أكثر مكانٍ منخفضٍ في الجزائر: 35 – متر تحت مستوى البحر.
إذًا، بدأت أفقد شعري. ربما كنت قد انتبهت، منذ بداية 2018 إلى أن الشعر النّابت وسط رأسي صار أرقّ من بقية الشعر، ولكن الغزارة كانت نفسها تقريبًا.. أو هكذا بدت لي. خلال رحلتي إلى أمريكا، نهاية 2018، كان شعري مثل كومة قش، حيث أني لم أحلقه لمدة ثلاثة أشهر، واكتفيت بتحديد وتشذيب ما حول الأذنين وأسفل الرقبة. وعدم حلق الشعر، حسب ما قرأت لاحقًا، سيءٌ لمن يُهدّده الصلع، حيث يُنصحُ دائمًا بقصّ الشعر قصيرًا حتى لا تتعب الشعرات وحتى تحفّزها على النمو مجددًا.
ومع عام الحراك تحقّق الأمر، صار شعري، مهما طال، يبدو فارغًا في الوسط. لكن قد يقول قائل: من يُفكّر في الشّعْرِ وقد انفجرت ثورةٌ في البلاد؟ إن أردتم الصراحة.. كثيرون. ولذلك انتبهتُ أنا أيضاً.
الصلع ليس حتميةً
خلال ذلك العام، وإلى اليوم، ألتقي أكثر من شخص في سنّي، نهاية العشرينات، من معارف الدراسة القدامى أو أناسٌ جُدد.. ولأن الصُلع يعرفون بعضهم، ويشكلون ككل المتشابهين في هذه الدنيا، طوائف وشيعًا سرية، يقول لي أحدهم أنه جرّب كذا وكذا من دواء وزيوت ولكن الأمر لا ينفع. ثم يقول الجملة السحرية التي يردّدها الجميع “أنا قرأت عن الأمر في الأنترنت، فقدان الشعر لا يعني نقصًا في الفحولة.. بالعكس، فهو راجع لإنتاج عالي من هرمون التستسترون في الجسم، فوق المعدل الطبيعي، هذا ما يجعل بصيلات الشعر في الرأس كأنّما تحترق وتتأثر بمعدل الإنتاج المتذبذب”. طبعًا، تختلف الصياغات حسب الشخص، لكنها تتفق جميعها في تطمين الصُلع لبعضهم بعض بخصوص فحولتهم.
أتذكر أيضاً الطائرة التي عُدت على متنها من إسطنبول إلى الجزائر، نهاية عام 2016، والتي كان قرابة ثُلثِ ركّابها يربطون رؤوسهم بـ “باندانات” سوداء، وصلعاتهم يا إما مضمّدة أو عارية تنتظر مطراً ما لينبُت الشعر فيها. يومها، وأنا لم أعرف أني سأنتمي لأخوية الصُلع قريباً، فهمتُ أن الإعلانات التي أراها في كل مكان عن زراعة الشعر في تركيا تُؤتي أُكلها.
في الجزائر، يُرجع الأخصائيون في أمراض الجلد سبب انتشار الصلع إلى استعمال مواد كيميائية ضارّة بجلدة الرأس. أنواع الغاسول التي “تحرق” جذر الشعرة وعشرات المواد الكيميائية التي يستعملها الشباب لدى الحلاقين، مثل الكيراتين، لجعل الشعر ناعماً. تعريض الشعر بشكل مستمر إلى المواد الكيميائية والسشوار يجعل جلدة الرأس هشّة، ويعرضها لأمراض مثل القشرة والجفاف، وهو ما يؤدي لاحقاً إلى فقدان الشعر.
في حين يخبرني صديقي، الطبيب المُقيم بمستشفى زميرلي شرق العاصمة، أن الضغوطات النفسية و”الستراس” الذي يعيشه الجزائريون، زِد عليه سوء التغذية ومياه البلدية في الحنفية.. كلها عوامل تضاعف من مشكل ضخ الهرمونات الذكورية وتؤثر عليها.
الصلع مُحدّدٌ سياسي، اليوم أيضاً، لأن الجزائري قديماً، على الأقل في نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين لم يكُن يعاني منه بشكلٍ واسع
كما قرأت في حوار لطبيب الأمراض الجلدية والتناسلية أن ثُلث الجزائريين، رجالاً ونساءً، يُعانون من تساقط الشعر. ويفرّق المختص بين تساقط الشعر (وتسميه العرب داء الثعلبة) والصلع الذي يُعتبر حالة متطورة من داء الثعلبة. يقول أن النساء يعانين أيضاً من تساقط الشعر بسبب القلق والتعب ونقص الحديد في الجسم واضطراب الهرمونات، لكن عددهن يبقى قليلاً مقارنة بالرجال. يؤكّد المُحاوَرُ على أن الصلع ليس حتميةً ولا قدراً، رغم أنّه يذكرنا بالحالة الوراثية للصلع، ولكن يُمكن مداواته ما أن يبدأ، لكن المشكل يكمُن في أن العلاج يوقف تساقط الشعر ومن الصعب العودة لتنشيط البُصيلات، خاصةً أن العلاج طويل ومُكلِف ولا يغطيه الضمان الاجتماعي، مُضيفاً أن هناك من يفضلون اختصار الطريق والقيام بزراعة شعر تجميلية تُكلّفهم أموالاً، أما الأغلبية فيفضلون التأقلم مع الأمر.
وأنا أقرأ وأسمع مختلف الآراء لا أستطيع منع نفسي من التفكير في أن انتشار الصلع، وتمظهره على روؤس الناس، هو أيضاً مُحدّد سياسي. يخبرنا عن تقبّل الكثيرين للصلع كقدر وحتمية، لأن علاجه غالي وأتذكر مغني الشعبي الأشهر -وغير الأصلع- الشيخ المرحوم عمر الزاهي وهو يغني “الطبيب عرف دايا والعلاج سومُه غالي”.
الصلع مُحدّدٌ سياسي، اليوم أيضاً، لأن الجزائري قديماً، على الأقل في نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين لم يكُن يعاني منه بشكلٍ واسع؛ وفي مقال بعنوان “الزهم والصلع المحوري عند السكان الأصليين في الجزائر” وضعه طبيب فرنسي اسمه جان مونبولييه، عام 1918، وحاول أن يكون فيه أقل عنصرية واستعمارية ممن سبقوه، يقول بخصوص الصلع أنّه نادر عند السكان الأصليين (أو “سكاننا الأصليون” كما يسميهم) في الجزائر، ثم يحاول ترتيب السكان كالقول أن سكان وادي ميزاب صُلعٌ أكثر من سكان منطقة القبائل وهؤلاء الأخيرين أكثر من القبائل ذات الأصول العربية وهكذا.. ولكنه يمضي في مقارنات مع سكان المدن والقرى الفرنسية ليجد أن الصلع لم يكُن قدراً، ويُرجع الأمر لطريقة الحياة التي اعتادها هؤلاء “السكان الأصليون” وقربهم من الطبيعة.
جسدٌ واحد حدّ الاختناق
ما يشغل بالي هذه الأيام، إلى جانب مسألة الصلع التي تعودت عليها، جزءٌ آخر من الجسد، ألا وهو القدم والساق عموما، حيث أرقد منذ بداية العام الجاري بكاحلٍ “مفعوص” ومربوط في انتظار أن يُشفى عظمه الذي “تشعّر” (كأنّه أصيب بخدوش، ولكن بعض مناطق الجزائر يفضّلون صفة التشعّر.. كأن الشقوق الصغير تشبه الشعر) وقارب الكسر. تقلّصت حركتي بنسبة 90 بالمئة بسبب الحادث الصغير الذي تعرّضت له. وصرت عاجزاً عن المشي دون ألمٍ تحت عظم الكعب الأيمن.
الحادث تافه لا يستاهل الكلام عنه، كنت أمشي فتعكلت رجلي بممهل اسمنتي متآكل وسط الطريق (أين البلدية من حال الطُرقات؟). سمعتُ صوت طرقعة على مستوى عظمتي الكعب الأيمن. كانت تجربة مؤلمة ومزعجة.. ولازالت.
قلت إذاً.. القدم والساق، العضو الذي يحمل وزننا ويحارب ضد الجاذبية ويُحرّك الجسد كاملاً. ماذا لو توقفت عن العمل مؤقتاً؟ بعد حوالي سنتين من تباطؤ إيقاع الحياة بسبب الوباء، وانعدام حركتنا السياسية وضمور حركتنا اليومية. الإصابة في الكاحل جعلتني أشعر أنني أطفأت كل الأفران والمحركات في جسدي، لا حركة ولا قيادة سيارة ولا أي نشاط يخرج عن إطار التحرك داخل البيت. كأنه حجر صحي داخل الحجر الصحي الأكبر.
حين أتذكر أيام المسيرات، والمشي الطويل والركض في بعض الأحيان، لا يحضرني تعرضي لمرض أو حادثٍ منعني من الالتحاق بالشارع. ربما نزلة أو مغص في المعدة، لكن لا شيء آخر. لم أصَب في قدمي ولم أعانِ من إصابة سابقة.
أتذكر مثلا صديقةً، كانت معي عند نهاية إحدى الجمعات، واضطررنا للهرب صعوداً عبر السلالم اللامتناهية لمدينة الجزائر هروباً من الشرطة وقنابل الغاز التي تطلقها على الجموع. كانت صديقتي قد خضعت لعملية جراحية، قبل عام، في ركبتها. توقّفنا أكثر من مرّة حتى تستعيد نفسها وتخفّف من ألم ركبتها.
أيضاً، كان هناك رجلٌ برجلٍ اصطناعية، يسير وسط الناس. لاحقاً التقيته في حدثٍ فنّي، اكتشفتُ أنه طباخٌ ماهر ويصنع مقبّلات ذات جودة. كان يسير بإيقاعه الخاص.
آخرون كانوا يتكئون على عكازات، وكان البعض يجلس على كراسي متحركة. رأيتُ أيضاً من يجلسون على هامش المسيرات وقد نزعوا أحذيتهم بسبب المشي الطويل، آلمتهم الأحذية الضيّقة –ربما- أو سيئة الصنع.

اسكتش لـ سفيان زوقار
ولطالما وقفتُ متأمِّلاً من يأتون للمسيرات وهم يلبسون بلغةً في أقدامهم. ربما بسبب وصيّة والدي القديمة “لا تخرج أبداً من المنزل إلا والحذاء في قدمك.. قد تتشاجر أو تضطر للجري”.
أغلبهم شباب، وكلهم في الصفوف الأمامية في وجه الشرطة. أذكر مشهداً لا يُنسى، في الجمعة الثانية، بالقرب من فندق الجزائر وعلى بُعد مئات الأمتار من قصر الرئاسة (ربما كانت تلك آخر مرّة اقتربنا فيها من القصر) وتماما في المكان الذي توقف قلب الشهيد حسان بن خدة، نجل “أول رئيس” للجزائر.
الشارع صاعد والأعداد كانت مهولة. ومع كل مرّة تهجم فيها الشرطة يحصل تدافع وكرٌ وفر يجعل الناس تدوس بعضها بعضاً. بعد عدّة محاولات، نجحت الشرطة في تفريق المظاهرة.. كأن قنبلة انفجرت.
احتمى البعض بالأسوار على جانبي الطريق وهرب الكثيرون نحو نهج الشهداء. عندما عُدنا إلى وسط الشارع وجدنا شباباً صغاراً يُجمّعون البلغات التي سقطت من أصحابها. عشرات البلغات، من كل الألوان، ليس كتلك التي نراها أمام باب المسجد، لا. كل فردة لوحدها. تشكّلت دائرةٌ كبيرة، مثل جزيرة من المطاط وسط بحرٍ من الإسفلت. وقفنا ننظر إلى البلغات. تساءلتُ عن مصير أصحابها: بعضهم سيعود إلى بيته البعيد حافياً.
إذاً، كنت غير مصاب في قدمي وألبسُ حذاءاً يضمن لي العودة إلى المنزل –أو إلى مركز شرطة- غير حافٍ. لكن تجربة الحراك كلها كانت أكثر شمولاً من القدم التي تمشي والصلعة التي تتلقى المطر في الشتاء والشمس والمياه المرشوشة من شرفات المدينة –لتبريد المتظاهرين-، ومياه الشرطة وغازاتها في كل الفصول.
كان جسدي ينتمي حرفياً إلى الجسد الأكبر، للنّاس الذي “شكّلوا شعباً” كما تقول العبارة الفرنسية (faire peuple). الالتصاق الخانق والناتج عن توقٍ للحركة، أخرجنا إلى الشارع فوجدنا أنفسنا متلاصقين في الشوارع وعاجزين عن الحركة أكثر من مرّة، هذا الالتصاق الخانق كان أبلغ تعبير عن “الجسد الواحد”.. لم يخلُ من سرقة ولا من تحرش بالنساء.. ولكنه كان الجسد الواحد بعلاّته وأمراضه ونقاط قوّته وضعفه.
ولم أشعر بذلك سوى عند الوباء ووصول الحجر الصحّي، وإن كان تفريق المسيرات عند نهاية اليوم، ومحاربتها كلّما قلّت الأعداد، كان تدريباً على تكسير وحدة الجسد قبل الوباء حتى. لكن الأكيد هو أن مشي عشرات الكيلومترات خلال المسيرات، في مدينة الجزائر، كان فِعلاً محرّراً ولو كنتُ مصاباً كما أنا اليوم لكنتُ عشت الحراك بشكلٍ مختلف ولكان فاتني الكثير.
اضطرابٌ في ضخ الهرمونات
تشكيل شعبٍ وصنعُ جسدٍ واحد، كان تمظهراً لحركة تعيشها البلاد طيلة تلك الفترة، غليانٌ كامل يطفو إلى السطح يوم الجمعة بالخصوص. طيلة عامٍ ونصف. كأننا كنا نعود أكثر من مرة في الأسبوع، وطيلة فترة طويلة، لتفقّد ومعاينة الأطلال والخسائر التي تكبّدها المجال العام والحياة السياسية طيلة عقود.
في حديثٍ مع صديق مصري، علّق قائلاً على ما ذكرته بخصوص سنوات بوتفليقة أن ما حصل هو “تجريفٌ” للميدان السياسي بمعناه الواسع. تجريف، وجذرها جَرَفَ. تماما مثلما نجرف الثلج أو التراب. وفي اللغة “جرف الإنسان أي كثُرَ أكله” و “جرف الأحجار والتراب أي كسحها بالمجرفة” و”جرفه الدهر أي أفقره وأهلكه”.
كذلك حصل الأمر هنا، ويتواصل إلى اليوم، تجريفٌ مُمنهج. حتى تصير الأرض بوراً ويصير البشر كسيحين، أي مشلولي الأرجل.
أتذكر كلام الصديق الطبيب، بخصوص عادات الأكل وسوء الرعاية الصحية في الجزائر، كل هذا يؤثر على صحة الناس ويسبّب الصلع وقرحات المعدة وأمراضا أخرى. لكنه يعود ليؤكد مسألة اضطراب ضخ هرمونات في الجسد كسببٍ أولي للصلع.. كأن الهرمونات تجرِفُ شعر الرأس.
ولا أستطيع منع نفسي من التفكير في مسألة اضخّ لهرمونات هذه، كاستعارةٍ على بلداننا -وليس الجزائر فقط- التي تعرف فوراتٍ وثورات كل بضع عشريات من الزمن. انتفاضات عارِمة، جرعات عالية من هرمون “الحركة”، ثم تغرق في شللٍ لعقود طويلة، تحافظ فيها السلطات على نسبة معيّنة من الضغط والشلل، ويحافظ المجتمع من جهته على نسبة معيّنة من الحركة والحق في التنفيس عن غضبه.. مسألة اضطراب في الضخ، حتى يصيبها الصلع هي أيضاً.. أو كما سمّاه صديقي تجريفٌ للنُخب والهياكل وكل إمكانيات التنظم ونقل الخبرات والتاريخ والحُلم، الحُلم بعدم الكف عن خلق عوالم جديدة ومهاجمة العالم الحالي والمشي فيه.
في هذه النقطة بالذات، المشي، أنا مدينٍ للقدر الذي أعطاني فرصة المشي ولنعمة الأقدام التي حملتني طيلة شهورٍ. وأتفق مع فتحي غرّاس الممثّل، عندما يقول في “إنلاند”: “المشي يحرّرني.. المشي ثورة..” فيجيبه صديقه ذو الشعر المنساب: “المشي هو التجديد والبحث عن الأفضل..” ولا أتفقُ مع فتحي غرّاس السياسي الذي ردّد طيلة فترة الحراك خطابات وتحليلات مُرتجلة وغير وازِنة كان يختمها بكلمة “سننتصر”.. ربما لم “تنتصر” ولكننا مشينا يا فتحي وأتمنى لك الحرية والبراءة كي تستطيع المشي أيضًا، أنت وجميع معتقلي الرأي، صُلعًا -مثلك- كانوا أم لا.