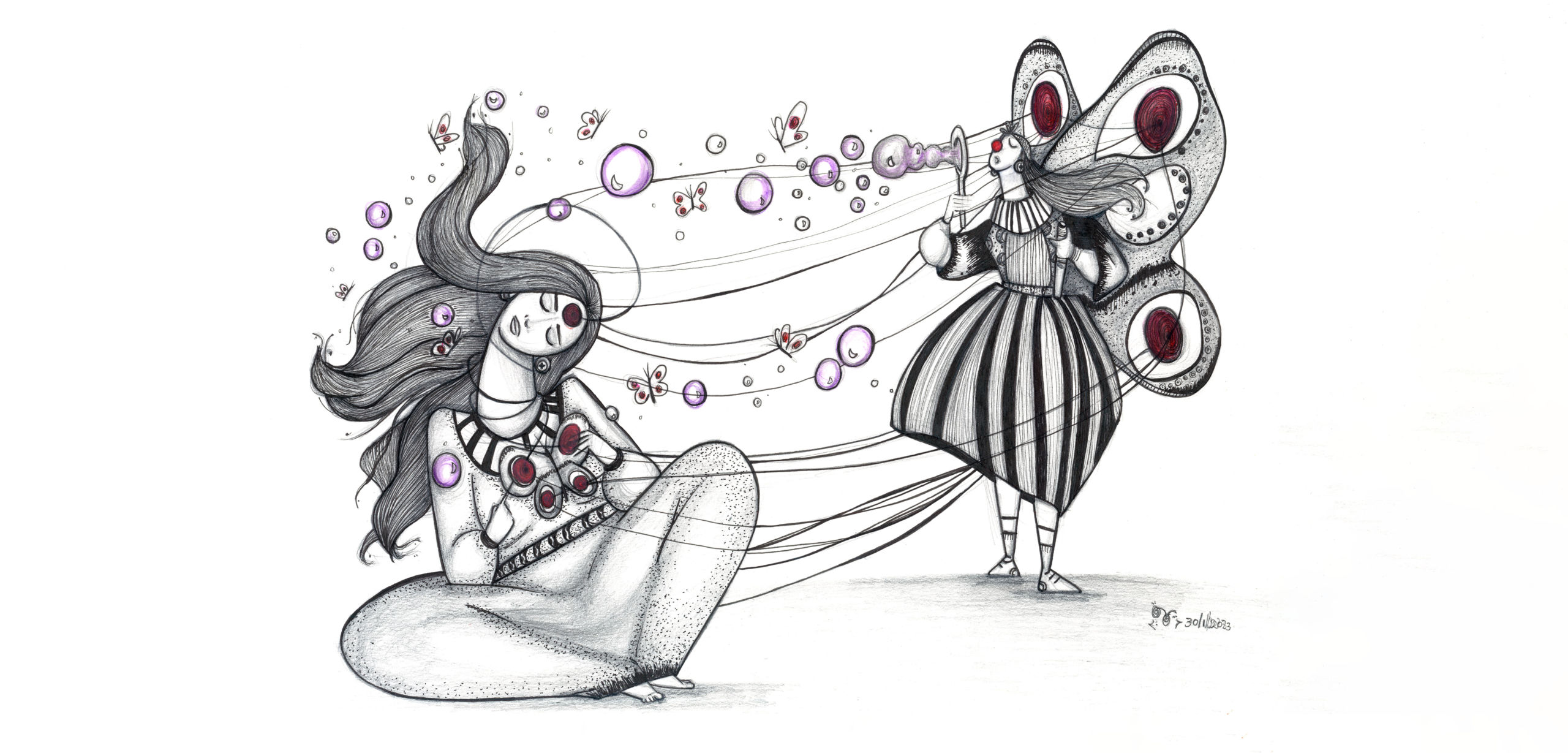عندما تمكّن صديقنا من التعرّف على البنت التي رآها في الميكروباص، كان هذا انتصارًا لنا. فقد كنا نجوب الميكروباصات طولًا وعرضًا لنيل الوصال من الجنس الآخر. وعندما نجح، كان علينا أن نكون في الجوار للحماية.
كنا ثلاثة في السنة الأولى من الثانوية العامة، عز مرحلة المراهقة، نكحتُ بماكينات الحلاقة ذقوننا كي تخضّر، ونفهم مشاكسات الذكور لبعضهم وبالذات عندما يمشي الواحد مع أنثى في الشارع.
ولقد حدث ما كنا نخشاه. فعند نزول صديقنا مع رفيقته الجديدة ونحن بصحبته، قرب حي المندرة، شرق الإسكندرية، تعرّض لنا أحد أشقياء المنطقة، وحاول مضايقتنا والبنت، ما دفع صديقنا لأن يُوقف لها ميكروباصًا متجهًا لبيتها ويركّبها إياه.
بعد ذهابها، “ثبّتنا” – أي أوقفنا بالقوة أو السلاح في لغة الشارع- وطلب من كل واحد منا جنيهًا، مبلغ ليس بالقليل وقتها. كان أشقياء المنطقة، بالنسبة لنا نحن أبناء الطبقة المتوسطة، “الفرافير”، قليلو الخبرة بالشارع، أشخاصًا خطيرين يجب تجنبهم. وكانوا يعرفون ذلك، فيتجرأون علينا وعلى أمثالنا، محاولين استعراض ذكورتهم وسحق ذكورتنا والهيمنة علينا، مستخدمين الشخر، والسباب، وطبقة صوتية ذكورية غليظة وجهيرة، والعنف أحيانًا.
كنت أعرف ساعتها أن المسألة في طبقة الصوت، يجب أن تكون غليظة قوية وثابتة وأن تنظر في عين خصمك. وأمام طلبه للمال ومحاولة إرهابنا، وجدتني أردّ بصوت قوي: “عايز جنيه يا روح أمك… لو راجل خليك مكانك وأنا أجيب لك اللي يديك الجنيه”.
وانطلقتُ أجري في الشارع، لا أعرف تحديدًا إذا ما كنتُ سأنجح فيما فكرتُ فيه. فقد جاءتني فكرة الاستعانة والاستنجاد بشقي منطقتي “علي فليكة”، فنحن ذكور وأبناء منطقة واحدة. لم أكن أعرفه، ولم أختلط به قط، وكنت أجهل ساعتها إذا كان في المنطقة الآن أم لا. لكنني واصلتُ الجري.
وجدتُه واقفًا على ناصيته المعتادة. “إزيك يا علي، أنا ابن منطقتك- قلتُها بصوت قوي وغاضب – وكنت راجع أنا واتنين صحابي، واحد منهم كان معه بنت خالته- الاصطلاح الشعبي للصديقة حيث لابد من وجود قرابة للمشي مع الأنثى- وعيل ثبتنا، ولما قلت له عيب عليك أنا أعرف علي فليكة.. قالِّي..كــس أُم علي فليكة”.
في أسرتنا متوسطة الحال، وكأغلب الأسر المصرية، الذكورة المهيمنة ليست عنيفة بل هي متعلّمة، صاحبة منصب أو نفوذ أو قوة مالية ومتديّنة أحيانًا، وقد تمارس عنفًا محدودًا بحجة التقويم والتهذيب على النساء والذكور الأقل سنًا، تفرض على الأنثي الوصاية وتعطيها حقوقًا اجتماعية كبيرة لكنها تسلبها إياها إذا تخطت الحدود المسموح بها ومسّت هيبة النظام الأبوي
لم يقل الشاب الذي أوقفنا ذلك، بل إنني لم أذكر له اسم فليكة أساسًا، لكن كان ولابد من تأجيج حميته الذكورية ليشارك في المعركة، وليس أفضل من أن أحدًا تعرّض لفظًا لأقرب وأهم أنثى عنده وهي أمه، سألني: “معاك موس – شفرة-“، قلت له “لا” وتعجبتُ من السؤال، هل معنى ذلك أنه حسبني خطيرًا مثله، أم أنه يفترض عمومًا أن الذكر يحمل سلاحًا وأن هذا سؤال بديهي؟
في وسط شارع جمال عبد الناصر، الشارع الرئيسي بالمنطقة، انطلق علي فليكة غير عابئٍ بالسيارات، يصرخ بصوت هادر وأنا بجواره، “يا منطقة وسخة مافيهاش راجل”، النداء الأثير، لتحقير أي ذكورة في المنطقة إيذانًا بالحرب.
أظنّ إن لم يكن بصحبتنا صديقة صاحبنا ما كانت ستحدث هذه القصة كلها، وما تعرّض لنا شقي المنطقة، لكن وجود أنثى معنا استفزّ ذكورته فقرّر أن يفرض علينا هيمنته. وفي النهاية وأمام علي فليكة اعتذر لي وقال إنه لم يكن يعلم أني “تبع” فليكة، وأنه موجود في حال إذا ما احتجتُ شيئًا.
أنت كذكر مهدّد، وضعيف، طالما في صحبتك أنثى في الفضاء العام، عرضة للتحرش اللفظي، أو الاعتداء عليك وعليها في أماكن بعينها، وهو ما يدفع الكثير من الذكور لاتخاذ وضعية الخطير: تربية العضلات، خشونة الصوت وعلوّه، والنظرة القوية، والاستعداد لممارسة العنف في أي لحظة.
كل رجل فينا يحمل أنثاه كأنها صليبه. هي وصمته لو فسدت، يحمل وزرها ويُعيّر بها بل ويُتَّهم في رجولته لو خرجت على المعايير المنصوص عليها في اللبس والسلوك، أو أنه لَانَ لها وأظهر عاطفته إليها وخضع لها فهو ضعيف، وخاضع، و”شُخْشِخة”. كان أبي يسبق أمي بخطوتين أو ثلاثة في أثناء مشيهما في الشارع، مثله مثل بقية رجال عصره، ينأون عن نسائهم كأن المشي بجوارهن ثقل، وحالة استنفار محفوفة بالمخاطر المادية والمعنوية.
عندما كبُرت أختى الصغرى وصارت في الإعدادية وأنا في الثانوية، كان المشي معها في الشارع شاقًا عليّ لأن أغلب الذكور في أعمار مقاربة أو أكبر كانوا يحسبوننا “متصاحبين” ولم نكن نسلم من بعض التعليقات وتلقيح الكلام. لكنني مع الوقت تعلّمت الرد، وذهبت للجيم، كما أوصني أخي على اعتبار أن عضلاتك دليل قوتك، وكنت كلما خرجنا أضع يد على كتفها وأنفخ صدري وأنظر لأي أحد يتكلم في عينيه.
في أسرتنا متوسطة الحال، وكأغلب الأسر المصرية، الذكورة المهيمنة ليست عنيفة بل هي متعلّمة، صاحبة منصب أو نفوذ أو قوة مالية ومتديّنة أحيانًا، وقد تمارس عنفًا محدودًا بحجة التقويم والتهذيب على النساء والذكور الأقل سنًا، تفرض على الأنثي الوصاية وتعطيها حقوقًا اجتماعية كبيرة لكنها تسلبها إياها إذا تخطت الحدود المسموح بها ومسّت هيبة النظام الأبوي.
احترام الأم، الأخت، والزوجة واجب. بل يحق لها كما يحق للذكر إبداء الرأي والاعتراض وإدارة البيت. لكن في حالة مساسها بالهيكل الذكوري الأبوي، تعاقب وتنزع عنها كافة الصلاحيات. في بعض الحالات تنجح الأنوثة في أن تحل محل الذكورة المهيمنة. وفي أغلب الحالات تكون الأنوثة تابعة. وفي كلتا الحالتين تعمل الأنوثة طواعية على إعادة إنتاج النظام الأبوي.
يدفع التهميش إلى المبالغة في الفعل وفي الإعلان عن الذات والقيام بأعمال انتحارية أحيانًا. ولا يقتصر على التهميش الطبقي الذي تمارسه المركزية الطبقية حيال طبقات أقل، فقد يمتد ويكون تهميشًا اجتماعيًا كالذي يتعرّض له المراهقون في أوساطهم الأسرية والعامة، باعتبارهم “عيال” لا يعتد بهم وبآرائهم ..
أمام هيمنة ذكورة المركزية الطبقية، وقدرتها على الاستحواذ على القوة والاستحقاق الاجتماعي وحق الاعتراف وإنكار جماعات بعينها، ووضع تعريف للمواقف، والمصطلحات التي يمكن من خلالها فهم الأحداث والمسائل الجدلية، وصياغة المُثُل وتعريف الأخلاق، لا يبقى أمام الذكورة المهمشة سوى مقاومتها، واتخاذ منحى راديكالي أكثر عنفًا وأكثر سيطرةً على النساء والذكور الأقل سنًا، لإعادة تأسيس ذاتها الجاري تهميشها بشكل ممنهج ومستمر وإعلان رجولتها التي لا تقارن بأي حال برجولة الطبقة المتوسطة التي تترك الحبل على الغارب لنسائها.
من هنا يمكن إعادة النظر في اعتداء شقي المنطقة علينا. لاشك أنه رأى في مشينا، كذكور من طبقة متوسطة مع أنثى في فضاء عام، خللًا يحتاج لإصلاح. الذكورة المهيمنة في طبقتنا سترى الأمر كذلك من باب “أترضاه لأختك؟” لكنها لن تعالج الموقف كما فعل شقي المنطقة. أولًا لأن دافعه ليس أخلاقيا كدافع الذكورة المهيمنة، هو لم يساهم في وضع تعريف لما هو أخلاقي وغير أخلاقي، خاصة إنه بالتأكيد له صاحبة يمشي معها، ولن يتكلم لو أنه رأى ذكرًا من نفس منطقته وطبقته الاجتماعية يمشي مع أنثى.
هو لديه تعريف آخر: كيف تجرأنا على إعلان ذكوريتنا في حضوره بالمشي مع أنثى في فضاء عام وبزي مدرسي يشي بطبقتِنا وخضوعِنا للنظام الاجتماعي الذي يحتقره بالضرورة، يبدو أن هذا ما استفزه فعلًا “شوية عيال عاملين رجالة”، لهذا قرّر معاقبتنا في الحال وفق ما تمليه عليه ذكورته الجريحة.
هو نفسه حين سيمشي مع أنثى سيحاول وضع يديه حول عنقها، وسيدخن، وقد يهمس لها بكلام خارج لتطلقَ ضحكة عالية، كي يعلن تحديه واستهزائه ولامبالاته بالقيم التي تفرضها المركزية الطبقية. وقد يدعي حبها ويدق وشمًا باسمها أو صورتها على جسده ولا يعني هذا أنه يحترمها بالضرورة هو ينظر إليها على أنها تخصه ولا يمكن مساءلته عما يفعله بها، وقد يؤذي من يقترب منها، وقد يؤذيها هي ويشوه وجهها بماء النار لو تركته وذهبت لغيره، وقد يقتلها.
خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft
يدفع التهميش إلى المبالغة في الفعل وفي الإعلان عن الذات والقيام بأعمال انتحارية أحيانًا. ولا يقتصر على التهميش الطبقي الذي تمارسه المركزية الطبقية حيال طبقات أقل، فقد يمتد ويكون تهميشًا اجتماعيًا كالذي يتعرّض له المراهقون في أوساطهم الأسرية والعامة، باعتبارهم “عيال” لا يعتد بهم وبأرائهم، أو ما يتعرّض له المسنّون، باعتبارهم “بركة” لا دخل لهم في مسألة اتخاذ القرار، كذلك المدنيون في حالة عسكرة الدولة والمجتمع، وغير المتدينين في مجتمع متدين، قد تهاجر وقد تُهمّش في مجتمع جديد خاصة إذا كان غير مرحِّب فيه بالأجانب.
التهميش ليس فعلًا ثابتًا، ذا توجّه محدَّد طيلة الوقت، هو متغير بفعل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. الكل مُعرّض للتهميش: ذكور وإناث. لكن الشيء الثابت أننا أمام التهميش نكون أكثر عنفًا على الذات والآخرين وأكثر رغبة في تحدي القيم السائدة التي ترسخ لهذا الوضع من أجل إثبات استحقاقنا الاجتماعي.
على شاطئ مدينة منتون، جنوب شرق فرنسا، حيث أقيم، شاهدتُ رجلًا في أواخر العقد الرابع من عمره كثّ اللحية يرتدي شورتًا بينما جزؤه العلوي عارٍ وإلى جواره امرأة شابة ترتدي مايوه بكيني من دون حمّالة صدر، كاشفةً عن نهديها. هكذا دون أي مبالاة، وفي هدوء شديد يشبه هدوء المتأملين جلسا دون أن يعيرا الآخرين انتباهًا ودون أن يلتفت إليهما أحد.
يبدو الأمر طبيعيًا، هناك نساء مثلها يفعلن ذلك، صحيح أكبر سنًا لكن في النهاية هنا سياق غربي متحرّر، فرنسا بلد النور والحرية، حيث أنّك حرُّ تمامًا ما لم تضرّ غيرك. لكنني لوهلة أشعر حيال تفسيري ذلك ببعض التنميط. هل لأنها فرنسا فإن التعري أمر عادي ومقبول لكل الفئات؟
أسأل صديقي، وطالبي السابق، فلوريون بونفوا، عن لقطة الرجل والشابة، وهل هذا مقبول اجتماعيًا؟ فيقول: لو أنها أكبر سنًا لاعتُبر الأمر عاديًا لكن لأنها شابة فغالبا سيُرى تصرفها على أنه فعل “سوقي”، غير راقٍ، ينتهك الكود الاجتماعي. أسألُه: ألن يتّهم أحدٌ هذا الرجل بأنه معدوم الرجولة؟ فيجيبني: لا الكلّ سيتكلّم عن البنت فقط؟
يحلو لي في هذه الأوقات أن أتخيّل أشخاصًا بأعينهم ممن أعرفهم وأعرف ردود أفعالهم وهم يشاهدون مثل هذا المشهد. أو أن أنقل الرجل والمرأة في ذهني ليجلسا على ضفة المقابلة للبحر الأبيض المتوسط، شاطئ أبو هيف في سيدي بشر مثلًا، وفي وضح نهار سكندري مشمس.
إلحاحي على السؤال عن صورة الذكر ما هو إلا انعكاس لقيمي الذكورية المتوارثة. يستشعر ذلك طالب آخر كنتُ أدرّس له في المعهد الفرنسي بالقاهرة، وأنا أسأله عن مشهد الرجل والمرأة، ليرد علي: “عادي يا أستاذ دي فرنسا مش مصر” ..
أضحك وأنا أتصور ماذا سيحدث حينها، وكيف أن الرجل أقل ما يوصف أنه “إريال” أو ديوث. الصورة السلبية للذكر عديم النخوة، التهمة التي تقضي مضاجع الذكور: وهي نفي ذكوريتهم.
تأكد لورين وتيموتيه، الزوجان والطالبان اللذان يدرسان العربية معي، ما قاله فلوريون: تصرّف البنت سوقي، ودون المستوى اللائق. أسألهما كما سألت فلوريون عن صورة الرجل. يقولان: لا، الكل سيتكلم عنها. أخذ السؤال إلى نقطة أبعد: لو أن في مجموعة من الشباب رفيقان، شاب وشابة، وكانت البنت تتصرّف بشكل غير لائق مع باقي ذكور المجموعة أو أحد منهم، هل يُنظر للرجل بصورة سلبية؟ يقولان: لا.
إلحاحي على السؤال عن صورة الذكر ما هو إلا انعكاس لقيمي الذكورية المتوارثة. يستشعر ذلك طالب آخر كنتُ أدرّس له في المعهد الفرنسي بالقاهرة، اسمه تيموتيه أيضًا، وأنا أسأله عن مشهد الرجل والمرأة، ليرد علي: “عادي يا أستاذ دي فرنسا مش مصر.” يعرف تموتيه مصر جيدًا، عاش في القاهرة لعدة سنوات، ويتحدث العربية بطلاقة. أقول وأنا أضحك: أترضاه لأختك؟ يضحك: طبعًا لأنني أثق فيها. عارف هيقولوا عليك إيه في مصر؟ يضحك: أيووه عارف.
“لكن ألستَ معي أن مسألة “دي فرنسا” تنميط للصورة يا تيموتيه،” أحاول أن أعود للب الموضوع، بعيدًا عن المزاح، أدلل أن ما يحدث على شاطئ منتون قد لا يكون مقبولًا في منطقة ريفية أو مهمشة. أخبرته بما سمعته من طلابي الآخرين، وأنهم اعتبروا تصرف البنت سوقيًا. يجيبني بأن الأمر وارد، خاصة وأنني على مقربة من الحدود الإيطالية على شاطئ المتوسط، لو كنتُ في بروتاني غرب فرنسا على شواطئ المحيط “حاجة زي الساحل في مصر”، كما وصف تيموتيه، ما كنتُ رأيت ذلك.
تخبرني بولا، مدرسة اللغة الفرنسية في الكورس المكثف الذي كنت أحضره، وهي في الأصل إيطالية تتحدث الفرنسية بطلاقة، أن الفرنسيين ينظرون للإيطاليين على أنهم أوروبيون من الدرجة الثانية. وذات مرة كانت في المخبز وقالت لها سيدة فرنسية -تحسب بولا فرنسية – بعد مغادرة رجل إيطالي كان يشتري الباجيت قبلهما – ما معناه “هو إحنا ناقصين إيطالين”. لا تنكر بولا أفضلية البيروقراطية الفرنسية على الإيطالية – لكنها في النهاية ترى أن الأم الإيطالية هي الأفضل فهي تهب كل وقتها لأسرتها بينما الفرنسية وقتها الخاص يأتي أولًا.
أتكون البنت إيطالية وقد فعلت ذلك لأن ثمة عنصرية غير معلنة جعلتها تكسر الكود الاجتماعي عن عمد؟ ربما. أو ربما هي فرنسية؟ من منطقة مهمشة كالضواحي الشعبية؟ أو شابة تعارض القيم السائدة على خلفية فكرية ما، ولذا هي تقوم بذلك من باب الاحتجاج؟ أليس التعري فعل احتجاج؟
يخبرني تيموتيه، أن البنات ذوات السلوك المبتذل، من وجهة الذائقة العامة، اللواتي يضعن مكياجًا مبالغًا فيه، ويرتدين ملابسًا مبهرجة، ويتكلمن بلكنة ولازمات لغوية في الحديث، ولا يخشين الرجال، يطلق عليهن “كاجول” Cagole، ويقال أن الكلمة أطلقت بالأساس في مارسيليا جاءت من كلمة caguer وتعني شخصًا يزعج الآخرين بطريقة وجوده، وأيضًا من لفظة cagoulo التي تشير إلى المريلة الشفافة التي كانت تضعها النساء عليهن عند الطبخ في القرن التاسع عشر، وصارت تقال للنساء التي تعمل في الدعارة.
أمّا ذكور المناطق المهمشة، ويطلق على الواحد منهم “قرصان”، أو “شارو”، أو “Narvalo” وغيرها من المسميات. هو في الغالب مسطول أو مخمور طيلة الوقت عنده دراجة بخارية، يبالغ في ملبسه وردود أفعاله، ولا يتورع عن العنف، وأكثر سيطرة على أنثاه عن غيره في الطبقات المتوسطة.
يتشابه هذا مع ذكور وإناث المناطق المهمشة في مصر، وعنايتهم المبالغ فيها بمظهرهم، وثيابهم المبهرجة، ولازمات البنات الشهيرة، إضافة “تشي” في نهاية الكلام: “حبيبتشي” و”أُختشي”، “صاحبتشي”، وكذلك لازمات الذكور: “يا صاحبي”، “يا شِق”، “يا شبح”، والموتسيكلات الصينية التي تفضلها الذكور في المناطق المهمشة، وغالبًا ما يُطلق عليهم “شمال”، “بيئة”، وأحيانًا “شراميط” والشرموطة هي خرقة لمسح بقايا الطعام، وغيرها من المسميات.
كلا الجنسين يعملان على مظهرهما كي يبدوا رائعين. هي ترغب أن تكون “مُزة” أي مثيرة وجميلة بشكل لا يخفى على أحد، وهو يعمل على اكتساب لقب “البرنس” بين أقرانه. ومن أجل ذلك هناك مصروف للملابس: وفي كثير من الأحيان يضيع المرتب كله على شراء ملابس أنيقة على الموضة.
في مقالها “وسط البلد: تمشية في أرض العدو” تقول لوسي ريزوفا: “هذا الاهتمام المفرط بالمظهر ينبع من الوعي المفرط بأنه سيُحكم عليهم باستمرار ويصنفون من قبل الآخرين بمجرد خروجهم خارج شوارعهم وأحيائهم وهل هم نظيفون أم لا، محترمون أم لا، ومن ثم التعامل معهم وفقًا لذلك.”
أمام هذا التشابه، وكما في غيرها من دراسات جندرية أخرى في أماكن مختلفة في العالم، يمكن القول أن ما يصنع التهميش يختلف بحسب السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، لكن ردود الفعل حيال التهميش تكاد تكون واحدة وثابتة: عنف ومبالغة في الفعل وميل للقيام بأعمال انتحارية.
مَن حمّل الرجل عندنا أنثاه وجعله يرزح تحت هذا الثقل ويفسد حياته وحياتها. لماذا نلغي وجود المرأة – في المتن والهامش – وإذا اعترفنا به فوفق تعريفات محددة؟ لماذا نحمّلها على رجلها: أبوها، أخوها، زوجها، وأحيانًا ابنها؟ هل تعكس هذه القيم الذكورية الواقع فعلًا أم أنها مدّعاة؟ معقولة أم مبالغ فيها؟
هل تصلح هذه الفرضية لتفسير المبالغة في الإعلان عن الذات، وزيادة وتيرة العنف التي نشهدها في مجتمعنا؟ والقتل الذي تتعرض له المرأة؟ ورواج القيم الذكورية العنيفة؟ هل يمكن القول أن كل هذا يحدث لأننا نشعر بدرجة أو بأخرى أننا مهمَّشون؟ طبقة متوسطة تتم إزاحتها إلى الهامش مع اقترابها من حد الفقر في ظل التضخم؟ رفع الدعم في الموازنة العامة مع وجود خدمات وإعفاءات يتمتع بها فئة معينة دون غيرها؟ النفي المستمر للمختلفين في الفكر والعقيدة؟ تهميش المرأة، المراهقين، المسنين؟
ورغم التشابهات إلا أن المختلف في القصتين أن أحدًا لم يتكلم عن الرجل في السياق الفرنسي ولم ينعته بشيء ولم يطعن في رجولته. بل إن للنساء وجودهن، سلبي أو إيجابي بحسب وجهة نظر العامة، لكنهن موجودات بشكل بارز وفاعل في المجتمع. لا أقول أن هنا الجنة، نسبة العنف المنزلي في فرنسا ملحوظة، بل هو الاعتراف بوجود المرأة ودورها الواضح داخل المركز وفي الهامش.
فمن حمّل الرجل عندنا أنثاه وجعله يرزح تحت هذا الثقل ويفسد حياته وحياتها. لماذا نلغي وجود المرأة – في المتن والهامش – وإذا اعترفنا به فوفق تعريفات محددة؟ لماذا نحمّلها على رجلها: أبوها، أخوها، زوجها، وأحيانًا ابنها؟ هل تعكس هذه القيم الذكورية الواقع فعلًا أم أنها مدّعاة؟ معقولة أم مبالغ فيها، خاصة مع تنامي دور المرأة الفاعل في المجتمع (نسبة النساء العاملات عملًا دائمًا تصل إلى ٨٨٪ مقابل ٦٥٪ للرجال)، كما أن أكثر البيوت تديرها وتتحكم فيها النساء؟ فلماذا يُوصم الرجل إذا فعلت أنثاه شيئًا؟ لماذا لا تُسمّى الأشياء بأسمائها؟ هل يمكن الخلاص من هذه القيم السامة؟ بل هل يمكنني أنا كذكر أن أتخلى تمامًا عن قيمي الذكورية المتوارثة؟
يخبرني فلوريون أن مسألة صديق البنت، بقدر ما هي أمر عادي في المجتمع الفرنسي، إلا أنها لدى كثير من الآباء أمر غير مريح، فالأب لن يتقبل دخوله البيت بسهولة، ولن يتعامل معه بأريحية كصديقة البنت، دائمًا ما سيكون هناك قلقٌ غير معلن لكنه موجود تحت السطح حتى يستريح إليه ويدرك تمامًا أنه يحب ابنته.
أسأل تيموتيه، لأحصل منه على اعتراف ذكوري: ماذا لو أن أختك كانت على شاطئ البحر بجوار ذكور من مناطق مهمّشة أو كانت في إحدى الضواحي هل كنت ستخاف عليها؟ يسكت ثم يقول: نعم. أقول له: لماذا؟ فيجيبني: لأن الذكر خطير.