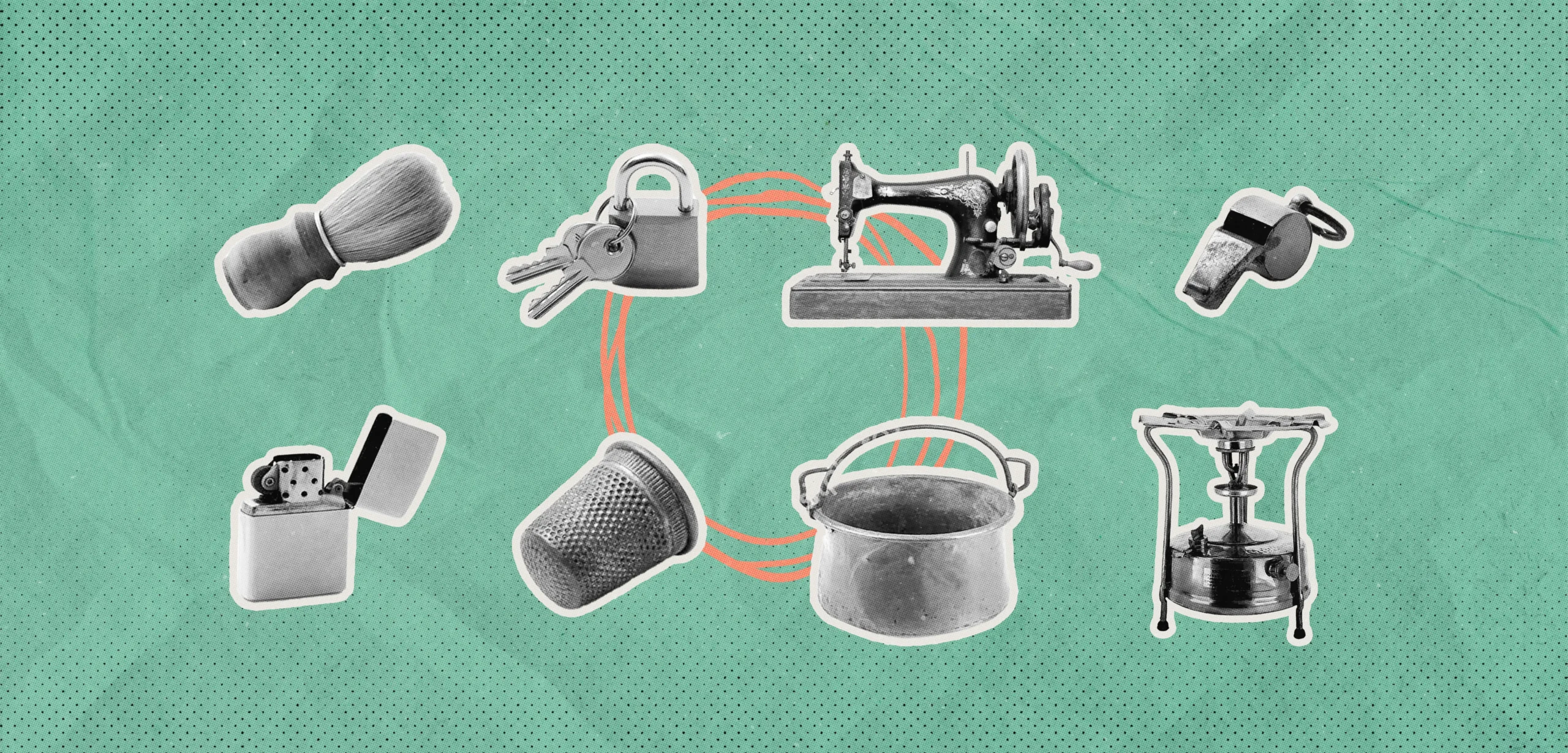في صيف عام 1998 بينما كنت أستعدُّ لخوض التجربة الجامعية التي ستبدأ بعد ثلاثة أشهر، اقترح أحد أبناء عمومتي عليّ أن ألتحق بالوظائف الصيفية التي توفرها الحكومة، كان أخي محمد الذي يكبرني بخمسة أعوام متخرِّجًا للتو من قسم القانون في نفس الجامعة التي سألتحق بها، جامعة الملك عبدالعزيز – جدة. محمد الذي سينتظر الوظيفة ثمان سنوات، قرر أن يلتحق معي بالوظيفة الصيفية، وكان المتاح في تلك السنة للطلاب والخريجين الجدد، وظائف مؤقتة في مصلحة الجمارك خلال موسم الحجّ، حيث تدربنا في عدّة أيّام على أساسيات التفتيش والمراقبة. ومع أول وفود الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، كنا نقف أنا ومحمد أمام بوابات القدوم، وبحكم قامة محمد وشكله الجاد، قرر مدير الوردية أن يجعله يستلم مهام التفتيش الشخصي.
قدر المراقبة
يقف مدير الوردية أمامنا، ويقوم بتوجيه القادمين من البوابة، كانت الطائرة قادمة من إحدى الدول الأفريقية، وقد أخبرنا مدير الوردية بقائمة الممنوعات التي يتوقع بخبرته وجودها ضمن حقائب الحجاج الأفارقة، ومن ضمنها نبتة (القورو) وكانت معروفة لدينا، واستخدامها شائع بين أهالي الحجاز. وقفت أنا خلف الطاولة التي يضع عليها الركاب حقائبهم للتفتيش، بينما وقف محمد بالقرب من باب غرفة التفتيش الشخصي، ينتظر أوامر مدير الوردية الذي يوجِّه الركاب المشكوك فيهم نحو غرفة التفتيش الشخصي، ولم يكن محمد قد قام بمهمته الأولى والأخيرة بعد، وبينما كنت أفتح حقائب المسافرين حقيبة تلو أخرى، إذ دخل أحد المسافرين بلباسه الإفريقي الملون وقامته الفارعة، انتبه المدير لشيء كبير يتدلى بين رجليه، وجهَّه بعد أن أخذ جواز سفره إلى غرفة التفتيش الشخصي، وأشار برأسه لمحمد الواقف بجدية مفتش متمرِّس، أدخل المسافر إلى الغرفة وأغلق الباب، وبعد لحظات خرج محمد بوجه مخطوف وشعور بالتقزز، بدا كشخص يكاد يقذف كل ما في جوفه.
كان قدر المراقبة يلاحق محمد، فبعد سنوات انتظار الوظيفة الحقيقية عُيّن مُحققًا في وزارة التربية والتعليم، وقد أبدى من البداية امتعاضه وتشككه من هذه الوظيفة..
في البيت أخبرني محمد عن السبب، كانت التعليمات تقتضي أن يدخل يده تحت ملابس المسافر الأفريقي، وبحكم أن الشكوك تحوم حول ذلك الشيء الذي يتدلى بين رجليه، قبض محمد عليه بقوة، وهو متأكد أنه يخبئ شيئا كبيرًا، إذ كان واضحاً رغم اتساع ملابسه الإفريقية الفضفاضة، وبمجرد أن قبض محمد على ذلك الشيء صرخ الإفريقي وانتفض جسمه بالكامل، وكأن يد محمد قبضت على جزء من جسده، كان التفسير المنطقي حينها أن هذا المسافر المسكين كان يعاني من فتق في منطقة الخصية أو ما يسمى علمياً بـ (الفتق الأربي)، وصحيح أننا ضحكنا وتندرنا على الموقف الغريب، الذي لا يخلو من طرافة، إلا أن ذلك اليوم البعيد كان آخر أيام أخي محمد في الوظيفة الصيفية.
لكن قدر المراقبة كان يلاحق محمد، فبعد سنوات انتظار الوظيفة الحقيقية عُيّن مُحققًا في وزارة التربية والتعليم، وقد أبدى من البداية امتعاضه من هذه الوظيفة، فالشاب الذي درس مقدمة في القانون الدولي، وأنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي، والعلاقات الدولية، ومواد أخرى تخوِّله أن ينضم إلى وزارة الخارجية، ويكون ممثلاً دبلوماسياً في يوم من الأيام، انتهى به الحال إلى فتح تحقيق مع معلِّم متغيِّب عن العمل لفترة طويلة، أو مدير مدرسة أقدم على ضرب طالب، أو طالب متهم بإحراق سيارة أحد معلميه. ومع مرور السنوات في هذه المهنة أصبح هذا الأخ متشكّكاً بصورة دائمة من كلّ ما حوله. وقد لمست فيه هذا التشكك مبكراً، فيما بعد صرنا نتحدث معًا لفترات طويلة حول مفاهيم كبرى كثيرة، واستمتع بتشككاته.
أعين مفتوحة على الدوام
كنا نمشي سوياً بسيارته البيضاء (النيسان صني 2001) في شوارع جدة، ونحاول تحليل مفهوم المراقبة، الذي باتت التكنولوجيا تلعب فيه دوراً محورياً، حيث تتوزع على جانبي الطريق وعند الإشارات المرورية، كمية مهولة من كاميرات المراقبة، التي يبدو من شكلها الخارجي أنها وضعت لتنظيم المرور، وضبط المخالفين لنظام السير، لكنها في جوهرها مفزعة، فهي أعين مفتوحة على الدوام، لا يرمش لها جفن لا ليلاً ولا نهاراً.
لدى محمد في سيارته، شريطان فقط، أحدهما للمنشاوي على مقام النهاوند مكتوب عليه (سورة الكهف)، والآخر لنجاة الصغيرة (تفرق كتير) ألحان سيد مكاوي، وكلمات عبدالوهاب محمد، ولن أكون مبالغاً لو قلت أن محمد يعشق نجاة الصغيرة إلى درجة التقديس. اقترحت عليه أن تبدأ رحلتنا لاكتشاف المكان بطريقة غير تقليدية من بيت العائلة الكبير في حي النزهة بالقرب من شارع حراء إلى مقر عمله في الرويس على شارع حائل الرئيسي، لكنه اعترض على فكرتي، وسألني: “هل تعرف شارع السيرة العطرة؟”، فأخبرته أن اسم الشارع يبدو محفِّزاً، ضحك وقال: “لا تغرَّك أسماء الشوارع في جدة، فشارع السيرة العطرة أشهر شارع لبائعي العرق الأثيوبيين”، ضحكنا ثم انطلقنا جنوباً، وتركت له اختيار الطريق والرحلة.
الرحلة مع محمد، وفي جو من التحفُّز للاكتشاف، تبدو لطيفة من حيث المبدأ، لكن الواقع سيخبرني بعكس ذلك، فطريقته في الوصول تبدو غريبة؛ ولهذا اخترت -متعمدًا- أن يكون رفيقي في الرحلة، طبعاً كنت أود اكتشاف المكان وربما الكتابة عنه، “متحبنيش كدا حب عادي زي حالة ناس كتير”، اختلط صوته بصوت نجاة، وبدأ السير ضمن خارطته النفسية الخاصة التي تتجنب السير في الشوارع الرئيسة. فلو أننا استعملنا تطبيق (google maps) لتحتّم علينا السير عبر شارع (الستين) – وهذا اسمه الشعبي، لأن اسمه المدوَّن على اللافتات هو (شارع الملك فهد)، وأعتقد أن في هذه التسميات الشعبية والإصرار عليها، نوع من الاعتراض الضمني الذي يتكوَّن بوعي جمعي غير منطوق – وصولاً إلى شارع (ولي العهد) الذي سيسلمنا إلى شارع (الجامعة) ومنه عبر شارع (المحاماة) حتى مقصدنا شارع (السيرة العطرة)، في فترة زمنية تقترب من أربعين دقيقة.
لكن حساسية محمد مدربة على تلافي كلّ هذه الشوارع المليئة بكاميرات الرصد الآلي، التي يحتاج تجاوزها بسلام إلى شخص متقيّد بالنُظُم، ولديه قدرة على الوقوف في صفوف طويلة من السيارات دون ملل، وهذا ليس من شيم أخي الكريم، الذي استغرقت الرحلة بصحبته أكثر من ساعتين.
في الطريق أخبرت محمد عن بعض الأخبار الغريبة التي جمعتها على عجل، عن قصصِ الناس مع كاميرات الرصد الآلي. أخبرته عن المرأة التي تقدمت بشكوى رسمية ضد زوجها الذي بينها وبينه قضية خلع في المحكمة، والتي تفاجأت بأن رصيدها من المخالفات المرورية بلغ ربع مليون ريال سعودي، ففي خلال أسبوع واحد، استطاع الزوج المخلوع – أو الذي يقترب من الخلع بحكم أن قضيته لا تزال مشرعة – أن يقود سيارته المسجلة باسم زوجته، في شوارع جدة، غير عابئ بالكاميرات، ما جعله مثالاً للزوج المغدور. ضحك محمد ، وأضاف “من كان له حيلة فليحتل!”. وأخبرني هو بدوره أن هناك امرأة في مدينةٍ أخرى، قامت بنفس الفعل، بعد علمها بارتباط زوجها بزوجة أخرى، أضفت أنا: “ملعوبة!”.
باركور وتخريم
لم تكن مخاوفي أنا ومحمد مخاوف تتعلق بخيانة الزوجات، مخاوفنا تتعلق بمستوى الفزع من عملية المراقبة المستمرة، أن تكون تحت وطأة الرصد المستمر، صحيح أن هذا الرصد يتعلَّق بالتنظيم المروري أو هكذا يبدو، بيد أن للموضوع بعدًا نفسياً آخر، فبالنظر إلى عدد الكاميرات الهائل والذي نقابله فور خروجنا من منازلنا، يجعلنا مراقَبين ومراقِبين بدورنا. نرقب شبحًا غير منظور ، وبينما يمتلك هذا الشبح آلةً هائلةً مجهزةً بأحدث التقنيات، نقبع نحن تحت وطأتها عزَّلًا، ولكي نهرب من هذه المراقبة المستمرة علينا الاختيار بين مخالفة الأنظمة، أو الهرب منها، وهذا على الأقل ما يفعله محمد، ففي رحلتنا كان يخترق الحارات حارةً بعد أخرى، لا يسلك الطُرق الرئيسة إلا من أجل أن يبحث عن مدخل جديدٍ لحارةٍ أخرى، عبَّر محمد عن هذا الفعل باسم (التخريم)؛ بمعنى أنه يخترم الحارات اختراماً، بدلاً من سلوك الطرق العامة، التي اختارها النظام ملعباً للمراقبة المستمرة.
مررنا بشوارع جانبية كثيرة، لبعضها أسماء غريبة، ومن بين هذه الشوارع مررنا بشارع اسمه (شارع المؤلفين) ضحك محمد وقال لي: “هذا شارعكم ابسط يا عم”، قلت له: “لعل الشارع سمي بهذا الاسم رفعًا للحرج بسبب كثرتنا”.
على الباركوري الماهر أن يتعلّم كيف يتحكم في عقله بالطريقة التي تجعله يتقن هذه الرياضة المحرّمة دولياً بسبب خطورتها، ولعلها محرّمة لأسبابٍ أخرى، من ضمنها فلسفتها الثائرة على الطريق في شكله الذي تنظمه المؤسسات الرسمية، وتتحكم به..
سألته عن مدى معرفته برياضة (الباركور) وأخبرته أن لدى ممارسيها موقفًا مشابهاً لفكرة (التخريم)، لكن أساليبهم أكثر تعقيداً وخطورة، تعرفت على مبادئ هذه الرياضة قريبًا، وهي مجموعة حركات للوَثَب والقفز وتسلق الموانع يكون الغرض منها الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية.
وبحسب (ديفيد بيل) واضع أسس هذا الفن، فإن روح الباركور تقودها فكرة “الهروب”، حيث تتوَّلد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة، والمهارة للخروج من المواقف الحرجة. وإحدى سمات الباركور الرئيسية هي الكفاءة أو الفعالية (efficiency)، والمقصود بها هنا أن لاعب الباركور لا يتحرك بسرعة فحسب، بل وأيضا يتحرك بالشكل الذي يستهلك أقل قدر ممكن من طاقته، ويوصله إلى هدفه بشكل مباشر، وتقاس أيضا كفاءته بقدرته على تفادي الإصابات، سواء الطفيفة منها أو البالغة.
فلسفة الباركور جزءً لا يتجزأ من هذا الفن. ذلك أن إتقان مهارات الباركور وحركاته، تفضي في النهاية إلى القدرة على التغلب على المخاوف، والآلام، ومن ثم نقل ذلك إلى الواقع وتطبيقه في أوجه الحياة المختلفة. كما أن الباركوري الماهر عليه أن يتعلّم كيف يتحكم في عقله بالطريقة التي تجعله يتقن هذه الرياضة، التي يعتبرها أربابها فناً ورياضة في الوقت ذاته، وهي رياضة محرّمة دولياً بسبب خطورتها، ولعلها محرّمة لأسباب أخرى، من ضمنها فلسفتها الثائرة على الطريق في شكله الذي تنظمه المؤسسات الرسمية، وتتحكم به.
هل يمكن الانتصار..؟
أفكرُ في التقاطعات بين فلسفة رياضة وفن الباركور، ومبادئ الحركة المواقفية التي تأسست على يد جي ديبور، وراوول فانيجم وغيرهما في خمسينات القرن الماضي، القائمة على الجغرافيا النفسية، والتي تقول بأن للمدينة “خريطة نفسية” المُحدِّد فيها هو اختلاف أجواء وتركيبات الأحياء.. فما أن تتحرّك من حي لآخر حتى تتغيّر الأجواء والأزياء والأصوات.. (تخريمات) أخي محمد وتحركاته وفق جغرافيته التي رسمها لنفسه تذكرني بمادئ المواقفيين، فهي بشكل من الأشكال محاولة رافضة وثائرة على ما يوجد في الطريق من مخاوف وعقبات، تعيق الإنسان من ممارسة السير الحر، الذي يحثه على تأمل الحياة من حوله، ولا يمنعه من الاستمتاع بتفاصيله، وبالتالي يحقق وجوده الأصيل.
سألت محمد بعد أن بلغنا “شارع السيرة العطرة” إذا ما كان هذا الفعل الذي يجعله يسفح الكثير من الوقت، مقابل الانتصارات التي أظن أنّها وهمية بشكل من الأشكال، هل تحقق له شيئًا من وجوده ككائن خاص؟ أم أنه بهذا الفعل يحاول أن يقدم اعتراضه الشخصي؟ فرفع كتفيه دون أن يحر جواباً، ثم رفع صوت المسجل حيث كانت نهاية رحلتنا، ونهاية صوت نجاة الصغيرة: “لا يا حبيبي.. لا.. تفرق كتييير”.