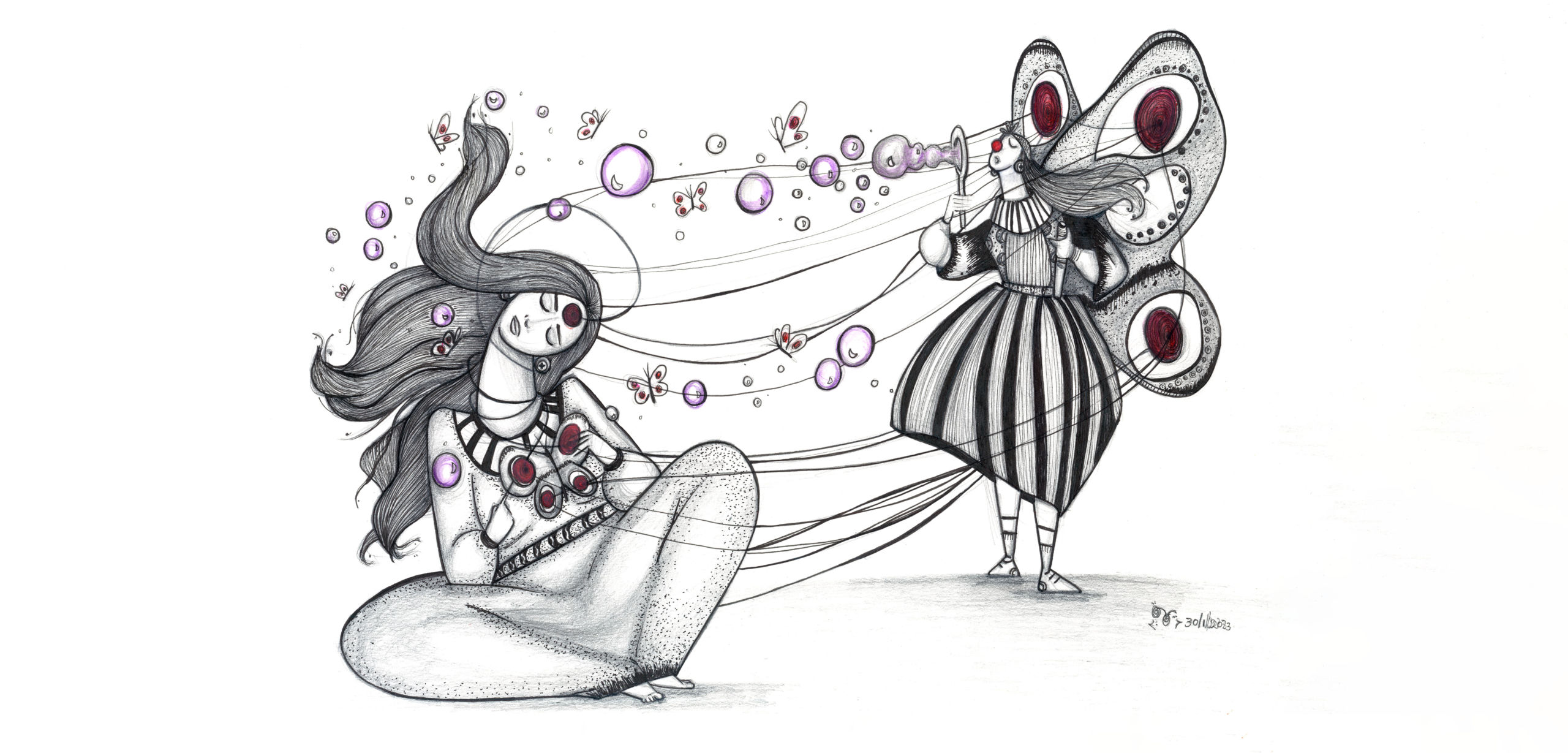القبض على اللحظة التي سمعت فيها المقارنة الأولى بشأن أطفالي ليست بالأمر الصعب. بالعودة إلى ذلك اليوم، حين كانت سيّارتنا تشقّ طرقات دمشق في السادسة صباحاً لنصل إلى موعد ولادتي الأولى المُرتقب، كانت أشدّ مخاوفنا في تلك اللحظات الوصول إلى وجهتنا آمنين، فسماء دمشق لم تكن لتُنذر أحد قبل إطلاقها رشقات الهاون على رؤوس قاطنيها في تلك الأيام من سنة 2017.
بعد مرور دقائق أجزم أنّها لم تتجاوز الخمس من إنجابي لطفلي البكر، مخدّرة بشكل جزئي على طاولة العمليات، وغارقة في مشاعر اختبرها للمرّة الأولى، عيناي تغشاهما دموع ثقيلة حالت بيني وبين إلقاء نظرة أخرى على ملاكي الجميل الذي قابلته لثوانٍ خاطفة لحظة خروجه مغطّى بدمائنا معاً، في تلك اللحظات أخبرتني الممرضة -في غفلةٍ من الطبيبة التي أشرفت على ولادتي ربّما- عبارة بدت في حينها رغم فجاجتها عفوية للغاية: لا تزعلي بس ابنك أسمر شوي!
خُلقت بذاكرة تمتلك استعداداً فطرياً لغربلة المواقف والذكريات المؤلمة والمربكة على حدٍّ سواء. فهي تقوم بفلترة كل ما من شأنه أن يجلب لي حزناً أو إزعاجاًَ لا طائل منهما. يسقط من هذا الغربال الدقيق في بعض الأحيان خيط رفيع من ذكرى هنا أو هناك فأستعيد سيلاً دافقاً من ذكريات عشوائية مكتومة، الأمر الذي يدفع بي إلى إعادة صيانة غربالي بصورة أكثر إحكاماً ودقة من جديد.
لكن تلك العبارة التي قيلت لي في لحظات أمومتي الأولى، والتي لم أدرك ماهيتها لحظة النطق بها، جعلت غربالي يشعر بشيء من الحيرة إزاءها، فهو قبل أن يقوم بابتلاعها إلى جوفه يتعيّن عليه التعامل معها للمرة الأولى. ما كنه هذه العبارة أو الملاحظة؟
فالعبارة التي افترضت أن لون ابني الأسمر مدعاةً للحزن غريبةٌ، ذلك أن الاسمرار لم يحمل لي يوماً مدلولات سلبية رغم معرفتي باستعلاء البيض أو ذوي البشرة الفاتحة في معظم أماكن الأرض، ولطالما ردّدت كغيري أغانٍ تغنّت بجمال السُّمر، وتجاوزت ملاحظات التمييز بيني وبين شقيقتي السمراء لأنّني لم أستطع فهم الأمر سوى أنّه مجرد لغوٍ في الكلام.
الأمر لا يتعلّق بفجاجة تلك الحمقاء فهي وإنّ قيّض لها امتلاك المقدرة على التعبير الملطّف لما كانت عبارتها أقلّ إيلاماً لي. ففي لحظة كانت ومازالت أجمل لحظات حياتي، سمحت إحداهنّ لنفسها بإطلاق ملاحظة فيها انتقاص من نوع ما لطفل يبلغ من العمر خمس دقائق. لكن العبارة الغرائبية تلك لم تكن سوى بداية الفصل الأوّل من مجلّد ضخم يحمل اسم: “المقارنات”.
في بداية أمومتي لم أكن أقوى على إتمام الرضاعة الطبيعية كغيري من الأمّهات فوسِم طفلي بأنّه: “المسكين الذي تغذّى على الحليب الصناعي”.
لاحقاً تأخّرت أسنانه بالظهور وعندما بزغ بياضُ سنّه الأوّل، انتبهنا لتأخره في المشي، وكأن هنالك ساعة محدّدة بتاريخ معين يتوجّب فيها على الطفل أن يستوي فيها واقفاً مُتأهّباً ليخطو خطواته الأولى.
لكن كلّ تلك “التأخيرات” الطفيفة كانت مجرد بروفا للتأخّر الأكبر الذي غيّرنا إلى الأبد كأهل، ووضعنا في امتحان مع الصبر والوعي الذي لم نكن نمتلك الكثير منه: “تأخّر الكلام”.
لا أذكر تحديداً متى نطق كلماته الأولى والتي يُفترض بها أن تكون “ماما” أو “بابا” ذلك أنّه كان يرشق مقاطعه الصوتية المُحببة بصورة مكثّفة على مدار الساعة كما لو أنّه يتكلم لغة حقيقية لكن مجهولة تماماً بالنسبة لنا. في البداية كان الأمر مضحكاً فوسم: “الطفل الصيني” لم يحمل في طيّاته أذى مباشر.
لاحقاً أصبحت الحياة أشبه بزجاجة مضغوطة مُعبّأة بالصراخ. فطفلنا لا يتقن التعبير عن حاجاته إلّا بالإشارة لها، وحين باتت الإشارة لا تكفي لتلبية رغباته التي تزداد تِباعاً غدا الصياح وسيلة تعبيره الوحيدة، ونحنُ بدورنا بادلناه الصراخ.
بدأت رحلتي مع الأطباء والاختبارات عندما أتمّ عامه الثاني؛ أطباء نفسية وعصبية، اخصائيّ لغة ونطق، اختبارات السمع والسلوك. لا شيء يشير إلى مشكلة معينة. وقد كان لهذا التشخيص أن يحمل معه الراحة لولا أنّنا نقطن في سوريّا، حيث الشكوك تساور الجميع أنّه لم يتبق في هذه البلاد من يصلح من الأطباء أو غيرهم حتّى، فاتّجهنا إلى بيروت، ولو أننا امتلكنا جواز سفرٍ يحملنا إلى مكانٍ أبعد لحلّقنا بطفلنا إليه.
دخل طفلي عامه الثالث وزوّادته من الكلمات معدودة، بالكاد تكفيه للتعبير عن حاجات أساسية محدودة جداً، في حين كان قلبي يُجلد بشكل آلي يومياً لدى سماعي وابل من التعليقات تقارن بين ابني وأقرانه من الأطفال مِمّن يسترسلون بوضوح ويروون لمن حولهم قصصاً وأغانٍ. “لو دربتِ ببغاء على الكلام لتعلّم كلمات أكثر من طفلك”.
أحياناً كنت استسلم للأمر رأفةً بطفلي وبحالي، لكن الآخر كان دوماً يتربّص بي ويُشير باصابع الاتّهام ودون مواربة بأنّ لي يداً في هذا التأخر اللغوي: “لقد تعرّض طفلك لساعات طويلة من مشاهدة الشاشات”.
حين كُنا نعود إلى منزلنا بصمت ذاهل مُثقلين بالتعليقات الحمقاء، الانتقادات والمقارنات، كنت أشعر وكأنّما دخلنا كهفنا الزجاجي الخاص بنا، مكاننا الذي حاولت جاهدةً أن أعوض داخله السوء الذي تعرّضنا له في الخارج، وأعوّض السوء الذي شعرت به لأنّي لم أكن خير أمّ لطفلي، لأنّي لم أصفع الفم المليء بخراء الانتقاد والمقارنة، لأنّ الحياء تملّكني ولأنّي شعرت أنّي لا أدري وأنّ الآخر أكثر دراية وخبرة منّي، لأنّ نفسي امتلكت بالشكوك، ولأنّ روحي القلقة غادرها الإيمان إلى الأبد.
في فضاء المنزل كان نوعاً آخر من المعارك يدور وسؤال واحد لا سبيل للإجابة عنه: لماذا أنا؟ أو لماذا نحن؟ خيّم علينا شعور غامر أنّ طفلينا محكومان بالتأّخر، تأخر من نوع ما يجعلهما ممهوران بدمغة خاصة تدفع الناس للسؤال إما بفضول أو بعطف أو بحذر عن حالهما!
رُزقت بطفلي الثاني بعد ثلاثة أعوام. حبيبتي الجميلة التي خطفت أنفاسي منذ اللحظة الأولى فكانت أجمل ما وقع عليه نظري. لحسن الحظ لم يخبرني أحد لحظة ولادتها بأنّها سمراء، قصيرة هزيلة، مُمتلئة، بل جاءت حصّتها من المقارنات مع شقيقها، هكذا كانت البداية على الأقل. ولأنّ قلبي تمرّس على سماع الملاحظات والانتقادات أصبحت أقلّ حدّة بل اعتبرته أمراً قدرياً لا مناص منه.
بنتك أحلى من ابنك، كأنّه بنتك قصيرة كتير.. ابنك أطول منها منيح، بنتك ذكية لأنها “نظفت” بسرعة، ليه هيك قدّ الكمشة؟ ابنك صحّته أحسن منها..
لكن صغيرتي خبّأت حصّتها من “التأخر” كمفاجأة كبرى جاءت على دفعات. فمنذ الشهر السادس علمنا بأنّ لديها “مرونة في الأربطة”، وهكذا طال انتظارنا حتى تمشي الصغيرة. لكن للمشي مراحل أوّلها أن يقوى الطفل على الجلوس بشكل مستقيم دون مساعدة، وهذا مالم تقو عليه حتى بلوغها عامها الأول، حينها استطاعت الجلوس بثبات طفل بعمر ستّة أشهر.
انتظرنا أن تحبو لكنّها لم تفعل. بدت قدماها الصغيرتان مجرّد كتلتين لحميتين بلا أعصاب، واستطاعت وسط ذهولنا أن تدير أرجلها للخلف استدارة كاملة كما لو أنّها تمتلك مفاصل دُمية باربي لكن دون أن تقوى على الوقوف أو حتى الاستناد.
الأطباء لم يجمعوا على تشخيص واحد. البعض أرجع الأمر لنقص حاد في فيتامين “د”، آخرون نسبوا الأمر لفرط ليونة العضلات، ومنهم من ذهب إلى تشخيص مفاده: نقص في المادة البيضاء في الدماغ يُسبّب تأخراً في تحريك الأطراف السفلية من الجسم. “كل ما عليكم فعله في الوقت الراهن هو الانتظار”. هذا ما قيل لنا وكأنّما بالإمكان عمل شيء سوى ذلك نحن الذين اتقنّا فنّ الانتظار.
لكن الحشود خارج باب المنزل لم تتقنه. صديقات مقرّبات، أفراد العائلة، الأقارب والجيران.. استبدلوا بكلمة “صباح الخير” عبارة: ” مشت بنتك؟”. حتى الأمّهات اللواتي يرافقن أطفالهن في ساحات اللعب لم يتوانين عن استنكارهنّ البريء المتنكّر في حلّة السؤال: لماذا تحملين طفلتك طوال الوقت. خلّيها تمشي! وكأنّهنّ هنّ من يحملنها على ظهورهنّ.
هل تحوّلت تلك الذكريات إلى مادة للتندّر؟ ليس بعد. لأصدقكم القول أنا أبكي حين استرجع صور مبعثرة من تلك الأيام. هذا القلق أصبح سمة للحياة، حياتي التي أصبح من غير الممكن التفكير فيها ببُعد فردي. لقد أصبحت وجهاً من شكل ثلاثي الأبعاد لا ينفصم ..
وهكذا تمّ كسر روتين السؤال الذي رافقنا طويلاً “حكا ابنك؟” واستبداله بسؤال المشي، لتغدو محبّة الناس وجهاً آخر للإزعاج المؤلم البغيض ولتتحوّل معه أبسط العبارات على شاكلة: “كيفك اليوم” فتصبح مدعاة للثورة والغضب.
في فضاء المنزل كان نوعاً آخر من المعارك يدور وسؤال واحد لا سبيل للإجابة عنه: لماذا أنا؟ أو لماذا نحن؟ خيّم علينا شعور غامر أنّ طفلينا محكومان بالتأّخر، تأخر من نوع ما يجعلهما ممهوران بدمغة خاصة تدفع الناس للسؤال إما بفضول أو بعطف أو بحذر عن حالهما!
وإنني لأتساءل مع ذلك، عمّا إذا لا قدّر الله كان الأمر أكبر من مجرّد تأخر.. أنا نفسي-حتى لا أمضي بعيداً- كُنت أنظر بعين المُقارن حين أدخل تلك العيادات والمختبرات وأماكن إجراء فحوصات التأّخر المختلفة.
آباء وأمّهات البعض منهم جاء من أقاصي الرقعة السوريّة في وقت كان الوصول فيه إلى دمشق رحلة غير مقدّرة العواقب، يحملون أطفالاً البعض منهم يعاني اضطرابات وإعاقات خلقية بدرجات مختلفة..كنت أجلس على مقربة منهم أتحاشى النظر إليهم حرجاً واستحياءً وخوفاً..تقترب منّي أمي التي تجلس بجواري لتسرّ في أذني: “احمدي ربّك ابنك مو متلهن”.
لو أنّ الله خصّني بحمل أكبر كيف كان لظهري أن يستقيم مُجدداً؟ لو أنّ ابني أو ابنتي “مثلهم” وجلست في عيادة على المقعد المقابل لسيدة تسرّ في أذن ابنتها تلك العبارة التي قالتها لي أمّي، كيف كان لي أن أقوى على الرّد. كيف كان لي أن أكمل الرحلة؟
خاطر آخر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه.. ماذا لو أنّني لم امتلك رفاهية زيارة الأطباء وإجراء الصور والتحاليل والاختبارات في بلاد أصبحت فيها علبة حليب الأطفال مادة ثمينة نادرة، في بلاد عاد إليها شلل الأطفال بعد أن كان هذا المرض نسياً منسياً.
هل أنا درامية أو بصورة أدق هل أنا هشّة؟ نعم ربّما في كل ما يتعلق بأطفالي. هل هذه الأفكار التي تعصف بي بشكلٍ دائم مردّها الخوف الذي اكتسبته من رأي الآخرين بأطفالي، فأسبقهم بإقامة تلك المقارنات ومداراة ما قد يكون نقصاً أو تأخّراً وربما حجبه أو تغطيته، أم أنّني ببساطة لستُ سوى نسخة عن الآخرين؟ ربّما نعم أيضاً.
قارب طفلي عامه السادس. يتكلّم الإنكليزية بطلاقة لا امتلكها أنا، أما عربيته فهي خليط من الضمائر العجيبة والحروف المُكسّرة. جميلتي الصغيرة تتمّ عامها الثالث قريباً. قبل أشهر قليلة وبعد العشرات من الاستشارات والمعاينات الطبّية وبعد أسبوع واحد من إجرائنا تصوير للرأس بالرنين المغناطيسي اقتضى تعريضها للتخدير العام.. هكذا فجّأةً قررت تلك الصغيرة، الصغيرة جداً حرفياً، قررت ذات يوم أن تمشي، بدون حتى إشارة مسبقة أو تحسّن تدريجي. هكذا فقط استندت إلى ذراع الأريكة المنخفضة واستقامت ودقّت الأرض بخطوات بطريق صغير، خطوات بطيئة ومرتجفة اهتزّ لها القلب وبكى.
هل تحوّلت تلك الذكريات إلى مادة للتندّر؟ ليس بعد. لأصدقكم القول أنا أبكي حين استرجع صور مبعثرة من تلك الأيام. هذا القلق أصبح سمة للحياة، حياتي التي أصبح من غير الممكن التفكير فيها ببُعد فردي. لقد أصبحت وجهاً من شكل ثلاثي الأبعاد لا ينفصم. وأدرك يقيناً أنّ تأخّراً ما أو مجّرد اختلاف أو تغيّر معين صعوداً أو نزولاً سيرافق أبناءنا في مراحل مختلفة من الحياة.. لأنّنا لم نخلق لنشبه بعضنا بعضاً. بقيّ عليّ أن أتغيّر أنا.