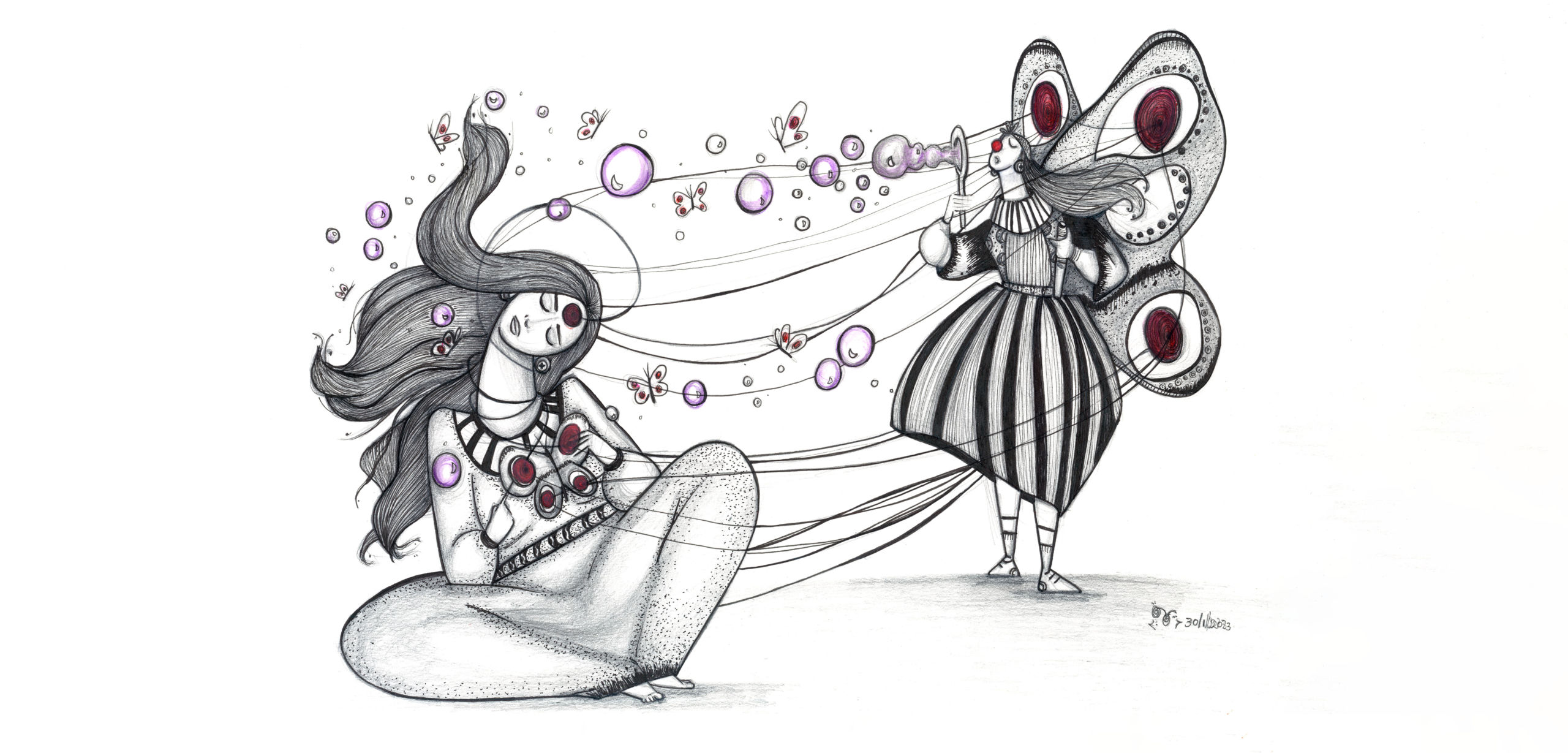منذ نيسان (أبريل) 2002 وأنا أحتفظ في داخلي بزيارة لمخيم جنين شماليّ الضفة الغربية. أتذّكر أن عمّي دخل ساحة منزلنا في بلدة كفر راعي وقال إنه عاد لتوّه من المخيم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أرضه. حاول أن يروي لنا ما شهده هناك لكن لسانه تلعثم وصوته أخذ بالارتجاف إلى أن تلاشى تماماً.
اكتفى بالقول إن “المناظر مش ممكن وصفها”، وبقينا نحن سكان البلدة التي تبعد حوالي عشرين كيلومتراً عن مدينة جنين والمخيم المجاور لها جالسين في منازلنا نتابع الأحداث عبر التلفاز والإذاعات، نردّد وراءه أن “الحكي مش متل الشوف”.
كانت القصص الواردة من جنين -والمرعبة في فظاعتها- تتزاحم على الألسنة خصوصاً بعد أن بدأت البعثات والوفود من قرى ومدن فلسطينية تدخل المخيم في الأشهر اللاحقة. كانت الأرقام متضاربة بين رواية الأمم المتحدة التي تحدثت عن مقتل 58 من المدنيين الفلسطينيين واعتُبرت رواية منحازة للجانب الإسرائيلي، وبين الرواية الفلسطينية التي تحدثت عن أكثر من 500 قتيل.
رأينا على الشاشات الزوار ومبعوثي المنظمات يعتلون الأنقاض ويتفحّصون آثار الحصار الذي دام نحو أسبوعين ومُحيت خلاله كامل المنازل والبنى التحتية، بل إن بعض البيوت هُدّمت فوق رؤوس ساكنيها وبينهم جرحى ومعوّقين، ويمكن القول إن المكان الذي بناه اللاجئون الأوائل من حيفا وما جاورها قد اختفى تماماً.
انشغل الفلسطينيون بعدها بموت الزعيم ياسر عرفات في 2004 ثم بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وما تلاها من انقسام فلسطيني في 2007، أما أنا فتوجهت لمتابعة دراستي الأكاديمية بعيداً عن جنين وما يحدث فيها.
ورغم زيارتي المتقطّعة للمدينة بغرض التسوق والعلاج ولقاء الأصدقاء، لم أستطيع الركوب في تاكسي يأخذني إلى المخيم الملاصق لها، لكن الزيارة تحققت عام 2021 مع مجموعة من الصحفيين في جولة على المخيمات الفلسطينية.
مخيم جنين. المصدر: francis mckee. وفق رخصة المشاع الإبداعي
مسافة قصيرة ومسار مختلف
في المرّة الأولى التي اجتاز فيها حدود المخيم وأتحدث لأهله لم أستطع كسر حاجز الغربة عن المكان وقلّة معرفتي الجغرافية وحتى السياسية به، فالأحوال تبدّلت كثيراً.
لا تستغرق الرحلة بين مدينة جنين ومخيّمها أكثر من خمسة دقائق. تنطلق حافلة النقل العمومي من كراج المدينة، تعبر دوّار السينما ثم تمرّ بمشفى جنين الحكومي الشهير وبعده يأتي المخيم. عادةً هذه المسافة تُقطع بربع ساعة سيراً على الأقدام للالتصاق الوثيق بين المخيم والمشفى الحكومي، لكن بعد محوه بالجرّافات في حصار 2002 أعيدت هندسة المكان بالكامل. صار الانتقال بين منزل وآخر يتطلب أحياناً ركوب باص أو سيارة أجرة، ولا بد من القول أن المقابر صارت أيضاً أكثر اتساعاً.
يصعب الحديث إلى أي شاب أو شابة هنا دون استعادة فترة الحصار التي دامت 12 يوماً وتلاها الاجتياح. يكاد الأمر يحضر مع كل مناسبة حتى لو كان الكلام عن أمورٍ يومية، دوماً هناك “قبل الاجتياح” و”بعد الاجتياح”.
فكّرتُ بأن معظم من التقيهم هنا كانوا أطفالاً سنة 2002 وبالكاد يذكرون ما حصل، بينما معظمهم اليوم عاطل عن العمل، وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 60 بالمئة بحسب تقدير اللجنة الشعبية للمخيم، لكن مع ذلك قلّما يتحدثون إلى الإعلام عن حياتهم اليومية.
في المقابل تحضر أجواء الاستعداد والترقّب لاقتحام جديد، ويحضر الحديث عن أسرى المخيم في سجون اسرائيل الذين يبلغ عددهم نحو خمسمائة (من أصل نحو 4450 أسيراً فلسطينياً)، بينهم ثلاث نساء وعشرة أطفال.
في الزيارة الثانية التي قمت بها قبل أيام، تكررت المشاهد نفسها والأحاديث ذاتها تقريباً. كان غرضي إنجاز تقرير عن الإهمال الطبي الذي تعرض له أسرى في سجون إسرائيل أصيبوا بالجنون أو الاعتلال المؤدي إلى الموت المفاجئ، لكن اللقاء بالشابين إسلام ضبايا ومحمود أبو كامل وبالسيدة مريم الدمج جعل قصّتي تأخذ مساراًَ مختلفاً.
الكلام معهم كشف عن بقايا جروح في أجسادهم لم تندمل، أو جروح اندملت على غير طبيعتها.
قلب أخفّ من الريشة
صعدت الدرج في حارة “الحواشين” حتى وصلت إلى منزل السيدة مريم الدمج (في الخمسينيات من عمرها)، يبعث بيتها المنظمّ على الراحة والهدوء. جلست في الصالون وانتظرت وصول السيدة مريم، إحدى الشاهدات على اجتياح المخيم ودماره. كان النسيم البارد يتسلل من النافذة المفتوحة تختلط فيه روائح أشجار التين والليمون والسرو الصيفية، حتى بدا انتظار مريم مستحقّاً.
وصلت مريم وهي تلهث بعد صعودها عدّة درجات. تركت عصاها أسفل الدرج واتكأت على “الدرابزين” لتصل الطابق الأول. قبل عشرين عاماً في بيتهم القديم اختبأت مع عائلتها وآخرين في تقعيدة البيت، شرحت ذلك في أول حديثها ثم قالت “كل من عاش معركة جنين كان يعرف أنّه سيُصاب أو يموت، لهول الطائرات والصواريخ التي قصفت المكان”، ثم أصبحت هذه الجملة متوالية.
استهدف بيتها صاروخ طائرة “أباتشي” الحربية، فخرجت هاربة مسرعة وعند نهاية الشارع أصابتها شظية فصلت قدمها تقريباً عن الساق. كانت الساعة حينها الثانية فجراً، تقول “لا أدري إن أغمي عليّ أم ماذا”.
في الصباح، عثر عليها مسعفون متطوعون ونقلوها إلى منطقة شبه آمنة، طهّروا لها جرحها بمواد معقمّة ولفوّا قدمها، ثم فجأةً قبضت عليهم قوات الاحتلال، اعتقلوهم جميعا، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم وهي تعيش ما أسمته بـ “صدمة الدبابة”.
تقول “كان زوجي من بين المعتقلين، وقد ألّح علي ضابط الجيش أن ينقلني للمستشفى، وهذا ما حدث، لكنهم استخدموني درعاً بشريّاً. وضعوني فوق الدبابة وذهبوا بي من شارع لآخر. في تلك اللحظات نسيت إصابتي المؤلمة وتذكرت الآيات والأدعية التي حفظتها، لعلّ الله ينقذني من جريمة قد يرتكبوها بحقي”.
على حدّ وصفها، كانت جريئة وشجاعة أيام الحصار، تتنقل من بيت لآخر تطمئن على جيرانها وتعد الطعام وتخبز الأرغفة للجميع من حولها. حتى زوجها كان يمازحها بين الحين والآخر “إن أصبتِ لن أسعفك“، لكن تثبيت جسدها فوق الدبابة كسر شجاعتها، وتحوّل قلبها من صخرة إلى “أخفّ من الرّيشة“.
مريم الدمج. تصوير: وصال الشيخ
الجسد يرمّم نفسه
تتقمص مريم دور النائمة والغائبة عن المكان كلما سمعت نبأ اقتحام الجيش للمخيم. يعود الخوف الذي يغلّف قلبها منذ سنوات طويلة ولم تتخلص منه. تقول “أصاب بالاكتئاب مباشرةً.. لقد انكسر قلبي منذ ذلك الوقت”. الصدمة لا زالت حاضرة بقوّة، إلى جانبها أيضاً تلك اللحظة التي قرر فيها الأطباء بتر قدمها للأبد، قبل أن يتراجعوا عن ذلك ويقوموا بإعادة ترميمها باستخدام البلاتين وأجزاء من الجسم.
بينما تحدثني عن خوفها حضرت بقوّة في ذهني لوحة “الصرخة” لإدوارد مونش. تقول مريم “أشعر أن أحداً يخنقني”، لكني كنت أسمعها تصرخ محاولة أن تصف شعورها دون أن يفهمها أحد. داخل هذه اللوحة، أصبحت مريم تتعايش مع قدم أقصر من أختها بسنتمترات. آثار عمليات زرع البلاتين وترميم العضل والعظام في قدمها واضحة للعيان. في أماكن أخرى من جسدها ظهرت نتوءات وأماكن أشبه بالحفر عندما لجأ الأطباء إلى استعارة أجزاء من جسدها.
خضعت مريم لثلاث عمليات متتالية على حساب الحكومة الفلسطينية وفق المادة (22) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، حيث “رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي”.
مرّ عام على قدمها ملفوفة بالجّبس، “عام من اللاحركة والحياة اللاطبيعية أمضيتها بالبكاء المتواصل. كان ذلك رفضاً لأنّ تكون حياتي قد تغيرت كلياً”. منذ ذاك الوقت وعائلتها ترعاها وتقدم لها احتياجاتها، تقول “انقطعت عن أعمال البيت نهائياً وتعطلت عن المشي كما السابق. ابنتي تتولى رعايتي.. لقد حُظيت بزوج وعائلة حنونين، يكفي أن أتوضأ وأساعد في القليل من الأعمال البسيطة”.
حاولت مريم التعايش مع إصابتها وتقبلها، فانطلقت نحو اسكافيّ تطلب منه تصميم حذاء يناسب القدم القصيرة، لكنه بدا يشبه “بوط” الرجال فتركته واستبدلته بعصا تتكئ عليها في مشاويريها اليومية.
عادت إلى المخيم تحقيقاً لرغبة زوجها، فقد وسّع الطرفان منزلهما وأسّسا لحياة جديدة اعتادت فيها مريم على إصابتها طالما لا تؤلمها، واعتادت العلامات التي تشوّه ساقها بأكمله. لقد نالت مشارط الأطباء وخياطة العمليات والترميم من طبيعة قدمها المغطاة بعباءتها الطويلة.
ترى مريم رجلها القصيرة “فأل خير”، كان من الممكن أن تكون ميتة بدلاً عن ذلك. تشعر أحياناً بألم خفيف في منطقة الكاحل يشبه وخز الإبر والدبابيس، قرأتُ مرّةً أنه يسمى بـ “الألم الوهمي”، يأتي من الشعور بالجزء المبتور الذي لم يعد موجوداً. كان الأطباء يعتقدون أن هذا الألم مجرّد اضطراب نفسي لكن تبين لاحقاً أن النخاع الشوكي والدماغ يشعران به حقاً.
إلى جانب هذه الوخزات لدى مريم جروح داخلية يصعب حجبها. تقول: “حياتي كئيبة، غير مستقرّة، أشعر أني مهددة دائماً. لقد حققت رغبة زوجي بالعودة إلى المخيم، واليوم بعد وفاته وكلما سمعت أنباء عن تحضيرات جيش إسرائيل لاقتحام المخيم أهرب إلى بيت ابنتي المتزوجة في مدينة جنين. لن أكرر صدمة عام 2002″.
انعدام الجاذبية
يأخذ “جسد الجريح” معنى مختلفاً وكذلك “جسد الشهيد” عندما تحيط بهما هالة من القداسة بالنسبة لسكان المخيم وللفلسطينين عموماً، وإن كانت بدرجات، فإصابة الجريح وألمه كناية عن مجد الفعل الذي قام به، بينما تحظى الأعضاء المبتورة بتقديسٍ أكبر وتسبق صاحبها إلى الخلود.
لا يختلف الأمر عندما قابلت مريم ومحمود وإسلام. تحمل إصاباتهم سمات خاصة مثلما يعاملهم الناس من حولهم في المخيم بتقدير ملحوظ إذ ترتبط الجروح لديهم بذكرى مجزرة أو اقتحام أو اشتباك. النظر إليهم يعيد التذكير بما حصل، ويطرح أسئلة عن ظروف الإصابة، معجزة النجاة، وعن حقّ الإنسان في الحياة، أما الأعضاء التي تعرضت للتلف فهي الطريق الأقصر لفهم تجريب أسلحةٍ حديثةٍ على الأجساد.
إسلام ضبايا ومحمود أبو كامل، شابّان من مخيم جنين، أصيبا خلال اشتباكات متفرقة مع قوات الاحتلال على أرض المخيم. محمود في اشتباك عام 2014، وإسلام في 2018.
كنت أحاور معجزتين ناجيتين من موت محقق، إسلام أعلنوا استشهاده سريعاً لكمية “البرابيش” التي أوصلوها في جسده وشدة النزيف وتفتت أعضائه الداخلية نتيجة رصاصة دخلت ظهره وخرجت من بطنه. كذلك محمود عندما أصابته قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال بإحدى عشر طلقة من “مسافة صفر”. صوّر لي مشهد إسعافه قائلاً إن أجزاءً من لحمه تركها على الإسفلت. وصل محمود المشفى، وبعد لحظات أعلنوا عن استشهاده أيضاً.
عادةً يوضع الجثمان في ثلاجة الموتى إلى حين انتهاء الإجراءات الرسمية ثم يبدأ تشييعه نحو مثواه الأخير. في لحظةٍ ما نتيجة نزيف داخليّ سعل محمود بخفة، فعادت له الحياة وللباكين من حوله.
مرّ زمن ثقيل على الشابين أثناء تلقيهما العلاج في مستشفيات الضفة الغربية. مكثا عدة أشهر في غرف العناية الفائقة وغرف العمليات وجلسات التدليك الطبيعي، خصوصاً محمود الذي أصيب بشللٍ في الجزء الأسفل من جسده سببته الطلقات الموزعة على عموده الفقري وبطنه.
فور خروجهما من المشفى اعتقل الشابان، لكن جروحهما الطرية شفعت لهما أثناء الحكم عليهما في محاكم الاحتلال فقد سُجِنا لمدّة عام أو يزيد قليلاً رافقها شعور بالسجن داخل الجسد نفسه.
مثلاً كان على إسلام (30 عاماً) أن يمسك نفسه عن الألبان والبقوليات والعصير والتفاح التي تسبب له آلاماً لمدة أسبوع داخل السجن، تسعفه حبة “أكامول” (مهدئ) فقط وحبّة تشبه الفحم لنفخة القولون تقدمها عيادة المعتقل.
عاش إسلام شتاءً مؤلماً وقاسياً بسبب أثره البليغ على إصابته. يقول “كان يجب أن أرتدي أربع “بلايز” ثم جاكيت شتوي فوقهما حتى أحصل على الدفء المطلوب”. بعد خمس سنوات من إصابته، استمر على نظامه الغذائي الذي يفتقد لقائمة من عشرات الأطعمة الممنوعة، كما تفرض عليه إصابته امتهان أعمال خفيفة كالشغل في مقهى أو في حراسة الأماكن.
في السجن، تناوب أصدقائه على رعايته في إعداد الطعام والزهورات وكمادات الماء البارد والسهر إلى جانبه. يذكر أسماءهم ويبدو مشغولاً عليهم أكثر من انشغاله بنفسه. سؤاله الأهم هو متى يخرجون من الأسر. يقول “أنا بفضلّ الموت على السجن.. أنا ما بتحمل سجن”.
يصف عالم الاجتماع الفرنسي دافيد لوبروتون في كتابه “أنثربولوجيا الجسد” حالة تفضيل إسلام للموت على السجن قائلاً إن جسد السّجين “مكان هندسي لكل العبوديات ولكل الآلام. إن وعي الشخص يوضع في حالة تشبه انعدام الجاذبية.. فهو يعارض جسده بإرادةٍ عاتية، مرتبطة برغبته في البقاء. لكن الإنهاك والجوع والخصومات تسحب المنفيّ (السجين) بخيط هشّ، وتجعله أحياناً يعتبر الموت أمراً بسيطاً”.
إسلام ضبايا. تصوير: وصال الشيخ
إخفاء الجسد
“هل تعتقدين أن أحداً من الجرحى في المخيم يشتكي”، أجبته “لا أدري”، قال الشاب محمود أبو كامل (32 عاماً). “لا أحد، وكذلك أنا. أنا فقط أغطّي إصابتي بهذه القطعة البيضاء لأنها بحاجة إلى عمليات أخرى”. كان ذلك جدالاً بيني وبين محمود حول قدرة الإنسان على الكشف عن مكان جرحه للآخرين.
الإصابات جزء من خصوصية فردية، لكن في حالة شعب من الجرحى، وجراحه تبثّ علناً على الشاشات وعبر السوشال ميديا، كيف لنا أن ننظر أخلاقياً إلى إصابات الآخرين. أفكّر، وفي خضم ذلك يجزم لي محمود بأن إصابته، بشكلها الحالي، رأتها أمه فقط.
بدا لي متردداً في إظهار إصابته والحزن بائن في عينيه، بينما عيناي متلصصة. لم أجبره، أخبرته أن “ذلك شأن يعود له شخصياً”. كان خائفاً أن أنظر إليه بعين الشفقة الشبيهة بالشفقات والحسرات المتداولة على فقدنا الدائم.
صممّت أن أصوّر المشدّ الذي يلف به وسطه، ثم تدريجياً نزع “كنزته” لأرى إصابته في كتفه ثم عموده الفقري، ثم أحشائه. التفاصيل التقطتها الكاميرا، أمّا عينايّ فكلفتهما بمهمة أخرى: عدم النظر.
في 22 نيسان (أبريل) 2014 كما يتذكر محمود، دخل الجيش المخيم وحاصروا الشاب حمزة أبو الهيجا وشباب آخرين، تصدّوا لهم في اشتباك، حتى وقع محمود جريحاً ثم أسيراً بعد رحلة علاج طويلة.
اعتقلته قوات الاحتلال وهو مقعد بعد شلل أصاب الجزء الأسفل من جسمه. سُجن لمدة عام تقدّم خلالها بخمس طلبات لإدارة المعتقل لتوفير العلاج له، حيث كان لا يزال بحاجة لعمليات في معدته وعموده الفقري وزرع قضبان بلاتين في كتفه، دون إجابة.
يقول “كنت إنساناً ميتاً، أمضيت عاماً كاملاُ في السرير. كانت إدارة المعتقل ترسلني إلى المستشفى بناء على طلب المحكمة، يدخلونني غرفة ثم يضعوني فوق سرير، بدون معدات ولا أطباء، وبعد دقائق يخرجونني، ثم يرسلوا تقريراً إلى المحكمة أني تلقيت العلاج في المشفى، لكني في الحقيقة حصلت على مسكنات فقط”.
قدّم له أصدقائه عوناً كبيراً خلال عام أسره، ساعدوا في وضعه على سرير النوم وإرفاقه إلى طاولة الطعام، واصطحابه في وقت الاستراحة لتنفس الهواء ورؤية الشمس أو ما يسمى بوقت الفورة، وعلى الاستحمام وقضاء حاجاته وغيرها.
بعد الإفراج عنه، عاد مباشرة إلى إحدى مستشفيات الحكومة الفلسطينية ثم خضع لسلسلة من التدريبات الطبيعية. يصف ما حدث معه بالمعجزة، فلم يعد يزحف على يديه متوجهاً نحو الأشياء التي يريدها. قال “خسرت أعضاء كثيرة، وعندما أخبروني بالأمر منحني ذلك قوة أكبر من السابق.. الإعاقة دائمة لكنها منحتني معنويات عالية”.
اختبرت بأكثر من سؤال معنويات محمود، لكنه أصرّ أنها عالية على نحو أكيد. عشرون يوماً أمضاها في غيبوبة بعد إصابته الخطرة، وأربعة أشهر تحت البنج بكميات مختلفة، وينتظر أن تنهي سلطات الاحتلال حظر السفر المفروض عليه لغاية عام 2028، حتى يجري عمليات معقدة لا يمكن إجراؤها في مستشفيات الضفة الغربية.
طعام محمود وحركته مقيدة بالكامل. “ممنوع عليّ ممارسة الرياضة، والمشي لا ينصح به عشان الأمعاء عندي بلاستيك والعمود الفقري بلاتين وكتفي الأيسر بلاتين أيضاً”. خزانته تخلو من بنطلونات الجينز التي تضغط على مكان الجرح، ومطبخه يفتقد معظم البهارات كالفلفل والقرفة والزنجبيل وغيرها. “اللحوم والرزّ ممنوعة أيضاً، لكني آكل قليلاً من الخبز”.
محمود أبو كامل. تصوير: وصال الشيخ
كيف نكمل الرحلة؟
تقوم عادة مؤسسة “رعاية أسر الشهداء والأسرى” الفلسطينية بتكليف باحث اجتماعي للوقوف على إصابات الجرحى الذين بلغت أعدادهم لعام 2022 نحو 700 جريح، حسب تقدير المدير العام للمؤسسة خالد جبارين.
من شأن الباحث أن يحدد الإصابات وخطورتها ونسبة العجز الذي سببته لجسد الجريح، وغيرها من سبل التوصيف، ثم يفتح هذا الباحث ملفاً للجريح في المؤسسة غايته توفير التأمين الصحي له وتوثيق إصابته وتقديم المساعدات المادية له على شكل راتب شهري، ويحق للجرحى ذوي الإصابات البالغة تأميناً صحياً مدى الحياة.
يقول جبارين “يحق لهم العلاج في المشافي الحكومية، وبعض المستشفيات الخاصة إن كانت أجهزة العلاج غير متوفرة في القطاع الحكومي”.
مجلس الوزراء الفلسطيني، ورغم الضغوطات الأمنية من الجانب الإسرائيلي والخارج على ملف رعاية عائلات الأسرى والشهداء، والتي تتمثل بمطالبته بقطع المساعدات المادية عن هذه العائلات باعتبارها “إرهابية”، إلاَ أنه قرر تغطية علاج الجرحى بنسبة مئة بالمئة بحسب جبارين. ويمكن للجرحى القدامى حاملي التأمين الصحي إكمال علاجهم وفق هذا القرار أيضاً.
لكن إسلام ومحمود وغيرهما من شباب المخيم، ليسا من المرغوب بهما لدى أجهزة السلطة الفلسطينية بحسب قولهما، وإن توفر لهما العلاج رسمياً، لكنّهما بانتظار قائمة طويلة من الموافقات كي يكملا الرحلة.
يضيفان أن لا أفق لحياتهما الخاصة والاقتصادية داخل المخيم أو خارجه، وأنهما طوال سنوات الإصابة يتعرضان لتضييق على مصادر رزقهما وعلى حقّهما في العمل المكفول بالدستور الفلسطيني. هناك متابعة أمنية لهما بشكل متكرر، وتقتير عليهما في منح تلقي العلاج.
أعود من المخيم وأنا أفكر بهما. لا أعرف إن كانت السلطة ستترجم قرارها على أرض الواقع بتوفير الرعاية لهما أم أن الأمر مجرد مادّة للاستهلاك الإعلامي. أفكر أيضاً بالألم الوهمي الذي وصفته السيدة مريم الدمج في حديثها لي عندما كانت تشعر بوخز دبابيس في مكانٍ لم يعد موجوداً. كل ما أرجوه أن يختفي ألمها هذا، وأن لا تتحول جراح هؤلاء الثلاثة ومعهم 200 جريح آخر في مخيم جنين إلى شكل من أشكال العبث.