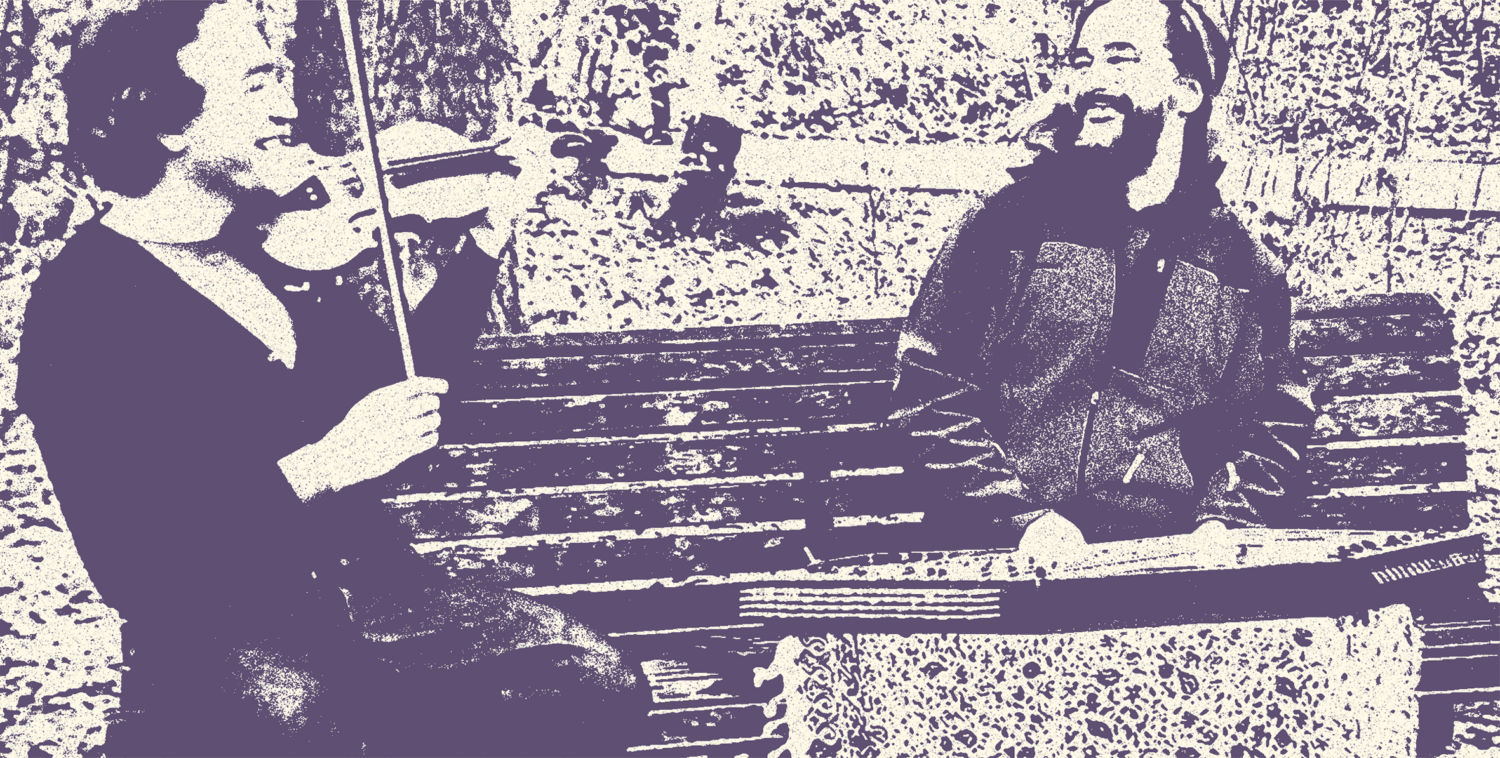حين دخلتُ القاعة وقفتُ لدقائق مشدودة النظر إلى الرجل الذي يحملُ الكمان، يصلُ صوته عذباً إلى الميكروفون. مسحتُ بنظري بقيّة أيدي ووجوه أعضاء الفرقة التي تحملُ آلاتٍ مختلفة. تذكرتُ أول حفل مالوف أحضره في الحادية عشرَ من عمري، كان في زفافِ أحد الجيران.
لم يكن اللحن في القاعة غريباً، ولا الجو. الإذاعة المحلية “سيرتا”، المدينة القديمة التي كان ينطلق منها صوت الحاج محمد الطاهر الفرقاني من مختلف المحلات، قد ينفذُ إلى أذنيك وأنتَ تمد بصركَ لمختلفِ الألبسة التقليدية المطرزة على طول الفيترينات. إنه خلفية سمعية للمدينة، يغلفُ الجو ويشدّك لها إذا ما غبت.
المالوف هو قسنطينة وقسنطينة هي المالوف. تؤسس هذه الوِحدة صورة وصوت المدينة في ذاكرتي. أكشاك كثيرة كانت مترامية في كل شوارع المدينة وفي أزقتها الضيّقة، كلها كانت تُعلّق بوستر كبير للحاج الفرقاني حاملاً كمانه، وحوله تشكيلة كاملة من صور أصغر حجماً للحاج مع معجبيه وتلاميذه، مرة في عرس أحدهم أو في الطريق وحتى داخل محل الأشرطة نفسه. لكن كل هذا اختفى مع دخولنا العصر الرقمي.
تخبرني بكوش مروة، 26 عاماً، معلمة لغة عربية وإحدى المؤديات لهذا الطابعِ الغنائي، إن أحد الأكشاك المشهورة أُغلِق منذ مدة لأسباب مادية، قبل أن أرافقها إلى حيث تتعلم العزف والغناء وتلتقي بزملائها في الفرقة.
تنتمي مروة إلى عائلة موسيقية، يؤدي والدها وجدها العيساوة وهو أسلوب غنائي آخر في المدينة، يمارسه الرجالُ فقط، وهم في الغالب مريدون من الطريقة العيساوية نسبة للشيخ محمد بن عيسى المكناسي. العيساوة قريب من المالوف “الدنيوي” أكثر، وعن العائلة، ورثت مروة حب المالوف.
من هنا بدأتْ “بكوش” البحث عن جمعية موسيقية للانتساب لها وكان لها ذلك مع أختيها أيضاً. لم يكن الأمر هيناً، ككل هواية عليك أن تخصّص لها وقتاً وتواظب عليها وسط مشاغل وتحديات الحياة. انضمت وهي تلميذة في المرحلة الثانوية إلى إحدى الجمعيات ثم توقفت استعداداً للتقديم لشهادة البكالوريا لتعود وهي طالبة جامعية وتنضمّ لجمعية “فنون ونجوم”، ومازالت إلى اليوم. لا تعلم أين ستأخذها الحياة خاصةُ وأن شقيقتها اضطرت للتوقف عن العزف بعد أن صارت أماً.
تقول إن “جيلي غير مهتمٍ بالمحافظة على هذا الفن جدياً، بل غير مهتمٍ بالحفاظِ على أي عنصرٍ من عناصرِ الهوية الثقافية، مهتم أكثر بما يُصدّرُ له من فنٍ جديد. في كثيرٍ من الأحيان أفكر، ومن معي، في التوقف بسبب ضغوطِ الحياة إلا أننا ننظرُ بعينِ المقدّر والمحبّ لأستاذنا الشيخ باجين، ونعود لأجلِ شغفهِ بهذه الموسيقى وهو شغف الذي لم يعرف المللَ طريقا له طيلة عقودٍ”.
ينفتح شبابُ هذه المدينة على أنواعٍ كثيرة من الموسيقى والغناء، بالإضافةِ إلى جمعياتِ المالوف، ثمة من هو مهتم بالراب أو الراي كما عرفت قسنطينة في بداية الألفينات تشكّل عدد من فرق الميتال والروك.
تسع سنوات انتظار
داخل أحدِ دور الشباب التقيتُ بأستاذ الصولفيج محمد الشريف، مؤسس جمعيةِ “فنون ونجوم” في قاعة صغيرة وبسيطة؛ طاولتان، كراسي وسبورة في انتظارِ التحاق بقية الأعضاء. يقول الشريف، “ليسَ من السهل التجمّع خلال هذهِ الفترة، نحن في كورونا.. والطلاب أيضاً منشغلون بدراستهم”.
يروي الشريف أن تأسيس الجمعية لم يكن أقل صعوبة من صعوبة الاجتماع اليوم، ففي سنة 2002 عندما كانت البلاد تخرج من الحرب الأهلية لم يكن جوّ الموت والتكفير مساعداً على دفع الناس لتعلّم الفنون وخاصة الموسيقى. “لقد انتظرت حوالي تسع سنواتٍ لأتمكن من إيجاد تبني حقيقي لمشروعي، تحولت الجمعية خلالها من مجموعة هواةٍ يتواصلون في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، إلى جمعية فنية موسيقية لها مركز للّقاء وتفتح باب الانتساب إليها وتعلّم أساسيات فن المالوف مع الشيخ باجين”.
يعود الأستاذ إلى الماضي حين بدأ بتعلم الصولفيج مع أصحابه، كان طالباً جامعياً في علم النفس، يقطن في حي السويقة العتيق، الذي كان أحد بيوته ملتقى أسبوعياً للشيخ قدور درسوني (ملقن المالوف الشهير في المدينة) مع أصدقائه. لم يكن محمد الشريف محباً ولا هاوياً للموسيقى كما صرح، “لقد كنت مجردَ باحث عن أوقاتٍ دافئة ومسلية”.
التحدي هو الفكرة التي ارتكزت عليها مسيرته وتحولت المتعة بصحبة الرفقة والآلات إلى مشروع موسيقي بعد استماعه للموسيقى في مجالس جمعيتي البسطانجية والفرقانية، أكبر عائلتين فنيتين في المدينة لتعليم المالوف، إذ كان الانتسابُ اليهما مقتصراً على أبناءِ العوائل الموسيقية، فيهما تورّث الألحان والكلمات والأداء كما تورّث الآلات.
بعد مجالس الدرسوني كان الأستاذ محمد الشريف يلتقي برفاقه لتأدية ما سمعوه، يصححون لبعضهم البعض ويكتشفون عالماً موسيقياً كاملاً ذاتياً. يقول: “الجمعية جعلت هذا النوع الغنائي في متناولِ الجميع، تتلمذ الكثير من مؤديي اليوم على يد الشيخ باجين والمُتحدِّث، منهم من واصلَ في أداء المالوف ومنهم من غير توجهه الموسيقي”.
سيرة الشيخ باجين
ينتمي الأستاذ باجين وهو اسم الشهرة (الشريف رقيق) إلى أسرة فنية عريقة، كان جدُه “بابا عبيد” من أهم مشايخ جيله يعلم العزف على جميع الآلات الموسيقية كالعود والفْحّل (الناي). لم يلحق بجدّه، لكن الجو الذي عاشه كان وصلاً لما تركه هذا الأخير. كان البيتُ عامراً بأهل الفن، خاصة وأن جدته من مؤسسات أول فرقةِ “فقيرات” وهو الفن النسوي الشائع في أعراس المدينة.
بدأ الشيخ باجين بالعزف عام 1972 ثم أسس ورفاقهُ فرقة موسيقية وكان بيتهم كالعادة حاضناً لهم بحي سيدي جليس العتيق. هو اليوم في منتصف عقده الخامس، ما زال يعيش في هذا البيت ويجتمع فيه مع محبي هذا الفن ويملك محلاً لتصليح الآلات الموسيقية.
عام 1980 قام أحد الشيوخ بتعليمهم فن الزجل وكانت تلك محطة مهمة وفارقة. لمدة عشرِ سنواتٍ نهلوا من علم الشيخ، حيث أدوا مع بعضهم ما تعلموه إلى غاية وفاته.
يقول الشيخ باجين “بدأت رحلةُ إحياء الأعراس والحفلات. تركتُ عملي في سكة الحديد ومنحتُ كاملَ وقتي وجهدي للفن. لقد منحني ممارسة الفن عملاً بدوامٍ كامل. كل العائلات تقريباً تحيي حفلاتها من أعراسٍ وختانٍ بأوركسترا المالوف، وكانت فرق المالوف تُعامل كالسلاطين، يتخذون لنا أحسن الأماكن ويرشوننا بماء الورد، ويقدمون لنا أحسن الطعام، ولا يكفون عن سؤالنا ما إذا كنا نحتاجُ إلى شيء، نحيي ليالٍ طوال وسط العائلات التي تعرف قيمة هذا الفن جيداً وتكن كل التقدير لممارسيه”. ويتابع: “لم يكن آنذاك غزو ثقافي. لقد كانت هذه الموسيقى، مع العيساوة والفقيرات كلُ ما تسمعه العائلات القسنطينية”.
يشبّه الشيخ باجين هذا الفن بـ “الخلافة” التي يتم توريثها أباً عن جد، فهناك في الجمعيات الأخرى في المدينة عائلات ذواتَ تاريخ موسيقي، يُدرّس فيها معلمون من نفس العائلات أيضاً، مشيراً مثلاً إلى عائلة الفراقنة ابتداءً من الشيخ حمو لمحمد الطاهر إلى الشيخ سليم والحفيد عدلان اليوم، وكذا عائلات البسطانجي وبغلي وشقلب وآخرون، أما ما تقوم به الجمعية، فهو عبارة عن “توسيع دائرة هذا التأثير الموسيقي، بفتحها المجال لتعلم المالوف لأشخاص من خارج هذه العائلات”.
كانت فرق المالوف تُعامل كالسلاطين، يتخذون لنا أحسن الأماكن، يرشوننا بماء الورد، ويقدمون لنا أحسن الطعام ولا يكفون عن سؤالنا ما إذا كنا نحتاجُ إلى شيء، نحيي ليالٍ طوال وسط العائلات التي تعرف قيمة هذا الفن جيداً، وتكن كل التقدير لممارسيه. لم يكن أنذاك غزو ثقافي، لقد كانت هذه الموسيقى، مع العيساوة والفقيرات كلُ ما تسمعه العائلات القسنطينية
يبدو الشيخ باجين مطمئناً لقدرة موسيقى المالوف على الاستمرار، مادام هناك أشخاص بل عائلات كاملة مازالت تعمل على نقلِ الرسالة، “لكن الأمر لا يُقارن بما كنا عليه في الماضي”، يقول، ويرى أن الفرق شاسعٌ في مكانة هذا الفن بين الجيلين، وأن من الضرورة التفكير بتأسيس “أكاديمية تعلّم المالوف، أساتذة من الوسط، يعتمدون على تنظيم النوبات (النوبة هي مجموع حركات موسيقية من الأقل سرعة إلى الأكثر) كما فعل الشيوخ في الماضي، ويعملون على جمع القصائد المدرجة ضمن النوبات”.
أكاديمية لموسيقى المالوف
تنتمي موسيقى المالوف إلى الموسيقى الكلاسيكية، وأيضاً هي نوعٌ من الغناء الأندلسي في الجزائر. حيث ينتمي المالوف القسنطيني للمدرسة الإشبيلية. تناقلت سمعياً من جيلٍ إلى آخر وكانت هناكَ محاولات لتدوينها كما قال الأستاذ محمد الشريف، فمثلاً قام سليم الفرقاني –نجل محمد الطاهر الفرقاني- بمحاولةٍ لتدوينها مع أستاذٍ مختصٍ خلال تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015.
لقد مورِس هذا الفن من جميعِ نُخب المدينة بغض النظرِ عن توجهاتهم وديانتهم، يُذكر في ذلك ريمون ليريس أو الشيخ ريمون، أحد أبناء العائلات اليهودية القسنطينية الشهيرة، الذي تتلمذ على أيدي شيوخَ مسلمين. كما أن المالوف يحفظ ذاكرة المدينة من خلالِ قصائد معينة كقصيدة صالح باي، أهم باي في تاريخ التواجد العثماني بالجزائر، التي تروي قصة الخيانة التي تعرّض لها صالح باي (الوصي على بايلك شرق الجزائر) ومقتله سنة 1792.
يؤكد الأستاذ محمد الشريف: “غياب الأكاديمية منع هذا النوع الموسيقي من التطور، بدءاً من غياب التدوين الموسيقي (الصولفيج) بالإضافة إلى المشكلات والنقائص التي تعتري القصائد المغناة”.
تعود قصائد المالوف التراثية إلى العائلات الأندلسية الهاربة من الحملات الصليبية إلى شمالي إفريقيا، تم تهريبها وبقيت بين أيادي العوائل كإرث ثقافي ممتد بين المغرب والجزائر وتونس حتى بلاد الشام كالموشحات مثلاً. وتكتب القصائد على “السْفِينة” وهي أشبه بدفتر صغير للكتابة. يقول الشريف: “لقد تعرضت للتمزيق مراتٍ أو عدم إمكانية قراءة بعضِ الكلمات، فتم استبدالها بكلماتٍ أخرى للمحافظة على وزن القصيدة، مما يجعلها مختلفة من مكان لآخر، وبين مؤدّ وآخر”.
ويعتقد الأستاذ محمد الشريف أن “أهم ما نستطيع تقديمه لهذا الفن حفاظاً عليه هو تدوينه صولفائياً وملئ فراغات القصائد بالصيغة الأقرب للحفاظ على المعنى والوزنِ معاً”. مضيفاً أن “العمل على إجراء مقارنة بين جميـعِ النسخ المؤداة بين البلدان واعتماد نسخة واحدةَ أقرب لتكون صحيحة موسيقياً وكتابياً سيكون أمراً رائعاً”.
أهم ما نستطيع تقديمه لهذا الفن، هو تدوينه صولفائياً وملئ فراغات القصائد بالصيغة الأقرب للحفاظ على المعنى والوزنِ معاً، وسيكون أمراً رائعاً إجراء مقارنة بين جميع النسخ المؤداة بين البلدان واعتماد نسخة واحدةَ أقرب لتكون صحيحةً موسيقيا وكتابياً
يواصل الأستاذ محمد الشريف: “لا تستطيع الجمعيات وحدها تعليم واستيعاب هذا الفن، فنحنُ هواة بخبرتنا الطويلة في الأداء والتعلم الذاتي، لكن العمل على مشروع مدرسةٍ أو أكاديمية لتعليمه هو ما نحتاج إليهِ وبشدةٍ في الوقت الحالي. حيث يستطيع المتعلم أن ينفق وقته وطاقته في طريق واضح ومضيء”.
ف. مروة، واحدة من أعضاء الجمعية وطالبة موسيقى كلاسيكية في الكونسرفتوار الجزائري ترى أن دراسة الموسيقى مجردَ مشروعٍ ذاتي غير واضح المعالم والنتيجة، “حتى طالب الموسيقى يُعتبر مجردٍ هاوٍ لا يمثل الفن سوى خيارٍ ثانوي في حياته وهذا عكس ما أريدهُ أنا مثلاً، أن تكون الموسيقى والمالوف مشروعاً أساسياً ذو أولوية في حياتي. بالاضافة إلى أن دراستي في الكونسرفتوار تمكنني وزملائي من تبني مشروع تدوين ودراسة هذا الفن، وملئ فراغاته. كلُ هذه الظروف جعلت نظرة الناس أن ما نمارسه مجرد تضييع للوقتِ والطاقة، ففي النهاية ما الذي سنجنيه؟”.
السبت.. ملتقى الآلات والقصائد
في الساعة الثانية من كلِ سبتٍ يلتقي أعضاء فنون ونجوم لمدة ثلاث ساعات متواصلة، كلٌ يحمل آلته مستعداً للعزف والغناء، على السبورة تُكتب الألحان بتسلسلها المقامي ليتدرب الطلبة عليها وتحفظ على الهواتفِ أحياناً. يبدأ الأعضاء في تهيئة آلاتهم وضبط الأوتار بين بعضٍ وبمساعدة أستاذهم الشيخ باجين. يُخبرهم الأستاذ أي نوبةٍ ستؤدى اليوم ثم يعطيهم إشارة البدء، مرةً عزفاً ومرة أخرى عزفاً وغناءً، ويرافقهم بدورهِ في ذلك. بدأ بموشحِ “الفجر الزان” ثم “أيها الساقي” و “جادك الغيث“وختاما بـ “حديث عشقي”.
ليست الموسيقى وحدها كانت حاضرة بل الضحك والمزاح أيضاً. ثمة ألفة وحميمية واضحة بين الأعضاء الذين سبق وأن وقفوا على مسارحٍ كثيرةٍ مع بعضٍ، رحلاتٍ داخل المدينة وخارجها، وخاضوا تدريبات لساعاتٍ متواصلة. بينَ كل نوبةٍ تتم مراجعتها وأخرى تُترك للأعضاء فرصةَ التدرب عليها مع بعضٍ، ثم يعودون للاجتماعِ مجدداً كجوقٍ موسيقي واحد.
ثمانية أفراد من أعمار متباينة، عشرينات، ثلاثينات وفي الأربعين أيضاً، حاضرين بالإيقاع والوتر: كمان، عود، غيتار، موندولين، ودربوكة. ولكلٍ منهم عمله الخاص بعيداً عن الفن.
يقول حسين قريريوش أحد أعضاء الجمعية، عازف عود، “بمجردِ أن تمتلك بطاقة فنان كتصريح لمزاولة النشاط فأنت فنانٌ مسجل لدى الدولة، لكنني حالياً لا أعتمد على الفن كعملٍ دائم، بل أنا عامل في مجالٍ آخر رغم إحيائي لحفلاتٍ وأعراس”.
قبل أن أنسحب من البروفة الأسبوعية، سألت منال درسوني وهي مهندسة معمارية، عن حلمها لدى التحاقها بالجمعية عام 2017 بعد انتهائها من الدراسة الجامعية، وهي حفيدةُ الشيخ دروسوني. تقول منال، “أحلم أن تكبرَ الجمعية لتكون بظروفٍ أحسن وتستطيع أن تفرض وجودها في الساحة الفنية وتقدم عروضاً داخل وخارج الوطن”.
نفس الأمنية وجدتها لآية بكوش، 23 عاماً، عازفةٌ عود، بعيداً عن عملها كأرطوفونية تعالج اضطرابات النطق لدى الأطفال. شعرتُ وأنا أخرج أن موسيقى المالوف، ورغم تواجدها في ذاكرتنا الصوتية، إلاّ أن الجسور التي أوصلتها لجيلي قد لن تمتدّ لتصل إلى أجيال أخرى، مستقبلاً.