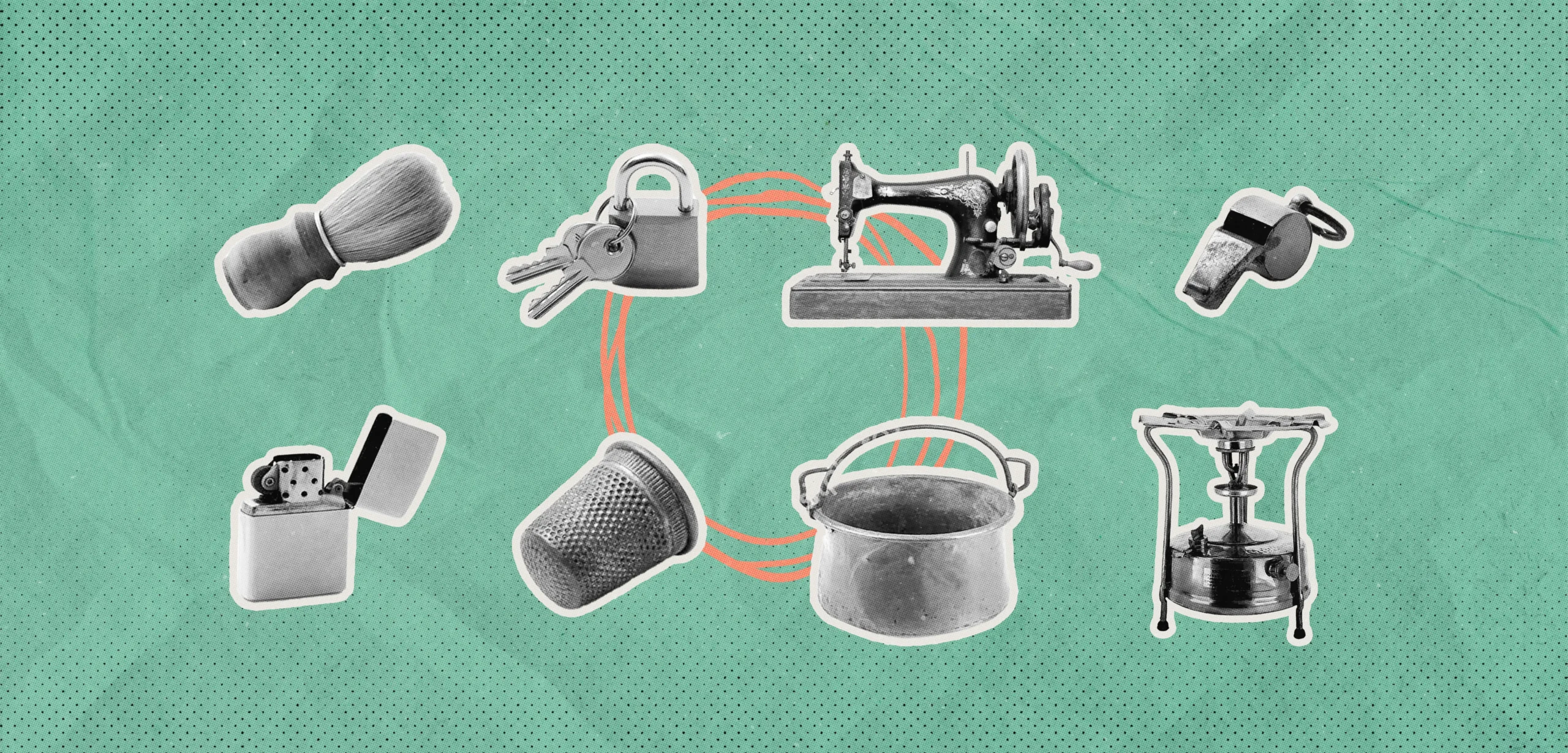عندما توقفت سيارة التاكسي أمام مقر مديرية الأمن بباب سويقة، في قلب الجزء القديم من العاصمة تونس، أدرك عادل أنه قد وقع في فخ السائق. فخّ لا فكاك منه. فقد كانت الشتائم التي استرسل في إطلاقها ضد الحاكم وأعوانه، منذ أن جذبه صاحب التاكسي إلى مستنقع الحديث حول أوضاع الناس، كافية لتشكل منه صيداً ثميناً للسائق المتلهف لتقديم خدمات لمشغليه داخل الجهاز الأمني.
كان حظ عادل جيداً قياساً بالكثيرين، عند الهزيع الأخير من «دولة زين العابدين بن علي» فقد خرج من مقر المديرية الموحش بعد ثلاثة أيام ذاق خلالها ما جعله نهباً لمشاعر الخوف والصدمة كلما شاهد سيارة تاكسي صفراء تذرع الشارع العام. وعندما ولج البيت الصغير، الذي كنا نتقاسمه وسط العاصمة، كان وجهه أقرب إلى كتلة مهشّمة منه إلى وجه إنسان.
وبعد أقل من عشر سنوات من تلك الحادثة، وجدتني أجلس مشدوهاً حذو سائق سيارة أجرة تقلني من الضاحية الشمالية نحو وسط العاصمة، يترك المقود من حين إلى أخر، ويفرك يديه ثم يضحك جذلاً، معلقاً على كلام شيخ الدين المنبعث من الراديو، داعماً إياه بآيات كنت قد سمعت بها لأول مرة في حياتي وأحاديث نبوية بدت لي من نسج خياله.
كان مستغرقاً في شرح كلام الشيخ، دون أن يخفي سخطه من حين إلى آخر بسبب فتاة تقطع الطريق بتنورة قصيرة أو ثوب ملون، زاعماً أن هذه «الخلاعة» هي من تقف خلف شح الأمطار وغلاء الأسعار.
كم جرت من مياه تحت جسور البلاد؟ فلكل دولة «تاكسياتها»!
لم يكن عادل حالة فريدة ولا شاذة، في بلاد تضيق بضوضاء التصفيق والأغاني الوطنية، فقد دأب قطاع واسع من سواق التاكسي على ممارسة «أدوارهم الوطنية» في ملاحقة «المخربين والمعارضين والعملاء»، منذ أن ظهرت هذه المهنة بشكل منظم مع بداية الاستقلال (1956) عندما كانت سيارات الأجرة في البلاد على عدد أصابع اليد أو أكثر قليلاً.
بيد أن حالة «الاندفاع الوطني والديني» لبعض سواق التاكسي لم تكن دائماً على وتيرة واحدة ولا نابعة من منطلق واحد، فقد شهدت تحولات مواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية. فعلى مدى عقود من عمر دولة الاستقلال لبس جزء من سواق التاكسي في تونس قبعات وعمائم عديدة، خدمت النظام في إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع «المنضبط».
الحزب الواحد يكتشف خدمة التاكسي
في المساحة الرمادية، التي مازال يغللّها الكثير من الغبش، بين الإستقلال الداخلي (1955) والاستقلال التام (1956)، بدأ الحزب الدستوري، طليعة الحركة التحريرية، في وضع برنامج السيطرة على المجتمع والدولة والثروة. ولأسباب موضوعية تعود إلى فقدان الحزب لذراع قوي يستطيع أن يحل محل سلطة الاحتلال، شكلت القيادة الحزبية قوة منظمة أشبه بالمليشيات، سمتها «لجان الرعاية»، التي وصف الرئيس الحبيب بورقيبة أعضاءها في نداء 25 مايو/ أيار 1956 بـ«المخلصين للدولة، المتطوعين للمحافظة على الأمن وردع المفسدين». فقد كانت مهمتها الأولى الفتك بالجناح المعارض داخل الحزب.
فبدأت دولة الإستقلال بأكل أولادها واحداً تلو أخر، اغتيالاً وسجنا وتهجيراً، من خلال شبكة لجان الرعاية المقسمة إلى مجموعات تعمل بالساعد ومجموعات تعمل بالفكر، لا وضعاً للأفكار والنظريات، وإنما جمعاً للمعلومات والتقصي، في شكل أقرب للعمل المخابراتي.
فقد تحول الحزب، الذي تداخل مع جهاز الدولة بشكل شديد التعقيد، إلى جهاز مراقبة يملك إمكانيات بشرية هائلة، لا تحركها فقط الأطماع الشخصية الضيقة بل العقيدة الصلبة، أي الوشاية من أجل الوشاية، من خلال تغليفها بغلاف «الوطنية»، ليتحول الواشي من ذلك «الحقير الخائن الذي باع وطنه ودينه وشعبه من أجل الاستعمار» إلى الرجل الوطني الذي أوصل المعلومات الضرورية للدولة لـ«حماية الوطن من الخونة والمخربين».
مهام سائقي التاكسي لم تنحصر حينذاك في جمع المعلومات عن ركابها أو جس نبضهم حول قضايا عامة، بل تجاوزت ذلك إلى المراقبة اللصيقة وحتى الاختطاف.
في هذا السياق التاريخي، تفطن النظام باكراً إلى القدرات الحركية لسيارة التاكسي في الفضاء العام، وقدرتها على النفوذ بسهولة إلى أعماق المدينة مخترقة تقسيماتها الطبقية والجغرافية دون عناء، والأهم دون أن تثير ريبة أحد. ولأن رجلاً خارق الذكاء، يسمى الطيب المهيري (1924 – 1965)، كان بصدد صنع جهاز أمني يتناسب مع دولة الحزب الواحد، فقد توجه نحو تعبئة كل ما يقع تحت يديه للسيطرة على المساحات المفتوحة والمغلقة، من أجل معرفة ما يجري دون توظيف للعنصر الأمني الظاهر، حيث لن يتجاوز عدد أعوان الأمن حتى العام 1967 في تونس 125 فرداً، كما ذكر الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في كتابه “بورقيبة الأهم و المهم”.
فالعامل في مصنعه، والموظف في إدارته والطالب في جامعته وسائق التاكسي خلف مقوده، كلُ يمارس «دوره الوطني»، الإسم الحركي للوشاية، تطبيقاً لما يسميه ميشيل فوكو «سياسة فضاءات التطويق الواسعة».
كانت رُخص سيارات التاكسي تمنح على أساس الولاء في شكل امتيازات “للمناضلين المتقاعدين” داخل الحزب وقدماء المحاربين في صفوف الحركة الوطنية، شأنها شأن رخص المقاهي والحانات، والتي شكلت هي أخرى فضاءات مفتوحة تستحق المراقبة والسيطرة من وراء حجاب، باعتبارها ملاذاً للمثقّفين والطلبة.
خلال هذه الحقبة شكلت حركة التاكسي في المدينة، أداة مراقبة ناجعة للحزب لإحكام السيطرة على الفضاء العام، ولتقدير الموقف في التعامل مع قطاعات المجتمع، لاسيما الطبقات التي كانت مستويات دخلها تؤهلها لركوب التاكسي.
من البرجوازية الصغيرة وصغار الكسبة والمثقفين وموظفي الدولة والأجانب المقيمين في البلاد، خاصة وأن هذه الفئات طالما شكلت وجع رأس للدولة سواء لجهة الوعي السياسي الذي تملكه أو لرؤية جزء منها النقدية تجاه النظام وسياساته.
غير أن مهام التاكسي لم تنحصر حينذاك في جمع المعلومات عن ركابها أو جس نبضهم حول قضايا عامة، بل تجاوزت ذلك إلى المراقبة اللصيقة وحتى الاختطاف.
صباح 12 مارس 1968، بينما كان أستاذ الجغرافيا الحبيب عطية يقطع ساحة المنجي بالي نحو محطة الأرتال بالعاصمة، اعترضته سيارة تاكسي مطلية بالأحمر والأبيض من نوع بيجو 403، لينزل منها ركابها الثلاثة ويجبرونه على الصعود، تختفي السيارة الخنفساء في شوارع العاصمة الضيقة.
بموازاة ذلك، كانت سيارة تاكسي أخرى قد اختطفت صديقه، الطبيب زهير السافي، عندما كان يهم بالخروج من إحدى البنايات السكنية في شارع لندرة. ينتهي بهما المطاف في المقر المركزي للحزب الدستوري الحاكم في شارع روما، لتشرع ميليشيات الحزب في استجواب عطية ورفيقه السافي بشأن العريضة التي عممتها لجنة التضامن مع فيتنام ووقع عليها 162 مدرسا جامعيا ومثقفا خلال ساعات قليلة، ولم تخلُ عملية التحقيق من عنف، تراوح بين الشتائم الجنسية وصولاً إلى الركل بالأقدام والضرب الشديد، في غمرة حماس بلطجية الحزب في تأديب «العناصر اللاوطنية الملحدة» ومحاولة إعادتها إلى «حظيرة الوطن وإلى حضن الحزب قائد الأمة».
من العفوية البورقيبية إلى المأسسة
شكلت السبعينات لحظة مفصلية في تاريخ دولة الاستقلال. دخلت البلاد عصر الانفتاح الاقتصادي من بابه الكبير، بكل استتبعاته الاجتماعية والطبقية، التي دفعتها إلى إعادة هيكلة الجهاز الأمني، خاصة مع تجذر حركة المطالب اليسارية وبروز الظاهرة الإسلاموية دفعة واحدة في الجامعة وفي المجتمع، لتتحول الأدوار الأمنية التي كان يقوم بها الحزب، ومن بينها إدارة حركة سيارات التاكسي وتحليل المادة المعلوماتية القادمة من خلف كراسي السيارات الصفراء، إلى وزارة الداخلية، ويكتفي الجهاز بأدوار بسيطة في حدود ضيقة.
أسّس جهاز المخابرات شركة تجارية تشغل المئات من سيارات التاكسي تحت إسم «ألو تاكسي» في إطار سعيها المتواصل لتطوير العمل الاستخباري على المستوى الداخلي.
وفي أعقاب الرحيل النهائي لبورقيبة عن السلطة خريف العام 1987، جاء بن علي يحمل في جرابه دولة أمنية عشنا فيها ثلاث وعشرين عاماً كإنسان جورج أوريل الهلوع في رواية «1984» ولأن أورويل نفسه يتحدث على لسان أحد شخصيات الرواية قائلاً: «إن جوهر حكم القلة ليس وراثة الابن لأبيه، وإنما هو استمرارية رؤية للعالم و أسلوب حياة يفرضها الموتى على الأحياء… فليس مهما من يتولى السلطة طالما إن التركيب الهرمي للمجتمع لن يمس وسيظل على ما هو عليه».
فقد حافظت أجهزة الوشاية المنتشرة كالأجسام الحرة داخل المجتمع على أداء أدوارها الوطنية بكفاءة عالية، ومن بينها سيارات التاكسي، التي اكتسبت اللون الأصفر تميزاً لها في غابة السيارات التي غصت بها المدينة بعد أن زحفت عليها الأرياف مشكلةً أحزمة فقر وبؤس لا تخطئه العين.
بيد أن النظام الجديد اتجه نحو تنظيم نشاط جمع المعلومات من خلال سيارات التاكسي، لمزيد رفع كفاءاتها واستغلال جميع إمكانيات حركتها الحرة وسط المدن والضواحي لتطويق الفضاء العام.
ويشير تقرير أمني سري يعود 2009، كما أشار تقرير “تفكيك منظومة الاستبداد” الصادر عن الهيئة الحقيقة والكرامة، إلى توجه النظام لـ«تنظيم مصادر المعلومات الأمنية حسب القطاعات المهنية، ومن بينها التاكسي، على أن يرفع نشاطها في شكل تقارير شهرية ذات طابع سري إلى الإدارة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم ثم إلى رئاسة الجمهورية».
ولم يتوقف قطار المأسسة عند هذه المحطة، فقد أسّس جهاز المخابرات شركة تجارية تشغل المئات من سيارات التاكسي تحت إسم «ألو تاكسي» في إطار سعيها المتواصل لتطوير العمل الاستخباري على المستوى الداخلي.
ويكشف تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، التي رصدت الانتهاكات لدولة الإستقلال، أن المخابرات «وظفت نحو سبعين سائقاً بين رجال الأمن المتقاعدين موظفين وسواقٍ لسيارات التاكسي في هذه الشركة الواجهة، كما وفرت لهم أجهزة لاسلكية» كي لا يبقوا أسرى نماذج الوشاية البدائية.
ويتابع التقرير: «كشفت لنا عمليات البحث والتقصي عن قيام بعض أصحاب سيارات التاكسي بمراقبة المعارضين السياسيين والمسرّحين من السجون وكل أفراد عائلاتهم سواء عن طريق المتابعة أثناء تنقلاتهم أو نقلهم عن طريق سيارة الأجرة، ثم يعمدون فيما بعد إلى إعلام أعضاء الشعب الدستورية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي أو إحدى مراكز الأمن بصفة مباشرة. حيث تكررت شهادات الضحايا في هذا السياق مع الإشارة بالخصوص إلى أوصاف بعض السائقين أو أسمائهم الحقيقية».
«تاكسي» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لم تنه ثورة 2011، الأدوار المخابراتية للتاكسي في تونس. لكنها حررت قطاع سائقي سيارات الأجرة، كما حررت قطاعات واسعة من الشعب. فقد تحول الانخراط في اللعبة الرقابية للأجهزة الأمنية طوعياً، مرتبطاً بالمصالح الشخصية والعلاقات القرابية، وليس «واجباً وطنياً».
في المقابل حافظ ملاك رخص التاكسي على عادتهم الأثيرة في تشغيل رجال الشرطة سواقاً لسياراتهم خاصة في الفترات المسائية.
تحول التاكسي من أداة مراقبة في يد السلطة السياسية إلى «داعية متطوع» أو «مُحّتسبْ» بيد سلطات أخرى أكثر نفوذاً وسطوة داخل المجتمع.
إلا أن الظاهرة الأبرز التي رافقت الثورة هي الميول المحافظة الدينية لبعض سواق التاكسي. فأغاني الراي والمزود التي كانت تنبعث من جهاز المسجل الصغير في تاكسيات التسعينات وبداية الألفية تحولت فجأة إلى أناشيد ودروس دينية، لا يكتفي السائق بإسماعك إياها بل يقدم لك تفسيراته الدينية الخاصة في قضايا شديدة الجدل والتعقيد، يدور أغلبها حول النساء والشيعة والمؤامرة على الإسلام والأحزاب الإسلامية، والتي تستأثر بحيز هام من خطاب السائقين خلال الحملات الإنتخابية.
بل إن الأمر قد ينحى في بعض الأحيان منحى العنف اللفظي أو حتى البدني، عندما تأخذ الحماسة السائق غيرةً على «بيضة الإسلام» ودفاعاً عن «القيم والمُثل العليا» فيدخل في عراك مع الحريف (الزبون) ينتهي عادة بتركه وسط الطريق «لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع». لتتحول التاكسي من أداة مراقبة في يد السلطة السياسية إلى «داعية متطوع» أو «مُحّتسبْ» بيد سلطات أخرى أكثر نفوذاً وسطوة داخل المجتمع.
إن قصة التاكسي في دولة الاستقلال التونسية الحديثة، هي قصة الدولة الحديثة التي تريد خلق مجتمع الانضباط، من خلال آليات رقابية حديثة كي تستطيع إعادة إنتاج المجتمع خدمة للطبقة التي تسيطر على الدولة، سواء كانت هذه الطبقة برجوازية أو عمالية أو غيرها.
ولئن نجحت آليات الضبط والمراقبة في بيئات التطويق المغلقة كالسجون والمدارس والمصانع في تحقيق أهدافها إلا أن سؤال السيطرة على فضاء المدينة المفتوح، بقي شاغلاً للدولة دائماً، باعتبار المدينة ساحة الاحتكاك الأولى والمفترضة بينها وبين المحكومين، لذلك شكلت وسائل المواصلات ومن بينها التاكسي آلية مراقبة ناجعة نسبياً، تضاهي آليات الرقابة الإلكترونية الحديثة، باعتبار أن عنصر الذكاء البشري يبدو شديد الأهمية في نقل المعلومات وتوصيلها في بيئات لها خصوصيات ثقافية ولغوية مغرقة في المحلية.