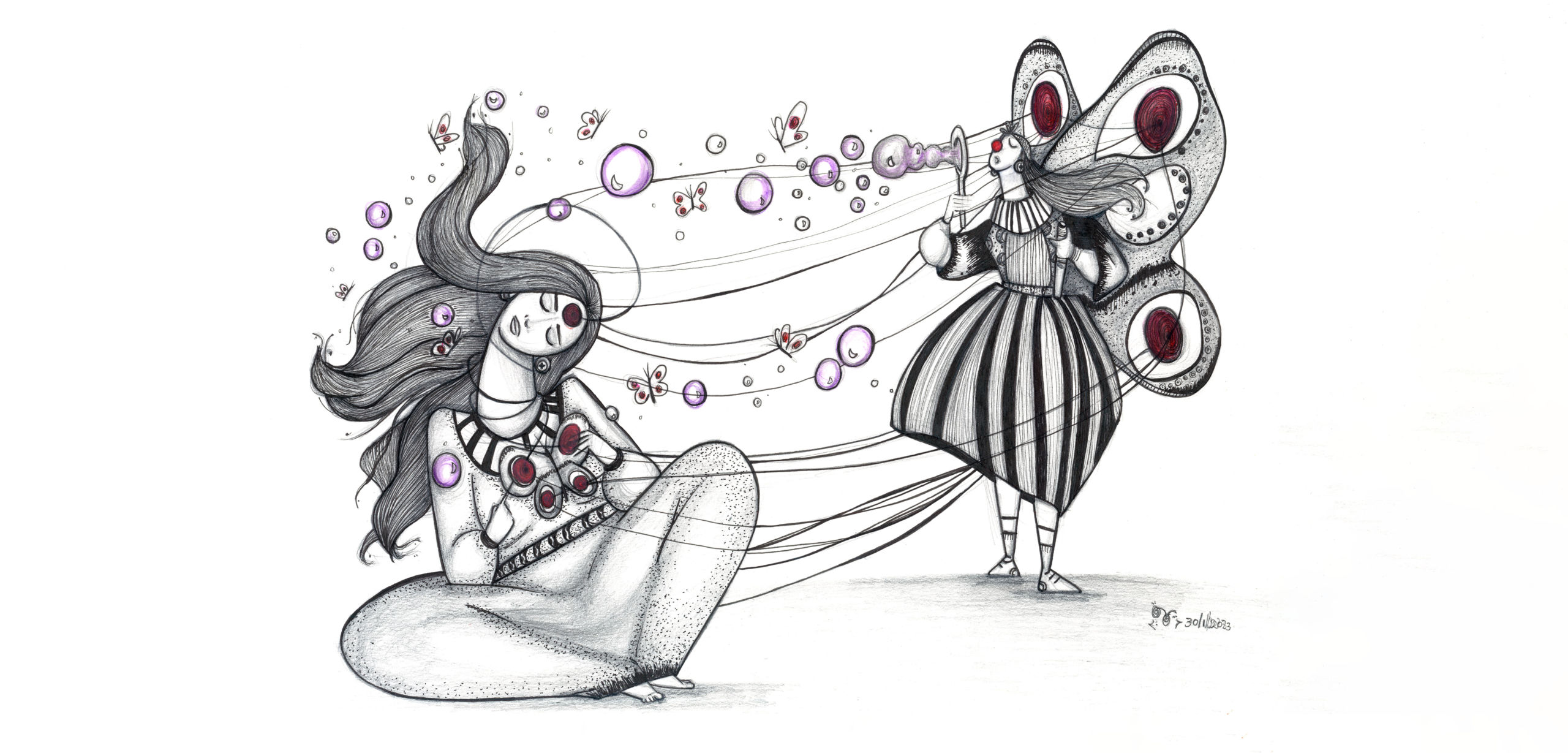قابلت أمي مصادفة إحدى جاراتها القدامى، بعد التحية، سألتها عن سبب ارتدائها للأسود، شرعت الجارة في البكاء، وقالت بين الشهقات المتقطعة أنها دفنت أباها بالأمس، أمي التي حضرت عزاء الرجل منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، رفعت حاجبها متشككة في قوى الجارة العقلية، لم تتركها الجارة للشك طويلًا، وحكت أنها تلقت منذ يومين مكالمة تفيد أن قبر أبيها تم نبشه، عثروا على رفات مكشوفة، بلا كفن، فقط الشاهد الذي دلهم على اسمه.
إعادة تدوير الأكفان
تعد الإجراءات اللازمة للدفن بمثابة وسادة أولية لتلقي الصدمات؛ أين توجد مقابر العائلة؟ من يستخرج تصريح بالدفن؟ من يجهز جثمان المتوفى؟ وأين يقام العزاء؟ تزاحم تلك الترتيبات الحزن فلا يلتهم العقل حيًا. أعادت الجارة دفن أبيها، وعاد الحزن مع الدفن الثاني أشد عنفًا بلا إجراءات لتتلقى الصدمة الأولى عنها. وبدافع من الارتياب قررت أن تجعل زيارة قبر أبيها أسبوعية، خوفًا من تكرار الأمر، فهي تظن أن هناك من يعيد تدوير الأكفان.
لا تعرف الجارة التي أخذت على عاتقها حماية قبر أبيها، أنها تقوم بنسخة ممتدة من طقس جنائزي يهودي يعرف ب“الشيميرا“ ومعناه الحراسة، حيث يقوم أحد أقارب الفقيد بملازمة الجثمان، يتحول المرافق الحي إلى ظل ميت، ممنوع من الأكل والشرب، بدءًا من لحظة إعلان الوفاة وانتهاءً بالدفن، المهمة التاريخية للشيميرا هي حماية الجثمان من أن تلتهمه القوارض، فالفئران تخاف الأحياء لا الموتى، وتبدلت المهمة عبر الزمن إلى إشعار للمتوفى بأن الأحياء لم يتخلوا عنه بسهولة.
عالم بدائي يعرف ضحاياه
الخوف على الجسد الميت من الالتهام شمل كافة الشعوب القديمة التي قطنت الصحراء، ففي بحث نشرته المجلة الدولية للصليب الأحمر، ذكر المؤلف: “في حروب المسلمين الأولى كانت الأطراف المتنازعة تعرف أسماء أعدائها بالاسم، مما يسر عملية البحث عن القتلى، وبعد القتال، يقوم الطرفان بممارسات طويلة الأمد للبحث عن جثثهم، حيث كانت الحروب تقام بعيدًا عن الأماكن المأهولة بالسكان. وفي فضاء الصحراء الشاسعة، تصبح الجثامين عرضة لأن تقع فريسة للحيوانات البرية”.
ولك أن تتخيل قسوة هذا العالم البدائي الذي لا يعرف الإحصائيات ويميز موتاه بالاسم، يحارب بعيدًا عن السكان، ويميز بين بشره وحيواناته. إن عدنا لتلك “القسوة” طوعًا، وقررنا الآن في تلك اللحظة أن نتعرف على قتلانا، فسيكون علينا أن نقرأ من غزة وحدها ما يزيد عن الـ 6000 اسم قتيل وقتيلة، ولو قررنا أن نتعرف على أعمارهم وعناوينهم، ستتكوم أمامنا مئات الأوراق، وإن رفعنا أصواتنا بأسمائهم سيصم العالم ضجيج أسماء لا يبدو لها نهاية، وكلما ظننا أن القائمة على وشك النفاذ، يضاف لها المزيد من الأسماء على مدار الساعة، أثناء كتابة هذه الفقرة مثلًا قفز الرقم إلى 7000 *.
ألم أقل لك عالمهم كان بدائيًا.
مرح الأرانب
تقدمنا اليوم. لم يعد العالم يخشى لا القوارض ولا الحيوانات البرية، أصبح العالم “المتقدم” مهذبًا جدًا، يدافع عن حقوق الحيوان، وينشىء له المحميات البرية، ويصرخ منددًا باستخدامه في التجارب المعملية، يصنف لك منتجاته المهذبة بأنها “خالية من القسوة” وعليك قبل شرائها أن تفتش عن رسم الأرنب القافز على الغلاف، لتتأكد أن أرانب العالم بخير ويمرحون.
يصنع لك أيضًا الأفلام الوثائقية، لتتعلم حب السلاحف، وبالرغم أن الأفلام تخبرك أن الخطر الرئيسي الذي يقتل المحيطات هو الشركات الكبرى بما تقوم به من صيد جارف، إلا أنك ستجلد نفسك مع كل كيس بلاستيكي تستخدمه، وستهرول خلفه إذا حملته الرياح بعيدًا، لأنه يربك السلاحف، حين تظنه قناديل بحر فتحاول التهامه.
أما العالم الحديث فهو ليس سلحفاة ليرتبك، يعرف وحوشه جيدًا ويلتهمها بلا تردد، ولا يتهاون مع الجهل بها، كما فعل مع ناشطة المناخ السويدية جريتا ثانبورج. حين نشرت صورة لها عبر حساباتها في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، كانت تحمل دمية محشوة على هيئة أخطبوط، هاجمها مستخدمو التطبيقات الواعون، فالجميع يعرف أن هذا الوحش البحري لطالما استخدم في دعاية عدائية ضد السامية، جريتا حارسة المناخ الساذجة قالت أنها لم تكن تعلم، وأن طبيبها النفسي هو من نصحها باقتناء دمية أخطبوط محشوة لتستعملها كأداة تعبيرية، وذلك حين شخصها بأن لديها طيف من أطياف التوحد، (الصوابية السياسية تحتم علينا ألا نقول مريضة توحد)، وكنت أظن أنه ليس على “الأشخاص الذين لديهم طيف من أطياف التوحد” حرج كما نعلم، لكنها استشعرت الحرج فاعتذرت وحذفت الصورة، فشكرًا للأخطبوط المحشي الذي ساعدها على التعبير حتى ولو بالمحو. يجب علينا أيضًا أن نشعر بالحرج مما فعلت، وأن نعرف أن سبيلنا للانتماء إلى العالم المتحضر هو أن نصبح جميعا شيميرا للسلاحف والأرانب الأحياء منها والأموات، فالعالم الآن يحب الحيوانات.
حين تراوغنا جذور التخلف الضاربة في أعماقنا ونتساءل لكن لماذا يكره الإنسان؟ يجب أن نششش تمامًا، لأن السؤال الوحيد المسموح لنا به هو لماذا نكره أنفسنا؟. العالم المتحضر يحب الإنسان أيضًا، وعالمنا العربي “المتخلف” يكره نفسه. قصف بيوت غزة -للأمانة- يسبقه تحذير بالقصف، فلماذا لا يتعاون أهل غزة مع مخلصي العالم من الشر ويتركونهم يهدمون منازلهم دون شعور بالذنب. إن كانوا جهلة بالجغرافيا ويظنون أن الأرض التي ولدوا عليها هي أوطانهم فلا يجب أن يجهلوا التاريخ أيضًا ويتناسوا ألم جولدا مائير وهي تقول: نحن نكره العرب لأنهم يجعلوننا نقتل أبنائهم. وحسب هذا المقال المنشور عبر صحيفة هأرتس، يتعاطف الكاتب مع شعب فلسطين، فلطالما خططت جماعات إرهابية لاستخدام أطفال غزة كدروع بشرية، ولا تملك إسرائيل أي خيار سوى تنفيذ مخططات تلك الجماعات الشريرة.
يحب العالم المتحضر الضحايا أيضًا، ولا يمكنك أن تكون ضحية قبل أن تقع المأساة، فدع المآساة تكتمل، حتى يمكنه فهمك والبكاء عليك، ثم ربما الشعور بالذنب تجاهك لاحقًا. يخشع الصحفي البريطاني بيرز مورجن في حضرة إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، يهز رأسه أسفًا عند تذكيره بجرائم النازية، يتجرأ الصحفي النابغة ويلمس جانب الجنرال الإنساني ويسأله عن مشاعره الشخصية تجاه ما حدث في السابع من أكتوبر، يختنق السياسي المخضرم، ويعود للحديث عن قوة الشعب الناجي.
الناجي الوحيد الذي لن ينجو بعده أحد.
الكثير مما يحدث الآن استدعي الحديث عن الهولوكوست وكيف أن عالمنا المعاصر تعلم الدرس ولن يكرره ثانية حتى لو تطلب الأمر قتل مسبق ووقائي، فهناك العديد من الشعوب التي لن تحتمل المرور بشعور الذنب هذا مجددًا، هل تعرف كم يكلف هذا الشعور ميزانية الدول. ميزانية الرعاية النفسية وحدها لبعض هذه الدول تخطت ال14 مليار يورو. فهل يحتمل العالم كل هذا الهدر في الموارد؟
Natrium Cadaverum Maris ملح مستخرج من مياه البحر الأبيض المتوسط، يحتوي على 0,00018 بالمئة من جثة لاجئ غارق. المصدر: Lluís Ibàñez y Guilherme Bressan
الحق في الدفن
كل السيناريو التعيس المتعلق بإعادة دفن الجارة لأبيها، يعد رفاهية لدى البعض في بلداننا العربية، حيث سلبتهم ظروف قهرية الحق في دفن موتاهم، وجعلت منها مهمة شاقة بل وأحيانًا مستحيلة. تتميز بلداننا الحبيبة بتنوع في تلك الظروف، ففي هذا العام وحده شهدنا كوارث طبيعية جرفت ودكت مدن بأكملها، غرق لمراكب هجرة غير شرعية، لم يؤكد أحد عدد من كانوا عليها، وحروب لا نرتقي إلى معرفة أسماء ضحاياها، وكل ما يمكننا أن نقدمه لبعضنا البعض في هذه الحالة هو نوع مختلف من الأفلام الوثائقية عن الحياة البحرية، مثل هذا الفيديو، الذي يعيد ترتيب البديهيات لأن الصدمات تمحوها، فلا تعبر البحر بدون سترات نجاة، وتذكر، جل ما تمخض عنه عصر التكنولوجيا والمعلومات هو خط ساخن لا يملك وسائل إنقاذ، ولا يضمن وصولها لك عند الاتصال بمن يملكها، فتوقع الأسوء.
لكن لا تقلق هناك قانون دولي إنساني يمنح جثمانك الحق في الدفن، حيث “يلزم الجميع باتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن جثث الموتى وجمعها، وإجلائها دون تمييز مجحف. (المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 32 و33 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 112 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي). لا تؤثر تلك التوصيات على تغيير مجرى الأحداث، لكن ربما ستستخدم -إن كان لنا عمر- في إدانتها لاحقًا. لذلك نذكّر أهل غزة بأن عليهم توثيق قصف منازلهم، وقصف الدفاع المدني الذي ينتشل المصابين والموتى من تلك المنازل، وقصف المستشفيات التي تعالج المصابين، وقصف الجنازات التي تدفن الموتى، وإن بقي منهم أحدًا فليوثقوا قصف المقابر إن تمكنوا من دفنهم.
عالمنا المعاصر “المتقدم” يجيد توثيق المآسي، لكنه يعاني قليلًا في التعاطي معها وقت حدوثها، ويتحتم علينا أن نراعي فهمه البطىء.
ودوما ما تذكّر المجلة الدولية للصليب الأحمر قرائها من المتنازعين، بوصايا العالم القديم المتعلقة بالدفن، خاصة في البحر، حيث يمتلئ البحر المتوسط حاليا بآلاف من المفقودين. فقديمًا إن كان المتوفى قريبًا من أرض صديقة، يربط جثمانه بلوح خشبي على أمل أن يلقي به البحر على شواطىء تدفنه، وإن كان قريبًا من أرض عدوة، يربط بثقل حجري فيتولى البحر عن الجميع مهمة الدفن، وحاليًا الخيار الأخير هو الأكثر شيوعًا، لكثرة الأراضي العدوة.
المطرح الذي تموت فيه الشمس
في الأبحاث التي تتناول الدفنات “الآدمية” خلال عصور ما قبل التاريخ، لاحظوا ارتباط تطور أساليب الدفن بالتطور الفكري والروحي للشعوب، فالتحول الاقتصادي الكبير الذي حدث في بلاد الشام في العصر الحجري الحديث تجلى في دفن موتاهم تحت أرضيات البيوت، ويعد موقع أريحا بفلسطين من أهم المواقع التي زودتنا بأكبر عدد من المدافن المنزلية، حيث اكتشف المنقبون حوالي 276 هيكلًا بشريًا مدفونًا داخل حفر تحت الأرضيات السكنية.(من كتاب سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية المجلد 14 العدد 4 ص 97)
ومع بزوغ فجر الحضارات، ابتعدت المدافن عن المنازل، كما يصفها كتاب “مصر وكنعان وإسرائيل في العصور القديمة”، قائًلا “في وادي النيل جذبت الصحراء الغربية الشاسعة التي تلوح أمام الأنظار باستمرارها، بصفتها المطرح الذي تموت فيه الشمس كل مساء. فهنا تقوم مملكة الموتى في الغرب، وأصبحت كلمة الغربي كناية رقيقة عن الميت. انفصلت الجبانات عن الأحياء وأقيمت في غالب الأحيان في أطراف الصحراء، وانطوى الموت بالتالي على رحلة من منازل الأحياء إلى بيوت الموتى.”
تلك الرحلة إلى المطرح الذي تموت فيه الشمس تطلبت حفظ للجثامين من التآكل، وأيضًا تجهيزًا للرحلة الأكبر في الحياة الثانية، فاخترعوا التحنيط، لأن المساكين لم يعرفوا مثلنا التبريد كوسيلة لحفظ أجساد الموتى، حتى لو كان التبريد في ثلاجات تستخدم لحفظ الآيس كريم كما حدث في غزة.
فسر بعض الباحثين العديد من جوانب الحضارة الفرعونية كعرض جانبي لاستعدادهم للحياة الخالدة، بينما العصور التي سبقتهم جهلت الموت، وولد جهلها خوفًا، فاعتقدت أنه يمنح الموتى قوى غير مرئية، فكانت تحول كهوفهم/ بيوتهم إلى قبور، خاصة الأقوياء منهم.
لكن كيف سيفسر الباحثون تحول 130 بيت غزاوي في شهر مايو الماضي إلى قبور جماعية فوق روؤس ملاكها، وكل ذلك قبل أن ينفجر العالم غضبًا في السابع من أكتوبر. في انتظار الأبحاث المستعصية تلك، يمكننا أن نتابع تحول المزيد من البيوت إلى مقابر، لحظة بلحظة عبر وسائط متعددة، ببث مباشر أو عبر ريلز انستجرام، أو تغريدات توتير سابقًا إكس حاليًا، أو عبر بوستات فيسبوك التي سرعان ما تتحول إلى وصايا موت لكتابها، بينما نلاعب الخوارزميات وتلاعبنا، وعلينا أن نفعل كل ذلك متجنبين حديث الكراهية والتنمر، فكلما زرنا صفحة من صفحات تلك الوسائط المتعددة، يظهر لنا شريط قصير يوبخنا على سوءات ألسنتنا، محذرًا بحذف التعليقات التي تجرح رهافة المستخدمين.
أعتدت أن أقرأ عبر صفحة بلدتنا على الفيسبوك، خبر غرق مقابرها إما بمياه الصرف الصحي، أو موسميًا بمياه الأمطار، مما تسبب في تآكل الشواهد وتضرر الرفات، هذه المرة مع عودة أخبار غرقها، وخوف السكان من موسم الشتاء القادم، فكرت في والد جارتنا، وكيف هو عصي على الدفن، لا يريد أن يحل ابنته، ويبقي عليها شيميرا أبدية.
* وصل العدد لحظة نشر النص إلى 11180