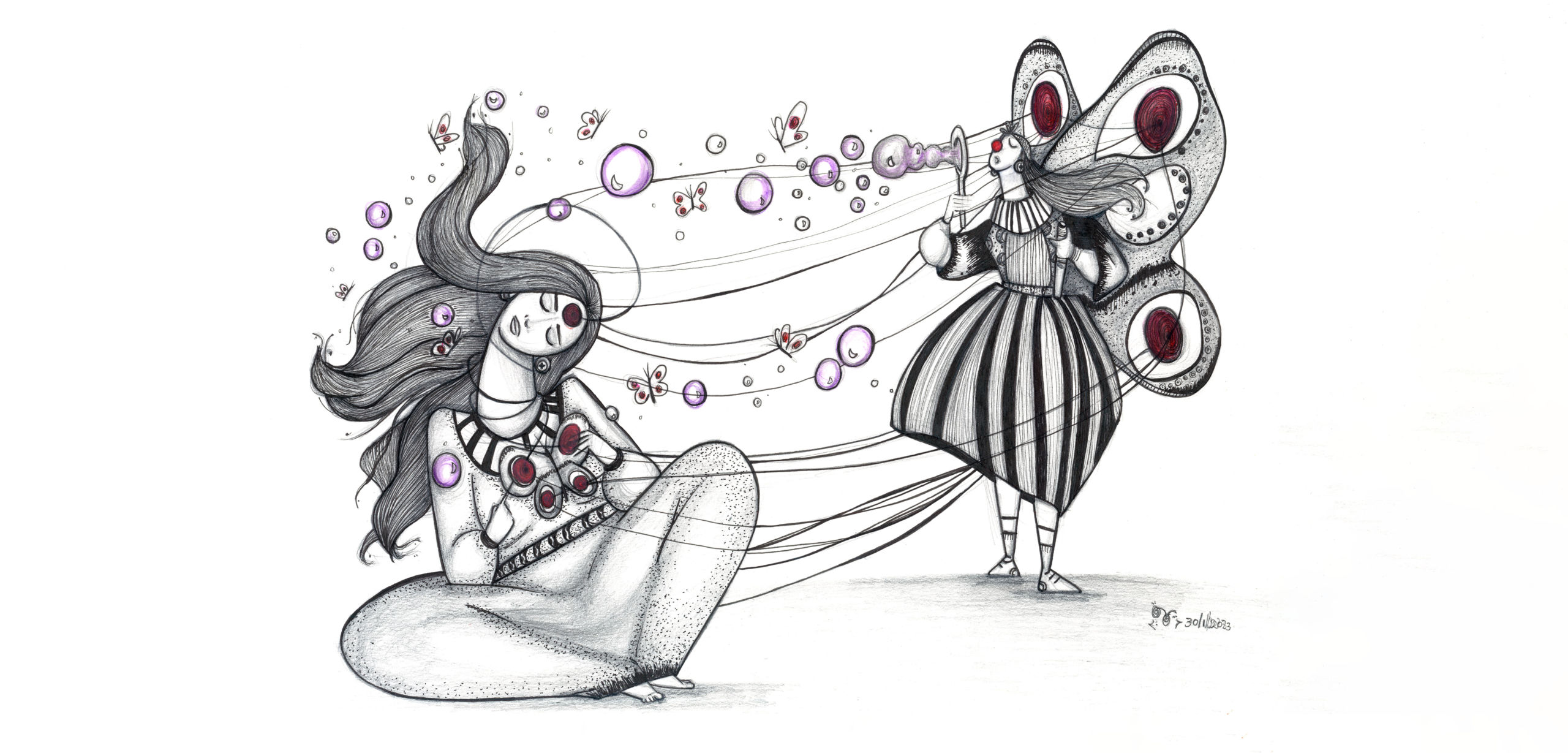كنت شديد النحافة طوال فترة المراهقة وحتى بعد نهاية الدراسة الجامعية. لم تتسبب لي النحافة بأي أزمات نفسية أو جسدية. على العكس، كنت خفيفًا وكثير الحركة، وكان مظهري مقبولًا بشكل عام. لكني نلت حظًا وفيرًا من التعليقات والأحاديث المتهكمة بالطبع. ذات مرة لم يجد أحدهم ما يمكن قوله إلا آية من سورة يس.. “يُحي العظام وهي رميم”.
لم يكن مصطلح التنمر في قاموس الحياة وقتها. وبالنسبة لي وجدت أن للناس حقًا في تهكمها، إذ كيف يكون الإنسان نحيفًا هكذا؟
أعتقد أن في النحافة الشديدة تذكرة للناس بالأصل الهش للجسد البشري. الأصل المتخفي خلف الشحوم والعضلات والملابس. ربما هذا ما يستفزهم فيها.
مارست بعض الرياضات خلال إجازات الصيف المتتابعة، كرة السلة والتنس والكونغ فو والسباحة. ولم تكن الأسر في الطبقة الوسطى تولي الرياضة نفس الاهتمام الذي نراه الآن. تكرس لها الشتاء والصيف. طغت علي تلك الرياضات في أشهر الصيف. وبعدها لم أواظب على ممارسة أي رياضة، وحتى بعد انتشار صالات الجيم. عدد التمرينات التي قمت بها داخل صالات الجيم يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة. لم أكن مهووسًا بالتغلب على نحافتي، وأدركت مبكرًا أن الزمن كفيل بها.
هواجس وتوهمات
كان لي نصيب لا بأس به من الهواجس، خاصة في فترة المراهقة. ذهانات أليفة لا تصل إلى حد الاضطرابات. تصورت لفترة أن كتفيّ ليسا على نفس المستوى، أحدهما أعلى من الثاني قليلًا. كذلك كنت أتحسس بطني كثيرًا خشية بزوغ كرش مفاجيء. والكثير من الإيحاءات والتوهمات التي كنت أدرك أنها كذلك. تصورت أنه لا يوجد أحد يشاركني مثل هذه السخافات الجسدية، ثم عرفت بعد ذلك أن تلك الهواجس موجودة لدى آخرين. وعرفت كذلك أن غالبية الناس لا تتأمل أجسادها.
اعتاد الأهل ومن هم أكبر سنًا تحذيرنا من خطورة إطالة النظر في المرآة. على الإنسان أن يترك جسده ولا يفكر فيه. فقط يحافظ عليه سليمًا. بالطبع تغيرت تلك النظرة إلى الجسد الآن. وصارت هناك طرق وبرامج وفيديوهات تتناول كافة العيوب المتوقعة في جسم الإنسان. تشرح للناس كيفية التخلص من دهون أسفل البطن، وكيفية الحصول أكتاف كاملة الاستدارة، وهكذا. هناك نموذج مثالي لمورفولوجيا الجسد. الآن يمكن نحت الجسم حسب باترون جاهز ومعد سلفًا.
جسدنة
تصف بعض البرديات المصرية القديمة وكتابات اليونانيين الاضطرابات التي تتضمن شكاوى متكررة من أعراض جسدية لا يمكن إرجاعها إلى أسباب عضوية، أو أنها أعراض جسدية دون مرض عضوي.
في كتابه “حكايات التعب والشقاء” يوضح الطبيب النفسي المصري نبيل القط أن أطباء القرون الوسطى الأوروبيين أرجعوا مثل تلك الأعراض إلى “سيطرة الأرواح على الجسد”، وهو الأمر الذي ما زال يحدث في الثقافات التقليدية.
يبين القط أن تلك الأعراض تأتي عادة عند مواجهة ظروف معاكسة لا يستطيع الشخص معالجتها، مثل العنف الأسري أو حدث مشين مثل الرسوب الدراسي.
ثم يلجأ المخ إلى التعبير عن توتره في شكل أعراض جسدية، ومع تكرار تلك الأعراض ونجاح ظهورها في تخفيف شدة التوتر، تتحول إلى نمط متكرر يلجأ إليه المخ في مواجهة الأزمات”.
يلجأ المخ إلى التعبير عن توتره في شكل أعراض جسدية، ومع تكرار تلك الأعراض ونجاح ظهورها في تخفيف شدة التوتر، تتحول إلى نمط متكرر يلجأ إليه المخ في مواجهة الأزمات
من أنواع اضطرابات الأعراض الجسدية ما يعرف بـ “الجسدنة” أو اضطراب العرض الجسدي. ويتميز بوجود واحد أو أكثر من الأعراض الجسدية المؤلمة أو الضاغطة”. وتتراوح في الشدة والخوف. و”تؤدي تلك الأعراض إلى الاستغراق في أفكار ومشاعر مزعجة، مع تعطل كبير في نشاط الحياة اليومية”.
نعيش الآن حالة جماعية من “الجسدنة”. تحولت بعض التمظهرات أو الخصائص الجسدية إلى مشكلات يجب حلها.. كيف تتخلص/ي من السليوليت أو الذقن المزدوجة أو الاستريتش ماركس..
شكاوى ومشاعر منزعجة من صفات لا يُفترض أن تثير كل ذلك، وتعديلات لا تزيد من كفاءة أو لياقة أو صحة أجسامنا.
لكن ألا يمكننا أن ننظر إلى مثل ذلك الاهتمام بوصفه مقاومة لإرث ممتد من تجاهل وتحقير الجسد؟
تدعم الحياة المعاصرة، بما فيها من بروباجندا، المناداة بأسلوب حياة صحي وفق نمط محدد. تأتي المشكلة الأساسية من سيطرة الرؤية الشكلية الصورية في التعامل مع الجسد. كيف يجب أن يبدو؟ وأيضا من الرغبة المحمومة في نتائج سريعة. كأن ثقافة الوجبات السريعة أنتجت مقابلها في تشكيل أجساد رياضية سريعة.
سيطرة تامة
في كتابها “فلسفة الجسد“، توضح الفيلسوفة الإيطالية ميشيلا مارزانو أن الجسم الوحيد المقبول اليوم هو الجسم المسيطر عليه تمامًا، وأننا نصطدم بعدد متزايد من التمثيلات التي تحيل كلها، بطريقة أو بأخرى، إلى فكرة “الضبط”.
تقول مارزانو إن الحقل الدلالي الذي تستخدمه الدعاية شديد الإيحاء، “فالمنتجات التي يجري إعلاء شأنها في أغلب الاحيان” هي التي تتيح النحافة، أو تجديد الشباب وهكذا..
تبين مارزانو أن الجراحة التجميلية والأنظمة الغذائية والتمرينات الرياضية تحظى بقيمة كبيرة بوصفها وسائل للتحرر.
ويستطيع المرء عبر النحافة أو أي شكل آخر إثبات “ضبطه وسيطرته على ذاته” في حين أنه “يعلن عجزه عبر السمنة وعدم الانتباه إلى مظهره الجسمي”. وتقول.. “هكذا يمثل الجسم المعتنى به ليس فقط رمزًا للجمال الجسمي، أيضًا خلاصة النجاح الاجتماعي، والسعادة والكمال”.
قصة حزينة
كانت لنا جارة وصديقة للعائلة تعاني من السمنة المفرطة. وكانت مثالًا معبرًا عن أن الطيبة، كصفة متأصلة في البدانة، ليست فكرة كليشيهية. عانت من مرض السكر وآلام المفاصل. لكنها أقدمت على إجراء عملية “تكميم المعدة” لا بسبب الأضرار الصحية التي تسببها السمنة قدر رغبتها في القبول المجتمعي. وتمثل دافعها الأساسي في الرغبة باستعادة رضا زوجها وأهله.
أجرى لها عملية التكميم استشاري شهير، ضيف معتاد في البرامج التلفزيونية، وتملأ صوره الإعلانات حول كباري ومحاور القاهرة وعلى كورنيش الإسكندرية. وعقب خروجها من المستشفى بيومين، توفيت الجارة الطيبة.
في مثل تلك الحالات، تبقى أسباب الوفاة غير واضحة، ولا يوجد مسؤول عنها. ومن أجل استقصاء الأسباب الدقيقة للوفاة يتوجب على أهل المتوفى طلب تشريح للجثة. والزوج، مثل غالبية الناس حولنا، يرى تشريح الجسد من المحرمات، وإحدى الكبائر التي لا يجوز أن يتعرض لها الميت.
لا أتذكر القصة القصيرة المأساوية للجارة من أجل البحث بأثر رجعي عن مذنب. لا زوج مذنب ولا جراح. ولا الجارة نفسها مخطئة حين رغبت في استعادة زمام حياتها والعيش بصحة أفضل. لكن القصة تكشف عن مفارقة مأساوية في تعاملنا مع الجسد. إننا نكن احترامًا بالغًا لـ الجسد/الجثة، احترامًا لا نجد له مثيلًا/نظيرًا مع الجسد الحي.

المصدر: Julia Moreno. جميع الحقوق محفوظة، تُنشر بإذن من الفنانة
ديكتاتورية الأفضل
تصف مارزانو البلاغة المعاصرة للخطاب الدعائي بأنها “شديدة الحنكة”. فـ “كل فرد ينبغي أن يكون حرًا في اختيار الحياة التي تروق له. لكن لا يكفيه بكل بساطة “أن يكون”، يجب أن يخضع لجملة من المعايير والمواصفات. تقول مارزانو إنه خلف “الحرية المزعومة تختفي ديكتاتورية من الأفضليات”. إن الفرد أمام “خداع” مستمر، بفعل الجراحات التجميلية أو صيحات الموضة، في طريقه لتحقيق الذات.
تشير مارزانو إلى العلاقة بين “الفضاء الرقمي” و”اللحم” حسب تعبيرها. الفضاء الرقمي بوصفه “مكانًا لا ماديًا حيث لم يعد الجسد يحتل أي مكان”. وتطرح سؤالا هامًا.. كيف يمكن تفسير نجاح عالم دون جسم؟
تقول إن أقراننا الرقميين avatars يتحركون دون الخضوع إلى القوانين المتحكمة في العالم الواقعي. ويصبح في العالم الافتراضي كل شيء ممكن. لذلك فإن “انمحاء مادية الجسد” هي التي تجعل كل تحول أو فعل من قبل “النسخ الرقمية” ممكنة.
لكن الفيلسوفة الإيطالية تتحدث عن تمثلنا داخل الفضاء الرقمي كأنه فرصة تتيح “الاختباء والتصرف تحت غطاء من الكتمان”، وهو ما يعاكس طبيعة الواقع الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي الآن. والسبب في طرح مازرانو البعيد عن الواقع أنها كانت تتحدث عن فترة زمنية سابقة على ثورة السوشيال ميديا، إذ صدرت طبعة الكتاب الأولى عام 2007، وركزت خلالها على المدونات blogs وغرف الشات والمنتديات وغيرها.
كل فرد ينبغي أن يكون حرًا في اختيار الحياة التي تروق له. لكن لا يكفيه بكل بساطة “أن يكون”، يجب أن يخضع لجملة من المعايير والمواصفات. وخلف “الحرية المزعومة تختفي ديكتاتورية من الأفضليات”
تتمثل مفارقة الواقع الافتراضي الأساسية في تأكيده المستمر على الوجود المادي للجسد رغم غيابه. نتفاعل مع غيرنا على السوشيال ميديا كحسابات وصور، ونتواصل بالتعليقات والرموز والميمز. لكننا في الوقت نفسه، نتابع كمئات الآلاف وربما الملايين على فيسبوك وانستجرام، التفاصيل اليومية لحياة المشاهير أو المؤثرين داخل الجيم أو في عاداتهم الغذائية والعلاقة مع الموضة والأزياء.
أشاهد الكثير من فيديوهات تمارين المشاهير داخل الصالات الرياضة أو تدريباتهم اليومية في المنزل. وكذلك فيديوهات عن نظام الوجبات الغذائية خلال اليوم لأساطين لعبة كمال الأجسام المحترفين. ولا أعرف السبب وراء متابعتي لأمور لا تهمني ولا أرغب في القيام بها يومًا ما.
لا تمحي السوشيال ميديا الجسد بل تؤكد مركزيته. الجسد قوام السوشيال ميديا لأنه من موضوعاتها الأثيرة، وأيضًا لأنه محور صراع دائم. تضع فتاة أو امرأة أو ممثلة مشهورة صورة لها بفستان سهرة أو على شاطيء البحر، فتنهال التعليقات الغاضبة والشتائم وعبارات التنمر. الجسد يمكنه أن يخلق نزاعًا حوله من خلال صورته فقط.
تصبح صورة الجسم، في عالم من الصور، مجرد انعكاس للتوقعات التي تحيط بنا. فالجسم ذاته يصبح صورة. وينتج عن ذلك “شكل جديد من الثنائية بين المادية والإرادة”، كما تبين مارزانو. هنا يأتي السؤال الأهم حول ملكية الجسد.
من يملك الجسد حقًا؟
تتشابك مجالات المعرفة المختلفة في التفاعل مع هذا السؤال. الجسد مبحث أساسي في البيو إيتيقا، أي تطبيق نظرية الأخلاق في المجال البيولوجي. وتُطرح في هذا المبحث الأسئلة حول الجسد كموضوع في البحث التجريبي، والتكنولوجيا والهندسة الوراثية، وغيرها من مجالات البيولوجيا. وتتعدد الجدالات حول ممارسات مثل نقل وزرع الأعضاء، بعض الجراحات التجميلية، الاستنساخ، وتكنولوجيا التحكم الجيني.
لا يوجد الجسد في الفراغ، فهو موضوع دائمًا داخل سياقات مختلفة حد اعتباره ثمرة للتكوين الاجتماعي الثقافي. الجسد تابع للشروط الاجتماعية والثقافية التي تتغير على مدى العصور.
من أهم إنجازات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو تحليل العلاقة بين السلطة والجسد. يتناول فوكو مادية السلطة على جسد الأفراد ذاته.
يفحص صاحب “الكلمات والأشياء” خطابات مؤسسات السلطة المختلفة، كالسجون والمصحات العقلية، وطبيعة ممارستها التي تتقنع خلف إدعاءات العقلانية والمهنية والعلمية، وتعمل على “تطويق” الجسد والتحكم به.
ويتتبع كذلك آثار السلطة على الجسد، حيث زحفت السلطة على.. جسد الأطفال، جسد الجنود، الجسد السليم، والجسد المريض.. فمثلا، يكشف فوكو كيف أصبحت المؤسسة الطبية سلطة استراتيجية منظمة بسطت هيمنتها على أجساد الأفراد وسلوكياتهم، لقد صار الطب مؤسسة تضم خبراء ومستشارين محترفين تقدم “حقائق مفصلية” عن الجسد. ويكشف أن استراتيجية الهيمنة على الجسد تحكمها أهداف سياسية واقتصادية.
لا يوجد الجسد في الفراغ، فهو موضوع دائمًا داخل سياقات مختلفة حد اعتباره ثمرة للتكوين الاجتماعي الثقافي. الجسد تابع للشروط الاجتماعية والثقافية التي تتغير على مدى العصور
يقول فوكو إن الجسد صار رهان صراع بين الأبناء والآباء. ويوضح الكيفية التي ترد بها السلطة على محاولات ثورة الجسد.
غير أن الفيلسوف الفرنسي يبين أنه لا يمكن اختزال طبيعة السلطة إلى مجرد “القمع”؛ إذ لو كانت وظيفتها مقتصرة على القمع، والاشتغال على منوال الرقابة والتهميش وتأبيد الكبت، وتُمارس ما سبق بكيفية “سلبية”، لكانت هشة للغاية. فالسلطة “قوية” لأنها تنتج آثارًا إيجابية على مستوى الرغبة. “إنها لا تمنع المعرفة بل تنتجها”. و”الجنسانية هي بشكل كبير واحدة من المنتجات الإيجابية للسطة”.
يذكر فوكو مثالا عجيبًا من التاريخ عن حملة ضد الاستمناء في أوروبا القرن الثامن عشر. ظهر الموضوع كرعب، “مرض مخيف يتطور في العالم الغربي”.. “الشباب يستمنون”. وبدأت عمليات “مراقبة” على الأطفال.
أتعجب من تصور حملة مضادة للاستمناء في أوروبا قديمًا. أجدها حملة عبثية وباعثة على السخرية. لكني أتذكر الطرائف المريرة التي نطالعها يوميًا، والتي إن حكينا عنها بعد أعوام فإنها ستكون في مثل طرافة الحملة الأوروبية القديمة.
عادية التوحش
وضعت علم قوس قزح على صورة البروفايل في حسابي على فيسبوك يوم رحيل سارة حجازي، الناشطة السياسية اليسارية والمدافعة عن حقوق المثليين.
وفرت السوشيال ميديا لنا طرقًا شكلية للتضامن والنقاش حول الشأن العام. لم أعرف سارة بشكل شخصي، لكن رسالتها الوداعية الأخيرة إلى أصدقائها والعالم هزتني بشدة. كانت صورتها وهي ترفع علم قوس قزح وسط الحفل الغنائي لحظة مختلسة من الفرح، من السكينة. هذا الصفاء الذي يُبعث داخل روحك حين تعبر عن ذاتك بصدق، وأن تواجه العالم بلا مواربة. كانت لحظة من هانئة دفعت سارة ثمنها كثيرًا.
جاءتني يومها رسائل مستفهمة ومستنكرة، وكذلك بعض التعليقات الرافضة. فإن كانت صورة سارة تمثل، لي وللبعض، دليلًا على البراءة والطيبة، فإنها لدى آخرين مثالًا مغايرًا تماما. بالنسبة للوسط الحقوقي والثقافي، والدوائر المقربة من سارة، فإن ردود الأفعال المسعورة، الشامتة والمتشفية تنتمي لأناس لم يعودوا كذلك. موتى أحياء ألقوا إنسانيتهم جانبًا. نسخ رقمية من وحوش تعيش في المجتمع.
لكن المرعب حقا، أن أصحاب مثل تلك الردود والآراء أفراد عاديون. وكانت عادية التوحش هي الفكرة الأكثر رعبًا بالنسبة لي، لكن الوسط “المتحرر” لم يستوعبها وقتها، ربما بسبب فاجعة الرحيل، أو لانغلاقه وعزلته. كان اللجوء إلى الشيطنة مريحًا.
لم أعرف سارة بشكل شخصي، لكن رسالتها الوداعية الأخيرة إلى أصدقائها والعالم هزتني بشدة. كانت صورتها وهي ترفع علم قوس قزح وسط الحفل الغنائي لحظة مختلسة من الفرح، من السكينة. هذا الصفاء الذي يُبعث داخل روحك حين تعبر عن ذاتك بصدق، وأن تواجه العالم بلا مواربة. كانت لحظة هانئة دفعت سارة ثمنها كثيرًا
اللجوء إلى الشيطنة ليس تجنيًا على أصحاب السُعار اللا إنساني، فما أظهروه من قسوة دليلًا على ضمور الحس الإنساني بداخلهم. لكن الشيطنة توقعنا في التعميم وتعفينا من المواجهة أو الحوار، وكذلك تشعرنا بلا جدوى المقاومة.
وجهت كلامي إلى من أعلم أنهم أعداء لما يجهلونه. إلى من يدفعهم الخوف على الدين والأسرة ومستقبل البشرية للنبذ والتبرؤ والرفض. وحتى المواجهة الصارمة التي ينادون بها يجب أن تخلو من التعذيب والإهانة.
تناقشت مع بعضهم، وحدثتهم عن وهم الضحية “المثالية”، وعن أن التضامن ليس امتيازًا نمنحه لمن يشبهنا فقط. والتضامن مع فرد لا يعني أن تتبنى أفكاره أو تسلك نفس طريقه. ما الضرر الذي سيصيبك إن وسعت رحمة ربك كل شيء؟ إن المطالبة بالعدالة لابد أن تبدأ من الأقليات المهمشة والمنبوذة، لأنه لو راعت الدولة حقوق الإنسان مع فتاة مثلية بلا ظهر أو سند، ستراعيها مع رئيس سابق أو مرشح سابق للرئاسة.
في وسط تلك السجالات تملكني قلق شديد. خفت من أن يضمر سجالي تذكرة للناس أنني لست مثل سارة. وفكرت لو أنني دخلت في دائرة رهاب المثلية، كهدفٍ محتمل، فإنه لن تشفع المعرفة بأن لدي زوجة وأطفال في توضيح حقيقة تضامني. سيقولون إنك تتضامن معهم لأنك مثلهم وما أسرتك سوى غطاء. وأدركت أن رهاب المثلية مرض معدٍ، وأن كثيرًا من راغبي التضامن قد يتراجعون عن إبداء تضامنهم خوفًا من أن يصيروا ضحايا رهاب الآخر.
جالت تلك الخواطر المقلقة في ذهني حين قرأت رد أحد زملاء العمل القدامى. كتب يشكرني على توضيحي ثم قال.. “لما شوفت شعار المثليين على صورتك قولت إزاي وامتى ده حصل.. أنا عارف “عُمر” كويس، الراجل ده صاحبنا بينا عيش وملح ومفيش حاجة تقول إنه كده”.
تناقشت مع بعضهم، وحدثتهم عن وهم الضحية “المثالية”، وعن أن التضامن ليس امتيازًا نمنحه لمن يشبهنا فقط. والتضامن مع فرد لا يعني أن تتبنى أفكاره أو تسلك نفس طريقه. ما الضرر الذي سيصيبك إن وسعت رحمة ربك كل شيء؟
نحن لا نملك أجسادنا. وطالما لم يربكنا الجسد بـ “عنف ماديته فإنه يظل مقبولا، أو يصير خصمًا نحاربه إذا تصدى للتوقعات” والمعايير والتصورات الثقافية والاجتماعية.
لحظتها أدركت مأساة من يحاول أن ينفض عن جسده المعايير التي لا تناسبه. فهو/هي عليه/ـا التجهيز لمعركة ضروس، أو الاستسلام الأبدي للكبت. قمع داخلي يمارسه الإنسان على نفسه. ولا أعلم ما موقفي من العالم لو كنت ضمن أقلية جنسية أو جندرية.
لكن التعليقات المتوجسة ليست الوحيدة التي أرقتني بالأسئلة. كتبت صديقة مؤكدة على كلامي بأن مصر مكان مثالي، فقط إن كنت “ذكر، مسلم، أبيض، غني”، أما إن كنت غير ذلك فأنت “عُرضة للأحكام المسبقة والمعاناة”.
وبعد أن حمدت الله سرًا أني لست غنيًا، ومع إيماني بتراتبية القمع والقرف في مصر، أي أن هناك فئات معرضة للاضطهاد والمعاناة بشكل يفوق فئات أخرى، فكرت في سؤال آخر..
هل الجسد الذكوري بمنأى عن القمع في مصر؟ وكيف يكون القمع إن وجد؟
تشريح الذكورية
تعمد الفتيات إلى تقليد النساء البالغات في الملبس والزينة والسلوك العام، ومحاكاة أفعال وإيماءات الراقصات المحترفات ونجمات الموضة. الأمر قريب من مشاهدتنا تقليد الصبية الصغار لنجوم المصارعة وأفلام الأكشن. محاولة التقرب من نموذج “مثالي” معطى سلفًا للذكورة والأنوثة. وإذا كانت محاولات الصبي الصغير لتقليد الذكور الكبار تثير الضحك أو المرح، فإن محاولة البنت الصغيرة فعل الأمر ذاته والتصرف كامرأة ناضجة لا يثير فينا إلا القلق والخوف.
تقول الفيلسوفة الفرنسية سيمون دو بوفوار.. “لا يولد المرء امرأة، بل يصير كذلك”. أي أن الجندر ليس هوية ثابتة بل مجموعة من الأفعال المتكررة. وتوضح جوديث بتلر أن الجندر يجب أن يُفهم “بوصفه الطريقة البسيطة التي تكوّن بها شتى الإيماءات والحركات والأداءات الجسدية” الصورة الجندرية للذات.
فصورة الجندر تخضع لتصورات تاريخية اجتماعية . لذلك فإن بوفوار تشدد على التمييز بين “الجنس” بوصفه “واقعة بيولوجية”، و”الجندر” بوصفه “التأويل أو الاستدلال الثقافي لتلك الواقعة”.
يتعرض النموذج المثالي، الذي تود الفتاة محاكاته، إلى نقدٍ مستمر، وهو في موضع تساؤل دائم. فمثالية النموذج تواجهها الوصاية الأبوية، والتقاليد، ومنظومة قيم الأسرة. ورغم تعسفية تلك المنظومة القيمية وعنفها وكثرة محاذيرها، فإنها تحفز الفتاة على التفكير في اختياراتها مبكرًا، بعيدا عن قدرتها على تنفيذ تلك الاختيارات. أي أن الفتاة ربما تكتسب مناعة نقدية تجاه ما يُقال حولها وما يُملى عليها.
أما الصبي أو الفتى، فإنه يشبه فريق كرة القدم المُنتصر. في أغلب الأحيان، يكون أداء الفريق الفائز محصنًا ضد النقد. لا أحد يهتم بالأداء طالما اعتبرت من الفائزين، أصحاب الأفضلية. وما يُنظر إليه بوصفه عيبًا في حالة الفتاة، يصير ميزة أو صفة مرغوبة في حالة الصبي، والعكس صحيح. تختلف النظرة إلى صفات مثل الجرأة والقوة والبذاءة والهدوء والخجل باختلاف النوع.
أقول إن تغييب النقد في مراحل كثيرة من تنشئة الذكر يحرمه من تكوين الوعي اللازم لمعرفة ذاته والآخر والعالم.
هكذا تصبح السلطة على جسد الذكر في مجتمعاتنا العربية منتجة لآثار “إيجابية” بالمعنى الذي صاغه فوكو. أما آثار السلطة على جسد الأنثى فإنها لا تُمارس إلا بكيفية “سلبية” أغلب الوقت، بـ”الطريقة نفسها التي تُمليها أنا عُليا ضخمة”، حد وصف فوكو. لذلك فإن رفضها يصير أسهل، أو بالأدق، تصبح آلية الرفض معروفة وواضحة.
الأنثى تعرف ما يجب أن تفعله كي تتحرر فعليًا، أما الذكر فلا يعرف، لأنه لا يدرك نوعية القمع الذي يُمارس عليه من الأساس.
بعد جريمة التحرش بطفلة في مدخل إحدى العمارات بالمعادي، وجدت منشورًا متداولًا بكثرة على صفحات وجروبات الأمهات، التي يطالعن فيها بعض المعلومات التربوية. المنشور عبارة عن نصائح لأي طفلة صغيرة، وهي في طريقها كي تصير امرأة: كيف تجلس، كيف تنحني لتلتقط شيئا من على الأرض، كيف تضحك، كيف تسير أو تهرول.
الأنثى تعرف ما يجب أن تفعله كي تتحرر فعليًا، أما الذكر فلا يعرف، لأنه لا يدرك نوعية القمع الذي يُمارس عليه من الأساس
كل تلك المحاذير تشحذ الوعي بحضور الجسد، لكنها تؤكد قبل ذلك على أن هذا الحضور يحدث وسط محيط خطير، حضور مُهدِد بالافتراس. على الأنثى أن تحذر من الذكر المفترس، وفي المقابل لا يُكلف الذكر بشيء إلا فيما ندر. كأننا خُلقنا لنَفترِس.
قصة مربكة
عرفت الفرق بين الجنس والجندر مبكرًا، مع بدايات القراءة في الصف الثانوي. والغريب أنني قرأت لأول مرة عن الفرق بين الرجل والذكر في قصة للكاتب المصري الكبير يوسف إدريس. عنوان القصة أبو الرجال من المجموعة التي تركت فيّ أثرًا عميقًا “العتب على النظر“. كان إدريس أول كاتب أعجب به، بنفس الطريقة التي تُعجب فيها بمطرب أو لاعب كرة. كان أيقونة أدبية. وشأن كل أيقونات البدايات، فإننا لا نلبث أن ننقلب عليها، ربما بسبب تغير الذائقة أو تطور الوعي، أو توهمًا منا بأن الانقلاب على أبطال البدايات نوعٌ من النضج.
الصورة السلبية المختزلة التي انطبعت بعد سنوات عن القصص الإدريسية هي أنها إما محصورة في نطاق الواقعية الاشتراكية، أو أن فكرة الغواية قائمة على “ضعف” المرأة، كأنها متأثرة برؤية “ريفية” عن المرأة. النساء شبقات على الدوام، يتمنعن وهن الراغبات.
في قصة “أبو الرجال”، يكتشف سلطان، بطل القصة، تغيرات غريبة في جسده وصوته. ويتساءل سلطان عن ما يحدث له، ولماذا الآن وهو رجل في الخمسين. عندما تجول بعينيه في أنحاء جسده اشمأز من نفسه، من الليونة والنتوءات التي تكونت فجأة في جسده. كما بدأ شعر ساقيه وصدره يقل. استنكر جسده شبه العاري وأحس به غريبًا عنه.
تبدأ ثورة التساؤلات في الاندفاع إلى عقل سلطان، وهل ما يحدث له وهم أم حقيقة؟ وكيف يصير كذلك وهو “أبو الرجال”، زعيم عصابة من عتاة المجرمين والمتمردين والقتلة، تشهق العيون لرجولته ويتحول الرجل إلى أرنب إذا نظر السلطان إليه.
تبدأ ثورة التساؤلات في الاندفاع إلى عقل سلطان، وهل ما يحدث له وهم أم حقيقة؟ وكيف يصير كذلك وهو “أبو الرجال”، زعيم عصابة من عتاة المجرمين والمتمردين والقتلة، تشهق العيون لرجولته ويتحول الرجل إلى أرنب إذا نظر السلطان إليه
يستدعي سلطان أحد رجاله، ويدعى الثور بسبب فحولته البادية عليه. لكن سلطان يظل جالسا في صمت أمامه سارحا في أفكاره عن رحلة حياته، “قصة طويلة مليئة بإرادة الفلاح الرهيبة”. من الفقر المدقع لأبيه إلى التفوق الدراسي والعمل السياسي أيام الجامعة ثم إلى الزعامة والنفوذ. تداهمه أحلام يقظة وتخيلات عن نفسه بين أحضان الثور، تتعاظم بداخله الرغبة بأن يضاجعه الثور.
“نداء مولول قد تحولت إليه ذكورته، ولا يعود يقاوم”. يرتحل في ذاكرته منقبًا عن منشأ أو سبب لما يحدث له. كل هذا والثور يجلس خاضعًا أمام الصمت الإلهي لسلطان.
أخذ يفتش عن موقف أو ذكرى أقدمت الأم فيها على جرح رجولته، عن لحظة شك في رجولته المبكرة لكنه لم يجد. حتى عندما فتحت أمه باب الزريبة ووجدته منفردًا بحمارة عمه، تصرفت “في حنكة كأنها طبيبة أمراض نفسية” حينما رأت الذعر الخجول في ملامح ابنها. استدارت ثم قالت من خلف ظهرها “كيف تركب حمارة عمك من غير بردعة يا جحش”. “هكذا أبرأته هي حتى أمام نفسه”، كما يقول النص.
ثم تتوالى الذكريات والمواقف من مراحل حياته المختلفة. وفي النهاية يقترب سلطان من الثور الذي ظن أن سلطان يريد أن يطلب منه ما يُطلب من النساء. لكن المفارقة في أن الطلب كان عكس ما وطّن الثور نفسه على الاستجابة إليه. مذهولا لما حدث ويحدث، فرحان أنه نجا، وإن كان بطريقة أخرى قد وقع”.
رمزية تحول سلطان، كما يقدمها يوسف إدريس، تعبر عن تحول الرجل عن مبادئه، وخيانته لكلمته، فـ “الرجل يربط لرجولته من لسانه”. كأن إدريس يريد لهذا الربط المجازي أن يجد تحققه المادي على مستوى الجسد. ويلمح السرد إلى حادثة مهمة داخل القصة، حين يُجبر سلطان على قول “أني مرة” ونصل المنجل مغروس في عنقه. أجبره على ذلك شاب في فورة غضب من إهانات سلطان المستمرة له وسط حاشيته.
يؤكد إدريس في أبو الرجال على فكرة اللوجوس/ الكلمة، أن الكلمة هي ضمان الحضور الكلي للعالم. يصبح لسان سلطان كلسان آدم الذي ذكرناه في البداية، يبعث لسانه الكلمة إلى الحياة. وفي حالته، فإن ما بعثه كان المرأة التي تحول إليها، أو التي كانت موجودة بداخله، خلف الشارب والصوت المزلزل المرعب.
هكذا يربط إدريس الخنوثة بالسقوط. كأنها علامة على التحلل و”تراخي الإرادة”.
إلا أنه قرب منتصف القصة، حين يأتي الراوي على ذكر الأم، تطالعنا تلك الكلمات المباشرة.. ” الرجل ليس بكثافة شاربه وشدة طغيانه، ولكن الرجل رجل؛ لأنه شهم وكريم وشجاع ومضح ومغيث للملهوف، وواقف بجوار المظلوم، مع الضعيف حتى يقوى، وضد القوي حتى يعدل ويعتدل، وتصبح قوته في خدمة العدل والحق. والمرأة امرأة لا بحسنها ودلالها وأنوثتها، وإنما بعملها الأعظم في أن تكون الأم الأعظم لبشرية أرقى، فالأمومة كالرجولة ليست صفة، ولكنها قيم، درجات عليا من السلوك البشري العاطفي والعقلي وحتى الجسدي، بها تفرد الإنسان وعلى هديها وصل إلى قمة في التطور جعلته أسمى حي في الوجود.. الأم”.
يبدو الخطاب القصصي متناقضًا. فإن كانت الرجولة مجرد صفات شكلية، فلا معنى إذن لضياعها أو تحولها. توحي عبارات كثيرة بالقصة أن سلطان لم يعد رجلًا، وأن إحساسه نحو جسده قد تغير..
“يحس كلما نظر إليه شاب وأطال النظر، أنه يرى فيه ما يخجل، فيخجل خجلا ليس مثلما كان يخجل حين كان السلطان، ولكنه خجل الخجلان من نفسه فعلا، الخائف على نفسه من الآخرين فعلا، الموشك أن يخفي كل قطعة من لحمه أو عضلاته كأنما ستفضح خجله، أو تفضح أنه لم يعد أبدا ذلك الرجل الذي كانه “.
فهل خسر سلطان الرجولة شكلًا لأنه خسرها مضمونًا من قبل؟ يبدو أن إدريس يفرق بين رجولة حقيقية ورجولة شكلانية/ مزيفة. ولا يبين السرد إن كانت التغيرات قد حدثت بالفعل، أم أنها مجرد هواجس وضلالات تعكس رؤية سلطان المتأزمة تجاه ذاته.
كذلك فإن الأمومة هي عمل المرأة الأعظم. الأم أرقى درجة في سلم التطور الخاص بالمجتمع، هذا المجتمع نفسه يعتبر المرأة سُبة في ذاتها. ربما نجح إدريس في تمثيل هذا التناقض عبر بطله المأزوم. فلا ينبغي أن ننسب خطاب الراوي الكاتب الضمني للنص، إلى إدريس، كاتبه الفعلي.
عقدة أوديب والمجتمع
كأن الأم هي المرأة الوحيدة المُقدرة من قبل المجتمع. المرأة “المطمئنة”. ينظر إليها المجتمع “كما ينظر الطفل لأمه في علم النفس.. المرأة التي انتهت من الرغبة الجنسية للأبد، مرة واحدة، لتصير ملكا لأبنائها”، كما تقول الكاتبة فيروز كراوية في مقالها عن المرأة وتمثيلها في خطاب الصحوة الإسلامية. تصف كراوية هذه الصورة قائلة ..
“هكذا المرأة المناسبة لمجتمعات السلطوية الدينية الريفية.. حاضنة السلطوية الأولى”، والمجتمع بأنه “مجتمع متشبث بأمه، عاجز عن فراق طفولته”، لأنه مازال واقعًا تحت وطأة “عقدته الأوديبية”.
لكن إن كانت عقدة أوديب تسمح بقراءة المجتمع وفهم العلاقات داخله، فإنها يمكن أيضًا أن تشكل نوعًا من التعمية.
حسب توظيف فرويد عقدة أوديب في تحليله النفسي، يدخل الطفل إلى الدور الرمزي للرجولة بعد أن يقيم سلامًا مع أبيه ويتوحد معه. وقبل ذلك، فإن ما يدفع الطفل-الذكر للتخلي عن رغبته المحارمية في الأم هو تهديد الأب بإخصائه.
هذا التهديد المتخيل في إدراك الطفل الذكر ينشأ من إدراكه أن الطفلة هي نفسة “مخصية”، فيتخيل أن مثل هذا العقاب قد ينزل به. يتجاوز الطفل عقدة أوديب بأن يدفع برغبته المحرمة إلى الخفاء، بكبتها في اللاوعي. قبل ذلك التجاوز، يستمد الطفل بهجة شبقية من جسمه ذاته، وهو فوضوي وسادي وباحث عن المتعة بلا هوادة تحت نير ما يسميه فرويد مبدأ اللذة.
ووفقًا له، فإن الطفلة تدرك “دونيتها” لأنها “مخصية”، لذلك تتوحد مع الأم بعد فشل المحاولة بإغراء الأب. وتحسد الطفلة القضيب لأنها لا يمكنها امتلاكه، لذلك فإنها تستبدله بصورة لا واعية.
وتمثل عقدة أوديب بالنسبة لصاحب تفسير الأحلام بداية الأخلاق والقانون وكل أشكال السلطة الاجتماعية والدينية، كما يوضح تيري إيجلتون.
كأن الأم هي المرأة الوحيدة المُقدرة من قبل المجتمع. المرأة “المطمئنة”. ينظر إليها المجتمع كما ينظر الطفل لأمه في علم النفس.. إنها المرأة التي انتهت من الرغبة الجنسية مرة واحدة وللأبد، لتصير ملكا لأبنائها
واجهت نظرة فرويد للنساء، بأنهن حاسدات للقضيب، انتقادات عديدة. وعلى الرغم من تجاوز التحليل النفسي الرؤية الفرويدية للدور الجنسي الأنثوي، حتى من قبل المنظرين الفرويديين أنفسهم مثل جاك لاكان، فإننا لا زلنا نستبطن فكرة حسد الأنثى للقضيب، وبالتالي سيادته، كأنها فكرة تأسيسية ضمن أقانيم لا وعينا الجمعي.
يميز جاك لاكان بين الخيالي والرمزي، وهما مصطلحان يستخدمهما لوصف تطور الطفل. أما مصطلح الخيالي فيرتبط بالمرحلة السابقة على المرحلة الأوديبية، ويبدأ الطفل فيها التعرف على نفسه بتعرف جسد أمه. وتغدو علاقته بالعالم علاقة قوامها الاتحاد. حالة لا تنطوي على تمييز واضح بين الذات والموضوع، وهذه المرحلة ببعدها الخيالي يسميها لاكان “مرحلة المرآة”. وبدخول الأب في بنية العلاقة، يتكون المثلث الأوديبي. ويدخل الطفل في البُعد الرمزي الذي يتعرف من خلاله موقعه ضمن شبكة أوسع من العلاقات، وبنية اجتماعية أكثر تعقيدًا.
دخول الطفل إلى عالم الاختلافات “الرمزي” يدفعه إلى التمييز: أنثى/ذكر، أب/ابن، حاضر/غائب. ويؤكد لاكان أن القضيب، كرمز لا عضو، “دال مفارق”، فـ”القضيب في المجال الرمزي هو الملك”، كما يوضح رامان سلدن.
وفق الرؤية اللاكانية، القضيب ليس العضو الذكري الفعلي، “إنه مجرد محدد فارغ للاختلاف، علامة على ما يفصلنا عن الخيالي، ويزرعنا في مكاننا المقدر سلفًا داخل النظام الرمزي”.

إلقاء أوديب الصغير في البراري ليلقى حتفه بتوجيهات من والده الملك. مشهد من فيلم “أوديب مَلكاً” للمخرج الإيطالي Pier Paolo Pasolini. المصدر: يوتيوب
ولأن الخيالي والرمزي، كليهما، لا يمكنهما إدراك الواقع إدراكًا كاملًا، فإن حاجتنا الغريزية تتشكل بواسطة الخطاب الذي نعبر به عن مطلبنا. يحتاج المجتمع إلى خطاب حول الرغبة والغريزة. وكما يشير تيري إيجلتون، فإن المجتمع الحديث، في رؤية ما بعد البنيويين، “متمركز حول القضيب Phallocentric “، وهو أيضًا متمركز حول اللغة Logo centric”، وفي الحالتين اعتقاد بتحقق كامل للصدق وحضور الأشياء.
أدغم جاك دريدا هذين المصطلحين في المصطلح المُركب Phallogocentric. وهو ما نراه في خطاب لغوي يتيح، بثقة مفرطة في صدق رموزه، إدامة الهيمنة أو الاستباحة أو التمييز الجنسي.
ويمكن أن نلحظه في أمثلة حياتية دالة.
منها أن يرسل رجل صورة قضيبه إلى امرأة لا يعرفها على حسابها بمواقع السوشيال ميديا. إنه في نظر الرجل الرمز الذي يٌغني عن الكلمات. إحالة استعارية تكشف عن الوعي البائس لصاحبها، وتكشف أيضا عن ثقة مفرطة في طبيعة الرمز.
ومنها ذكر أعضاء من جسد المرأة بوصفها سبة في ذاتها. تحقير دلالي متعمد. تصير من خلاله أعضاء الجسد علامات على الدونية. وسيميوطيقا الاحتقار هذه غريبة جدًا لأنها لا منطقية.
تحويل نقطة الضعف
تابعت ذات يوم من بلكونة البيت مشادة كلامية بين عدة أطراف. كانت هناك امرأة تجادل الطرف الآخر، حول إيجار بيت أو أعمال صيانة تقريبًا. وحين احتدم الجدال، قال الرجل الذي أمامها: “انتي حتة كُس أصلًا “. كان هذا رده على لومها المتصاعد له. بعدها هاج من معها وماجوا ، وبالطبع مات الكلام. مات لأنه وصل إلى نقطة، كانت فيها الدلالة من العنف الذي يفجر جدوى الكلام ومعناه من حولها. وبالطبع تحولت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي.
هذا الموقف نمطي ومتكرر رغم لا معقوليته الفجة. لكن هناك بعض المواقف الاستثنائية التي يمكن للواحد أن يراها في مجتمعنا الحبيب. منها ما رأيته وما يمكن أن نراه في بعض المناطق الشعبية.
في تلك المناطق، وحين يشتد الوغى ويحمى وطيس المعركة، تقوم المرأة المخضرمة إن كانت إحدى أطراف المعركة، برفع عباءتها ووضع ذيلها بين أسنانها، لتكشف بذلك عن الذي لا نذكر اسمه وتشير إليه بإصبعيها الوسطيين، في مناورة استراتيجية رائعة، تحيل بها ما قد يظنه البعض نقطة ضعفها إلى قوة. ولسان حالها يقول..
“أهو.. اللي عنده حاجة يقولها”.
تكشف أفعال الاستباحة والتحرش اللفظي والجسدي بالمرأة عن نظرة دونية وتحقيرية إليها. إلا أن تلك النظرة تنطوي، في عمقها، على حسد ذكوري لجسد المرأة. ربما الحسد لا الاحتقار هو محرك الرجل في علاقته بالمرأة. وبالطبع، هذا ليس عزاءً للأنثى أو تبريرًا للذكر. إنه يحسد المعرفة الأنثوية بالجسد، الإحساس به والنضال من أجله، بينما يرزح الذكر تحت صور معرفية متوهمة عن نفسه، بوصفه الأقوى، والأكثر عقلانية وطهارة.
الذكر وفق هذا اليقين أشبه بالانتحاري الذي يُفجر نفسه إلى أشلاء على أمل أن يعاد تجميعه في الجنة وسط سبعين من الحور العين. كأن كل ذكر هو قنبلة موقوتة محتملة، وذلك هو عنف “الوثوقية”. فاليقين الذي يربط الأفكار الذكورية إلى صاحبها يجعل فك روابطها غير ممكن، إلا عن طريق صدمة تهشمها أو ضغط هائل يفجرها، تماما مثل الروابط الكيميائية التي تحتاج إلى كم هائل من الطاقة كي تنحل.
جسد الذكر في قمع مركب، فهو خاضع مثل غيره من الأجساد إلى هيمنة السلطة، لكنه يجهل شروط خضوعه. مما يجعل تحرره مستحيلًا، واحترامه للجسد “الآخر” كرهًا لا طوعًا.
مجازات الجسد
تنطلق الكاتبة الأمريكية كاميلي باليا في سفرها الضخم “أقنعة جنسية” من منظور طبيعي وبيولوجي للجسد. وهي تتخذ من الطبيعة دليلًا على تفرد الجسد الأنثوي وتفوقه، وفي الوقت نفسه تعارض الكثير من الرؤى النسوية حول البطريركية والبنى السلطوية بالمعنى التاريخي السياسي.
تنظر باليا إلى المرأة بوصفها “الكيان الأصل”، مثل الطبيعة. وقد خاب سعي الرجل في السيطرة على المرأة صاحبة الرحم بتجلياته الرمزية.. المظلم، والكثيف، والمخيف، والحنون.
تؤكد باليا على الأساس البيولوجي للفروق الجنسية، وترى المرأة بوصفها القوة الغالبة التي تلعن الرجل بنوع من القلق الجنسي طوال حياته، وما الإنجازات العقلية والبدنية إلا وسيلة الرجل للهروب من ذلك القلق.
تقول باليا إن النسوية قد ورثت كل تناقضات الليبرالية الحديثة، الليبرالية التي تبجل الفرد والحرية وتشجب النظام الاجتماعي ومن ناحية الأخرى تطالب ذلك النظام بسلوك أمومي حاضن وداعم.
تقول إن النسوية ترى.. ” كل هرمية قامعة خيالًا اجتماعيًا، وترى كل ما هو سلبي حول المرأة ذكرًا قابعًا صمم خصيصًا ليُلزمها مكانها. لقد تجاوزت النسوية مهمتها الصحيحة في السعي إلى مساواة النساء سياسيًا، وانتهت إلى رفض الحدث العرضي، أي محدودية القدرة البشرية أمام الطبيعة أو القدر”. وتؤكد أن الحرية الجنسية أو التحرر الجنسي مجرد ضلالات حديثة، فما نحن إلا حيوانات في تراتبية هرمية”. والمجتمع هو “المانع الرخو ضد الطبيعة”.
وتبين أن التكامل بين جسد الإنسان وذهنه يمثل مشكلة عميقة، وأن طبيعتنا الجسدية ما هي إلا عذاب فالجسد شجرة الطبيعة التي نُصلب عليها. والجنس لايمكن فهمه لأن الطبيعة لا يمكن فهمها، والبحث عن الحرية من خلال الجنس يُعد أمرًا محكوما عليه بالفشل.
الحرية الجنسية أو التحرر الجنسي مجرد ضلالات حديثة، فما نحن إلا حيوانات في تراتبية هرمية”. والمجتمع هو “المانع الرخو ضد الطبيعة”
تغوص باليا في الميثولوجيا والثقافات الشعبية القديمة من أجل فهم الطرز الأولية أو الأنماط البدائية للوعي بالجسد بين الذكر والأنثى. لذلك فهي ترى أن الديانات السماوية لم تستطع هزيمة “الوثنية”، وأن الثقافة الغربية في علاقة ضدية مع الطبيعة التي كانت متوحدة مع المرأة.
وفي مجتمعات الصيد أو الزراعية، كانت الأنثوية محتفى بها، ويتم تمجيدها كأساس بارز للخصوبة. واخترع الرجل الثقافة كدفاع ضد الطبيعة الأنثوية. وترى باليا أن المطابقة بين المرأة والطبيعة، التي لن يوافق عليها معظم النسويات، ليست أسطورة بل واقع. فالرجل قد أجَلَّ المرأة كما أجَلَّ الطبيعة، لكنه كان يخافهما. فهي كانت “الفك المظلم الذي لفظ الرجل خارجه، وسيعود ليبتلعه مجددًا”. وهو ما يذكرني من أبيات قصيدة العقاد..
أسائل أمنا الأرض سؤال الطفل للأم
فتخبرني بما أفضى إلى إدراكه علمي
جزاها الله من أم إذا ما أنجبت تئدُ
تُغذي الجسم بالجسم وتأكل لحم ما تلدُ
مثلت “مركزية” المرأة عقبة أمام الرجل. والفكرة القيامية مثل فعل التناسل عند الرجل.. مجرد “ذروة قضيبية” لحظية. والمرأة الحبلى طوال تسعة أشهر تكون نموذجًا “لوحدة وجود النفس”. وكما تقول باليا.. “العبودية الذكرية والبطريركية كانت الخيار الإجباري للرجل بحكم شعوره المريع بقوة المرأة، قوتها المانعة، وتحالفها الأصلي مع الطبيعة الأرضية. فجسد المرأة هو التيه الذي يهيم فيه الرجل على وجهه. إنه الجسد.. الحديقة المسورة.. نموذج البستان الشيطاني”.
وتؤكد أن “النساء لسن في حاجة إلى صياغة مفاهيم ليكن موجودات”. وتتناول المجاز المتعلق بالأعضاء التناسلية للرجل، وهو التركيز والإسقاط، وهو النموذج المثال لكل إسقاط ثقافي وصياغة للمفاهيم.
ومن خلال رؤية مجازية عميقة، توضح باليا أن.. “تيقن الرجال الوهمي من أن الموضوعية ممكنة إنما يقوم على إمكانية رؤيتهم أعضائهم التناسلية”. أما النساء فهن أكثر قدرة على تحمل الغموض، ولذلك هن أكثر ميلًا إلى الموضوعية، فعجزهن عن معرفة أجسادهن بشمول خلق تقبلا لفكرة المعرفة المحدودة على أنها ظرفهن الطبيعي. وهي “حقيقة إنسانية كبرى قد يفني الرجل عمره ليصل إليها”، بتعبير باليا.
وتوضح باليا كذلك أن المساواة السياسية سوف يقتصر نجاحها على النجاح السياسي ولكن لا حيلة لها أمام النموذج الأصلي/ الطرز البدائية archetypal، والذي وفق مفهوم كارل يونج، يشكل العقل اللاواعي الجمعى. فهناك طرائق للفهم سليقية ولاواعية وهي هذه الطرز الأولية، أشكال فطرية من (الحدس) وتمثل محددات مهمة في جميع العمليات النفسية. فكما أن الغرائز تحدد أفعالنا كذلك فإن الطرز الأولية تحدد طرائق فهمنا. وتتسم الغرائز والطرز الأولية بصفة جمعية فهما معنيتان بالمكونات العالمية المتوارثة الممتدة إلى ما وراء كل شخصي أو فردي النزعة.
وكذلك لن تنجح “الخنوثة”، وهي النموذج الذي تروج له بعض النسويات بوصفه نموذجًا مسالمًا معارضًا للعنف في سبيل يوتوبيا جنسية. وتعمل النسوية على “تسييس الخنوثة كسلاح ضد المبدأ الذكوري”. لا ترى باليا الخنوثة كفعل التباس أو سقوط كما في قصة يوسف إدريس. لكنها تعتقد أنها لا يمكن أن تؤثر على الواقع الفعلي أو “الطاقة العدوانية للشوارع”.
العبودية الذكرية والبطريركية كانت الخيار الإجباري للرجل بحكم شعوره المريع بقوة المرأة، قوتها المانعة، وتحالفها الأصلي مع الطبيعة الأرضية. فجسد المرأة هو التيه الذي يهيم فيه الرجل على وجهه. إنه الجسد.. الحديقة المسورة.. نموذج البستان الشيطاني
بعد الإسهاب السابق في تأملات واستبصارات الكاتبة الأمريكية كاميلي باليا، أجدني قد رجعت إلى البداية، إلى الجسد كبداية للعلاقة بين الأرض والسماء، وبين المقدس والمدنس، وبين الإنسان والعالم. اليقين الوحيد الذي يلازمني الآن هو عدم وجود حقيقة نهائية للجسد.
اليقينية في تعاملنا مع مفهوم الجسد ستعيقنا عن فهمه بالتأكيد.
لكني أدركت كذلك شيئا آخر؛ أن كل المسارات التي يتخذها الإنسان بشكل يفارق وجوده الطبيعي، أو فوق هذا الوجود، هي في علاقة مع هاجس فناء الجسد.
يدرك الفنان حتمية الفناء، لذلك يكابد ألم الخلق الفني أملًا في الخلود بعد الموت. والرياضي العظيم يحاول أن يدفع جسده إلى ما بعد حدوده القصوى من أجل البطولة في أبسط أشكالها ملحمية. هناك من ينغمس في اللذة حد الغرق، فطالما تلخصت النهاية في أن نكون وجبة للدود، فلا معنى للحياة القصيرة إلا بالسعى وراء اللذة. والناسك الذي يعمل على إماتة الجسد، يحركه اليقين في حياة أخرى.
وكذلك كان الوعد حال صعودنا مرة أخرى إلى السماء، أن نكون في هيئة آدم، في سن الثلاثة والثلاثين، في شباب دائم. كأن الفردوس امتياز للجسد، وكفارة له عن آثار السقوط.